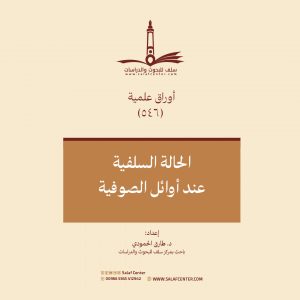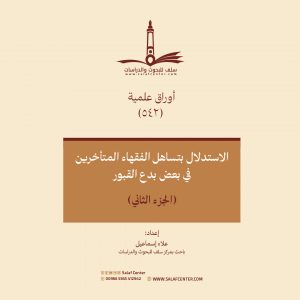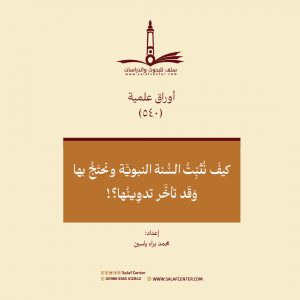العقلُ أصلٌ والشرعُ تَبَعٌ ..قانونٌ كُليٌّ أو مُغالَطة؟ (قراءة في أدبيات السّجال العقدي)
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
لا تخطئُ عينُ المطالع للسجال العقدي وكتُب التراث الكلامي عمومًا رؤيةَ جدلٍ كبير حول العلاقة بين العقل والنقل، وهي قضية قد بُحثت كثيرًا، وللعلماء تحريرات حولها. والذي أودُّ إبرازه هنا مناقشة قضية أصالة العقل وتبعية الشرع، وبها يظهر أنها ليست مُسلَّمَة أو قانونًا يُرجع ويُحتكم إليه عند التعارض، إن كان ثمّ تعارض حقيقيّ.
فإنه قد بات مُسلَّمًا لدى كثير من المتكلمين وبعض الباحثين المعاصرين صدق هذه القضية والتعامل معها كأنها قانون كلّيّ، وما هي إلا حصن تحصّن به من كانت له مخالفة لظاهر النَّص الشرعي بفكرة مادّتها العقل، وهي مليئة بالمغالطات، فضلًا عن لوازمها وآثارها السيئة.
وبين يدَي هذه الدراسة المختصرة أورد مثلًا مقرِّبًا لفكرة هذه الدعوى:
جاء مريض يبحث عن طبيبٍ حاذق مشهور بمهارته في الطبّ، وأخذ يسأل الناس، فسأل عاميًّا فدلَّه على طبيب حاذق، فذهب المريض إليه، ثم وصف الطبيب للمريض علاجَ ما يشكو منه. ولما خرج المريض سأله الرجل العامي الذي دلَّه قائلًا: ماذا وصف لك الطبيب؟ فأخبره المريض بنوع العلاج، فقال له العامي: إن هذا العلاج غير نافع، وينبغي أن تتركه، ولا تتناوله، فقال له المريض: أنت لا تعرف شيئًا في مهنة الطب، وأما الطبيب فهو من أهل اختصاص. فقال العامي: لا، بل يجب أن تسمَع قولي؛ لأني أنا من دلّك على الطبيب، وأنا الذي زكيته لك، فيجب أن تأخذ بقولي في محلّ الخلاف؛ لأن عدم الأخذ بقولي يقدح في الأصل الذي عرفتَ به الطبيب.
فهنا يقال للعامي: علمُكَ بأنه طبيب ماهر لا يعني أبدًا علمَك بمهنة الطب، وشهادتُك بوجوب إتيانه والأخذ عنه دونَ تقليدك، وموافقتي لك في العلم بأنه طبيب حاذق لا يستلزم بالضرورة أنني أوافقك في العلم بأعيان المسائل التي هي محل الخلاف بينكما، وخطؤك في أعيان المسائل التي خالفتَ فيها الطبيب لا يسلزم خطأَك في دلالتك عليه وشهادتك وتزكيتك له، وفي علمك بأنه طبيب حاذق.
فهذا مثالٌ مقرِّب، مع الفارق الكبير بين الرسول والطبيب، وقيام احتمال ورود الخطأ من الطبيب في وصف المرض وعلاجه، وتنزُّه الرسول عن الخطأ في نقل الشرع والوحي.
ويكفي لبيان بؤس تقلُّد مقولة “العقلُ أصلٌ والشرعُ تبع” أنهم جعلوه «قانونًا كليًّا فيما يُستدلّ به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يُستدل به؛ ولهذا ردُّوا الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى، وغير ذلك من الأمور التي أنبؤوا بها، وظنَّ هؤلاء أنَّ العقل يعارضها، وقد يضمّ بعضهم إلى ذلك أنَّ الأدلة السمعية لا تُفيد اليقين»([1]).
وفضلًا عن هذا فإن هذا الموقف الذي كان سببًا في رفع شأن العقل وحطّ منزلة النقل والوحي يشار إليه بأصبع الاتهام في شرع أبوابٍ من الضّلال؛ وقد نصَّ البعض على أنه قد كان «ذلك الموقف هو مدخَل الإلحاد»([2])، فهذه المعارضات العقلية للوحي والنقل كفيلة بإذهاب الإيمان أو تشويشه، وبعث الشكّ فيه جملة وتفصيلًا.
أما إذا نظرنا في تفاريق المذاهب والفرق فسنجد دعاوى القوانين الكلية لا تكاد تختصُّ بطائفة دون أخرى من المخالفين لأهل السنة والجماعة، فهي طريقة مُطَّردة لكل من خالف الحقَّ في أمرٍ ما؛ فـ«يضع كلُّ فريق لأنفسهم قانونًا فيما جاءت به الأنبياء عن الله، فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنّوا أنَّ عقولهم عرفته، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعًا له، فما وافق قانونهم قبلوه، وما خالفه لم يتبعوه»([3]).
المبحث الأول: دعوى أصالة العقل وتبعية الشرع:
استقرَّت دعاوى بعض المذاهب الكلامية بتقديم العقليات على السمعيات، وجعله أصلًا وقانونًا كليًّا، ونلحظ فيها استقرار القانون العقليّ عند توهُّم معارضة العقل للنقل، فيلجؤون إليه على أنه قانون مُسَلَّم عندما يُواجَهُون بالنصوص.
ومن ذلك موقف الماتريدية: فقد ساق التفتازاني رحمه الله عددًا من آيات الصفات، ثم ذكر قانونًا كليًّا في الجواب عنها، فقال: «والجواب: أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية، فيُقطَع بأنها ليست على ظاهرها، ويُفوَّض العلم بمعانيها إلى الله، مع اعتقاد حقيقتها؛ جريًا على الطريق الأسلم… أو تؤوَّل تأويلاتٍ مناسبة موافقةً لما عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في كتب التفسير وشروح الأحاديث؛ سلوكًا للطريق الأحكم»([4]).
وكذلك موقف الأشاعرة: فهم يقرِّرون بأن الاستدلال بالنقل متوقِّف على حكم العقل بالجواز، وإلى هذا الموقف ذهب أئمةُ الأشاعرة، أمثال الباقلاني([5]) والجويني([6]) والغزالي([7]) والرازي([8]).
يقول الغزالي: “كلُّ ما دلَّ العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال؛ إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها، فإن ورد دليل سمعيّ على خلاف العقل، فإما ألا يكون متواترًا فيعلم أنه غير صحيح، وإما أن يكون متواترًا فيكون مؤوَّلًا ولا يكون متعارضًا، وأما نصٌّ متواتر لا يحتمل الخطأ والتأويل وهو على خلاف دليل العقل فذلك محال؛ لأن دليل العقل لا يقبل الفسخ والبطلان”([9]).
ثم وضع الرازي تقديم العقل على النقل في قانون كليّ اعتمده المتكلّمون، وهو قوله: «اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء، ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. وإما أن نبطلهما، فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية. وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية، وذلك باطل؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثباتَ الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول r وظهور المعجزات على يد محمد r، ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متّهمًا غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معًا، وإنه باطل. ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها غير صحيحة، أو يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. ثم إن جوّزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم نجوّز التأويل فوّضنا العلم بها إلى الله تعالى. فهذا هو القانون الكليّ المرجوع إليه في جميع المتشابهات»([10]).
ويقول الرازي: «قيل: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين؛ لأنها مبنية على نقل اللغات، ونقل النحو والتصريف، وعدم الاشتراط، وعدم المجاز، وعدم الإضمار، وعدم النقل، وعدم التقديم والتأخير، وعدم التخصيص، وعدم النسخ، وعدم المعارض العقلي، وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم، والموقوف على المظنون مظنون، وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية، وأن العقلية قطعية، والظن لا يعارض القطع»([11]).
وقد بُنِي هذا القانون على افتراضاتٍ ومقدمات جدلية ثلاثة، وهي:
- ثبوت التعارض بين العقل والنقل.
- وانحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه.
- وبطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع: وهو تقديم العقل([12]).
أما أهل السنة والجماعة: فيرون أنَّ للعقل مع الشرع ثلاث حالات:
الأولى: أن يدلَّ على ما دلَّ عليه الشرع، فيكون شاهدًا ومؤيِّدًا ومصدِّقًا، فيحتجّون حينئذ بدلالة العقل على من خالف الشرع، وفي القرآن من هذا النوع -أي: من الأدلة العقلية- شيء كثير، فأدلّة التوحيد والنبوّة والمعاد، فتلك الأدلة هي عقلية شرعية.
الثانية: ألا يدلّ على ما دلَّ عليه الشرع لا نفيًا ولا إثباتًا، فحكم العقل إذن جوازُ ما جاء به الشرع.
الثالثة: أن يدلّ العقل على خلاف ما جاء به الشرعُ، فيكون معارضًا له، فهذا ما لا يكون مع صحَّة النقل، ولهذا قال أهل السنة: إنّ العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح، وقالوا: إنَّ الرسلَ جاؤوا بمجازاتِ العقول لا بمحالات العقول، أي: أن الرسل لا يخبرون بما يُحيله العقل، ولكن يخبرون ما يجيزه العقل ويَحارُ فيه. هذا تحديد موقف أهل السنة من العقل والشرع، فإذا دلَّ العقل على خلاف ما جاء به الشرع الثابت الصحيح نتَّهم العقل ونخطِّئه، ونتبع النقل الثابت الصحيح([13]).
ونقل الإمام قوام السُّنة الأصبهاني عن أبي المظفر السمعاني قوله: «فصلُ ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل؛ فإنهم أسَّسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول، وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع، والمعقول تَبَعٌ، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئًا حتى يعقلوا»([14]).
المبحث الثاني: نقد دعوى أصالة العقل وتبعية النقل:
قام علماء السنة بدحض المقدمات المؤسِّسة في قضية أصالة العقل وتبعية الشرع، وكشف زيغها، وبيَّنوا أنها مغالطة، وليست قانونًا كليًّا.
وخلاصة هذه الدعوى أنَّ العقل أصلٌ والشرع تبَعٌ، ولا يستدلّ بالنقل إلا إذا أجازه العقل، وعند التعارض يُقدَّم العقل على النقل؛ إذ إن ما ثبت بالعقل قطعيّ، وما ثبت بالنقل ظنيّ، والظني مصيره إما التأويل أو التفويض.
وفيما يلي تفنيد هذه الدعوى:
أولًا: منع أساس هذا القانون المُدَّعى (منع تعارض العقل والنقل):
فإن العلوم الضرورية لا تتعارض، فلا يمكن إثبات أن نقلًا صحيحًا عارض عقلًا سليمًا([15]). فالنص إذا صح سندًا ومتنًا وفهمًا لا يتعارض أبدًا مع الدلائل العقلية الصريحة الصافية من الشبهات والخالية من الشكوك.
أما الذين يقولون بإمكان التعارض بينهما فتجد أحدهم يدَّعي أن ما معه من النقل صحيح، وقد يكون الأمر خلاف ذلك، وقد يكون النقل صحيحا، ولكن ما فهمه منه ليس فهمًا صحيحًا.
وكذلك تجد الآخر يدَّعي أن معه من الدلائل العقلية المعارِضة للسمع ما يردُّ به نصًّا صحيحًا، وعند التأمّل تجد أن ما معه ليس له من النظر العقلي الصحيح نصيب، وإنما هو شبهات فاسدة أو شكوك طارئة، سرعان ما تزول بالبرهان القطعيّ الصريح، أما أن يكون النقل صحيحًا والدليل العقليّ صريحًا فهذان لا يمكن أن يتعارضا أبدًا([16]).
والعقل والنقل وسيلتان لتحقيق غاية واحدة هي الوصول إلى الحق، والتعرف عليه في الأقوال والأفعال والاعتقادات، والوسائل التي تؤدي إلى غاية واحدة لا يعارض بعضها بعضًا، وإنما يؤيّد ويعاضد بعضها بعضًا؛ فكلاهما حقّ والحق لا يعارض الحقّ أبدًا.
والمتكلمون يزعمون وجود تعارض بين العقل والنقل في المسائل التي خالفوا فيها الحق، وهذه دعوى غير صحيحة بنفسها، ولا وجود لها إلا في عقولهم، أما الواقع فإنَّ العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح.
ومرجع ذلك إلى حقائق مهمة، منها:
الأولى: أن الذي خلق العقل هو الذي أنزل الشرع، فذاك خلقُه، وهذا أمرُه، فكيف يمكن أن يكون بينهما تعارضٌ ومصدرهما واحد وهو الحق سبحانه؟!
الثانية: أن الله تعالى في القرآن الكريم قد دعا في مواطن عديدة إلى استخدام العقل والنظر من خلاله إلى آياته وبيناته ليصل الإنسان إلى الإيمان بالله ورسله، كما قال جل وعلا: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24]، وقال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} [سبأ: 46].
الثالثة: أن الله عز وجل قد أبان في مواطن عدة من كتابه أن سبب هلاك من هلك من أهل النار أنهم لم يستخدموا عقولهم الاستخدام الصحيح، كما قال تعالى: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الملك: 10]، وقال: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [الأعراف: 179]؛ فلهذا لا يمكن أن يكون بين العقل الصحيح والنقل الصحيح تعارض بحالٍ من الأحوال.
ثانيًا: أن القسمة لا تنحصر فيما ذكروه:
فعلى تقدير المحال يقال: يمكن تقديم الدليل العقلي تارة والسمعي أخرى، فأيهما كان قطعيًّا كان مقدَّمًا.
ثم إنه يجب تقديم الشرع؛ لأن العقل شهد له وصدَّقه، فلو قدم حكم العقل لكان ذلك قدحًا في شهادته، وإذا بطلت شهادته بطل قوله، ففي تقديمه طعن فيه وفي الشرع([17]).
ثالثًا: منع دعوى أنّ العقل أصل الشرع، والصواب أنه أصل الإيمان بالمعجزة التي يُعلم بها صدقُ الرسول:
فإن إطلاق أنّ العقل أصلٌ للشرع غير صحيح، بل الحق أنَّ العقل أصلٌ لإدراك المعجزة التي يُعلم بها صدق الرسول.
فكأنّ ههنا مرحلتين:
الأولى: إدراك صدق الرسول، والأداة فيها هي العقل.
والثانية: الالتزام بما جاء به الرسول علمًا وعملًا، وهذه العقل فيها تابعٌ مُنقادٌ مُستسلمٌ؛ لأنها إمّا غيب أو مبنية على الغيب، والعقل لا مدخل له هنا، وليس أصلًا لها، بل هو هنا محلّ للعبودية والانقياد.
فإذا قال المعتزلة أو الأشاعرة أو الفلاسفة قديمًا أو حديثًا: إنّ العقل أصل لثبوت المعجزة صدقناهم.. وإذا اشترطوا على النص ألا يأتي بتكذيب المعجزة أو التشكيك فيها صدقناهم أيضًا([18]). أمّا إذا جعلوا العقل أصلًا يُحتكم إليه في إثبات “العلم” للأدلة الشرعية وما كان قدحًا فيه صار قدحًا في الشرع؛ فذلك لا يصدقهم فيه عاقل يريد أن يعبد الله وحده.
ولذلك إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع؛ لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به، ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل. ويكفينا من العقل أن يُعلّمنا صدق الرسول ومعاني كلامه بالطريقة التي يحددها الشرع؛ وذلك لأن العقل دلَّ على أن الرسول r يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر دلالة عامة مطلقة([19]).
رابعًا: يقال لهم: ما المراد بالعقل الذي تجعلونه أصلًا: الغريزة، أو العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟
فيقال لمن يجعل العقل أصلًا والشرع تبعًا: أتعني بالعقل هنا الغريزة التي فينا، أم العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟ فهو قطعًا لا يريد الأول، فتلك الغريزة ليست علمًا يتصوَّر أن يعارض النقل.
وإن أراد بالعقل -الذي هو عنده دليل السمع وأصله- المعرفةَ الحاصلةَ بالعقل، فيقال له:
إنه من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلًا للسمع ودليلًا على صحته؛ فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر. فقدر يسير من العلوم العقلية هو المستعمل في الاستدلال على صدق الرسالة، وذلك لا يجعل العقل أصلها مطلقًا.
والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقّف على ما به يُعلم صدقُ الرسول r، وليس كل العلوم العقلية يُعلم بها صدق الرسول r، بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله تعالى أرسله، فليس جميع المعقولات أصلًا للنقل([20]).
خامسًا: ما العقول التي يجعلونها مُقدَّمة على الشرع؟
هل هي عقول الفلاسفة اليونانيين الوثنيين، أم عقول الجهمية، أم عقول المعتزلة، أم عقول الأشاعرة؟ فهؤلاء جميعا يدَّعون العقل وهم مختلفون اختلافا كبيرا. فأيُّ عقل من تلك العقول يزعم هؤلاء المتكلمون أنه مقدَّم على الشرع؟!
وعمليًّا نجد أن كثيرًا من العقليات التي يُزعم أنها تعارض نصوص الوحي ترجع إلى شبهات فلسفية، كشبهة التركيب، وكذلك أصل التوحيد بالمعنى الاعتزالي.
سادسًا: إنه لم تدوَّن حالة واحدة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم قالوا عن نصٍّ: إنَّ العقل عارضه أو رفضه:
فلم نقرأ عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان -رضي الله عنهم أجمعين- الذين نقلوا إلينا أقوال الرسول r وأفعاله أنهم توقّفوا أمام آيةٍ أو حديثٍ فقالوا: إنَّ العقل يعارضها أو يرفضها، أو ينبغي تأويلها بصرفها عن ظاهرها.
وإنما عملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه، وقالوا: {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}، خاصة فيما يتصل بقضايا الغيب من هذه الآيات، وفي مقدمتها آيات الصفات الإلهية التي هي محكّ الخلاف بين السلف ومخالفيهم، وكذلك آيات البعث والحساب. كذلك لم يتساءلوا عن كيفية أي صفة من الصفات المذكورة في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية، وإنما تلقوها بالقبول كما سمعوها عن الرسول r([21]).
ومما يجد أن يشار إليه هنا: أن النظر العقلي الذي أعملوه حين نظرهم في النصوص نظر وظيفي، أي: أنه وقع منهم في وقائع محدودة توظيف العقل المستند إلى الدلائل النقلية الأخرى في معارضة خبر من الأخبار، فتكون المعارضة في واقع الأمر بين دليلين نقليين، لا بين نظر عقلي ودليل نقلي([22]).
سابعًا: إن حال من يؤصل هذا الأصل كمن يقول: أنا إيماني مشروطٌ بعدم المعارَضَة:
ومن المعلوم أن ذلك الموقف هو مدخل الإلحاد، كما أن في أخبار الأنبياء عن الغيب ما لا يُنال بالعقل، ولا يدرك بالحس، ويمتنع أن يصل أحد إلى هذه الأخبار الإيمانية إلا بواسطة الوحي والأنبياء فقط.
والواجب على المسلم ألا يقدم رأيه على قول الله ورسوله r، وإن كان على يقين بأن الله ورسوله r أعلم بما أنزل منه، وأما إن كان في شك من ذلك فليس له معنا حينئذ حديث؛ لأن كل من تعوّد معارضة الشرع برأيه لا يستقرّ في قلبه الإيمان، وهو أشبه بمن يعلق إيمانه بالرسول r على شرط عدم الـمُعارِض العقلي لأقوال الرسول r وأخباره، فإيمانه مشروط بعدم المعارضة([23]).
ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإِسلام أنه يجب على الخلق الإِيمان بالرسول إيمانًا مطلقًا جازمًا عامًا: بتصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أوجب وأمر، وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل، وأن من قال يجب تصديق ما أدركته بعقلي وردّ ما جاء به الرسول r لرأيي وعقلي، وتقديم عقلي على ما أخبر به الرسول r مع تصديقي بأن الرسول r صادق فيما أخبر به فهو متناقض فاسد العقل ملحد في الشرع([24]).
ثامنًا: يفرق بين الأدلة العقلية والعقل والهوى:
فقد يخيّل للإنسان أنه إنما يتكلم عن الأدلة العقلية وصريح العقل ومسلّماته، كمنع اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما وغيرها، وإنما هو حاكٍ عما يستحسنه هواه ومذهبه، أو يقصد العقل الذي هو أداة التفكير.
فمنشأ المغالطة الخلط بين الأدلة العقلية والعقل الذي هو أداة التفكير؛ فإن العقل في الحقيقة «ما عنده شيء من حيث نفسه، وأن الذي يكتسبه من العلوم إنما هو من كونه عنده صفة القبول»([25]).
وينبَّه إلى أنه لا يُنكر النظر العقلي؛ فإن القرآن قد هدى الناس إلى الدلائل العقلية واستدل بالمعقول. أما الذي أنكره أهل السنة فهو جعل العقائد الدينية والصفات الإلهية وأخبار عالم الغيب محلًّا لنظريات فلسفية، وموقوفًا إثباتها على اصطلاحات جدلية ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يستفد أصحابها منها غير تبديل الدِّين وتفريق المسلمين والبعد عن حق اليقين، ويرى هؤلاء أن كون القرآن من عند الله قد ثبت ثبوتًا عقليًّا من وجوه كثيرة، فوجب اتباعه حتى يتلقّى العقائد والأحكام منه، مع اجتناب التأويل للصفات الإلهية والأمور الغيبية بالنظريات الكلامية كما كان عليه السلف الصالح([26]).
المبحث الثالث: ضوابط العلاقة بين العقل والشرع:
يدفعنا التناول السابق في المباحث الفائتة إلى القول بأن علاقة العقل بالشرع ليست علاقة إثبات للوجود أو منع ونفي له، وإنما هي علاقة علم بالموجود على ما هو عليه في الوجود الخارجي.
فالعقل لا يمنح وجودًا للمعدوم، ولا يمنعه عن الموجود، حتى يقال: إن العقل أصل في إثبات الشرع، أو إن العقل أساس الشرع، ذلك أن العقل يعلم وجود الأشياء الموجودة بالفعل على ما هي عليه في الوجود، ولا يعلم وجود المعدوم إلا على سبيل التخيل، فكيف يقال: العقل أصل أو أساس للشرع؟! لذا فإن هذه بعض الضوابط المحددة للعلاقة بينهما.
الضابط الأول: أن قضايا الغيب لا مدخل للعقل فيها إلا العلم بها، خلافًا للعمليات فتحتاج لاجتهاد لتحقيق المناط:
فإن قضايا الغيب -كالإيمان بالله والنبوة واليوم الآخر والصفات الإلهية- هي من الثوابت التي لا مدخل للعقل فيها إلا العلم بها فقط، على ما أخبر به الرسول r عنها.
أما ما يتصل بحياة الناس اليومية من الشرعيات في مسائل السياسة والاجتماع وما يتفرع عنهما فهي محل اجتهاد العقول لتحقيق المناط واستنباط الأحكام الشرعية وما يسدّ حاجات الناس اليومية المتجدّدة.
وهذه التفرقة بين الثوابت والمتغيرات في علاقة العقل بالشرع أمر على جانب كبير من الأهمية؛ حتى لا تختلط الأوراق عند البعض، فيظن أن ما هو ثابت قابل للاجتهاد العقلي، أو أن ما هو من قبيل المتغيرات يثبت عند حدود وعصر معين أو اجتهاد فقيه معين.
الضابط الثاني: إذا ظهر في الشرعيات ما يَعِزُّ على العقل فهمُه، فلا ينبغي للعقل أن يَتَّهِم الشرعَ أو يردّه:
فلا ينبغي للعقلاء أن يقولوا: نحن نأخذ بدليل العقل ونردّ دليل الشرع، بدعوى أننا لو رفضنا الأخذ بدليل العقل لكان ذلك قدحًا في الشرع لأننا عرفنا الشرع بالعقل، ولو رددنا أحكام العقل الذي به عرفنا الشرع لكان ذلك رفضا للشرع أيضًا. أو غير ذلك من المقولات التي نجدها في بعض الكتابات قديمًا وحديثًا؛ لأن هذه الأقوال فيها من التمويه والمغالطات شيء كثير، ذلك أن علاقة العقل بالشرع هي علاقة تعلُّم وتلقٍّ خاصة ما يتعلق منه بالغيبيات، ومن المعلوم أن العقل دلنا على صدق الرسول r في كل ما أخبر به، وأصبحت طاعة الرسول r واجبة في ذلك.
مثال يوضح العلاقة بين العقل والشرع:
يمثَّل للعلاقة بين العقل والشرع بموقف الرجل العامي الذي يعلم أن فلانًا من الناس هو المفتي، وجاء إليه من يسأله عن هذا المفتي فدلَّه عليه، وبيّن له أنه العالم المفتي الذي يستفتيه الناس عند الحاجة، ثم اختلف هذا الرجل العامي مع العالم المفتي وقال لسائله: يجب أن تسمع قولي ولا تسمع قول المفتي، وحينئذ يجب على السائل المستفتي أن يقدّم قول المفتي لا قول الرجل العامي.
فإذا قال له الرجل العامي: أنا الأصل في علمك بأنه مفتٍ، فإذا قدّمت قوله على قولي عند الاختلاف كان ذلك قدحا في الأصل الذي علمت به أنه مفت.
قال له السائل: أنت شهدتَ بأنه عالم مفت، وزكيته ودللت عليه، فشهدت بوجوب إتيانه والأخذ عنه دون تقليدك، وموافقتي لك في العلم بأنه مفت لا يستلزم بالضرورة أنني أوافقك في العلم بأعيان المسائل التي هي محل الخلاف بينكما، وخطؤك في أعيان المسائل التي خالفت فيها المفتي لا يستلزم خطأك في دلالتك عليه وشهادتك وزكيته له وفي علمك بأنه مفتٍ، هذا مع الفارق الكبير، فإن المفتي قد يجوز عليه الخطأ أما الرسول فإنه معصوم؛ ولذلك وجب تقليده على كل من آمن به، سواء وافقه عقله أو خالفه.
وكذلك العقل لما دلنا على أن نبوة محمد r صحيحة، وأنه صادق فيما أخبر به عن ربه، كان ذلك صحيحا منه؛ لوضوح دلائل النبوة لكل ذي عقل، ومعرفة العقل بأن محمدًا نبي بدلائله الواضحة لا يعني أبدا أن العقل متخصّص في علم النبوة، وأنه يعلم ما علمه النبي، بل هنا يقال للعقل: “ليس هذا بعشّكِ فادرجي”، فنحن في حياتنا العادية نعلم أن غيرنا أعلم منا بصناعات كيماوية أو معدنية مختلفة، فإذا سألنا سائل عن صانع حاذق بالمعادن وأنواعها، فدللناه عليه، فهل يعني هذا أننا أكثر علما بهذه الصنعة من الصانع نفسه؟! وهل إذا اختلف معنا السائل في سر من أسرار هذه الصناعة نقول له: إن قولنا مقدم على قول الصانع الماهر فيها؟ إن في ذلك من التمويه والمغالطة ما لا يخفى على العقلاء، وهذا هو شأن من يقدّم بين يدي الله ورسوله في مسائل الغيب([27]).
الضابط الثالث: أن العقيدة توقيفية:
فالعقيدة عند السلف -رحمهم الله تعالى- توقيفية، لا مجال لآراء البشر فيها، وكثير من نصوصها بكلمة “قل” التلقينية.
مثل قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [سورة الإخلاص]، وقوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ} [سورة الكافرون]، وقوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة :136].
وختامًا:
لقد كانت الدعوى القائلة بأن العقل أصل والشرع فرع مغالطةً كبرى،و من أكبر الجنايات البدعية، فقد سلَّطت سيف العقل والهوى والاستحسان البدعي على النقل، بل وافترضت قسمةً ضيزى جائرة؛ مفادها: أن السمع والوحي مجرد تلقٍ ورواية بلا فهم، وأن العقل مستقل وأصل بذاته، يَقبَل ويَرد ما شاء.
ومن جور أصحاب هذه الدعوى تلميحُهم بل تصريحهم أن السلف كانوا لاغين لعقولهم وعماد صنعتهم السمع فقط، وهذا كذب عليهم؛ فنصوص الكتاب والسنة جاءت بالدلائل العقلية والأمثلة المضروبة، وكان السلف يجمعون النصوص ويراعون فهمها، وينزلون العقل منزلته التي أنزله الله إياه، بلا إفراط ولا تفريط.
ومن تأمل صنيع السلف وجد أن الله تعالى قد عصم مذهبهم من التناقض الذي حلّ بالمذاهب الكلامية المخالفة لهم ممن قدموا العقل وجعلوه أصلًا للشرع، فكل طائفة تنقض مذهب الأخرى، وتقيم معتقدها على أشلاء ما رفضوه من المذهب الآخر، وهكذا تذهب بهم العقول وتروح إلا ما كان من معتقد السلف الذي أنزل الأدلة الشرعية منزلتها، وأنزل العقل منزلته.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([2]) ينظر: الوحي والإنسان – قراءة معرفية، للجليند (ص: 109).
([4]) شرح المقاصد للتفتازاني، ط. المعارف النعمانية (2/ 67).
([5]) ينظر: التمهيد للباقلاني (ص: 38، 152-153).
([6]) ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص: 358-359).
([7]) المستصفى للغزالي (2/ 137، 138).
([8]) أساس التقديس للرازي (ص: 220-221). وينظر: المطالب العالية (9/ 116-117).
([10]) أساس التقديس (ص: 220-221). وينظر: المطالب العالية (9/ 116-117).
([11]) معالم أصول الدين (ص: 24)، وينظر: المطالب العالية (9/ 113-118).
([12]) ينظر: درء التعارض (1/ 78)، والصواعق المرسلة (2/ 521).
([13]) ينظر: مجموع الفتاوى (3/ 88) وما بعدها.
([14]) الحجة في بيان المحجة (1/ 320).
([15]) انظر: درء التعارض (1/ 79)، وشرح الأصفهانية (ص: 80)، والصواعق المرسلة (2/ 521)، وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص: 123).
([16]) الوحي والإنسان – قراءة معرفية (ص: 99).
([17]) ينظر: الصواعق المرسلة (2/ 522، 528)، وإيثار الحق (ص: 123).
([18]) درء تعارض العقل والنقل (1/ 87-90).
([20]) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (1/ 78-90).
([21]) ينظر: الجليند، الوحي والإنسان – قراءة معرفية (ص: 98).
([22]) ينظر بتفصيل وتقصٍّ: دفع دعوى المعارض العقلي، للدكتور النعمي (ص: 92) وما بعدها.
([23]) ينظر: الوحي والإنسان – قراءة معرفية (ص: 109).
([25]) الفتوحات المكية (1/ 289).