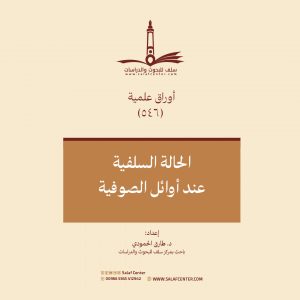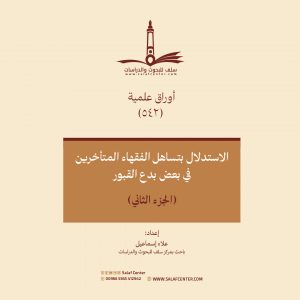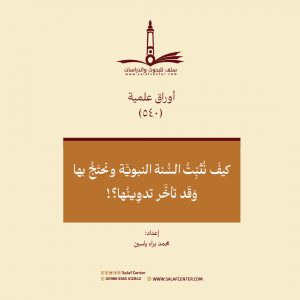نظرةٌ في الفلسفة ومدى الحاجة إليها
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
وبعد، فإنَّك حين تريد الحديثَ عن قضايا الفلسفة، وترغب في التَّقديم بين يدي ذلك بتعريفٍ علمي لها، فالغالب أنَّ كتب الفلسفة لن تساعدَك في ذلك، بل حتى الكتب المدرسيَّة التي تُؤلَّف كمدخل أو مبادئ للفلسفة، يُقصد بها تسهيل الفلسفة للطلاب أو البادئين في دراستها؛ ليس فيها ما تصبو إليه، وإنما يكاد الجميع أن يتفقوا على مفهوم واحد، وهو أن الفلسفة من حيث اللغة تعني: (حب الحكمة).
ويذكر المؤرِّخون أنَّ أقدم سِفر يوناني جاءت فيه كلمة “فلسفة” بمعنى الرغبة في المعرفة هو كتاب “هيرودوت” المؤرخ، حيث يروي أنَّ “كريتس” قال لسولون -أحد الحكماء السبعة-: “إني سمعت أنك جبت كثيرًا من الأقطار متفلسفًا” أي: راغبا في المعرفة([1]).
والفلسفة كلمة معرَّبة، أصلها يوناني مأخوذ من “فيلا سوف”، ومعناها: محبّ الحكمة، و”سوفيا” مصطلح يطلق على الفلسفة ويقابله تعريبًا: الحكمة، و”فيلا” بمعنى محبّ أو مؤثر الحكمة، فالفلسفة إذن: محبّة الحكمة، وقد انتقلت إلى لغات العالم كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية من أصلها الإغريقي هذا، وحاولت كلّ لغة تعديل المصطلح بما بتوافق مع منطقها([2]).
ومن حيث الاصطلاح يمكن أن تضيق حتى تنحصر في قضايا الغيب والمعرفة والأخلاق والجمال، ويمكن أن تتَّسع حتى تجعل كلّ إنسان يفكّر في حاله وفي رزقه ومستقبله فيلسوفًا صغيرًا، فالكون حينئذٍ عبارة عن جماعات من الفلاسفة يتفاوتون فيها حسب تفاوت عقولهم؛ وهذا التَّفسير الواسع للفلسفة يكاد يكون بدافع التَّرويج لها وربطها بالسَّجِيَّة الخِلْقِية للإنسان، وهي السؤال والتفكير، لكن ذلك يتعارض مع حقيقة أنَّ كبار الفلاسفة الأقدمين الذين يُعدُّون المؤسِّسين للفلسفة لم يكونوا يحملون تقديرًا كبيرًا لعامَّة الناس الذين يَعتبرهم هذا التعريف فلاسفة، بل كانوا يحملون عليهم وعلى صغر عقولهم وغوغائيَّتهم؛ حتى إنَّ سقراط قُتل بحكم العامة عليه لَمَّا كان ضدّ النظام الديمقراطي؛ لكون الديمقراطية تُسلّط العامة على إدارة الدولة وقراراتها.
إذن على الرغم من ذيوع هذا المصطلح وانتشاره بين اللغات لم يُتفق على وضع معنى واضح له؛ بل تجاذبته اللغات واختلفت في تحديد معناه، وسوف أعرض شيئًا من تعريفات الفلاسفة لها؛ لا إغراقًا في التعريف، ولكن لأصل لاحقًا إلى جوابٍ لسؤال الورقة عن مدى أهميَّة الفلسفة في بلادنا المملكة العربية السعودية، فمنها:
١- “البحث عن الحقائق بحثًا نظريًّا، وخاصة الحقائق والمبادئ الخلقية من خير وعدل وفضيلة”. وهذا تعريف سقراط (ت: 399 ق.م)([3])، وهو تعريف يكاد يبتعد بها عن الغيبيات وما إليها مما هو غالب عمل الفلاسفة بعد سقراط.
٢- “البحث عن الأمور الأزليَّة، أو معرفة حقائق الأشياء، ومعرفة الخير للإنسان”. وهذا تعريف أفلاطون (ت: 347 ق.م)([4])، وهو تعريف يلقي بها في غمرة الغيبيات.
3- “معرفة نظرية بالمبادئ والعلل الأولى”. وهذا تعريف أرسطو (ت: 322 ق.م)([5])، وهو من حيث علاقته بالغيبيات كتعريف أستاذه.
4- “معرفة حقائق الأشياء كما هي”، أو “علم الأشياء بحقائقها”([6]). وهو تعريف الكندي (ت: 256هـ)، وهو يضم العلم بالغيبيات والعلوم التي انفصلت عن الفلسفة كالكيمياء والفيزياء والطب.
5- “العلم بالموجودات بما هي عليه موجودة”([7]). وهذا تعريف أبي نصر الفارابي (ت: 339هـ)، ويمكن القول: إنه تزويق للفلسفة ونسبة لكل العلوم إليها، ولعل الفارابي كان يعيش الصراع نفسه الذي يعيشه دعاة الفلسفة في بلادنا اليوم، ويسعى بهذا التعريف لترويجها بين المسلمين.
6- “صناعة نظر وفعل عقل يستفيد منها الإنسان في تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه، وما الواجب عليه عمله مما ينبغي أن يكتسب فعله لتشرف بذلك نفسه وتستكمل، وتصير عالما معقولا مضاهيًا الوجود، وتستعد للسعادة القصوى بالآخرة، وذلك بحسب الطاقة الإنسانية”. وهذا تعريف ابن سينا (ت: 427هـ)([8])، وأنت تلاحظ أنه لا يبدو تعريفًا، بل يبدو مرافعة يحاول فيها صاحبها إدخال كل العلوم -بما فيها الفقه والعقيدة وعلم الحديث- في الفلسفة، وهو تعريف دعائي، يمثل الحالة النفسية لدى دعاة الفلسفة المسلمين لإيجاد موطئ قدم لهم في بلاد الإسلام.
7- “التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية؛ لتحصيل السعادة الأبدية، كما أمر الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله: «تخلَّقوا بأخلاق الله»، أي: تشبهوا به في الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن الجسمانيات”([9]). وهذا تعريف الجرجاني (ت: 392هـ)، وهو كما ترى لا يكاد ينطبق إلا على علم الكلام، وفيه إشكالات حتى على عقائد المتكلمين.
ويمكن القول بأنَّ أسباب هذا التباين في تعريف الفلسفة عائدة إلى أمور:
1. اختلاف مشرب كل معرِّف ومنهجه وطريقته في التفكير عن سواه.
2.مرور الفلسفة بعدة أطوار، اختلفت فيها موضوعاتها إلى حد بعيد.
3.اختلاف بيئة كل فيلسوف وعصره ومجتمعه عن الآخر.
4.وهو الأهم في نظري: أن الفلسفة نشاط عقلي محض، ليس له علاقة بالعلم الصحيح الذي ينفع الإنسان، والذي ينبغي أن ينطلق منه تفكيره، فإذا انتقل فرع من الفلسفة من كونه نشاطًا عقليًّا صرفًا ليكون علمًا تعضده التجارب والبحث الصحيح، خرج من الفلسفة ولم يعد له علاقة بها كالفيزياء والكيمياء.
والذي لا يمكننا إغفاله ونحن نريد الحديث عن الفلسفة في المملكة العربية السعودية أن الفلسفة لا تنشأ إلا في البلاد التي ابتعدت عن الرسالات الإلهية وطال العهد بينها وبين ظهور الأنبياء؛ الأمر الذي يؤدّي إلى شيوع الخرافات والأساطير التي تملأ مخيّلة الأمة وتأسرها وتجعل مصيرها في أيدي الكهان والأباطرة، عند ذلك يظهر أذكياؤها وينشغل بعضهم بالبحث عن تفسير للكون والحياة وما يحيط به من عوالم وأحداث، فلا يجد لدى الكهنة أو الموروث إلَّا ما ينافي العقل ويضادّه، فيبدأ بطرح الأسئلة والإجابة عنها، فتكون هذه هي الفلسفة.
ولذلك كانت أهمّ قضاياها لدى اليونان هي الخلق والأخلاق والمعرفة، وهي تعبر عن مفقودات اليونان الذين كانت الأساطير عن مئات الآلهة وصراعاتهم وحروبهم فيما بينهم وغرامياتهم تُشكل عائقًا أمام التفكير الصحيح، ولا تقدّم أيَّ حلٍّ لأي مشكلة فكرية، بل كانت كلها عبارة عن مشكلات فكرية عويصة مستعصية عن الحلّ، فلم يكن أمام الأذكياء إذ ذاك سوى التفلسُف للوصول إلى حلول؛ وكان الضعف السياسي وضعف سلطة الكهنة نتيجة له سببًا فيما كانوا عليه من الحرية.
ووُجد أمثال هؤلاء الأذكياء في الهند والصين قبل أن يوجدوا في اليونان وربما في غيرهما من الحضارات التي لم تصلنا؛ إلا أن مؤرخي الفلسفة يرفضون تسمية نتاجهم فلسفة، ومنهم البيروني قديمًا ويوسف كرم حديثًا، ولعلهم محقُّون في ذلك، فقد كانت قوة الكهنة وقوة الدولة تحول بين الفلاسفة وحرية السؤال والجواب؛ الأمر الذي جعل نتاجَهم الفكري في الأغلب مسخَّرًا لخدمة الخرافة لا لتقديم البديل عنها.
وفي مطلع العصور الحديثة -أو لنقُل: مطلع النهضة الحديثة والذي يحدّده البعض أمثال هربرت فشر بما بعد الألف ومائتين للميلاد، أي: نهاية القرن السادس الهجري- كان أذكياء أوروبا في حالٍ تشبِه كثيرًا حالَ أذكياء اليونان عند نشوء الفلسفة، فهناك بُعد كبير عن أثر النبوات وشيوعٌ للخرافات والأساطير التي لا يمكن للأذكياء الاستسلام لها، فالديانة النصرانيةُ لم تكن تُقدّم أيَّ حل يرضاه العقل وتطمئنّ إليه النفس لكل ما يحيط بالعقل من تساؤلات، وكهنةُ الكنيسة يعملون على ترسيخ الخرافة، وأيضا على مضاعفتها وزيادة تأثيرها على العقول، وكان معظم الأذكياء ينخرطون في السّلك الكنسي، وكان انتماؤهم إليه يحول بينهم وبين نقده؛ لذلك لم تبرز الحاجة إلى التفلسُف حتى جاء القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي واختلط عوام الأوروبيين بالأمة الإسلامية، ولم يعد الاختلاط بالمسلمين مقتصرًا على خواصهم من الأثرياء والأمراء؛ بل أصبح عوام الناس يدخلون إلى بلاد المسلمين على شكل جنود في الحملات الصليبية المتكررة وإمداداتها المتواصلة، ثم يعودون إلى أوروبا بانفتاح كبير على ثقافة راسخة مطمئنة واثقة من نفسها؛ وهناك بدأ الرجوع الأوروبي إلى التراث اليوناني كبديل لإيجاد الطمأنينة عن الرجوع إلى التراث الإسلامي العدو؛ ومن هناك بدأت الفلسفة الأوربية الحديثة تعمل على محاولة حل المشكلات الفكرية التي لم ولن تستطيع الكنيسة حلها، وكانت قضاياها هي عين قضايا الفلسفة اليونانية، والسبب في ذلك أن احتياجات العقل الإنساني المعرفية هي هي منذ أن خلق الله الإنسان وإلى ما لا نهاية، ويمكننا أن نقول: إنَّ هناك أمرين اختلفا:
الأول: عمق النقاش؛ إذ إن الأوروبيين قد استفادوا كثيرًا من علم الكلام الإسلامي، وطوّروا به لغتهم العلمية كثيرًا، وإن كانوا لا يُقِرُّون بذلك ولا يشهدون به؛ لكن القارئ لِما كتبه مثلًا فرانسيس بيكون (ت: 1626م) عن الاستقراء، أو ما كتبه جون لوك (ت: 1704م) في إنكار الفطرة، وما كتبه ديكارت (ت: 1650م) في ضرورة التجربة، وما كتبه كانت (ت: 1804م) في نقد العقل الخالص؛ يُدرك أن هؤلاء كلهم لا يمكن أن يكونوا نبتوا كفقعة القاع دون أن يكون لهم جذور فكرية، وقد ثبت أنهم جميعًا اطّلعوا على الإنتاج الفكري عند المسلمين، وكمثال لذلك فإن ديكارت وُجد في مكتبته كتاب: المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي رحمه الله (ت: 505هـ) وعليه تعليقات بخطّ ديكارت؛ وشخصيًّا أعتقد أن إيمانويل كانت تأثر في كتابه “تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق” بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت: 728هـ)، ولم أقصد لإثبات ذلك؛ لكنه انطباع قويّ ثبت في ذهني حين قرأت الكتاب مع معرفتي المتواضعة بتراث شيخ الإسلام، وكما أثبت البعض تأثّر ديكارت في كتابه “بحث في المنهج” بالغزالي، فقد يتسنى لأحد الباحثين المتخصّصين إثبات ما ادّعيته هنا.
المهمّ في سياقنا هذا أن نقول: إن التطوّر الذي شهدته الفلسفة الأوروبية وتفوّقت به على اليونان كان لعلم الكلام الإسلاميّ أثر فيه كبير جدًّا، وإن لم نجد من مؤرخي الفلسفة الأوروبية اعتراف كافٍ به.
الأمر الآخر: أن فلسفة الشكّ التي تزعمها فرانسيس بيكون (ت: 1626م) ثم ديكارت (ت: 1650م) كانت مفتاحًا لاشتغال أوروبا بالمنهج التجريبي الذي كان الأصل في العلم الإسلامي، فإضافة إلى كونه هو الذي أدّى إلى النهضة الأوروبية إضافة إلى عوامل أخر، فإنه أدّى أيضًا إلى تقلّص الفلسفة؛ وذلك أن الانصراف نحو التجارب جعلت كثيرًا من العلوم التي كانت عبارة عن نظريات وتقديرات وتساؤلات وأجوبة ليس لها حظّ من التجريب انتقلت من كونها جزءًا من الفلسفة إلى كونها علومًا قائمة بذاتها، فالطبّ كان على عهد اليونان عبارةً عن نتيجة لتأمّل في جسم الإنسان وما يصيبه من أدواء، وتأمل مماثل فيما يمكن أن يكون علاجًا لذلك، ثم تطوّر على يد المسلمين ودخلته التجربة والتَّشريح؛ فعُرفت أجهزة الجسم وخواص الأدوية والجراحة، وانتقل الأمر إلى أوروبا، فمارسوا التجارب والمداواة عبرها، فلم يعد الطبّ قضية فلسفية بل علمًا مستقلًّا، مع التنويه بأن الطب عند المسلمين لم يكن جزءًا من الفلسفة، بل كان مستقلًّا، وإن كان بعض الأطباء كابن سينا فلاسفة، لكن لم يكن ذلك يعني عند المسلمين أن الطبَّ فرع عن الفلسفة، وقل مثل هذا في سائر العلوم؛ في الفيزياء والكيمياء وعلم النفس وعلم الاجتماع والجغرافيا والسياسة، فكلها كانت عبارة عن أسئلة وأجوبة نتيجة تفكير وتأمل؛ فلما خرجت عن نطاق الجهد الذهني الخالص إلى التجربة واستخلاص النتائج من التجريب أصبحت علومًا مستقلة؛ لذلك لا يصح اليوم أن نسمّي الطبيب أو الفيزيائي أو الكيميائي أو الجيولوجي فيلسوفًا، ولم يعد تحت عبارة الفلسفة سوى هذه العلوم التي لا زالت عند الأمم التي لا تؤمن بكتاب الله تعالى وليس لها مستند سوى العقل، وهي علوم ما وراء الطبيعة أو لنقل: عالم الغيب، وكذلك علم الأخلاق وعلم الجمال؛ ويمكن أن نقول: إن ما يسمّى اليوم بالفكر ويسمّى أصحابه بالمفكرين يدخل في نطاق الفلسفة من حيث كونه عبارة عن تساؤلات ومحاولات للجواب، لكنها بالتأكيد ليست الفلسفة التي عليها مدار الكلام عن الفلسفة وقضاياها في التواليف الفلسفية والمؤتمرات الفلسفية؛ ومع ذلك فهي -أي: القضايا الفكرية- إن كانت تستند إلى الكتاب والسنة أو لا تتعارض معها فهي قطعًا خارجة عن الفلسفة التي هي جهد عقلي بشري محض، ليس له أي مستند يقيني، فإذا كان المقصود بالفلسفة الفكر كما صورناه آنفًا فلِمَ المطالبة به في السعودية وهو موجود أصلا؟! ولدينا العشرات ممن يُحسبون في زمرة المفكرين، كما لدينا عشرات المطبوعات في هذا السياق، أضف إلى ذلك أن ما يسمى بكليات الدعوة والثقافة الإسلامية قائمة على دراسة الفكر وتدريسه، فهل الضجيج فقط على مسمى الفلسفة؟!
وإن كانت -أي: القضايا الفكرية- مستندة إلى الوقائع فقد خرجت عن الفلسفة إلى العلوم التجريبية، ومثال ذلك ما يعرف بتفسير التاريخ، والبعض يسميه (فلسفة التاريخ)، وأعتقد أن هذه التسمية من التسامحات في المصطلحات؛ لأن تفسير التاريخ إن كان يعتمد على الخيال فهو هراء، كتفسير هيجل وتفسير ماركس وتفسير فرويد، وإن كان يعتمد على حصر الوقائع وتحليلها فقد أصبح علمًا مستقلًّا ليس من الفلسفة في شيء، وكذلك نقول مثله فيما يُسمَّى: فلسفة التربية، وفلسفة علم النفس.
إذن عرفنا مما تقدم أن من عوامل ظهور الفلسفة الفراغ من الأجوبة المقنعة للفطرة الإنسانية، وثورة العبقرية البشرية على الخرافة كونها لا تقدم حلًّا؛ وأيضا نقول هنا: إن الثورة على الخرافة دون هدْي ومع الخضوع للنوازع الشيطانية والضعف أمام الواقع والاستكبار عن الحق الأغلب عليها أن تعيد الإنسان في أجوبة خرافية أيضًا، وهذا ما حدث مع فلاسفة الهند والصين الذين هم أسبق من اليونان؛ لكنَّ مؤرخي الفلسفة يأبون وصفَ نتاجهم بالفلسفة، ولا أظن ذلك إلا من التعالي الأوروبي، والمؤسف أن ينحى المؤرخون العرب نحوهم كيوسف كرم الذي يُعدّ من أبرع من أرَّخ للفلسفة من العرب، ومع ذلك هو ينحى هذا النحو في كتابه “تاريخ الفلسفة اليونانية”.
فالفلسفة تفرّ من الخرافة ثم تعود إلى الخرافة لبُعدها عن الهدي الإلهي في قضايا لا مصدر لها إلا هي، وبعدها عن المرتكزات اليقينية فيما سوى الغيب من قضايا؛ ومن هنا أصبحت دراسة مذاهب الفلاسفة مجرد تطويل وتعوير، وهو من تضييع الأعمار فيما لا ينفع، ويحضر في ذلك قول الغزالي: “الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل؛ فإنّ خبطهم طويل ونزاعهم كثير وآراءهم منتشرة وطرقهم متباعدة”([10]).
فالقول السائد عند مؤرخي الفلسفة أنها ظهرت أول ما ظهرت في اليونان، ومنهم بدأت([11])، وفي ذلك يقول البيروني وهو يتكلم عن الحضارة الهندية: “فهذا براهمهر أحد فضلائهم حين يأمر بتعظيم البراهمة يقول: (إنّ اليونانيين وهم أنجاس لمّا تخرّجوا في العلوم وأنافوا فيها على غيرهم وجب تعظيمهم، فما عسى نقوله في البرهمن إذا حاز إلى طهارته شرف العلم؟) وكانوا يعترفون لليونانيين بأنّ ما أعطوه من العلم أرجح من نصيبهم منه… وأقول: إنّ اليونانيين أيّام الجاهلية قبل ظهور النصرانية كانوا على مثل ما عليه الهند من العقيدة، خاصّهم في النظر قريب من خاصّهم، وعامّهم في عبادة الأصنام كعامّهم… ولكنّ اليونانيّين فازوا بالفلاسفة الذين كانوا في ناحيتهم حتى نقّحوا لهم الأصول الخاصة دون العامّة”([12]).
وقد أيد هذا الرأي أغلب الأوروبيين ممن أرخ للفلسفة ومن أذيالهم من غيرهم من الأمم، جاء في كتاب “قصة الفلسفة اليونانية”: “لم تستمدّ الفلسفة اليونانية فلسفتها من تلك الأمم القديمة، ولكن خلقها اليونان خلقًا، وأنشؤوها إنشاء، فهي وليدتهم وربيبتهم، ويستطيع الباحث أن يرجع بالفلسفة خطوة بعد خطوة حتى يصل إلى مهدها في بلاد اليونان دون أن يشعر في خلال البحث بحلقة مفقودة أو غامضة”([13]).
وهذا القول مع شيوعه يبدو أنه مجانب للصواب؛ لشهادة كثير من الفلاسفة قديمًا وحديثًا بسبق أهل المشرق إلى العلم والفلسفة والتفكير، ولوجود أثر الحضارات الشرقية على الفكر اليوناني بشهادة الفكر اليوناني نفسه، يقول الطيب بوعزة: “تأسست أطروحة فصل نشأة الفكر الفلسفي اليوناني عن العطاء المعرفي الشرقي على منظور واهم يعتقد بنظرية المركزية الأوروبية التي تضع أوروبا في مركز العالم، وغيرها من الأقطار والشعوب في هامش التاريخ… وهكذا انطلقت الكتابة التاريخية على أساس وصل مرحلة النهضة باللحظة الإغريقية والرومانية، وهو الوصل الذي سيخلص إلى بناء صيرورة تاريخية مترابطة بناء على إطار منهجي كلياني سمي بـ (التاريخ العام)!”([14]).
ثم يقرر بعد ذلك أن “التفلسف ليس نمطًا مخصوصًا بحضارة أو بشعب، بل الأمر كما يعبر ابن خلدون عند وصفه العلوم العقلية بأنها: طبيعة للإنسان من حيث إنه ذو فكر فهي غير مختصة بملة”([15]).
وأيًّا ما كان فإن فلسفة الهند والصين لم تهدهم إلى الحق، كما أن فلسفة اليونان لم تهدهم إلى الحق، ولا تكاد تجد يونانيَّيْن يتفقان في جميع قضايا الفلسفة على رأي واحد، بل عاد أكثرهم ليُقرِّرُوا تعدد الآلهة وخرافات اليونان التي كانت هي مبعث انشغالهم بالفلسفة.
ومن هنا يجب أن يعلم الجميع أن ذمَّ الفلسفة لهذه الأمور لم يختصّ به السلفيون أو علماء الدعوة النَّجدية كما يُشيع ذلك دعاةُ الفلسفة في السعودية، وإنما كلّ من درس الفلسفةَ من علماء الإسلام خرج بهذه النتيجة، وينظر إلى قول ابن الصلاح (ت: 643هـ) -وهو عالم محدّث شافعي أشعري-: “الفلسفة رأس السَّفَه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيَّدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة، ومن تلبّس بها تعليمًا وتعلّمًا قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذَ عليه الشيطان، وأيّ فنّ أخزى من فنّ يُعمي صاحبه، أظلم قلبه عن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كلما ذكره ذاكر وكلما غفل عن ذكره غافل”([16]).
وقال ابن الوزير (ت: 822هـ) -وهو عالم يمني من مجتهدي الزيدية-: “وثانيهما أهل الفلسفة، وقد نقل الرازي عنهم الاعتراف بأن خوضهم في الربوبيات بالظن، وأنهم لا يعلمون إلا أحكام المشاهدات والمجريات، ولو لم يقروا بذلك قام الدليل القاطع عليهم بذلك، وهو اختلافهم وتكاذبهم المتباعد المتفاحش الذي تميز الأنبياء بالعصمة منه عن جميع أهل الدعاوي الباطلة، والنظر في هذا نفيس جدًّا، فإن الشيء إنما يزداد شرفًا على قدر خساسة ضدّه، وصحة على قدر ضعف معارضه”([17]).
وقال ابن الوزير أيضًا: “وأما أئمة الكفر والسفه والتعلق بمذاهب الفلسفة فهم كمن استحكم الداء عليه، فلا تنفعه الأدوية النافعة، فالداعي لهم إلى حق حقائق الإيمان وإن جاء بأعظم برهان في اليأس منهم وعدم الطمع فيهم كالداعي للعميان إلى النور وللأموات إلى الخروج من القبور”([18]).
إذا أقررنا هذا فإننا ندخل في سؤال آخر، وهو: لماذا إذن وُجدت الفلسفة الإسلامية؟
فالجواب: أنَّ نسبة الفلسفة هنا ليست إلى الإسلام الدين، وإنما إلى العصر الإسلامي أو لكون أصحابها من أبناء المسلمين، وإلا فالإسلام ليس في حاجة إلى قضايا الفلسفة في الميتافيزيقا والمعرفة والأخلاق؛ فهو يقدّم الجواب النافع المختصر لكل قضاياها؛ وما لا يقدم الإسلام جوابًا عنه ولا يتعارض مع نصوصه فقليل، أما علوم الفلك والرياضيات والفيزياء والطب فقد أبدع المسلمون فيها ووضعوها في مسارها الصحيح حيث أخرجوها من كونها هواجس نظرية إلى جعلها علومًا صحيحة، واستلمتها أوروبا منهم وهي كذلك فبنوا عليها.
ودخول المسلمين في جانب الميتافيزيقا كان خطأ شنيعًا وضلالًا بعيدًا شسَّع الفرقة بينهم، وأوقعهم طرقًا تتناءى بهم على عقيدتهم؛ بدءًا بالتفلسف في صفات الله تعالى والذي أسموه: علم الكلام، وانتهاء بإنكار الدين الواحد وإنكار علم الله تعالى بخلقه إلى غير ذلك من الضلالات؛ فالصحيح أنه لم يكن هناك أي داع لدخول المسلمين في الفلسفة، فقد خسروا بها خسائر كبيرة، بل إن دخول الفلسفة كان من الأسباب التي حالت دون تقدم المسلمين بالتكنولوجيا؛ ولهذا حديث آخر كنت كتبت عنه عدة مقالات نُشرت في الصحافة وفي موقعي الإلكتروني.
وليس هذا الحكم بأن الفلسفة أضرت بتاريخ العلم الإسلامي قولًا خاصًّا بالسلفيين؛ بل يقول به كل منصف درس تاريخ العلوم الإسلامية، ونضرب لذلك مثلًا بالشيخ محمد الغزالي رحمه الله (ت: 1416هـ) -وهو ليس سلفيًّا؛ بل حدث بينه وبين السلفيين سجالات كبيرة حتى وصفهم بأصحاب الإسلام البدوي-، فانظر إليه وهو يقول: “ثم تعكَّر صفو هذه العقائد بالفكر الأجنبي الذى أقحم على الحياة الإسلامية، وبضروب الجدل التي زجى بها المتبطلون أوقات الفراغ.. وعندي أن الفلسفة اليونانية وما أشبهها من تخمين عقلي في الإلهيات كان حقنة مسمومة لتراثنا الديني النظيف، ولولا ما في هذا التراث من أصالة ومنعة لذوى وانقضى كما تلاشت ديانات سابقة في دوامة التخريف البشرى القديم، لكن العقائد الإسلامية اعتلت حينا، وغام وجهها، وتحولت كتبها إلى صور ذهنية ومهاجمات كلامية عنيفة، أثر ذلك الاختلاط بالفلسفات الأجنبية”([19]).
فالمسلمون لم تكن لديهم مشكلات فلسفية حتى يعرضوها على عقولهم أو يستعينوا عليها بفلسفة اليونان أو الهند والصين؛ لأن كل المشكلات الماورائية -ومنها قضايا القضاء والقدر وأفعال العباد والأخلاق ومصادر المعرفة- كلها قدّم القرآن الكريم الجواب عليها، وفصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ) رحمه الله في كتابه “درء تعارض العقل والنقل”، ولأحد المعاصرين كتاب ميزته أنه ظهر مبكّرًا، وهو كتاب “الفلسفة القرآنية” لعباس محمود العقاد الذي عرف فيه الجواب القرآني لعدد من مشكلات الفلسفة.
لننتقل هنا إلى المملكة العربية السعودية، هل هي بحاجة إلى الفلسفة؟
الدولة السعودية منذ نشأتها الأولى هي الوريث -أو لنقل: الممتثّل- الأمثل لعقيدة السلف الصالح، ومنهجهم في رعاية الكتاب والسنة وبناء الحياة والأفكار والتصورات عليهما؛ ولمَّا كان هذان المصدران يتكفّلان بالجواب الصحيح لكل الإشكالات التي قامت الفلسفة لحلّها، وأعني بها التي بقيت حتى اليوم تحت وصف الفلسفة، وهي التساؤلات الماورائية والأخلاق والمعرفة، وأيضا لَمَّا كانت التجربة التاريخية مع الفلسفة سيئة لا تُغري بإعادتها، كما تقدم من ضررها على التطوّر العلمي والتقارب الفكري والاستقرار النفسي؛ لمَّا كان ذلك كذلك لم تكن دراسة الفلسفة بشكلها المجرد من المأذون فيه في التعليم في جميع مراحله في المملكة، سوى الدراسة النقدية لها في أقسام العقيدة في الكليات والجامعات الشرعية.
ولم تخل الساحة الفكرية داخل السعودية وخارجَها من ظهور نقد حادٍّ لهذا الموقف من الفلسفة، ومطالبات بدراستها وتدريسها في جميع المراحل، بل والتدريب عليها، فإن النفوس الإنسانية في المجمل تتلاقى طبائعها، كما حصل أواخر الدولة الأموية وصدرًا من العباسية بلغ ذروته في عصر المأمون من تأثير اختلاط بعض شباب المسلمين بالأمم الأخرى، ونقلهم بعض القضايا الفلسفية إلى الأمة المسلمة، ثم بعد ذلك: الاطلاع على تراث اليونان والانبهار به، حدثت في السعودية ظروف مشابهة أخرجت شبابًا يتنادون بالفلسفة، ولهم في مناداتهم بها حجج يمكن أن نقول: إنها تتلخّص فيما زعموه من وصفهم للفلسفة ومنافعها في الدليل التعريفي بمؤتمر الفلسفة الذي أقيم في مكتبة الملك فهد الوطنية، وتم تأريخه بالتأريخ الميلادي، ولم يؤرَّخ في ذلك الدليل بالتاريخ الهجري، مما يشي قليلًا بالنفسية المنصرفة للغرب عند مُعِدِّي الكُتيّب، وهو يوافق الثالث من جمادى الأولى عام ١٤٤٣هـ، أي: ٨/ ١٢/ ٢٠٢١م.
فقد عَرَّفُوا الفلسفة بقولهم: “تدور حول أسئلة جوهرية، فهي تتناول أبعاد من نحن كأفراد وكجزء من مجتمع أكبر وهي الأسرة البشرية، وتتفحّص موقع الفرد في العالم المحيط به، وتفصل سعيه نحو فهم ما يدور حوله من أحداث كبرى أو حتى الأمور الحياتية المعتادة والمنطق الذي يؤثّر في كل ذلك، كما تبحث الفلسفة في ماهية الجمال باعتباره قيمة إنسانية مشتركة إلى جانب بحثها في مفاهيم التعايش بين البشر رغم سعة الاختلاف”.
وهذا التعريف يُمرر الأسئلة الكبرى والتي هي أعظم قضايا الفلسفة، وهي أسئلة ما وراء الطبيعة أو عالم الغيب عن الخالق وصفاته وعلاقته بالكون وعلاقة الكون به واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين، ونعتقد أنَّ هذا التمرير متعمَّد كي لا يَظهَر تصادم الفلسفة مع نظام الدولة، ومع ذلك فإنَّ ما يظهر في هذا التعريف رغم محاولة الاختباء خلفَ أغطية لغوية مما لا يمكن إقراره؛ فسؤال: من نحن؟ واضح الإجابة في كتاب الله تعالى؛ فنحن خلق الله تعالى وعباده: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]، ونحن أيضا كأفراد مؤمنين مسلمين مكلَّفون بطاعة الله تعالى في أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأوطاننا وأمّتنا؛ وقبل أن نكون جزءًا من الأسرة البشرية فنحن جزءٌ من مجتمعنا السعودي العربي المسلم، وتجاوز المجتمع السعودي العربي المسلم إلى الأسرة الدولية لا مبرِّرَ له؛ لأننا ننظر إلى علاقتنا بالعالم وفق ما يوجّهنا إليه ديننا من مسؤولية إبلاغ الدين الإسلامي كما وصلنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، والعدل والشهادة بالقسط كما قال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلى أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ﴾ [المائدة: ٨].
وأما قولهم: “تتفحّص موقع الفرد من العالم المحيط به” فبصرف النظر عن كونها كلمة غامضة لا تصلح أن تكون جزءًا من تعريف، فإن مهمّة الفرد في هذا العالم واضحة لنا كما في القرآن والسنة، ويمكن أن نقول: إن من جِمَاع ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته»([20])، فالمسؤولية تعبر عن مهمة الفرد بالإضافة إلى عبوديته لله تعالى، ويقع تعبيد المجتمع لله وإشاعة الحق والصبر فيه إحدى المسؤوليات الواجبة عليه، فليس في مسؤولية الفرد من حيث العموم أي أسئلة عقلية. فهو واجب كُلِّف الإنسانُ به من جهتين:
الجهة الأولى: خِلقية، بمعنى: أن الإنسان مجبول أساسًا على هذه المسؤولية، وعدم القيام بها على وجهها الصحيح أو عدم القيام بها مطلقًا هو أحد أنواع الانحراف عن الفطرة.
والجهة الأخرى: أنه مأمور بها شرعًا كما في قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾، وكما في قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا قوا أَنفُسَكُم وَأَهليكُم نارًا وَقودُهَا النّاسُ وَالحِجارَةُ عَلَيها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعصونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُم وَيَفعَلونَ ما يُؤمَرونَ﴾ [التحريم: ٦]، وكل هذا مناقض لفلسفة الفردانية التي تجعل الفرد فوق الجميع بما في ذلك الدولة والأمة والمجتمع، كما هو مناقض أيضًا للفلسفة الجمعية أي: وجهة النظر التي لا تقيم للفرد وزنًا في مقابل مصلحة المجتمع، وكلا الفلسفتين تضمنتها العديد من المذاهب الفكرية المعاصرة، لكن النظرة المتوازنة التي يعطيها القرآن للفرد والمجتمع والتي تجمعها كلمة المسؤولية هي النظام الإسلامي الذي لا يجوز العدول عنه ولا يجوز التساؤل مع وجوده؛ لأن الإسلام هو استسلام لله تعالى كما قال عز وجل: ﴿بَلى مَن أَسلَمَ وَجهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ فَلَهُ أَجرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [البقرة: ١١٢].
وأما قولهم: “وتفصل سعيه لفهم ما يدور حوله من أحداث كبرى أو حتى الأمور الحياتية” فهذه ليست مهمة الفلسفة، بل مهمة مختصين في علوم أخرى كالسياسة والتاريخ وما يعرف بتفسير التاريخ وعلم الاجتماع؛ نعم، تاريخيًّا كان للفلاسفة الأقدمين شذرات في تفسير التاريخ، لكن ليس كل ما تكلم به الفلاسفة يُعدّ من الفلسفة، وإلا لزم جعل الطب والفلك من الفلسفة، ولعل أسوأ من اعتنى بتفسير التاريخ هم الفلاسفة، وأعني: هيجل (ت: 1831م) الذي نتج عن تفسيره للتاريخ اعتماد ماركس (ت: 1883م) عليه وظهور النظرية الماركسية التي ألحقت الكثير من الدمار في المناطق التي حلت بها، وسيجموند فرويد (ت: 1939م) الذي نتج عن تفسيره للتاريخ أكبر موجة انحلال حدثت في أوروبا، لم تستطع التراجع عنها حتى الآن؛ وأنضج تفسير أوروبي للتاريخ هي التفسيرات العديدة للتاريخ لدى توينبي (ت: 1975م) والذي لم يكن فيلسوفًا بل مؤرّخًا؛ وكذلك جوستاف لوبون (ت: 1931م) قبله والذي كان طبيبًا وأيضًا معتنيًا بالتاريخ كثيرًا، وأتصور أنه أول من تحدّث عن علم نفس الجماهير في كتابه “سيكلوجية الجماهير”.
وربما نقول: إن السبب في فشل الفلاسفة في تفسير التاريخ هو سعيهم لإيجاد عامل واحد لتفسير الأحداث انطلاقًا من فهمهم هم لمجموعة معينة من أحداث التاريخ التي يعرفونها، مع أن الأمر في حاجة إلى استقراء تام أو شبه تام لأحداث التاريخ، وهذه ليست بوسع الفلاسفة كما أن الاستقراء التام أو حتى الناقص يُخرج الفيلسوف من كونه فيلسوفًا إلى أن يكون شيئًا آخر؛ لأن الفلسفة جهد شخص وليست عمل جماعات بحث علمي؛ واستقراء التاريخ لا يمكن دون وجود جماعات بحيث إذا أردنا استقراءً حقيقيًّا -حتى ولو كان ناقصًا- علينا أن نُكَوِّن فرقًا علمية لدراسة تواريخ ضخمة لسائر الشعوب على وجه الأرض متباينة الأماكن والأزمان،كما أن النتائج المبنية على الاستقراء تُخرج الأمر من كونه جهدًا تأمّليًّا -كما هي الفلسفة- إلى كونه عملًا تجريبيًّا؛ أي: عملا علميًّا محضًا، وهذا ما لا يمكن أن توصف به الفلسفة إلا عند المتحمسين لها؛ لأن تسمية الفلسفة علمًا أمرٌ غير علميّ؛ إذ إن من أول أوليات العلم أن يكون له تعريف إما متفق عليه أو متفق على مضمونه، وهذا ما لا تملكه الفلسفة مطلقًا.
وكذلك البحث في الأمور الحياتية الأخرى ليست هي الفلسفة إلا من باب التوسّع الكبير في شرح الفلسفة، والذي يعتبر بحقّ توسّعًا غير مقبول أبدًا، وربما نقول: إنه توسّع مخادع يريد أن يجعل الفلسفة بديلًا عن الدين، وبديلًا عن العرف، وبديلًا عن الحكمة الموروثة، وبديلًا عن الشخصية المفردة لكل أمة لها مكوناتها ومؤثراتها الخاصة، وبديلًا أيضًا عن علم الاجتماع، وعن علم نفس الجماهير، وهي العلوم التي أصبحت لها قواعدها وأخصائيوها؛ وهذا بحق أمر يؤدّي حتمًا إلى التراجع بالمجتمعات وليس التقدّم بها؛ إذ ستجعلها عرضة للتقلب والتغير وفق أهواء أشخاص يشار إليهم بالبنان على أنهم فلاسفة، وهذا الأمر حدث بالفعل في أوروبا في أوج تعاطيها للفلسفة؛ فقد استطاع بعض الفلاسفة تغيير الأخلاق وإشاعة قيم تعاني منها أوروبا اليوم كما تعاني منها البشرية جمعاء في السياسة؛ حيث أدّت فلسفاتهم إلى قيام ثورات كبرى، أهمها الثورة الإنجليزية والفرنسية، كما تضمّنت الثورة الفرنسية تحديدًا ثورات أخرى على الإيمان والقيم والأخلاق على أيدي أمثال فولتير (ت: 1778م) ودعاة الحرية الذين سبقوا الثورة، وإن كان بعضهم حاول في فلسفته عن الحرية الحفاظ على القيم كما فعل جان جاك روسو في كتابه “أصل التفاوت بين الناس”، إلا أن الجماهير لا تتلقى النظريات الفلسفية بكل محترزاتها، بل تأخذ الفكرة الأم ويصعب عليها فهمُ أو العمل بالمحترزات ما دامت قادمة من بشر مثلهم؛ وهذا ما حدث أيضًا مع ديكارت قبل ذلك حيث كان يدعو للإيمان بوجود الله وبالدين النصراني، لكنه كان أبًا لفلسفة الشكّ، فأخذ الناس بالشك في كل شيء، وشكُّوا أيضًا في الله؛ الأمر الذي جعل محاولة إثبات وجود الله تعالى أحدَ هموم الفلاسفة بعده كديفيد هيوم (ت: 1776م) وإيمانويل كانت (ت: 1804م).
يقول ويل ديورانت عن أثر الفلاسفة في الثورة الفرنسية: “إنِّ الفلاسفة وفّروا الإعداد الأيدولوجي للثورة، وكانت أسبابها اقتصادية أو سياسية، وعباراتها فلسفية، وقد تيسر للأسباب الأساسيّة للثورة أن تفعل فعلها بفضل عمل الهدم الذي قام به الفلاسفة لإزالة العقبات القائمة في طريق التغيير، مثل الإيمان بالامتيازات الإقطاعية والسلطة الكنسية، وحق الملوك الإلهي. فقد كانت كل الدول الأوربية حتى عام 1789م تعتمد على معونة الدين في غرس قدسية الحكومات في النفوس وحكمة التقاليد وعادات الطاعة ومبادئ الأخلاق؛ وكانت بعض جذور السلطة الأرضية مغروسة في السماء، واعتبرت الدولة الله رئيس شرطتها السرية. كتب شامفور والثورة تدور رحاها يقول: (إن الكهانة كانت أول معقل للسلطة المطلقة، وقد أطاح به فولتير). وذهب توكفيل في 1856م إلى أن سوء السمعة العام الذي انحدر إليه الإيمان الديني كله في نهاية القرن الثامن عشر كان له ولا ريب أعظم الأثر في سير الثورة برمته”([21]).
أما ما ذكره معدُّو الكتيِّب التعريفي من كون الفلسفة تُعنى أيضًا بمفهوم الجمال فهذا من حيث المبدأ صحيح؛ لكن علم الجمال أو الأستاطيقا ليس أصيلًا في الفلسفة، فهو لم يدخل إليها، بل لم يوجد كتساؤلات مستقلّة إلا في القرن الثامن عشر الميلادي على يد الألماني بومجارتن (ت: 1762م)، لكن الواقع أنه مع نشأته المتأخرة لدى الأوروبيين فإنه هو علم النقد، فإذا كان المسؤول عنه جمال قصيدة أو قصة فهو علم النقد الأدبي، وإذا كان المسؤول عنه جمال لوحة فهو علم نقد الفن التشكيلي، وإذا كان المسؤول عن نقده قطعة موسيقية فهو علم نقد الموسيقى، إلا أن الفلاسفة الأوروبيين المعاصرين قدّموا تساؤلات يمكن أن نسميها تساؤلات ماورائية أو ميتافيزيقية كما هو تعريف الفنّ، ولماذا يبدو جميلًا؟ وما الفرق بين العملين؟ ولماذا تبدو هذه القصيدة أو اللوحة أو المقطوعة أجمل من الأخرى مع استيفائهما لمعايير الفن؟ وما غاية الفن؟ هل هي للفن أم للتربية أم لرسالة فكرية أم مجرد تعبير عن مشاعر؟
ويطرحون أيضًا كلّ هذه التساؤلات على مناظر الطبيعة. والذي يبدو لي أن هذه التساؤلات حقًّا فلسفية ما لم تخضع لمعايير نقدية علمية، فإذا تم ذلك خرجت من الفلسفة، وعندي أن خضوعها لمعايير علمية صعب جدًّا بل هي مسألة ذوقية، ولو أنها هي فعلًا الفلسفة المراد إدخالها لما كان في ذلك بأس ما دامت المادة المراد مناقشة جمالها مباحة وليست محرمة كالرقص والموسيقى؛ لكن الواقع يحكي أن علم الجمال من أقل المهارات التي يتحدث عنها الفلاسفة سواء المتقدمون منهم أم المتأخرون.
لكن السؤال المطروح على معدِّي كتيِّب التعريف بالمؤتمر: لماذا طُرح علم الجمال، ولم يطرح علم الأخلاق في هذا التعريف؟ مع أن علم الأخلاق أرسخ في تاريخ الفلسفة من علم الجمال، وأيضا ففهم علم الجمال والتفكير فيه لا يتمّ مطلقًا إلا بعد اعتناق الناقد مذهبًا فلسفيًّا في علم الأخلاق؛ فإما أن يكون ليبراليًّا أو ماركسيًّا.
ولعل السبب في تجاهل هذا العلم -أي: علم الأخلاق- هو ارتباطه التام في الوقت الحاضر بمدى الانتماء الديني.
وأيًّا ما كان فعلم الأخلاق بعد تنحية الجانب الطبي منه ليس علمًا محتاجًا إليه مطلقًا؛ ففي الإسلام نجد جميع أجوبة الأسئلة التي يتحدث عنها فلاسفة الأخلاق:
هل الأخلاق فطرية أم مكتسبة؟
وما النظري منها وما المكتسب؟
وما معيار تقييم الأخلاق؟
وما الخير وما الشر؟
ولماذا وُجِد الشر؟
وما الغاية من الخير؟
كلها أسئلة جوابها موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ثَمَّة أسئلة أخرى لا يمكن العثور على جوابها مباشرة في النصوص الشرعية فيمكن العثور عليه عبر التدبر والتفكر في كتاب الله سبحانه وفي خلقه.
أما قولهم: “إلى جانب بحثها في مفاهيم التعايش بين البشر” فغير صحيح مطلقًا؛ فالتعايش بين البشر يُبحث في علم الاجتماع في مفاهيمه وليس الفلسفة، وهو علم أصبح اليوم قائمًا، كما أنه يُدرَّس في المملكة العربية السعودية منذ المرحلة الابتدائية؛ حيث يُدرَّس الطالب بعض مبادئ علم الاجتماع المشتركة بينه وبين الجغرافيا البشرية أو الجغرافيا السكانية في المرحلة الابتدائية، ثم يُدرَّس بشكل مستقل في المرحلة الثانوية، ثم يكون أحد التخصصات العلمية في المرحلة الجامعية؛ هذا إضافة إلى أن علاقة المسلم بالمسلم وعلاقة المسلم بغير المسلم هي بحث فقهي، يحتوي على ثوابت لا يمكن التراجع عنها، وعلى قضايا تفصيلية يمكن أن تكون قابلة للاجتهاد وتغيير الفتوى؛ أما الزعم بأنها جزء من الفلسفة التي هي عبارة عن مجهود عقلي صرف فهذا غير صحيح كما قدمت.
ثم تحدث معِدّو الكُتيِّب الترويجي للمؤتمر تحت عنوان: (أهمية الفلسفة) عمَّا يرون أنه سبب للدعوة إليها وإقامة هذا المؤتمر لها، ومما جاء في حديثهم: “تُساعدنا الأسئلة الفلسفية الجوهرية على مواجهة التحديات اليومية”.
والسؤال هنا: ما التحديات اليومية؟
الجواب: أن هذا الطرح من الأطروحات الناشئة عن مرض نفسي، فهو ناتج عن شعور مستمرّ بالقلق وخيبة الأمل والضيق بالنفس وبالناس؛ فهو طرح يُشعر الإنسان بأنه يعيش في حياته في تحديات يومية وصراع مع محيطه، وهذا في ذاته ترويج خطير جدًّا للمشاعر السلبية من القنوط واليأس؛ فماذا عسى الإنسان فاعل حينما يشعر أنه في تحدٍّ دائم؟!
والمشكلة أنه تحدٍّ لا ينقذه منه إلا الفلسفة! فالفلسفة هي التي ستضمن له رزقه وتربية أبنائه ومستقبله وعلاقته بالواجبات الشرعية والمنهيات التي هي حدود الله! وأين هذا من قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجًا وَيَرزُقهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِبُ * وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمرِهِ قَد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدرًا﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: 5، 6]، وغير ذلك من آيات تنشر الطمأنينة في النفس، وتشبعها بالتوكل على خالق الكون ومقدر الأقدار ومدبر الليل والنهار.
وقالوا عنها: “كما تُسهِّل التواصل بين البشر، وتعلِّمنا ثقافة التعايش”.
فأقول: إن التواصل بين البشر أمر عمليّ، وتسهيل التواصل شيء تقوم به وسائل الاتصالات والإعلام وعلم الترجمة، وليس للفلسفة دخل فيه، ولا يوجد في كتب تاريخ الفلسفة أو معاجمها أيّ شيء يدلّ على أن قضية التواصل بين البشر وتسهيله شكّلت جزءًا من اهتمامات الفلاسفة، اللّهم إلا أن يقال: إن ذلك كان فيما عُرف بكتب المدن الفاضلة، من أمثال “جمهورية أفلاطون: (ت: 347 ق.م)، و”آراء أهل المدينة الفاضلة” للفارابي، و”أتلانتس الجديدة” لفرانسيس بايكون (ت: 1626م)، وغيرها، وهذه المدن الفاضلة هي في الحقيقة مشاريع سياسية يجري في داخلها الحديث عن الله وماهيته وصفاته كما فعل الفارابي (ت: 339هـ)، وهو الوحيد من بين هؤلاء المنتمين لأبناء المسلمين، ومع ذلك فتصوّره لله تعالى تصوّر كفريّ كما بَيَّن ذلك أبو حامد الغزالي رحمه الله (ت: 505هـ) في “تهافت الفلاسفة”. كما يتحدّث أصحاب المدن الفاضلة عن تقسيم المجتمع كما فعل أفلاطون في تقسيمه الطبقي العنصري، وتتضمّن المدن الفاضلة الحديثَ عن الأخلاق كما فعل فرانسيس بايكون، وهي أخلاق ليست مبنية على أسس دينية، وإنما على أساس افتراضي وهو الحرية؛ لذلك فالتواصل بين البشر ليست قضية أصيلة في الفلسفة، وعلى القول بأنها من محدثات الفلاسفة، فأين الحاجة إليها مع نظرة الإسلام للبشر التي تنظم علاقاتهم تنظيمًا دقيقًا مبنيًّا على طاعة الله وابتغاء مرضاته يحقّق التراحم والتواؤم والتكافل والتناصح كما يتضمن المسؤولية التي تكلّمنا عنها ويرفضها اليوم الفلاسفة والحداثيون؛ حيث يرونها وصاية تحول بين الإنسان وحقه في العيش حرًّا؟!
وقالوا أيضا: “تعلِّمنا ثقافة التعايش“.
وهذه فرية كبيرة؛ لأن تاريخ الفلسفة إذا جعلناه من عهد طاليس الأول فلها اليوم أكثر من ألفي عام وستمائة عام، ولم نر العالم قد حقّق التعايش؛ بل إن اليونان في عهد ازدهار الفلسفة كانت عبارة عن دويلات صغيرة جدًّا ومتحاربة!
والفلاسفة أنفسهم وتلاميذهم لم يستطيعوا أن يحقّقوا التعايش لأنفسهم فضلًا عن أن يحققوه لغيرهم؛ فسقراط مات مقتولًا بحكم من الشعب! وأفلاطون بيع في سوق العبيد! كمثالين فرديين، وإلا فإن المجتمعات لم تحقّق في ظل الفلسفة أيّ نوع من التعايش حتى يومنا هذا؛ والولايات المتحدة ودول أوروبَّا نفسها لا تعيش تعايشًا بينها وبين بعضها، وإنما تعيش فترة انكفاف عن الحرب بسبب عوامل ردع؛ منها ما هو عائد إلى امتلاك أسلحة خطرة، ومنها ما هو عائد إلى مصالح اقتصادية.
ونسأل الله تعالى العافية من أي انفجار له، فجميع هذه الدول منكفّة عن بعضها على مضَض؛ لأن الحلول العسكرية أصبحت مع تطورات المخترعات القاتلة خطيرة التكلفة؛ فجعل الانتصار لأحد الطرفين مسألة مستحيلة في حال حدوث أي نزاع مباشر.
أما النزاعات غير المباشرة -والتي تسمى الحروب بالوكالة- فَسَيل من اللافا البركانية لا يكاد ينقطع.
وأما التعايش داخل هذه الأوطان -أعني: الغربية- فإنه وهم غير موجود؛ لأن الإنسان الغربي اليوم يعيش حالة من العزلة والانكفاء على الذات تجعله يبدو متعايشًا مع غيره، والحقيقة أنه غير متعايش حتى مع نفسه.
المهمّ أن أيّ حالة من التعايش يعيشها العالم ليست ولن تكون ثمرة للفلسفة؛ لا سيما أن من الفلسفات ما هي فلسفة تنافر لا تعايش كفلسفة نيتشه التي لا تجعل العيش حقًّا إلا للقويّ (السوبرمان)، وقبلها فلسفة ميكافيلي (ت: 1527م): “الغاية تبرر الوسيلة”، والتي نشرها في كتابه “الأمير”، والمؤسف أن هاتين الفلسفتين كان لهما أثر كبير في الدمار الذي حصل في أوروبا عبر الحربين الكونيتين، وكذلك اعتنقهما عدد كبير من العسكريين في بلاد العالم، وألحقوا بسببهما الويلات ببلادهم؛ وربما نضيف إليهما فلسفة وليم جيمس (ت: 1910م) البراغماتية، فهي أيضًا فلسفة تجعل النفع الحسيّ هو مبرر العلاقات، وعليه فلا تكون هذه الفلسفة دعوة كريمة للتعايش.
المهم أن أيّ تعايش حصل أو سيحصل لم يكن في أي مكان في العالم بدافع من الفلسفة مطلقا.
كما قال معِدّو الكتيب: “وذلك من خلال طرح الأسئلة التي تنمِّي التفكير النقدي وتشجع الحوار المفتوح”.
صحيح، إن الفلسفة تعتمد على الأسئلة الناقدة، وهنا عدة ملاحظات:
إحداها: أن الأسئلة الفلسفية لا تفرّق بين عالم الغيب وعالم الشهادة، فهم يسألون عن كل شيء، وهذا الأمر ليس جيّدًا؛ لأن عالم الغيب يجب أن يكون في منأى عن أي سؤال؛ لأن السائل والمسؤول كلاهما لا يملكان إلا أجوبة عقلية، والعقل لا يمكنه أن يقدّم أي جواب صحيح إلا على ما كان محسوسًا، وعالم الغيب ليس له أدلة حسّية ما خلا وجود الله تعالى، أما صفات الله تعالى فالكثير منها لا تثبت إلا بالنصوص، نعم العقول لا تمنعها لاستحالة التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، لكنها لا تثبتها، وكذلك البعث وما يجري فيه والبرزخ والملائكة والجنة والنار وغيرها كلها أمور لا يمكن للسؤال الناقد أن يكون نافعًا فيها، وإنما سيكون ضارًّا مُوقِعًا صاحبه في الشكوك والاضطراب؛ بل إن محاكمتها إلى العقل من المنهي عنه بدلالة قوله تعالى: ﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]؛ إذ لا ينفع فيها سوى التسليم لله تعالى.
ثانيتهما: أن الحضّ على التفكير النقديّ مطلقًا كما هو حاصل الآن أمر شديد الإضرار بالنشء؛ وذلك لأن النقد لا بد أن يُسبق بالتعلم، والتدريبُ على النقد قبل تكوين المعرفة له مخاطر كبيرة جدًّا، أهمها عدم الثقة بالمعارف مطلقًا، وهذا أمر لا يؤدّي إلى أي نوع من الاستقرار الفكري والاجتماعي، بل هو طريق واسع نحو الضياع.
وهناك من مؤيّدي تعميم التدريب على التفكير الناقد من يستند إلى الفكرة الديكارتية وهي فكرة الشكّ في كلّ المعارف، بل حتى الشكّ في وجوده هو، وهي المرحلة من الشك التي تخلّص منها بوجود شيء يقيني واحد استطاع أن يبني عليه فلسفته، وهو أنه يَشُكّ، وكونه يَشُك دليل على أنه يفكِّر، وكونه يفكِّر دليل على أنه موجود.
ويقول البعض دفاعًا عن فلسفة الشكّ: إن هذا الشكّ الذي أصَّل له ديكارت كان من أبرز أسباب التقدم العلمي في أوروبا، فلولا شك الأوروبيين في وجودهم وموروثهم من سائر العلوم والعقائد لما وصلت إلى ما وصلت إليه، ولأصبحت أسيرة دينها وعاداتها الموروثة وثقافتها التقليدية؛ ولذلك فتربية الناس والنشء خاصّة على التفكير الناقد سوف يكون لها أثرها عند المسلمين بالقدر الذي كان لها عند الأوروبيين.
والحقيقة أن هذا اللون من التفكير ممن يدَّعون أنهم دعاة الفلسفة أبعدُ ما يكون عن نسق التفكير الفلسفي الذي دعا إليه ديكارت في كتابه “مقالة في المنهج”، وبالمناسبة فديكارت في كتابه هذا أكّد على أن الفلسفة لا تثمر الحقيقة، ولا يمكن البناء عليها، ومما قاله: “ولن أقول عن الفلسفة إلا أنه لما رأيت أن الذين كانوا يتدارسونها هم خيرة العقلاء ممن عاشوا منذ عهود كثيرة، ومع ذلك ليس فيها بعدُ أمر لا يُجادل فيه، أي: مشكوكًا فيه”([22]).
المهمّ في سياقنا أن قياس الحالة الأوروبية بكل ما تختلف فيه عن العالم الإسلامي وعن المملكة العربية السعودية لا يدلّ على منهج علمي في التفكير، ولكنه يدلّ على إعجاب بالغرب غير منضبط، ومحاولة أطر الشرق ليتّخذ أساليب الغرب في التفكير.
ونقول: إن فكرة الشكّ الديكارتي أثمرت في أوروبا ثمارًا جيّدة فيما يتعلق بالفلك والفيزياء، حيث كانت الكنيسة تعتبر آراء أرسطو وبعض آراء أفلاطون مقدّسة، وتضيفها إلى التعاليم الرسولية، والشكّ فيها قد أفاد الغرب في التفكير من جديد فيها؛ كما دعم الشكّ الديكارتي لاحقًا فكرة العلم التجريبي التي ظهرت فيما بعد على أيدي فلاسفة كأمثال دايفد هيوم؛ لكنها -أعني فكرة الشكّ الديكارتي- أنتجت مشكلات كبيرة، منها: التأسيس للإلحاد العلمي، أي: الإلحاد الذي يستدلّ أصحابه له بالفيزياء والنظريات العلمية كما فعل الأديب الفرنسي فولتير مع نظرية الجاذبية لإسحاق نيوتن، وكذلك أسست الديكارتية للانهيار الديني والأخلاقي ومن ثم الاجتماعي في أوروبا.
المهمّ أن التفكير الناقد ليس أمرًا إيجابيًّا بشكل مطلق؛ بل لا بد من بناء النشء على التسليم للمسلّمات الشرعية في العقيدة والفرائض والأخلاق ومصادر التلقي، ثم بعد ذلك يكون النقد خارج هذه الأطر، ولا يكون النقد فلسفيًّا؛ لأن الفلسفة كما قال ديكارت: لا تقدّم حلًّا للمشكلات وإنما تعمّقها، لكن يكون النقد وفق مبادئ وأسس تلك العلوم المنقودة.
أما ما ذكروه -أي: معدُّو الكتيب التعريفي- من كون الفلسفة تساعد على فهم العالم بشكل أفضل فهي مغالطة ودعاية مجردة عن الدليل، ولا يمكن أن يكون لها دليل؛ لأن الفلاسفة الكبار لم يستقرّوا على شيء من أجل فهم أي شيء من ظواهر العالم؛ لا السياسي ولا الاجتماعي ولا الطبيعي، ولم يحُلّ إشكالات الفلاسفة سوى العلم التجريبي أو الدين الحقّ فيما مردُّه الدين، أما ما مردُّه إلى الفكر المحض فلا الفلاسفة ولا غيرهم استطاعوا الوصول فيه إلى فهم واحد أو حتى فهم متقارب، كما أن الفهم الواحد أو المتقارب لجميع الظواهر ليس شرطًا أبدًا، ولعله من المستحيل؛ حيث إن الناس لم يتفقوا على القطعيات وخالفوا فيها، وممن اختلف فيها الفلاسفة، فلا يمكن أن يقال بحتمية التوافق تحت ظلال الفلسفة.
ثم أنتقل الآن إلى جهة أخرى لقراءة دعوات إحياء الفلسفة السعودية من خلال النظر في الإصدارات الفلسفية في السعودية، كي نجيب عن السؤال الْمُلِحْ: هل نحن هنا بحاجة إلى الفلسفة بهذا المسمّى ذي الثقل التاريخي الكبير، والذي يحمل في نظرنا أعباء ولا يحمل حلولا مطلقا؟ وهل ما يقدّمونه الآن بغية الترويج لهذا المطلب هو فلسفة كما يدعون أم ليس الأمر كذلك؟
ولعل أبرز من أراه يمثل الفلسفة في السعودية جهتان: الأولى: مجلة حكمة، الثانية: جمعية الفلسفة.
وحين نراجع إصدارات الجهتين نجد أنهما تشتركان في كون هذه الإصدارات يغلب عليها جانب الترجمة أو دراسة الشخصيات الغربية، وتخلو تقريبا من إثارة أيّ قضايا يمكن أن نقول: إنها اهتمامات شعبية مسلمة أو عربية أو سعودية، كما أن الإصدارات يقلّ فيها طَرْق الجانب الميتافيزيقي، وغالبًا فإنّ طرق هذا الجانب يكون عبر نصوص مترجمة وليس إبداعًا من الكتاب المشاركين، كما تكثر لديهم -أي: في إصداراتهم- طرح الموضوعات التي قدَّمنا فيما سبق من الطرح في هذه الورقة أنها موضوعات في الفكر العام وليست من صميم الفلسفة؛ وهذه القضية أعني قضية تقديم نصوص ليست فلسفية على أنها من الفلسفة هو من التوسع الذي يُراد به تزكية الفلسفة وتسويتها وادِّعاء أنها لا ضير فيها، مع أن الحقّ خلاف ذلك؛ لأن الفلسفة ليست هذه الموضوعات في الفكر العام، وإنما هي في مسائل أعمق وأخطر من ذلك.
وهنا نبدأ جولة مختصرة في إصدارات مجلة الحكمة، والتي هي على صلة كبيرة بدار (جداول)؛ حيث يوجد رابط إصدارات دار جداول ضمن موقع مجلة الحكمة.
ولأبدأ باختيار بعض المقالات في مجلة الحكمة، وسنخصّ المقالات التي تم تصنيفها بأنها فلسفية.
فمنها مقال: “الفكر الإصلاحي عند نوردين بوكروح”، هكذا تمت كتابة اسم الشخصية المدروسة، وأعتقد أن اسمه نُقِل عند كاتب المقال من الهجاء الفرنسي مباشرة، ولم يُكلّف الكاتب نفسه العودة بالاسم إلى أصله العربي، وهو: “نور الدين بو قروح”!
وحين تقرأ المقال تجد أن الشخصية المدروسة ليست شخصية فلسفية أصلًا، وإنما هو اقتصاديّ ومفكر عاصر الثورة الجزائرية، وكان له موقف من الاشتراكية، ويؤيّد الفكر الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي، ومشكلة محاولة وصف كل اقتصادي أو اجتماعي أو عالم نفساني في سياق الفلاسفة هي كما قدمنا رغبة في تسويق الفلسفة لا غير.
المقال الثاني: “التربية وإيتقيا الصورة عند جاستون لاشلار”، وهو مقال مُترجَم عن نظرية باشلار حول التربية بالخيال أو أثر الخيال الإيجابي على تربية الأطفال؛ فهو إذن يُصنَّف ضمن كتب علم النفس أو كتب التربية، وكلا العلمين انفصلَا كما قدمنا عن الفلسفة وأصبحا مستقلين، إضافة إلى أن بلادنا منذ بدء التعليم فيها وهي لا تمانع من تدريس هذين العلمين، كما لا تمانع من تدريس جميع العلوم التي انفصلت عن الفلسفة بسبب خضوعها للعلم التجريبي الذي لا زالت الفلسفة تفتقر إليه.
المقال الثالث بعنوان: “ماذا يعني التوجه في التفكير؟”، وهو مقال للفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، وهو حقًّا في الفلسفة، لكنه في ذلك العلم الذي لا يعنينا ولا يقدِّم شيئًا؛ وكما نصَّ المترجم نفسه بقوله: إنَّ كانت في هذا المقال لا يقدّم إلينا شيئا لا نعرفه، فالمقال يناقش مسألة العقل ودوره في المعرفة، وهي مسألة كانَت زمن كانْت تشكّل أزمةً بين الكنيسة والمثقفين، ونحن في الإسلام الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة -رضوان الله عليهم- ليست هذه من مشكلاتنا، ولدينا الحلول الوافية فيها والتي أشبعها بحثا ابن تيمية في موسوعته: “درء التعارض بين العقل والنقل”، والعجيب أن ابن تيمية الذي أظهر أن حلول المشكلات الفلسفية واضحة في كتاب الله تعالى ونقَد الفلسفة نقدا لا نظير له ليس له أي مكان في منشورات هاتين الجهتين، الحكمة وجمعية الفلسفة.
ونكتفي بهذه النماذج من إصدارات حكمة لنأتي على ثلاثة نماذج أيضا من جمعية الفلسفة.
وليكن أولها نص بعنوان: “شكرًا”، ويحتوي على ترجمة لمحاورة بين دايوتيما وسقراط نقلها رئيس الجمعية عبد الله المطيري، وهو حوار لا يمتّ للفلسفة وقضاياها بصلة حول ما يلزم من قول القائل: شكرا، هل هو إنهاء الحوار أو الشعور بالامتنان، وهو نصّ أكثر ما يمكن أن يقال عنه: إنه نصّ أدبي جرى قبل ألفين وأربعمائة عام، وكما أنه لا يمتّ للفلسفة بصلة فهو أيضا لا يقدّم كبير فائدة للمثقف بشكل عامّ، ولا للمثقف السعودي بشكل خاصّ، سوى كونه نصًّا من أعماق التاريخ؛ والحقّ أن لدى المتحمسين لتسويق الفلسفة ولعًا بتوسيع نطاقها، حتى إنهم يعدُّون كلّ ما صدر عن الفيلسوف فلسفة كما في هذا النص الذي ليس له من الفلسفة سوى أن أحد طرفيه سقراط!
النموذج الثاني: “رسالة في النفس والطبيعة ليزيد يدر”، وهذه الرسالة مثل ممتاز لاضطراب الفلاسفة وعدم قدرتهم على الإجابة على أي تساؤل، وأنهم لا يقدّمون أي حل، فقد ساق الكاتب أقوالًا كثيرة متباينة للفلاسفة في معنى النفس وعلاقتها بالطبيعة، ولم يستطع الوصول إلى جواب مقنع للقارئ، كما أنه لم يستند في براهينه إلى يقينيات يمكن أن يبني عليها المتلقي قناعات، أو يمكن أن يتخذها برهانًا؛ إضافة إلى أن البحث دليل على ما قدَّمنا من أن دعاة التفلسف العرب مصابون بالهزيمة الحضارية تجاه الغرب، فهو لم يحاول الرجوع إلى القرآن الكريم الذي تحدّث عن النفس في عدد من المناسبات، ويمكن من دراسة تلك النصوص الخروج بنتيجة تتميز بأنها ترجع لمصدر يقيني، وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن الذي لم يجد له الكاتب مكانًا سوى في التصدير للمقال حيث وضع ثلاثة نصوص وهي:
الأول: لمعيد دلفي.
الثاني: لأرسطو.
الثالث: قوله تعالى: ﴿وَيَسأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمرِ رَبّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].
والعجيب أن المسلمين كتبوا في النفس كُتُبًا، منها ما نتّفق معه، ومنها ما نختلف معه، ومن أمثلتهم الغزالي (ت: 505هـ) رحمه الله في كتابه “معارج القدس في مدارج معرفة النفس”، و”تلخيص كتاب النفس لأرسطو” لأبي الوليد بن رشد، وكذلك معظم علماء الكلام المسلمين كـ”المواقف” للإيجي، و”المقاصد” للنسفي، وشروحهما، كلها تحدّثت عن النفس وعن علاقتها بالطبيعة، إلا أن الباحث لم يتطرق في بحثه للعلماء المسلمين سوى ابن سينا.
المهم لديّ هنا: أن هذا البحث لا يتضمّن أسئلة ملحّة أو غير ملحة في المملكة العربية السعودية سواء عند النخب أو عامة الناس؛ فالجميع مكتف بالأجوبة القرآنية، ولا يعانون من أي صراع في المفاهيم بين الدين والعقل أو الدين والواقع كي يكون لهم مشكلات حول حقيقة النفس سوى ما ينتاب بعض الناس من أمراض ليس علاجها أبدًا عبر الميتافيزيقا؛ وإنما بالعلم الحقيقي المبني على نتائج تجريبية تستحق أن تبنى العلوم عليها.
النموذج الثالث: مبحث مُترجم بعنوان: “البراجماتية بوصفها مناهضة للاستبداد”. وسيرى قارئ البحث أنه لا علاقة حقيقيّة بين عنوان البحث ومضمونه سوى أن الباحث أثار في مقدمة البحث نظرة جون ديوي للإله على أنه مستبدّ، وأن الحياة ستكون أفضل بدونه. أما بقية البحث فهو محاولة لفهم أعمق لفلسفة مؤسِّسَي المذهب البراجماتي([23]) من خلال اتخاذ فلسفة سيجموند فرويد مدخلًا لها، مع أن الظاهر وجود بون شاسع بين التوجهين.
المهم هنا أن البحث لا علاقة له بالسعودية، ولا يطرح أيّ مشكلة فكرية موجودة لدينا، ولكنه يصنع مشكلة ويدعو إلى عدم الثقة بالله تعالى بزعم أنه كائن خارجي ليس له الحق في إملاء إرادته علينا.
هذه النماذج الستة التي اخترتها لتكون ممثلًا لجميع إصدارات هاتين المؤسَّستين اللتين حتى الآن تمثلان دعاة الفلسفة في بلادنا يتضح منها: أنها عبارة عن دعوة لصناعة مشكلات عقدية غير موجودة، وبالتالي هي عمل لزعزعة الدين في نفوس النخبة من الشباب، كما أنها دعوة صريحة للتبعية الفكرية للغرب، ويبدو ذلك من خلال اتجاه جميع هذه الإصدارات إلى اجترار المشكلات الفلسفية الغربية التي تُعبِّر عن الاحتياج الفكري لدى الغرب، ولا تعبر أبدًا ولا تشيد بالاستقرار الفكري العقديّ لدينا، وهو الاستقرار الذي تعمل الدعوة إلى الفلسفة على الإطاحة به.
الخاتمة:
الخاتمة قصيرة جدًّا، وهي نتيجة السؤال الذي قدّمتُ به هذه الورقة، وأعني سؤالي: هل نحن بحاجة إلى الفلسفة في بلادنا؟
الجواب: لا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) المعجم الفلسفي: جميل صليبا – مادة فلسفة.
([2]) ينظر: تاريخ الفكر الفلسفي الغربي، الطيب بوعزة (ص: 39).
([3]) دراسة في الفلسفة اليونانية والإسلامية، صالح الرقب (ص: 6).
([5]) تاريخ الفكر الفلسفي الغربي، الطيب بوعزة (ص: 56).
([6]) كتاب الكندي إلى المعتصم بالله، تحقيق: أحمد الأهواني (ص: 77).
([7]) ينظر: دراسة في الفلسفة اليونانية والإسلامية، لصالح الرقب (ص: 8).
([8]) دراسة في الفلسفة اليونانية والإسلامية، صالح الرقب (ص: 8).
([10]) تهافت الفلاسفة (ص: 76).
([11]) ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم (ص: 8).
([12]) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (ص: 20).
([13]) قصة الفلسفة اليونانية، أحمد أمين وزكي نجيب محمود (ص: 19).
([14]) تاريخ الفكر الفلسفي الغربي، الطيب بوعزة (ص: 135 وما بعدها).
([15]) المرجع السابق (ص: 259).
([16]) فتاوى ابن الصلاح (1/ 209).
([17]) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد (ص: 71).
([19]) الإسلام والطاقات المعطلة (ص: 73).
([20]) أخرجه البخاري (893)، ومسلم (1829).