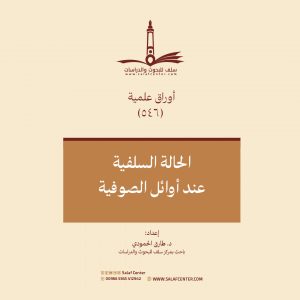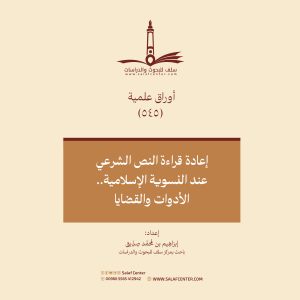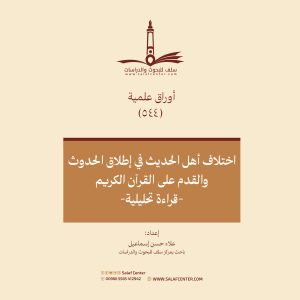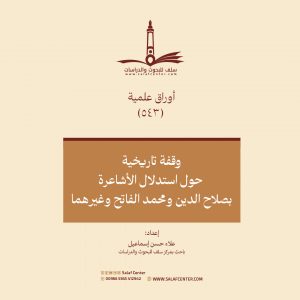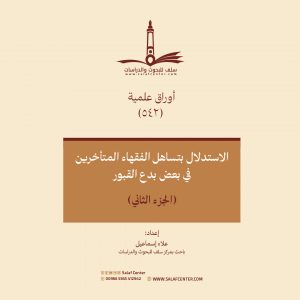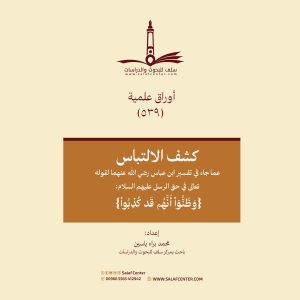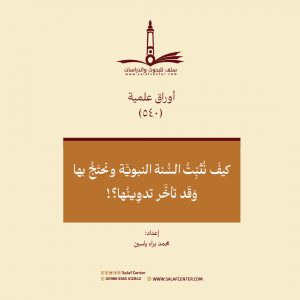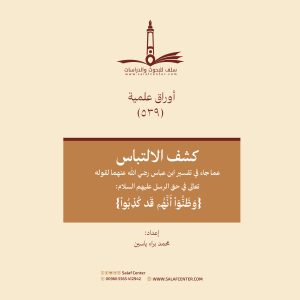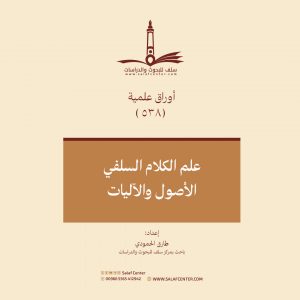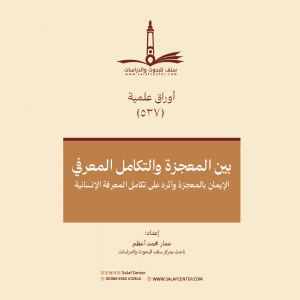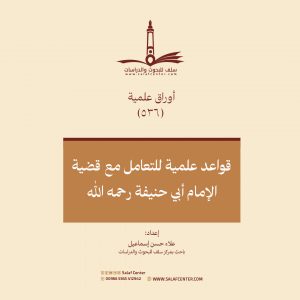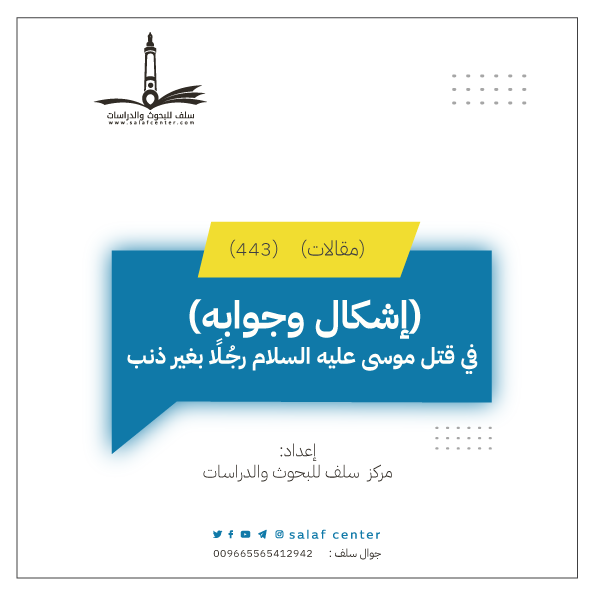
(إشكال وجوابه) في قتل موسى عليه السلام رجُـلًا بغير ذنب
من الإشكالات التي تُطرح في موضوع عصمة الأنبياء: دعوى أن قتل موسى للرجل القبطي فيه قدحٌ في نبوة موسى عليه السلام، حيث إنه أقدم على كبيرةٍ من الكبائر، وهو قتل نفسٍ مؤمنة بغير حق.
فموسى عليه السلام ذُكِرت قصتُه في القرآن، وفيها ما يدُلّ على ذلك، وهو قَتلُه لرجُل بَريء بغير حقّ، وذلك في قوله تعالى: {وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ * قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي فَٱغۡفِرۡ لِي فَغَفَرَ لَهُۥٓۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ * قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلۡمُجۡرِمِينَ} [القصص: 15-17].
وهذه القصة موجودة أيضًا في التوراة (العهد القديم) في الإصحاح الثاني من سفر الخروج، مع وجود بعض الأخطاء فيها([1]).
يقول ابن خمير السبتي: (فمن أقوال المخلّطة في هذه القصة أن موسى عليه السلام قتل القبطي من أجل العبراني؛ لأن كان العبراني من قبيله، والقبطي من غير قبيله، فصيروا الكليم عليه السلام متعصّبًا لأجل قبيلته وعشيرته، وليس الأمر كذلك، وحاشاه من ذلك، فإن هذه هي حمية الجاهلية)([2]).
والجواب عن هذا: أنه لا يصح الطعن في موسى عليه السلام بسبب قتل القبطي، ومن تأمل كامل السياق علم ذلك؛ لأمور منها ما يأتي:
أولًا: أنَّ القِبطيَّ فِرْعَونيٌّ ظالمٌ كافرٌ، وتسمية الله تعالى له عدوًّا دالٌّ على أن العداوة دينية، وهذا يدل أن موسى عليه السلام وكز الكافر العدو لأجل كفره لا لغير ذلك([3]).
وقد جاء عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: {وَقَتَلۡتَ نَفۡسًا فَنَجَّيۡنَٰكَ مِنَ ٱلۡغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًاۚ} [طه:40] : (قتل قِبْطِيًّا كافِرًا)([4]).
ثانيًا: أنَّ المُعتَدَى عليه عبراني مَظلومٌ مؤمِنٌ، على بقايا من دينِ يوسف عليه السلام، حيث كان في بني إسرائيل وفي القبط مؤمنون يكتُمُون إيمانَهم، فكان هذا الرجلُ المُستغيث بموسى عليه السلام منهم، ونُصرة المظلوم مطلوبةٌ.
ثالثًا: أنَّ العبراني قدِ استنجَد بموسى، واستغاث به، واستصرَخه، وطلَب منه إنقاذَه ونجْدتَه، وكيف لا يُنجِده موسى ويُغيثه؟!
رابعًا: دخَل موسى بينهما ليَردَع المُعتديَ عن عُدوانه، ويفُضَّ الاشتباكَ، ويُنهِيَ القتال، ولمَّا وكَزه كانت وَكْزَته لهذا الهدف، وهو هدَفٌ نبيلٌ مطلوبٌ.
خامسًا: أن موسى عليه السلام ما وَكْزُه وضَرْبُه له إلا وسيلةٌ لذلك، والوَكْزة (وهي الطعنُ، والدفعُ، والضربُ بجميع الكفِّ) لا تقتُل رجُلًا في الغالب، لكنَّها إرادةُ الله وحِكمته التي أنهَت عُمْرَ القِبطي بوَكْزةِ موسى له؛ وذلك ليُحقِّق الله إرادتَه في ترتيب الأحداث التالية وتَدبيرها كما قدَّرها الله سُبحانه.
يقول ابن خمير السبتي: (فإنه ما طعنه بحديدة، ولا رماه بسهم، ولا ضربه بفهر، ولا بغيره، وإنما وكزه، وما جرت العادة بالموت من الوكزة، وإن مات منها أحد فنادر، والنادر لا يحكم به)([5]).
سادسًا: لم يكن دافعُ مُوسى عليه السلام في ذلك التدخُّل إلا الانتصار للحق على جميع التقادير، ولذلك لما تكرَّرَت الخصومةُ بين ذلك العبراني وبين قبطيٍّ آخر وأرادَ موسى أن يبطش بالقبطي لم يقُل له القبطي: إن تريد إلا أن تنصر قومك، وإنما قال: إن تريد إلا أن تكون جبارًا في الأرض، وهذا يبطل القول بأن الذي حمل موسى على ما فعل العصبية لقومه([6]).
سابعًا: لم يَقصِد موسى قَتلَ القِبطي، ولم يتعمَّدْه، ولكنَّ الله جعَل انتهاءَ أجَله بوَكْزةِ موسى له، ولا يُلام على موت إنسان تسبَّب في موتِه دون أنْ يَقصِد ذلك أو يتعمَّدَه.
وأما استغفاره فهو لأنه فعل شيئًا قبل أن يأمره الله تعالى به، وهذا ما سيعتذر به يوم القيامة حين يقول: «إنِّي قتلتُ نفْسًا لم أومَرْ بقتلِها» كما سيأتي.
يقول أبو عبد الله السنوسي: (وأما خبر موسى عليه السلام مع قتيله الذي وكزه: فقد نصّ الله تعالى أن القتيل من عدوِّه، وإنما قصد موسى عليه السلام إغاثة الملهوف الإسرائيلي، فوكز العدوَّ القاهر له بنيةِ دفعه عمَّن استولى عليه، فصادف موتَه من غير عمدٍ)([7]).
أحوال القبطي:
ومَن لم يَقنَع بما تقدَّم يُقال له: حالُ القِبطي لا يَخْلو من أربعة احتمالات:
الاحتمال الأول: إمَّا أنْ يكون مُستحقًّا للقتل، وقتَلَه موسى مُتعمِّدًا، فلا يَقدَح ما فعَلَه في العِصمة بغير إشكال.
الاحتمال الثاني: أن يكون غير مستحقّ، وقتله موسى متعمّدًا، فيقال حينئذٍ: إن ذلك كان قبل نبوته، فقد جاء عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى : (كان إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة)([8]).
ولا يجب على النبي قبل أن يبعث نبيًّا أن يكون لا يُخطِئ، أو لا يذنب، فليس في النبوة ما يستلزم هذا([9]).
وهذا على افتراض تحقّق كون قتله تلك النفس ذنبًا في حقّ موسى عليه السلام، وإلا فلم تكن ثمة شريعة يتبعها القبط الذين نشأ بينهم موسى عليه السلام، إلا أن يكون ملتزمًا بشريعة يوسف عليه السلام.
يقول ابن خمير السبتي: (وأما قوله عليه السلام لفرعون: {فَعَلْتَهُا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ} فيعني به أنه كان عندما قتله من الغافلين الغير مكلفين، فكأنه يقول له: فعلتها قبل إلزام التكليف، وإذ كنت غير مكلف فلا تثريب عليَّ، فإنه لا يقع الذنب والطاعة إلا بعد ثبوت الأمر والنهي)([10]).
ويقول ابن تيمية: (الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه، كما قال تعالى: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: 124]، وقال: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ} [الحج: 75]. بل قد يبعث النبي من أهل بيت ذي نسب طاهر، كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها([11]). وقد قالوا لشعيب مع استضعافهم له: {وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ} [هود: 91].
ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه منهم نقصٌ ولا بُغض ولا غَضاضة إذا كان على مثل دينهم إذا كان عندهم معروفًا بالصدق والأمانة، وفعلِ ما يعرفون وجوبه، واجتنابِ ما يعرفون قُبحَه، وقد قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]؛ فلم يَكُن هؤلاء مستوجِبِين العذاب قبل الرسالة، وإن كان لا هو ولا هم يعلَمُون ما أُرسِلَ به.
وفرقٌ بين من يرتكب ما عَلِم قبحه وبين من يفعل ما لم يعرف، فإن هذا الثاني لا يذمُّونَه ولا يعيبُونَه عليه، ولا يكون ما فعله مما هم عليه مُنفِّرًا عنه بخلاف الأول؛ ولهذا لم يكن في أنبياء بني إسرائيل من كان معروفًا بشركٍ، فإنهم نشؤوا على شريعة التوراة، وإنما ذكر هذا فيمن كان قبلهم…
وقد اتفقوا كلهم على جواز بعثة رسولٍ لم يَعرِف ما جاءتْ به الرُّسُل قبلَه من أمور النبوة والشرائع، ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو كافر.
والرسل قبل الوحي قد كانت لا تعلم هذا، فضلًا عن أن تقر به، فعلم أن عدم هذا العلم والإيمان لا يقدح في نبوتهم، بل الله إذا نبَّأَهُم عَلَّمَهم ما لم يكونوا يعلمون، وقد قال تعالى: {يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [غافر: 15]، وقال: {يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ} [النحل: 2]. فجعل إنذارهم بعبادة الله وحده كإنذارهم بيوم التلاق: كلاهما عرفوه بالوحي.
وقد كان إبراهيم الخليل قد ترَبَّى بين قوم كفار ليس فيهم من يوحد الله، وآتاه الله رشده، وآتاه من العلم والهدى ما لم يكن فيهم كذلك غيره من الرسل.
وموسى لما أرسله الله إلى فرعون قال له فرعون: {قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (٢٠) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢١) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [الشعراء: 19-22])([12]).
ويقول ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [القصص: 16]: (وقدِ اهتدى موسى إلى هذا كله بالإلهام، إذ لم تكن يومئذ شريعة إلهية في القبط.
ويجوز أن يكون علمه بذلك مما تلقاه من أمِّه وقومها من تديّن ببقايا دين إسحاق ويعقوب.
ولا التفات في هذا إلى جواز صدور الذنب من النبيء، لأنه لم يكن يومئذ نبيئًا، ولا مسألة صدور الذنب من النبيء قبل النبوءة؛ لأن تلك مفروضة فيما تقرر حكمه من الذنوب بحسب شرع ذلك النبيء أو شرع نبيء هو متبعه مثل عيسى عليه السلام قبل نبوءته لوجود شريعة التوراة وهو من أتباعها)([13]).
ولو رتّبنا ما صدر من موسى عليه السلام على مسألة العصمة قبل النبوة؛ فإن ما فعله لا يقدح في عصمته كما تقدّم، والله أعلم.
الاحتمال الثالث: أنْ يكون القِبطيُّ مُستحقًّا للقتل، وقتَله موسى خطأً، فلا يقدَح ذلك في العصمة.
الاحتمال الرابع: أنْ يكون القِبطي غيرَ مُستحِقّ للقتل، وقتَلَه موسى خطأً، فلا إشكالَ أيضًا كسابقه؛ لأنَّ الخطأَ في غير التبليغ ليس ممَّا يَقدَح في النبوة والعصمة، وهذا الاحتمال هو الأظهر باعتبار ما جاء عن السلف في تفسير الآيات.
يؤيد كون موسى عليه السلام قتله خطأ لا عمدًا، ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: (إنّما قتلَ موسى الذي قتلَ مِن آلِ فرعون خطأً، يقول الله: {وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ})([14]).
وقال يحيى ين سلّام: {وَقَتَلْتَ نَفْسًا}، (يعني: القبطيَّ الذي كان قتلُه خطأً، ولم يكن يحل له ضربُه ولا قتلُه)([15]).
وعدم استحقاق القبطي للقتل ليس لأنه لم يكن كافرًا ظالمًا، وإنما لأنه لم يكن ذلك الوقت حال إذن بالقتال، كما جاء عن الحسن البصري: (ولم يكن يَحِلُّ قتلَ الكفار يومئذ في تلك الحال، كانت حال كفٍّ عن القتال)([16]).
وقال ابن علان: (قال بعض المفسرين في قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} الآية فيه إشارة لمنع قتال الكافرين بغير إذن الله، ولهذا لما قتل موسى ذلك القبطي الكافر قال: هذا من عمل الشيطان الآيةـ)([17]).
وعلى القول بأن موسى عليه السلام لم يكن عالمًا بشريعة يوسف أو غيره من أنبياء بني إسرائيل، يكون ندمه (على فعل لم يؤمر به، والأفعال قبل الشرع إنما هي مطلقة لا غير، فإن المباح يقتضي مبيحًا، فإذا لم يثبت شرع فلا مباح ولا مبيح)([18]).
تساؤلات واردة:
وإذا تقرر أن موسى عليه السلام لم يقع في ذنبٍ أصلا، ثمة عدة تساؤلات وهي:
لماذا نَدِم موسى على قتْل القبطيِّ؟
ولماذا عَدَّ قتْلَه من عملِ الشيطان العدوِّ المُضِل المُبين؟
ولماذا ذكَرَ لفرعون بعد ذلك أنَّه فعَل ذلك وهو من الضالِّين؟
ولماذا يتأخَّر عنِ الشفاعة يومَ القيامة أليس بسبب قتْلِه القبطيَّ؟
والجواب عن هذا: أنَّ سَبب ندمِه هو أنَّه أقدَم على فِعلٍ لم يُؤمَر به، وهذا ما بيَّنه عليه السلام حين يقول يومَ القيامة عندما يَطلُب منه الناس أنْ يشفَع لهم إلى ربهم: «إنِّي قتلتُ نفْسًا لم أومَرْ بقتلِها»([19]).
يقول ابن خمير السبتي: (أما قولكم: لم ندم وتحسر، واعتذر واستغفر، وغفر له؟ فهذا من النمط الذي قدمناه في حق غيره من الأنبياء عليهم السلام أنهم يتحسرون، ويندمون، ويستغفرون على ترك الأولى من المباحات)([20]).
وتأخُّرُ موسى عليه السلام وسائرِ الأنبياء عنِ الشفاعة يومَ القيامة لم يكُن لنقْص دَرجاتهم عمَّا كانوا عليه، بلْ لِما عَلِموه من عظَمة المَقام المحمود الذي يَستَدعي من كَمال مَغفرة الله للعبد، وكمال عُبوديَّة العبد لله ما اختصَّ به مَن غفَر الله له ما تقدَّم من ذنْبِه وما تأخَّر، وهو نبيُّنا محمد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم([21]).
يقول ابن هبيرة: (فإنه إنما قتل نفسًا كافرة مباح قتلها، ولكن إنما أخطأ من حيث إنه لم يكن تقدم له إذن في ذلك من الله عز وجل، وقد أخبرنا الله سبحانه أنه تعالى غفر له ذلك، وأن موسى علم أن الله غفر له، وإنما تفكر موسى عليه السلام فوجد أن المهيّج لقتل النفس التي قتلها كان من العصبية لقومه، والله عز وجل قد غفر له قتل النفس، إلا أنه بقي معه خجلٌ أن يكون إنما أثار ما أثار منه حتى قتلها العصبية لقومه، لا الغيرة لله)([22]).
وقال ابن حجر: (فإن موسى عليه السلام مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك، ورأى في نفسه تقصيرًا عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر منه)([23]).
وقال ابن علان: (ثم إن هذا من موسى من كمال معرفته بعظمة ربه عز جلاله، فإنه أشفق من قتله ذلك، مع أن الله أخبر بنص القرآن أنه غفر له)([24]).
وقال السنوسي: (وقوله عليه السلام: {ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} [القصص: 16] جري على المألوف من خوف الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الله تعالى، خوف هيبةٍ وتعظيمٍ، وإن علموا عدم المؤاخذة من المولى تبارك وتعالى، ولهذا اعتذروا في الموقف بما علموا عدم المؤاخذة به)([25]).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) انظر: «قصص التوراة والإنجيل في ضوء القرآن والسنة» د. عمر سليمان الأشقر (ص: 204-206).
([2]) «تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء» (ص: 108).
([3]) «تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء» (ص: 111).
([4]) «الكشف والبيان» (6/244).
([5]) «تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء» (ص: 113-114).
([6]) «التحرير والتنوير» (20/ 89).
([7]) «شرح صغرى الصغرى» (ص227).
([8]) «تفسير البغوي» (5/ 273).
([9]) «منهاج السنة النبوية» (2/ 397).
([10]) «تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء» (ص: 112).
([11]) أخرجه البخاري (7، 2941)، ومسلم (74).
([12]) «تفسير آيات أشكلت» (1/ 191-196).
([13]) «التحرير والتنوير» (20/ 91).
([15]) «التحرير والتنوير» (20/ 91).
([16]) «تفسير يحيى بن سلام» (2/582).
([17]) «دليل الفالحين» (8/ 695).
([18]) «تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء» (ص: 112-113). ومسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع معروفة في علم أصول الفقه.
([20]) «تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء» (ص: 112-113). ومسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع معروفة في علم أصول الفقه.
([21]) «منهاج السنة النبوية» (2/ 425).
([22]) «الإفصاح عن معاني الصحاح» (6/ 438).
([23]) «فتح الباري» (20/ 450).