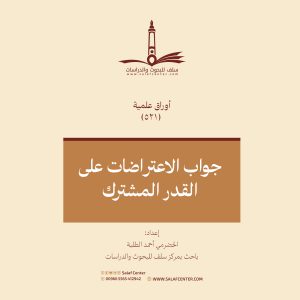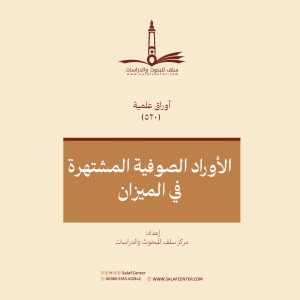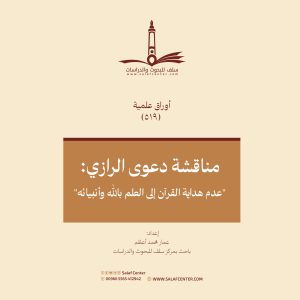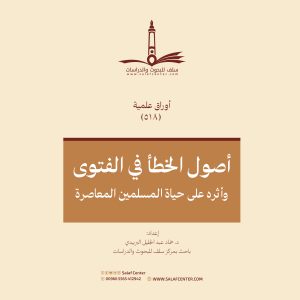جواب الاعتراضات على القدر المشترك (الجزء الأول)
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
مقدمة:
كنا كتبنا ورقةً علمية بمركز سلف للبحوث والدراسات حول مفهوم القدر المشترك، ووضّحناه وقربناه للعامة، وبقِيَت اعتراضات يوردها بعضهم عليه، وقد تُلبس على العامة دينَهم، وهذه الاعتراضات مثاراتُ الغلط فيها أكثرُ من أن تحصى، وأوسعُ من أن تحصَر، وبعضها ناتج عن عُجمة في اللسان، وبعضها أنشأه أصحابه على عَجَل؛ فلم يُحضِروا لقولتهم الذهنَ، ولا لجوابهم العقلَ، فكان تأمّله كافيًا في ردّه؛ لأن القائل لم يبين بما يكفي، ولم يأت بما يشفي، وإنما جلُّ اعتماده على جهل خصمه وصحة دعواه عند نفسه، فصدَّق أمانيه العلميةَ من قوة في الرد وقوة في الاعتراض، يظن أنه لا انفكاك عنها ولا جواب لها إلا السكوت، فأردنا لهذين الصنفين أن يبدلهما ربهما عن هذا المعتقد خيرًا منه زكاة وأقرب رُحما.
ولا شكّ أنَّ المعترض إمّا أن يعترض على وجود القدر المشترك، وتعليمُ الدعاء بقول: (رب زدني علما) هو أنفع شيء لدواء هذا الداء.
والحالة الثانية: أن يعترض على إعماله؛ إما بالتفريق بين الصفات، وإما بعدم تسليم الأمثلة، وغالب شُبَه من يتكلم في هذا الباب تدور حول هذا المعنى، إلا أن اعتراضاتِهم متفاوتةٌ وبعضُها إن لم يجعل في خانة التوسّع في الاستدلال والتكثر من الأدلة فلا وجه له إلا نقصان العقل والدين. ونحن في هذه الورقة نجيب عن أهمّ الاعتراضات، وننبّه على ضعف الباقي مما نرى في الجواب عليه تطويلًا أو إسهابًا لا داعيَ له من علم ولا موضوع.
وحتى لا نقع في التكرار المملّ فإننا نحيل إلى الورقة السابقة: (مفهوم الاشتراك المعنوي في الصفات) فيما يتعلَّق بالتعريف للمفهوم والتفريق بينه وبين بعض المفاهيم التي قد تتداخل معه، كما أننا ننبّه إلى أن الورقة تعتمد الردَّ على الكتب المشتهِرة في الباب، التي كتبها منتسبون لأهل المذاهب المردود عليها، ولا تردّ على موادَّ صوتيةٍ أو مقالاتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لفقدان الأخيرين للتوفر في كل وقت وقابلية عدم تحمّل مسؤولية الكلام من طرف الكاتب، هذا مع عسر التتبّع، وعدم فائدة الإحالة إليها علميًّا.
ونحن نورد الاعتراض غير منسوب لشخص أو لكتاب؛ وذلك لاشتهاره بين أهل المذهب المردود عليهم، وعدم إنكارهم له، وما رأينا فيه خصوصية لباحث عزوناه إليه؛ أداءً لأمانة العلم، ودرءًا لمفسدة التعميم الذي هو ظلم في مقابل التقسيم.
مركز سلف للبحوث والدراسات
الاعتراض الأول: التفريق بين صفات الأعيان وصفات المعاني:
يعترض المعترضون على الاحتجاج بالقدر المشترك بالفرق بين صفات المعاني وصفات الأعيان، ويرون أنه يجوز في صفات المعاني لأنها لا تقوم بنفسها، ولا يلزم منها التجسيمُ، أما صفات الأعيان كاليد والوجه والعين وغيرها فلا يجوز فيها لسببين:
السبب الأول: أن هذه الصفات لا تُتصوَّر إلا أبعاضًا وأجزاءً.
السبب الثاني: أن صفات المعاني وردَت في سياقات تكون فيها مقصودةً للشارع بخلاف صفات الأعيان.
فيلزم على مذهبهم من إثبات الصفات -التي يطلقون عليها صفات أعيان- التركيبُ الذي هو من خصائص المخلوقين.
جواب الاعتراض:
هذا الاعتراض مبنيّ على مسألة لم يفصّلوها، وهي: ما ضابط صفات الأعيان عندهم وصفات المعاني؟ وهل كلّ من قال بالاشتراك المعنوي يوافقهم أنه خاصّ بصفات المعاني دون الأعيان كما يدَّعون؟
وهذه معضلة لا أبا الحسن لها في مذهبهم؛ إذ متقدِّمو أهل المذهب من مثبتة الصفات ينصّون على ردّ هذا القول وإبطاله، وقبل أن نخوض بك -أيها القارئ- في بحار القوم وأمواجهم لا بدّ أن تستحضرَ مسألة في غاية الأهمية، وهي أن المعترض بهذا الاصطلاح لا تضيق هُوَّة الخلاف معه حين نسلِّم له أننا لا نثبت هذه الصفات على أنها صفاتُ أعيان أو أبعاضٌ أو أجزاء، فستجده يعيد المسألة جذَعة، ويبقيها على حالها، وينازع في صفات نتَّفق نحن وهو على أنها ليست صفات أعيان مثل: المحبة والرضا والغضب وغيرها، وهنا يقع في الإشكال الذي أشرنا إليه آنفا، وهو أن مثبتة القوم من المتقدمين يردّون عليهم في هذه الجزئية، ويبيّنون خلافَهم فيها للحقّ، ويقومون بفرض الكفاية عنّا في جوابها، وهنا يتبين لك أن مطلق التفريق مجرَّد تبرّع علمي لا يسمِن ولا يغني من جوع؛ إذ التفريق لا يترتّب عليه شيء ما لم يكن مؤثِّرا.
وعليه فإننا نختصر المسألة ونقول: إن صفات المعاني التي يعرّفها الأشاعرة بقولهم: “الصفة الموجودة في الخارج القائمة بالمحلّ الموجبة له حكما”([1])، وبنحو هذا التعريف قال الآمدي([2]) والسنوسي([3]).
فإذا أريد بالصفات المعنوية هذا المعنى -وهو كونها وجودية زائدة على الذات، أو أنها صفات قائمة بغيرها- فهذه المعاني ندَّعي فيها عدمَ الفرق بين الوجه واليد والعلم والسمع والبصر، فكلّها صفاتٌ وجودية زائدة على الذات قائمة بالباري، وليست قائمة بنفسها؛ فإن أريد بها صفات معانٍ لا تكون محلًّا لصفات أخرى فهذه مسألة خلافية بين الأشاعرة أنفسهم، وأيّ تشنيع بها يلزمهم في مذهبهم([4])، وهم قد اختلفوا في قيام المعنى بالمعنى، وأحيانا يعبِّرون عنه بالعَرَض مع نفينا لهذا المعنى في حقّ الله، لكن أصل المسألة مبنيّ على هذا الخلاف، وشقه الراجح هو جواز وصف المعنى بالمعنى؛ فنقول: علم نافع، وسواد شديد، وبياض ناصع، وهذه الصفات التي نثبت بعضها وُصِفت في الشرع بمعان لم نخترعها ولم نلحِد فيها، بل أخبر أحرص الناس على هداية البشر وأتقاهم لله وأخشاهم له فوصَف يدَ الله باليمين، وأنه يقبض بها الأرض، ويجمع السموات على إصبع والأرضين على إصبع، ووصفها القرآن بالبسط، إلى غير ذلك مما تدفع به النصوص تأويل المتكلمين، ووصف وجه الله بالنور، وأنه يرى يوم القيامة، وأنه لا قِبَل للبشر برؤيته في هذه الدنيا؛ فعن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام؛ يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل، وعمل الليل بالنهار»([5]).
وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما يشفي ويكفي في هذه النقطة، فردَّ المعاني الباطلة وأثبت المعاني التي نطق بها الحقّ، فقال: “أحدهما أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف، فلا شك أن من قال: إن هذه المعاني وشبهَها من صفات المخلوقين ونعوت المحدَثين غيرُ مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن؛ إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفّرون المشبّهة والمجسّمة، لكن هذا القائل أخطأ حيث ظنّ أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث؛ وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه؛ فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام؛ وليست هذه المعاني المحدَثةُ المستحيلةُ على الله تعالى هي السابقة إلى عقل المؤمنين، بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات، فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضًا تدلّ على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها؛ فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساما كذلك محدثة يمتنع أن يوصف الله تعالى بمثلها. ثم لم يقل أحد من أهل السنة: إذا قلنا: إن لله علمًا وقدرةً وسمعًا وبصرًا إن ظاهره غير مراد ثم يفسّر بصفاتنا، فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه غير مراد؛ إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم”([6]).
وهذه الصفات التي نثبت وننفي عنها التبعيض والتجسيم يثبتها متقدمو الأشاعرة، ويحكي فيها متأخّروهم الخلافَ، فممّن أثبتها أبو الحسن الأشعري في كتابه (الإبانة) حيث قال بعد سرده للآيات والأحاديث الواردة في هذه الصفات: “ونفى الجهمية أن يكون لله تعالى وجه كما قال، وأبطلوا أن يكون له سمع وبصر وعين، ووافقوا النصارى؛ لأن النصارى لم تثبت الله سميعا بصيرا إلا على معنى أنه عالم، وكذلك قالت الجهمية، ففي حقيقة قولهم أنهم قالوا: نقول: إن الله عالم، ولا نقول: سميع بصير على غير معنى عالم، وذلك قول النصارى… -إلى أن قال:- فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجها؟ قيل له: نقول ذلك، خلافا لما قاله المبتدعون، وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَام} [الرحمن: 27].
مسألة:
قد سئلنا: أتقولون: إن لله يدين؟
قيل: نقول ذلك بلا كيف، وقد دل عليه قوله تعالى: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10]، وقوله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75].
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته»([7])، فثبتت اليد بلا كيف، وجاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده»([8])، أي: بيد قدرته سبحانه، وقال تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64]، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كلتا يديه يمين»([9])، وقال تعالى: {لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِين} [الحاقة: 45].
وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويعني به النعمة، وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها، ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني النعمة؛ بطل أن يكون معنى قوله تعالى: {بِيَدَيَّ} النعمة، وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يدي، بمعنى: لي عليه نعمتي، ومن دافَعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها دُوفع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة؛ إذ كان لا يمكنه أن يتعلّق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة، فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتها، وأن لا يثبت اليد نعمة من قبلها؛ لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالى: {بِيَدَيَّ}: نعمتي؛ فليس المسلمون على ما ادعى متفِقين، وإن روجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: بيدي يعني نعمتي، وإن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه، ولن يجد له سبيلا.
مسألة:
ويقال لأهل البدع: ولِم زعمتم أن معنى قوله: {بِيَدَيَّ} نعمتي؟ أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة؟
فلا يجدون ذلك إجماعا ولا في اللغة.
وإن قالوا: قلنا ذلك من القياس.
قيل لهم: ومن أين وجدتم في القياس أن قوله تعالى: {بِيَدَيَّ} لا يكون معناه إلا نعمتي؟! ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسير كذا وكذا مع أنا رأينا الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز الناطق على لسان نبيه الصادق: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم: 4]، وقال تعالى: {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِين} [النحل: 103]، وقال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُون} [الزخرف: 3]، وقال تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [النساء: 82]، ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن نتدبَّره، ولا أن نعرفَ معانيه إذا سمعناه، فلما كان من لا يحسن لسان العرب لا يحسنه، وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه على أنهم إنما علموه؛ لأنه بلسانهم نزل، وليس في لسانهم ما ادعوه…
حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته، ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة.
ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة الظاهر، وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة، كذلك قوله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75] على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين، ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة.
ولو جاز ذلك لجاز لمدّع أن يدّعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة، وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز أن يكون مجازا بغير حجة، بل واجب أن يكون قوله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} إثبات يدين لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي، وهو يعني النعمتين”([10]).
وأنت ترى استفاضة الأشعريّ في إثبات هذه المعاني وردّ الاعتراض على من اعترض عليها.
وقال الباقلاني بعد أن استعرض بعض التأويلات لهذه الصفات: “لِأَنَ القَوْل: يَد لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي الْيَد الَّتِي هِيَ صفة للذات، وَيدل على فَسَاد تأويلهم أَيْضا أَنه لَو كَانَ الْأَمر على مَا قَالُوهُ لم يغْفل عَن ذَلِك إِبْلِيس وَعَن أَن يَقُول: وَأي فضل لآدَم عَليّ يَقْتَضِي أَن أَسجد لَهُ وَأَنا أَيْضا بِيَدِك خلقتني الَّتِي هِيَ قدرتك وبنعمتك خلقتني؟! وَفِي الْعلم بِأَنَّ الله تَعَالَى فضل آدم عَلَيْهِ بخلقه بيدَيْهِ دَلِيل على فَسَاد مَا قَالُوهُ.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَمَا أنكرتم أَن يكون وَجهه وَيَده جارحة إِذْ كُنْتُم لم تعقلوا يَدَ صفةٍ وَوجهَ صفةٍ لَا جارحة؟ يُقَال لَهُ: لَا يجب ذَلِك كَمَا لَا يجب إِذا لم نعقل حَيّا عَالما قَادِرًا إِلَّا جسمًا أَن نقضي نَحن وَأَنْتُم على الله تَعَالَى بذلك، وكما لَا يجب مَتى كَانَ قَائِما بِذَاتِهِ أَن يكون جوهرا أَو جسما؛ لأَنا وَإِيَّاكُم لم نجد قَائِما بِنَفسِهِ فِي شاهدنا إِلَّا كَذَلِك، وَكَذَلِكَ الْجَواب لَهُم إِن قَالُوا: فَيجب أَن يكون علمه وحياته وَكَلَامه وَسَائِر صِفَاته لذاته أعراضًا أَو أجناسًا أَو حوادث أَو أغيارا لَهُ أَو حَالَة فِيهِ أَو محتاجة لَهُ إِلَى قلب وَاعْتَلُّوا بالوجود”([11]).
وتجد نحو هذا الكلام عند ابن فورك وغيره من الأشعرية. فبأي حديث بعده يؤمنون؟!
وجماعتنا مصرّحون بنفي الأعضاء والأبعاض عن الله عز وجل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى إِذَا أَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ مَا أَضَافَهُ إِضَافَةً يَخْتَصُّ بِهَا، وَتَمْنَعُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ خَصَائِصِ الْمَخْلُوقِينَ، وَقَدْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: إِنَّهُ {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} وَإِنَّهُ {لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَمِيٌّ، كَانَ مَنْ فَهِمَ مِنْ هَذِهِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمَخْلُوقُ قَدْ أُتِيَ مِنْ سُوءِ فَهْمِهِ وَنَقْصِ عَقْلِهِ، لَا مِنْ قُصُورٍ فِي بَيَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ صِفَةٍ وَصِفَةٍ.
فَمَنْ فَهِمَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمَخْلُوقُ مِنْ أَنَّهُ عَرَضٌ مُحْدَثٌ بِاضْطِرَارٍ أَوِ اكْتِسَابٍ، فَمِنْ نَفْسِهِ أُتِيَ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِنَا: عِلْمُ اللَّهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ مَنْ فَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} الْآيَةَ [المائدة: 64]، {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75] مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمَخْلُوقُ مِنْ جَوَارِحِهِ وَأَعْضَائِهِ، فَمِنْ نَفْسِهِ أُتِيَ، فَلَيْسَ فِي ظَاهِرِ هَذَا اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمَخْلُوقُ كَمَا فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ”([12]).
هذا مع أن لفظ البَعض تشنيع لفظيّ ليس وراءه علم يذكر، ولا إيمان يثبت، ولو فتح باب الاعتراض على الألفاظ لشنّع على القوم بالضمائر وما توهمه من تذكير وتأنيث، وأن ذلك لازم في حقّ الله، وهذا محض تشنيع ليس وراءه إلا التشغيب، وصفات الله لا تحصى، فلو قلنا: العلم من صفات الله وليس هو الله، والقدرة من صفات الله وليست هي الله، هل يشنع علينا مشنع بالتمسك بظاهر اللفظ وهو تبعيض الصفات؟!
أما جوابهم عن الفرق بين صفات المعاني وصفات الأعيان أن صفات المعاني وردت في سياقات تكون فيها مقصودة لذاتها، أما صفات الأعيان فلم ترد مقصودة لذاتها.
وجوابًا عن هذا نقول: ما ضابط المقصود لذاته وغير المقصود لذاته؟ وهل هذا إغفال لدلالة الإشارة أم ماذا؟
ومن ناحية أخرى هذا الفرق غير مسلَّم به، بدليل أن الصفات الخبرية تنوّعت سياقاتها وتكررت عباراتها في أكثر من مناسبة؛ مما يدل على قصد إثبات المعنى الذي سيقت من أجله، وهذا واضح في صفة الرحمة والرضا والغضب والمجيء والنزول، فمن تأمّل نصوصها علم عِلمَ يقين أن هذا التوارد لا يمكن أن يكون لو لم يكن المعنى المرتبط به غيرَ مراد خاصة، وأن المناسبات متعدّدة، ولا يصحب السياق ما يدل على الحرج من اللفظ، أو من معناه المتبادر إلى الذهن، قال سبحانه: {وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22]، وقال تعالى: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الامُور} [البقرة: 210].
وقد جاءت الصفات الخبرية مسندَة إسناد الفعل إلى الفاعل: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَام} [الرحمن: 27]، وإسناد الخبر إلى المبتدأ: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10]. وكلها وردت في سياق المدح؛ فجعلُ ظاهرها موهمًا لغير اللائق خروجٌ بها عن سياقها أصلا، فالأصل في الكلام أن يقصد كامل معناه، وماذا تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام؛ يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل، وعمل الليل بالنهار»([13]) وغيره من الأحاديث التي سيقت لبيان عظمة الله عز وجل، وبيان كمال صفاته، فكيف يقال: إن الألفاظ التي أريد بها إثبات هذا كلها محال ولا يليق بالله عز وجل؟! وما جوابك عن إثبات معنى صحيح بألفاظ لا تليق ونسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟!
بل اللائق بالله أولا وبرسوله صلى الله عليه وسلم أنهم إنما يعبّرون عن المعاني بألفاظ لائقة ومؤدية للمعنى، فذلك من كمال قصد الهداية والبيان، ودليلنا على ذلك حرج لسان الشارع وتحريجه في الألفاظ الموهمة، فقد قال الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم} [البقرة: 104]، وفي الحديث عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بئس الخطيب أنت؛ قل: ومن يعص الله ورسوله»([14]). وليس مرادنا هنا الحكم على جواز التشريك في الضمير، بل المراد أنه متى ما أوهم السياق ما لا يليق فإن مقام النبوة يجلّ أن يقره أو يتركه يمضي على الأمة، ويكون لهم شريعةً دون قيد يقيده وحكم يبينه.
وعن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديّا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تندّدون، وإنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، ويقولون: ما شاء الله ثم شئت([15]).
وفي الختام: نحن لا ننكر فروقا بين الصفات سواء في طرق الشريعة في الحديث عنها أو في سياقاتها، لكن الذي نردّه أن هذه الفروق مؤثرة في الخلاف أو مُلجئة إلى نفي ما ثبت بلسان الشارع؛ لأن اعتقادنا أن ألفاظ الشارع حقّ، فإن لازمها حقّ، ومن ادعى فيه البطلان ردّ عليه وبيِّن له أن الشبهة نشأت له من فهمه أو في محاكمته للشارع إلى اعتقاد استقر عنده قبل الاستدلال لا غير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) حاشية الدسوقي على كبرى السنوسي -مخطوط-، نقلت عنه بواسطة الانتصار للتدمرية (ص: 461).
([3]) شرح أم البراهين (ص: 20).
([4]) ينظر: حاشية العطار على جمع الجوامع (2/ 500).
([7]) أخرجه أبو داود (80)، والترمذي (3075).
([10]) الإبانة عن أصول الديانة (ص: 125-132).
([11]) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص: 298).