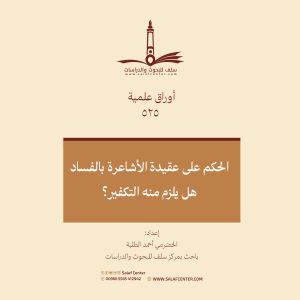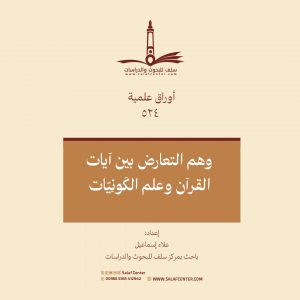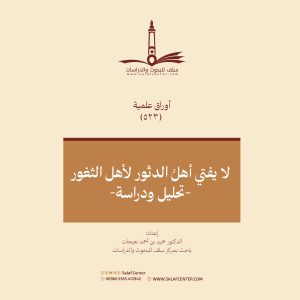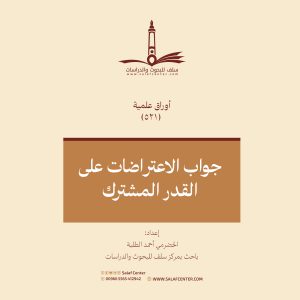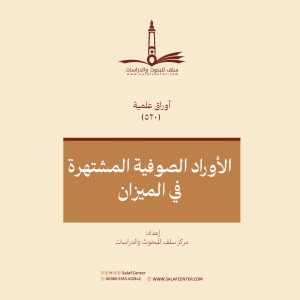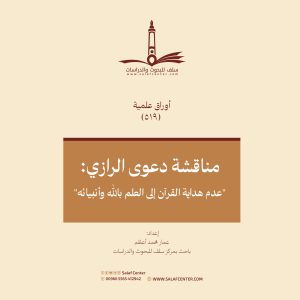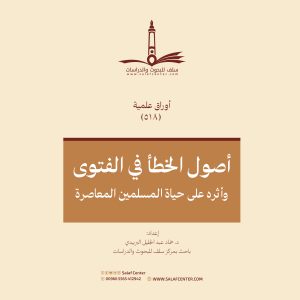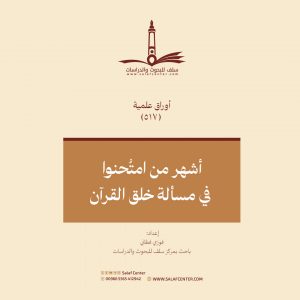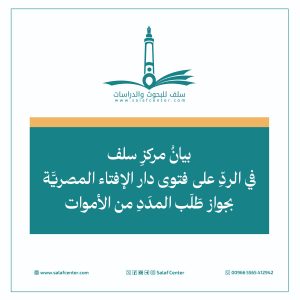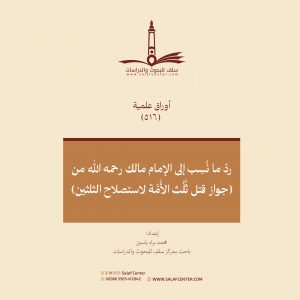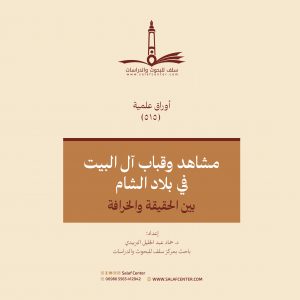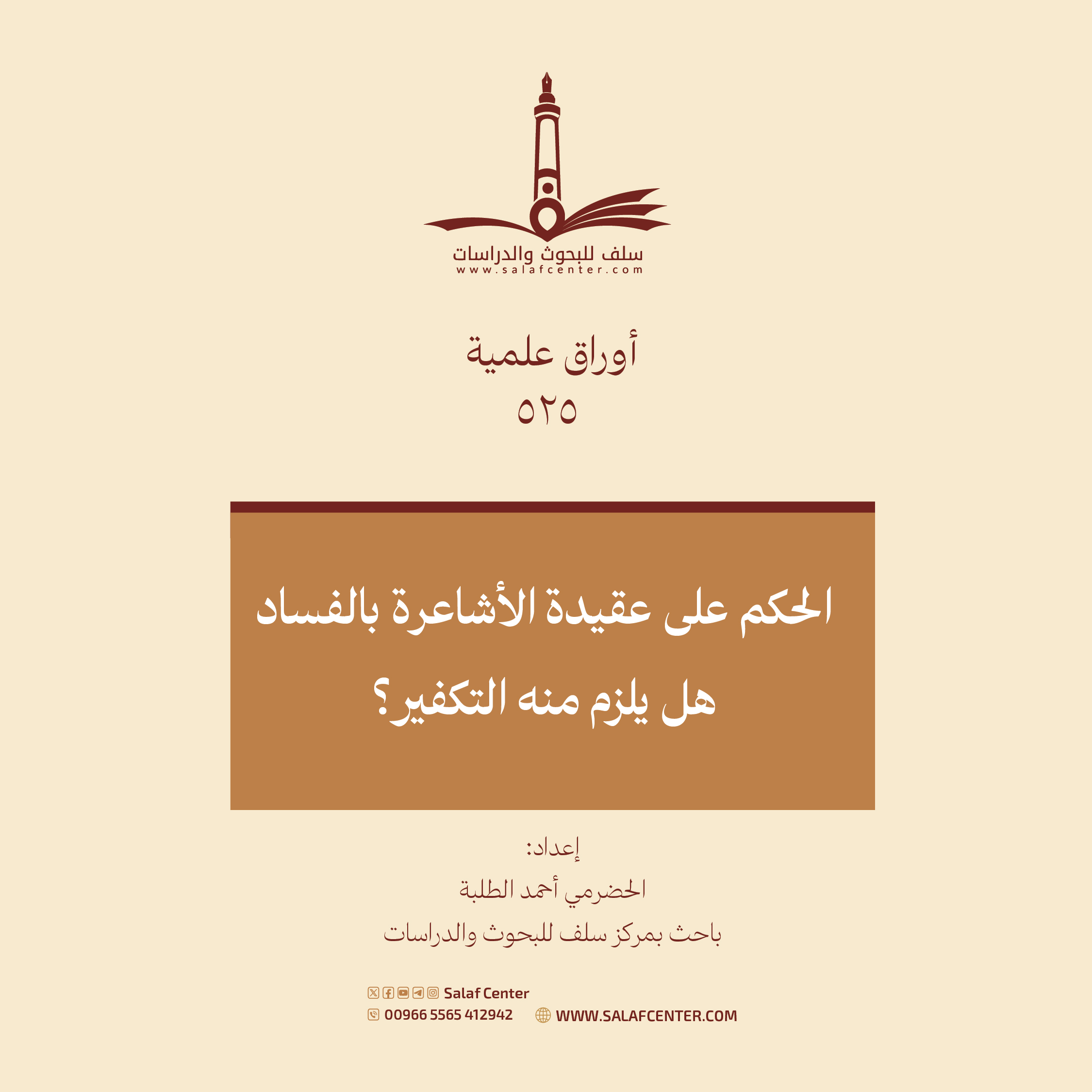
الحكم على عقيدة الأشاعرة بالفساد هل يلزم منه التكفير؟
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
مقدمة:
لا شك أن الحكم على الناس فيما اختلفوا فيه يُعَدّ من الأمور العظيمة التي يتهيَّبها أهل الديانة ويحذرها أهل المروءة؛ لما في ذلك من تتبع الزلات، والخوض أحيانا في أمور لا تعني الإنسانَ، وويل ثم ويل لمن خاض في ذلك وهو لا يقصد صيانة دين، ولا تعليم شرع، فما أكثرَ خصومَه أمام ربه! وما أشدَّ تهلكتَه يوم القيامة!
ونحن في مركز سلف للبحوث والدراسات إذ نهتمّ ببيان عقيدة السلف والردّ على كل ما يخالفها في أوراقنا العلمية؛ فإننا نحرص كلَّ الحرص على أمر في غاية الأهمية؛ وهو التنبيه إلى أن الحكم على الأقوال بالبطلان والفساد لا يعني تأثيم كلّ قائل بها، ولا نسبته للضلال؛ لأن ذلك راجع إلى أمور خارجة عن محلّ الكلام يُطلب وجودها في المكلَّف أو نفيها عنه، فالمتكلم بما يخالف الحقَّ قد يكون مخطئا، أو جاهلا، أو متأوّلا، أو أراد معنًى صحيحا فخانته عبارته وسبق لسانه إلى غير الصواب، أو غير ذلك، ومن هنا كان الحكم على المعيَّن لا بد فيه من مراعاة حاله من تديّن وقصد للخير ونصرة للدين، إلى غير ذلك مما يدفع الشنعة عن المكلّف، وتوزن به أعماله شرعا؛ فالإنسان ينظر إلى حاله قبل الخطأ فيحكم له به؛ فإن ذلك من العدل ومن الوزن بالقسطاس المستقيم الذي أُمرنا به شرعًا، وبه حكم صلى الله عليه وسلم في حق العجماوات، وفي المكلفين حوادثه أكثر من أن تُحصى وأوسع من أن تحصر، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين»، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش([1]) فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل([2])، فألحت فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء([3])، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل»([4]). وقد نقل ابن حجر عن ابن بطال وغيره تعليقا على هذا الحديث أن من فقهه: “جواز الحُكمِ على الشّيءِ بِما عُرِف مِن عادتِهِ وإِن جاز أن يطرأ عليهِ غيرُهُ، فإِذا وقع مِن شخصٍ هفوةٌ لا يُعهدُ مِنهُ مِثلُها لا يُنسبُ إِليها، ويُردُّ على من نسبهُ إِليها، ومعذِرةُ من نسبهُ إِليها مِمّن لا يعرِفُ صُورة حالِهِ؛ لِأنّ خلاء القصواءِ لولا خارِقُ العادةِ لكان ما ظنّهُ الصّحابةُ صحِيحًا، ولم يعاتبهم النّبِيّ صلّى اللّهُ عليهِ وسلّم على ذلِك لِعُذرِهِم فِي ظنِّهِم”([5]).
وفيما نقله ابن حجر فائدة أخرى وهي أن الناس تختلف أحكامهم على الشخص بحسب معرفتهم به، فمن كان له مزيد اطلاع عليه كان لحكمه مزية على من ليس له نفس العلم به، ومن هنا قد تختلف أنظار الناس في الحكم على الطوائف والأفراد باختلاف علمهم بأقوالهم ولوازمها وبحقيقة ما هم عليه.
والحديث عن الأشاعرة يستلزم بيان أمور لا بدّ أن يدركها المكلّف في حقيقة الخلاف معهم، وهو أن بعض ما عندهم من أقوالٍ الخلافُ فيها حقيقي؛ لأنهم مصرّحون به، وبقية الأمور الخلاف فيها ظني لأنها لوازم ينفصلون عنها بإنكارها، أو بعدم التزامها إجرائيًّا، والخلاف معهم في ثلاث مسائل:
الأولى: الأسماء والصفات.
الثانية: القضاء والقدر.
الثالثة: الموقف من النص الشرعي.
وهذه الأخيرة يرجع إليها ما قبلها، وهم في حقيقة أمرهم يُعَدّون من الطوائف المعظِّمة للوحي المنتسبة للسنة تصديقًا وإخبارا وعملا وجهادا، لا نقاش في هذا، والخلاف معهم في العمليات لا يكاد يذكَر، وما ذكر منه لا أثر له في الحقيقة، وهم في باب الصفات يصنَّفون من جملة المثبِتَة، لكنهم خالفوا السنة في التعامل مع الصفات الخبرية؛ لأنهم حاكموها إلى ما استقرّ عندهم من دليل الحدوث والأعراض، وما قرروه من قطعية تلك الأدلة، والحكم على نصوص الصفات بمخالفةِ القطعيات؛ فأولوها على أنها ظواهر سمعية خالفت قطعيات عقلية، ولازم هذا القول تقديم العقل على النقل؛ لكن هذا اللازم لا يمكن نسبته إليهم لعدم التزامهم به، ولتصريحهم بخلافه في التحسين والتقبيح، ولانفصالهم عنه بمحل الاتفاق بينهم وبين مخالفيهم في تقديم القطعي على الظني مطلقا، فيبقى النقاش في الدعوى فقط، لا في الأصل، ولا في القاعدة.
والإنكار عليهم في هذا الباب هو من باب النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فمن كان عارفا بالمقالات وبلوازمها علم أن قولهم في الصفات بشقَّيه -تأويل الظاهر، وتفويض المعنى- لا يستقيم مع حاكمية الشريعة ورفعها للخلاف في أعظم أبواب الدين، وهو ما تعلق بالله سبحانه وتعالى وصفاته، لكن لا بد من استحضار قصدهم هم بذلك، وهو أن قولهم لم يبنوه على ردّ الوحي، وإنما بنوه على قصد التنزيه، ومن هنا اختلفوا عن غيرهم من الطوائف. هذا مع انتسابهم للسنة، وتعظيمهم لأئمة السلف، وانتسابهم للمذاهب الأربعة، كل هذه عوامل ترفع عنهم الإثم، وتجعلهم في مصاف المتأولين المأجورين من أهل القبلة ممن يحكم لهم بالأصل وهو العدالة وقصد الخير.
ونحن إذ نسعى إلى تبيين حقيقة الموقف من الأشعرية، وهل يلزم منه تكفير علماء الإسلام أم لا، نقدم هذه الورقة العلمية والتي ستكون في جزأين إن شاء الله تعالى. وهذا أوان الشروع في المقصود.
مركز سلف للبحوث والدراسات
المبحث الأول: ضوابط عامة في الحكم على الناس:
المسلم يستحضر في كل وقت أن رحمة الله تسبق وتغلب غضبه، ومن ثم فإن أي تعارض بين الوعد والوعيد في حقّ المسلم يلزم المكلّف استبراءً لدينه وعرضه أن يظن بأهل الشهادة خيرا ويحملهم على ما يظنّ بهم من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا وحده كاف في دفع الوعيد عنهم، ففي الحديث: أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إلا إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»([6]).
وللعلماء في معنى الحديث كلام حاصله منعُ اللعن في حق ذي الزلة وغير المجاهر، أو من حُدَّ، والصواب المنع مطلقًا من لعن المعين لاحتمال قيام مانع به لم يطّلع عليه اللاعن([7]).
وسنتحدّث عن ضوابط مهمّة ينبغي مراعاتها في الحكم على الناس؛ ليتجلَّى للقارئ الكريم أهميةُ معرفة مباني الأمور وأصولها بدل الأخذ بالنتائج دون معرفة مقدّماتها وما تبنى عليه، فليس كلّ مُطْلَقٍ باق على إطلاقه، ولا كل عموم باق على عمومه؛ لأن الخطاب الوضعيّ -الذي هو الشروط والموانع والأسباب- أعمّ من الخطاب التكليفيّ، بل لا يخلو خطاب تكليفيّ منه، كما هو معلوم عند دارسي الأصول من طلبة العلم وحذاق الفقهاء، وقد تهيَّب الفقهاء الحكم على الناس لعلمهم بعسر تطبيق الحكم على المكلَّف دون استكمال النظر في الشروط والموانع، وأيّ ذنب أعظم من تأثيم من رفع عنه الشارع الحرج، وأدخله في زمرة الصديقين والمأجورين؟!
فمن جملة هذه الضوابط في الحكم على الناس:
أولا: تعظيم أمر الشهادتين:
فمن نطق بالشهادتين دخل الإسلام بيقين، والمقصود باليقين في العرف الفقهي: الظاهر الذي يُضعف الاحتمال، وليس اليقين بمعنى الحكم العقلي، فذلك لا سبيل إليه في هذا الباب، ومن طلبه حاد عن الشرع، وهو مردود بما ورد في الحديث عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات([8]) من جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟!» قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح، قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!» فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين -يعني أسامة-. قال: قال رجل: ألم يقل الله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّه للهِ}؟! فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة([9]).
فالناطق بالشهادة مؤتمن على دينه، يُقبَل منه ظاهره، ويُعذر في كل خطأ أبان عذرَه فيه أو أمكن ذلك؛ فإنه من درء الحدود بالشبهات.
ثانيا: خطأ محاكمة عالم إلى قول عالم مثله:
لا ينبغي محاكمة عالم إلى قول عالم مثله جاء قبله أو بعده؛ فإنه لا تأثيم ولا أجر إلا بشرع كما هو مقرر في الأصول، فالحكم ما به يجيء الشرع، فلا يبدع مسلم ولا يفسق بقاعدة مبتدعة أو عقلية مولّدة أو عصبية جاهلية لمذهب أو لفرقة أو لمجتمع، وقد قال الله عز وجل: {وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم} [البقرة: 231].
وقد ذم الله اتباع الهوى في الشرائع والحكم على الناس، فقال سبحانه: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم: 23].
قال الطبري: “وقوله: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ} يقول تعالى ذكره: ما يتبع هؤلاء المشركون في هذه الأسماء التي سموا بها آلهتهم إلا الظنّ بأنّ ما يقولون حقّ لا اليقين، {وَمَا تَهْوَى الأنْفُسُ} يقول: وهوى أنفسهم؛ لأنهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم من الله، ولا عن رسول الله أخبرهم به، وإنما اختراق من قِبل أنفسهم، أو أخذوه عن آبائهم الذين كانوا من الكفر بالله على مثل ما هم عليه منه”([10]).
وقال سبحانه: {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: 28].
وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 94].
وهذه الآية من أسباب نزولها ما مر آنفا في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وفيها تعظيم أمر الإسلام، وأنه يثبت للمسلم بالكلمة والدلالة والتبعية، فالكلمة مثل الشهادة، والدلالة مثل السلام والتحميد عند العطاس، والتبعية يُقصد بها الانتساب لدار الإسلام أو الوالدين، فمن كان في دار الإسلام فالأصل فيه الإسلام، ومن كان أبواه مسلمين فالأصل فيه الإسلام. فلا بد للمسلم في مقام الحكم على الناس أن يستحضر عظم الشهادتين، وأنهما يُحرِّمان النفس والمال والعرض، وبهما يغفر الله عز وجل كثيرا من ذنوب العبد، فالمخالف للحق من غير هوى قد تغلب حسنته المقبولة سيئته المغفورة، وهو موكول إلى رحمة الله وعفوه.
ثالثا: الحسنة الكبيرة تغفر السيئة الكبيرة:
فمن كانت له مساعٍ مشكورةٌ في الإسلام، والذبّ عن حياضه، وجهاد أعدائه، وإقامة دولته؛ فإن هذه الحسنة تُطمر فيها كبائر الذنوب، ويدلّ على ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين أخبر المشركين بما يعده المسلمون لهم، وهذه كبيرة؛ لأن فيها بيانا لعورة المسلمين، ومع ذلك استحضر النبي صلى الله عليه وسلم حسنته العظيمة وهي مشاركته في بدر، فقال لعمر في الذب عنه: «إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فأنزل الله السورة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ} إلى قوله: {فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}([11]). وخصوصية حاطب هي مشاركته في بدر.
أما مغفرة الحسنة الكبيرة للسيئة الكبيرة فهذا منصوص عليه في القرآن، وهو عام، فقد قال الله سبحانه: {لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُون} [الزمر: 35].
قَالَ مُقَاتِلٌ: “يَجْزِيهِمْ بِالْمَحَاسِنِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَا يَجْزِيهِمْ بِالْمَسَاوِئِ”([12]).
قال ابن عطية: “واللام في قوله: {لِيُكَفِّرَ} يحتمل أن تتعلق بقوله: {الْمُحْسِنِينَ} أي: الذين أحسنوا لكي يكفر، وقاله ابن زيد. ويحتمل أن تتعلق بفعل مضمر مقطوع مما قبله، كأنك قلت: يسَّرهم الله لذلك ليكفِّر؛ لأن التكفير لا يكون إلا بعد التيسير للخير، واستدلوا على أن {عَمِلُوا} هو كفر أهل الجاهلية ومعاصي أهل الإسلام”([13]).
وقال ابن الجوزي: “قوله تعالى: {لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ} المعنى: أعطاهم ما شاؤوا {لِيُكَفِّرَ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا} أي: لِيَسْتُر ذلك بالمغفرة، {وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ} بمحاسن أعمالهم، لا بمساوئها”([14]).
ويؤيد هذا المعنى قول سبحانه: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ} [الْأَحْقَافِ: 15، 16]، وقوله سبحانه: {أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ} [الْأَحْقَافِ: 16].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وهذا متفق عليه بين أئمة الدين، كما قال مالكٌ وغيره من العلماء رضي الله عنهم: كلُّ أحدٍ من الناس يُؤخذ من قوله ويُترَك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الصالح الحَسَن التعبُّد المجتهد في اتباع الكتاب والسنة إذا كان منه كلام أو دعاء أو ذِكْر فيه خطأ لم يُعاقب على ذلك، ولا يَسقط به ما يستحقّه من الموالاة والمحبة والحُرْمة، فإن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان، كما ذكره سبحانه في دعاء المؤمنين بقوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: «قد فعلت»([15]). ولا يجوز أن يُتَّبع أحدٌ في خطأ يتبيَّن أن الكتاب والسنة بخلافه، وما زال لأئمة الصحابة والتابعين -الذين لهم في الأمة لسان صدق، وهم عند الأمة من أكابر أولياء الله المتقين- أقوالٌ خفيت عليهم فيها السنة، فلا يُتّبَعون فيها، ولا يُساء القول فيهم لأجلها، بل لا بد من اتباع الحق وتعظيم أهل الإيمان والتقوى. وهذا أصلٌ مستقرّ بين أهل الإسلام”([16]).
رابعا: الحكم على الأقوال لا بد فيه من الاستفصال:
فبطلان ظاهر القول لا يعني بطلان مراد المتكلم به، ومن هنا قد يتكلم الإنسان بلغة علم معين، أو لغة طائفة، ويريد معاني صحيحة شرعا، فلا يحمل قوله على اصطلاح الطائفة المبطلة ولا على العلم الفاسد، بل من تمام التبين أن يُتَبَيَّن من مراده؛ فإن أراد معنى صحيحا كتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، وتعظيمه في قلوب المؤمنين، وخانته العبارة، أو قصرت به الكلمة؛ فإن كلامه لا يحمل إلا على ما أراد، ويقبل منه قوله في بادئ الأمر، ولا يزاد على ذلك، وأنت ترى مسارعة رسول الله عليه وسلم في استفصال حاطب عن دافع فعله وتصديقه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأ مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ، يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ صَدَقَكُمْ»([17]).
ومحل الشاهد استفصال النبي صلى الله لحاطب لبُعد أن يصدر الفعل منه على جهة الكفر، ولهذا قال القرطبي رحمه الله: “مَنْ كَثُرَ تَطَلُّعُهُ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَيُنَبِّهُ عَلَيْهِمْ وَيُعَرِّفُ عَدُوَّهُمْ بِأَخْبَارِهِمْ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ كَافِرًا إِذَا كَانَ فَعَلَهُ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ وَاعْتِقَادُهُ عَلَى ذَلِكَ سَلِيمٌ، كَمَا فَعَلَ حَاطِبٌ حِينَ قَصَدَ بِذَلِكَ اتِّخَاذَ الْيَدِ وَلَمْ ينو الردة عن الدين”([18]).
خامسا: القول بقول الطائفة لا يلزم منه الانتساب إلى الطائفة:
وهذه مسألة بدهية التصوّر، فلا يلزم من خصلة الفسوق جواز النسبة إليه، ولا يلزم من خصلة النفاق نسبة الإنسان إليه، فالعبرة بالغالب من حال الإنسان؛ فمن غلب عليه الخير ولم يجاهر بمعصية ولا علم عنه اتباع للهوى فإنه لا ينسب إلى الإثم، وكذلك موافقة الطوائف في أقوالها، فإن الإنسان لا ينسب إلى هذه الطوائف على سبيل الذم إلا إذا قال بأصولها؛ فمن عرف عنه تعظيم الوحي واتباع السنة والعمل بها فإنه لا ينسب إلى طائفة مخالفة للسنة إلا إذا قال بأصولها ودان بقولها.
سادسا: لا تكفير إلا بمجمع عليه لا بظني أو ببدعة:
فالتكفير حكم من أحكام الله عز وجل لا دخل للأهواء فيه، وأعظم الجرم أن يضيّق الإنسان مساحة الغفران على عباد الله، فيجعل من الخطأ الموجب للأجر والعفو ذنبا موجبا للإثم؛ ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: “فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا، فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بُغض المسلمين وذمهم ولعنهم، واستحلال دمائهم وأموالهم. وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة، فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة، ومن كفر المسلمين بما رآه ذنبا سواء كان دينا أو لم يكن دينا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. أما الأول فشبه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد: إما حديث بلغه عن الرسول لا يكون صحيحا، أو أثر عن غير الرسول قلده فيه ولم يكن ذلك القائل مصيبا، أو تأويل تأوله من آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أو ضعيف، أو أثر مقبول أو مردود، ولم يكن التأويل صحيحا، وإما قياس فاسد أو رأي رآه اعتقده صوابا وهو خطأ. فالقياس والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفقهة، وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة خطأ طوائف المتكلمة والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة”([19]).
سابعًا: لا تأثيم إلا بالوحي:
فالناس لا تُأثَّم ولا تُغلَّط إلا بالوحي، فلا تحاكَم إلى أقوال الرجال، ولا يجعل كلامهم دليلا بمحضه على الصواب، وهذه المسألة أظهرُ من أن يستدلَّ عليها.
ثامنًا: لا تأثيم إلا بعد استيفاء النظر في الشروط والموانع:
لا يُأثم أحد من أهل القبلة ولا ينسَب إلى الذم إلا بعد تحقق الشروط فيه وانتفاء الموانع عنه؛ لأن هذا من كمال التثبت، ومن البيان الذي أراده الله من شرعه، قال سبحانه: {وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم} [التوبة: 115].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “ليس لأحد أن يكفِّر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبيَّن له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشكّ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة”([20]).
وهذا في حقّ عامة الناس، أما العلماء وأهل الاجتهاد ومن نصروا الإسلام وقصدوا الحقّ فإن فواته عليهم في بعض المسائل لا يوجب التأثيم قطعًا، بل إنما يُذكَرون بما غلب عليهم من الخير، ويُطوى ما يُروى عنهم من الشر، وهم معدودون في أئمة الهدى الذين تُذكر محاسنهم وتطوَى مساوئهم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: “ومن له في الأمة لسان صدق عامّ بحيث يُثنى عليه ويُحمد في جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتّبعون العلم والعدل، فهم بُعَداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس”([21]).
تاسعا: أحكام الوعد والوعيد معلقة بالمشيئة:
أحكام الوعد والوعيد معلقةٌ بالمشيئة في حقّ الأعيان ما لم يرد نصّ يقصدهم بالدخول فيها، فيقطع لهم بما ورد من شهادة النصّ بالخير والشر، وإلا فالمكلَّف من أهل القبلة تحت المشيئة، قد يغفر الله له بالشهادتين، وقد يحاسبه على ذنبه، “وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا؛ إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذَّب، مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة، ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبةً صحيحةً، فإنا نقيم الحدَّ عليه مع ذلك كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك وعلى الغامدية مع قوله: «لقد تابت توبة لو تابها صاحبُ مكس لغُفر له»([22])، ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازَع فيه متأوّلا مع العلم بأنه باقٍ على العدالة. بخلاف من لا تأويل له؛ فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة واعتقدوا أنها تحلّ للخاصة تأوّل قوله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ} [المائدة: 93] اتفق الصحابة -مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما- على أنهم إن أقرّوا بالتحريم جُلِدوا، وإن أصرّوا على الاستحلال قُتلوا. وكذلك نعلم أن خلقًا لا يعاقبون في الدنيا مع أنهم كفّار في الآخرة، مثل أهل الذمة المقرّين بالجزية على كفرهم، ومثل المنافقين المظهرين الإسلام، فإنهم تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة كافرون كما دلّ عليه القرآن في آيات متعددة، كقوله: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} [النساء: 145]، وقوله: {يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَاب يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُور} [الحديد: 14].
وهذا لأن الجزاء في الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة التي هي دار الثواب والعقاب، وأما الدنيا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يُدفع به الظلم والعدوان… وإذا كان الأمر كذلك فعقوبةُ الدنيا غير مستلزِمة لعقوبة الآخرة، ولا بالعكس؛ ولهذا أكثرُ السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضِلّ الناس لأجل إفساده في الدين، سواء قالوا: هو كافر أو ليس بكافر. وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم -بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرساليةُ التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعيَّنين”([23]).
عاشرًا: الحكم على الناس ليس لكل أحد:
الحكم على الناس ليس متاحًا لكل أحد، فالحاكم لا يخرج عن أن يكون قاضيًا أو مفتيًا، وكلاهما يُطلب فيه العلم والديانة والورع؛ لأن الحكم على الناس لا بدّ له من تحقيق المناط: مناط الدليل، ومناط الحكم، وهذا الأمر ليس بتلك السهولة التي يظنّها العوام وصغار طلبة العلم ومن يتقحّمون أبوابا لا تتّسع عقولهم لإدراكها ولا مداركهم لفهمها، وقد نبّه الإمام الشافعي رحمه الله إلى طريق الحكم في الفتيا والقضاء فقال: “ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علمٍ مضى قبله، وجهةُ العلمِ بعدُ الكتابُ والسنةُ والإجماعُ والآثارُ وما وصفتُ من القياس عليها، ولا يقيس إلا من جمع الآلةَ التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله وفرضه وأدبِه وناسخِه ومنسوخِه وعامِّه وخاصِّه وإرشاده، ويَستدلّ على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكون إجماعٌ فبالقياس. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرِّق بين المشتبه، ولا يَعْجَلَ بالقول به دون التثبيت، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزدادُ به تثبيتًا فيما اعتقده من الصواب، وعليه في ذلك بلوغُ غاية جهده والإنصافُ من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك، ولا يكون بما قال أَعنَى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما ترك إن شاء الله. فأما مَن تمَّ عقله ولم يكن عالمًا بما وصفنا فلا يحلُّ له أن يقول بقياس؛ وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. ومن كان عالمًا بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضًا بقياس؛ لأنه قد يذهب عليه عَقْل المعاني، وكذلك لو كان حافظًا مقصِّرَ العقل أو مقصِّرًا عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قِبَلِ نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس، ولا نقول: يَسَع هذا -والله أعلم- أن يقول أبدًا إلا اتباعًا لا قياسا”([24]).
وقال ابن القيم رحمه الله: “وَلَمَّا كَانَ التَّبْلِيغُ عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ يَعْتَمِدُ الْعِلْمَ بِمَا يُبَلَّغُ وَالصِّدْقَ فِيهِ، لَمْ تَصْلُحْ مَرْتَبَةُ التَّبْلِيغِ بِالرِّوَايَةِ وَالْفُتْيَا إلَّا لِمَنْ اتَّصَفَ بِالْعِلْمِ وَالصِّدْقِ؛ فَيَكُونُ عَالِمًا بِمَا يُبَلِّغُ صَادِقًا فِيهِ، وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ حَسَنَ الطَّرِيقَةِ، مَرَضِيَّ السِّيرَةِ، عَدْلًا فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، مُتَشَابِهَ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ فِي مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِهِ وَأَحْوَالِهِ؛ وَإِذَا كَانَ مَنْصِبُ التَّوْقِيعِ عَنْ الْمُلُوكِ بِالْمَحلِّ الَّذِي لَا يُنْكَرُ فَضْلُهُ، وَلَا يُجْهَلُ قَدْرُهُ، وَهُوَ مِنْ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ السَّنِيَّاتِ، فَكَيْف بِمَنْصِبِ التَّوْقِيعِ عَنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ؟! فَحَقِيقٌ بِمَنْ أُقِيمَ فِي هَذَا الْمَنْصِبِ أَنْ يَعُدَّ لَهُ عِدَّتَهُ، وَأَنْ يَتَأَهَّبَ لَهُ أُهْبَتَهُ، وَأَنْ يَعْلَمَ قَدْرَ الْمَقَامِ الَّذِي أُقِيمَ فِيهِ، وَلَا يَكُونُ فِي صَدْرِهِ حَرَجٌ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَالصَّدْعِ بِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُهُ وَهَادِيهِ، وَكَيْف هُوَ الْمَنْصِبُ الَّذِي تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ رَبُّ الْأَرْبَابِ فَقَالَ تَعَالَى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} [النساء: 127]؟! وَكَفَى بِمَا تَوَلَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ شَرَفًا وَجَلَالَةً؛ إذْ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [النساء: 176]، وَلِيَعْلَمَ الْمُفْتِي عَمَّنْ يَنُوبُ فِي فَتْوَاهُ، وَلِيُوقِنَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ غَدًا وَمَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ”([25]).
وباب التكفير والتأثيم والحلال والحرام واحد؛ لأنَّ كل حكم سيترتّب عليه حكمٌ آخر من استحلال دم، وفراق زوجة، ونزولٍ عن مرتبة العدالة الشرعية إلى الفسق، وغير ذلك، وهذه الأحكام أعظم من أن تباح للعامّة يتخوَّضون فيها بغير حق، ويتّخذون آيات الله هزؤا.
فإذا عُلم هذا بقي أن نتكلّم عن موضوعنا وهو الحكم على الأشاعرة بالكفر، فقد تبين بما سبق أن ذلك لا يلزم، وأنه غير وارد، بل لا يلزم من إبطال بعض أقوالهم في المعتقد إخراجُهم من الدائرة السنية، فلم يبقَ إلا التدليل على ذلك مما يُتوقَّع أنه خصم لدود لهم وهم شيوخ السلفية المعاصرة، وهذا ما سنناقشه في المبحث الثاني.
المبحث الثاني: موقف شيوخ السلفية المعاصرة من الأشعرية:
وقبل الخوض في هذا الباب لا بد أن نقعِّد لقاعدة مهمّة وهي أن محدِّثي جميع المذاهب ومفسِّريهم في الغالب يختلفون عن أهل المذاهب الخلَّص الذين اعتنَوا بالمذهب من الداخل وبتفاصيل الأقوال، ومن ثم يختلف الناس في تصنيف المحدثين من أهل المذاهب على أهل المذاهب؛ وذلك لغلبة رجوع أهل الحديث للحقّ واتباعهم للسنة، وأَطرهم لأهل مذهبهم عليها؛ ولهذا قد تجد من يخالف أهل مذهب معيَّن يعظِّم بعض منتسبيه تعظيما خاصّا، بل ويستدل بهم لمذهبه الذي يقرّره؛ لأن الله عصمهم بالسنة من كثير من الزلل الذي وقع فيه غيرهم، ومن ثَم فإن الكلام عن المحدِّثين ممن يتكاثر بهم الأشاعرةُ -كالخطابي والبيهقي والنووي وابن حجر وأبي العباس القرطبي وغيرهم كثير- لا يمكن تسليمُ انتسابهم لهم لمخالفتهم لهم في أصول المذهب، ولو وافقوهم في بعض فروعه وفات عليهم الحقّ في آحاد المسائل التي لا يحيط بها إلا نبيّ، وإنما الكلام منصبّ على من خَلُص للمذهب وأصَّله في بيئته الكلامية الخالصة، وهذا يشمل أصحاب المتون المفردَة المطوَّلة والمختصرة في العقائد مثل الإمام الغزالي والجويني والآمدي والرازي، ومن سار على نهج الرازي رحمه الله فيما يقرِّر، ويمكن ملاحظةُ الموقف السلفي من هذه المدرسة من خلال أهمّ شخصية محورية مؤثّرة في الفكر السلفي المعاصر وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، فخلاصة موقفه من الأشاعرة تعدّ هي المعيار الموضوعيّ الذي ينتهي إليه كلّ باحث جادّ أو عالم مكتمل الآلة المعرفية، وذلك أن الخلاف مع الأشعرية في باب الصفات والقدر وترتيب المصادر ليس بالأمر الهين الذي يُدْرَك ببادئ الرأي، ولا قولهم فيه ظاهرُ البطلان بحيث يدرَك بالتأمل العابر، بل الخلاف معهم هو خلاصة بحوث لغوية عميقة، وأخرى كلامية أعمق وأدقّ، وبعضه خلافٌ في النقل يحتاج عالما بمذاهب السلف وأقوال العلماء، قادرا على التفريق بين اصطلاحات أهل الفنون وأهل القرون، فالاصطلاح قد يختلف في الفن الواحد، كما هو الشأن في لفظ “المفرد” عند النحاة، ولفظ النية عند الفقهاء، والتفويض والتأويل والمتشابه عند كل من المفسرين والمتكلّمين والسلف، والمدرسة نفسها طبقات، فيها المتقدمون المنتسبون لأهل الحديث، وفيها المتأخرون الذين غلبت عليهم الصنعة الكلامية، فلا يمكن لعامّيّ في اللغة أو في علم الكلام أن ينصبَ نفسه حكَما بين هؤلاء وغيرهم؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره، ويجدر التفريق بين مقام الإنكار ومقام الإعذار، فقد يُغلِّظ العالم القولَ على القائل في مقام معيّن يستوجب الصدَّ عنه، ويحفظ له مقامه في مقامات أخَرَ، فلا يمكن معرفة موقف طائفة من خلال الردود والإنكار؛ لأن هذه خاضعة للسياسة الشرعية في دعوة الناس وتعليمهم، وقد يرى الإنسان فيها من اختلاف الأحوال والأحكام ما يظنه تناقضًا، وليس الأمر كذلك.
وحاصل موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة هو الآتي:
أولًا: وصفهم بأنهم من أهل السنة في مقابل المعتزلة والرافضة.
ثانيًا: تفضيله أقوالَهم على أقوال غيرهم من المعتزلة والجهمية والفلاسفة.
ثالثًا: ذكره لمحاسنهم وردودهم على الباطنية والملاحدة وغيرهم.
رابعًا: حمدُه لهم لِمَا لهم من مساع وجهود مشكورة([26]).
ولهذا المعنى أمثلةٌ عملية في موقفه من أساطين الأشعرية وثنائه عليهم، فقد أثنى على أبي الحسن الأشعري في أكثر من موضع من فتاويه ونسبه للسنّة والحديث، وردّ غلوّ الغالين فيه والجافين عنه([27])، كما مدح الباقلاني وقدَّمه على الأشعري في الإثبات خاصّة في كتاب “الإبانة” وقال عنه: “هو أفضل المتكلّمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله، لا قبله ولا بعده”([28]).
ووصف الغزالي بقصد الحقّ والتفاني في طلبه، وكان هذا في معرض نقل الإمام أبي حامد الغزالي نقولا عن الإمام أحمد لا تثبت، فقال عنه ابن تيمية: ” ولم يكن ممن يتعمّد الكذب؛ فإنه كان أجلّ قدرًا من ذلك، وكان من أعظم الناس ذكاء وطلبًا للعلم وبحثًا عن الأمور، ولما قاله كان من أعظم الناس قصدًا للحق، وله من الكلام الحسن المقبول أشياء عظيمة بليغة، ومن حسن التقسيم والترتيب ما هو به من أحسن المصنفين، لكن لكونه لم يصل إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الطرق الصحيحة كان ينقل ذلك بحسب ما بلغه، لا سيما مع هذا الأصل الفاسد إذ جعل النبوات فرعًا على غيرها”([29]).
وقد رصد الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود طرفا كبيرا من إنصافه للرازي والآمدي وأثير الدين الأبهري وسراج الدين الأرموي وغيرهم، فليراجع فإن فيه كفاية([30]).
ومن تأمل كلامه وطريقته وجد أنه يسلك مسلكين في التعامل معهم:
المسلك الأول: مسلك الرد وإبطال الأقوال، وهذا يبيّن فيه مخالفة الاصطلاح للكتاب والسنة أولا، ثم يبين بطلانه بما يلزم عنه من باطل، ومن موافقةٍ لأرباب البدع كالجهمية وغيرهم، وتجد هذا مفصّلا في كتابه الشهير “بيان تلبيس الجهمية”.
المسلك الثاني: تقويم الأداء العملي والعلمي للطائفة، وهنا تجده يصفهم بسادة الإسلام والعباد والزهاد وأصحاب المساعي المشكورة في الذبّ عن دين الحق، ومدافعة أهل البدع من الروافض والجهمية والمعتزلة، ويصفهم بأنهم أهل حديث وأهل قصد للخير.
وهذا الموقف نجده عند كل عالم منتسِب للمدرسة السلفية كلَّما زاد علمُه واعتناؤه بالعقائد، والمدرسةُ السلفية المعاصرة لها أعلام كبار خالفوا الأشعرية وردوا عليها، وهؤلاء كانوا قسمين في الأغلب:
الأول: قسم خرج من بيئةٍ أشعرية مثل كثير من علماء المغرب وشنقيط، وهؤلاء أقلّ حدَّة، وإن كانوا يظهِرون الخلاف مع الأشعرية ويبطِلون أقوالها، لكن يرون أنهم إنما يبطلون ما وافق أقوال الجهمية ويحتجّون على الأشعرية بمتقدّميهم، وهذه المدرسة مثلها في شنقيط الشيخ سيديا باب ابن الشيخ سيدي في أنظامه وكتبه، وقد أصدرنا في مركز سلف ورقة علمية عنه وعن منهجه العقدي([31])، ووافقه على ذلك العلامة المفسّر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد تناول آيات الصفات وردّ على الأشاعرة في بحثه المعروف: “منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات”([32])، وفي كتابه “أضواء البيان” في عدة مواضع منه، وكذلك العلامة الوزير اللغوي الشيخ محمد سالم عدّود رحمه الله في نظمه المعروف بـ”مجمَل اعتقاد السلف”، وقد جعله مقدّمةً لنظمه لخليل، وفيه يقول:
أذكر جملةً من العقائدِ *** على طريق السلف الأماجدِ
ولست ذاكرًا سوى المتَّفق *** عليه من قبل نشوء الفرق
مما إليه الأشعري قد رجَع *** متّبعًا أحمد نِعم المتَّبَع
لا ما يقول من لِذا أو ذا انتَمى *** زعمًا ولم يسِر على ما رسما([33])
ومثله في ذلك العلامة بداه بن البصيري الشنقيطي، وتجد هذا ظاهرا في كتابه “تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهر”([34]).
فهؤلاء ينحَون منحى حمل كلام متقدِّمي الأشعرية على اصطلاح السلف؛ فينسبونهم للسلف من هذه الجهة، ويرون أنهم أولى بهم ممن حمل التأويل والتفويض على معناهما عند المتكلمين.
الثاني: رموز المدرسة المشرقية، وهذه أكثر تفصيلًا وأقوم قيلا في الباب من غيرها من المدارس، ويرجع ذلك إلى الاحتكاك المباشر بالنُّسَخ الأشعرية الأكثر تطرفًا، مع العلم بالحديث وأقوال السلف، وتوفّر المراجع بشقّيها: مراجع السلف، ومراجع المتكلمين؛ مما يسمح بتحقيق الأقوال، سواء في نسبتها إلى أهلها أو نفيها، بالإضافة إلى الاعتماد شِبه الكلي على تراث شيخ الإسلام ابن تيمية العقديّ، والذي يعدّ مؤسّسا لكثير من المدارس السلفية المعاصرة، وهذا الاعتماد يجعلنا نصل إلى نتيجة مجملة مفادُها أن السلفيين المعاصرين -وإن كثر كلامهم في الأشعرية، وفي ذمّ بعض معتقداتها التي يرون فيها مخالفة لما كان عليه السلف- فإنّ خلاصة المنهج هي عدم التبديع والتضليل بإطلاق، وإنما الحكم على تلك الأقوال بمخالفة ما كان عليه السلف في ذلك الباب مع الإعذار للمخالف؛ إما بالتأويل، أو جهل ما كان عليه السلف في الباب لعدم تحقيقه لأقوالهم، ويُثنون على أهل الحديث خاصّة من الأشاعرة، فتجد في كتب النجديين وصفَ شيخ الإسلام ليس مقتصرا على ابن تيمية بل يطلقونه على زكريا الأنصاري([35]) وعلى الحافظ ابن حجر العسقلاني وعلى البُلقيني([36])، وتجد الشيخ العلامة ابن عثيمين -وهو أحد كبار علماء السلفية المعاصرة- يبين هذا الموقف -وهو من أكثر من تكلّم في العقائد شرحا وتدريسا- يبين أن هذا الموقف الممانع ضدّ الأشعرية لا يقرب من التكفير ولا يستسهله، فهو يراهم من نفس الزاوية التي يراهم منها شيخ الإسلام، وهي أنهم أصحاب مقاصد حسنة، وحسنات مشكورة في الإسلام، وأنهم خالفوا مذهب السلف في بعض الصفات، فلا يوصفون بالسنة في ذلك الباب للمخالفة فيه([37]).
وحسبُك من القلادة ما أحاط بالعنق، فلو تتبّعنا أقوال علماء السلفية من المعاصرين وغيرهم على كثرتها وتعدّدها وتفاوت أصحابها في التخصّص في الباب، فلن تجدَ تصريحا بالتكفير فيها ولا جنوحًا إليه، وقد لخّص ذلك العلامة الأصولي محمد زارق -الملقب الشاعر ناصر السنة- في ردّه على بعض أساطين الصوفية ممن تترّس بالأشعرية، وهو في ذلك مقرّر لما يتّفق عليه السلفية من عدم التكفير للأشعرية، ولما عليه المدرسة الشنقيطية من نسبة متقدمي الأشعرية لمنهج السلف ومحاكمة متأخّريهم لذلك، فقال:
وهاكَ جمعًا للدليل آثروا *** ممن بهم (ألهاكم التكاثرُ)
جمعٌ إلى تفويضها قدْ رجعوا *** والأشعريةُ بهم قد فُجعوا
فالباقلاني منهمُ استقالا *** فانظرْ لدى التمهيد ماذا قالا
ثمّ الجويني كان فيهم حاميهْ *** رجَعَ في العقيدة النظاميهْ
ورجَعَ الغزالي في الإلجام *** عن علم ما سُمّيَ بالكلام
والفخرُ في التقسيم للّذات *** قال: أنا أقرأ في الإثْبات:
(ربي على العرش استوى) وسَلْبا: *** (ليس كمثله) فيشفي القلْبا
وفتنةُ المشرق والزلازلُ *** منطقُكم فيها غريبٌ نازلُ
فلنطْلُب العلوّ في الخطاب *** شرحُ البخاري للفتى الخطّابي
ويلخّص معتقده فيهم فيقول:
وفي الأخير هذه توصِيّهْ *** لكلّ من ينْمى للأشعرية
كلّهمُ عليهمُ الإثباتُ *** لما قضى للاشعري الأثْباتُ
فالأشعريُّ كان ذا تأوُّلِ *** لكنّه رَجَعَ عنْ ذا الأولِ
فكيفَ يُنْسَبُ له قولانِ *** وهو بثانٍ ظلّ ذا إعلانِ
لهفي على قواعدٍ للنّسخِ *** قد مسّها هذا الهوى بالمسْخِ
واسمع لما ثَبَتَ في الإبانهْ *** مما سليلُ الأشعري أبانَهْ
أن الإلهَ فوقَ عرشه استوى *** مقالة تهزُّ أربابَ الهوى
وهاكَ من عزا له الإبانهْ *** من حاملٍ للصدْقِ والدّيانهْ
نَجْلُ عساكرٍ نمى للأشعري *** إبانةً في سِفْر كِذْبِ المفتري
والذهبيُّ في العلوِّ للعلي *** والبيهقي والفارسي أبو علي
والمرتضى الزبيدي ثم ابنُ كثيرْ *** ثم ابن دِرْباسَ وغيرُهم كثيرْ
ثمّ ابنُ فرْحُونَ الفقيهُ النابغهْ *** المالكيُّ قال فيه النابغهْ:
(واعتمدوا تبصرةَ الفَرحوني *** وركِبوا في فلكها المشحونِ)
وابنُ عمادٍ حنبليُّ المذهبِ *** أوْرَدَ ذا في شذراتِ الذهبِ
ومن هنا نسبةُ الأشعريةْ *** للأشعري عن الهدى عريّهْ
واعْلمْ بأنّ كلّ منْ أبطَلَها *** ليس مفسِّقا لمن أعمَلَها
من علماءَ اجتهدوا تنزيها *** والله باجتهادها يَجزيها
مهما أتوا من خطأٍ يعفى وأينْ *** فماؤُهم جاوزَ حدّ القُلّتينْ
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) أي: غبار الجيش. ينظر: شرح صحيح البخاري للأصبهاني (5/ 185).
([2]) حَلْ حَلْ: زَجْرٌ لِلْإِبِلِ. ينظر: المصدر السابق.
([3]) هو كالحران للفرس. ينظر: مطالع الأنوار (3/ 435).
([7]) ينظر: الإفصاح لابن هبيرة (1/ 190) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 399).
([8]) بضم الحاء وفتح الراء بعدها قاف: نسبة إلى الحُرَقة، واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة، تسمى الحرقة لأنه حرق قومًا بالقتل فبالغ في ذلك.
([10]) تفسير الطبري (22/ 528).
([13]) المحرر الوجيز (4/ 532).
([16]) الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق (1/ 24).
([18]) تفسير القرطبي (18/ 52).
([19]) مجموع الفتاوى (19/ 74).
([20]) مجموع الفتاوى (12/ 466).
([21]) مجموع الفتاوى (11/ 44).
([23]) مجموع الفتاوى (12/ 499) باختصار.
([24]) الرسالة (ص: 511) وما بعدها.
([25]) إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 9).
([26]) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن صالح المحمود (2/ 699).
([27]) ينظر: درء التعارض (1/ 270)، ومجموع الفتاوى (3/ 227).
([29]) بيان تلبيس الجهمية (6/ 128).
([30]) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (2/ 717) وما بعدها.
([31]) ينظر الرابط: https://salafcenter.org/439/
([32]) ينظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص: 9).
([33]) نظم مجمل اعتقاد السلف (ص: 1).
([34]) ينظر: تنبيه الخلف الحاضر (ص: 15) وما بعدها.
([35]) الدرر السنية (11/ 172).
([36]) ينظر: كتاب الإيمان والرد على أهل البدع (ص: 21).
([37]) ينظر: كتاب موقف ابن عثيمين من الأشاعرة (ص: 58) وما بعدها.