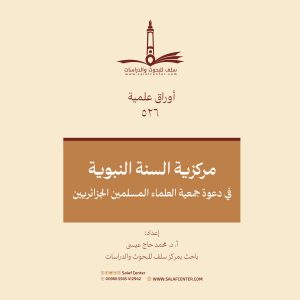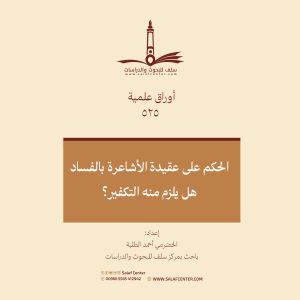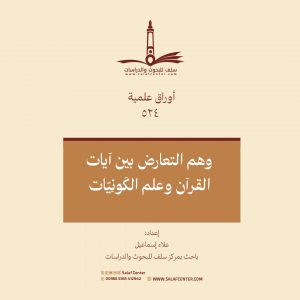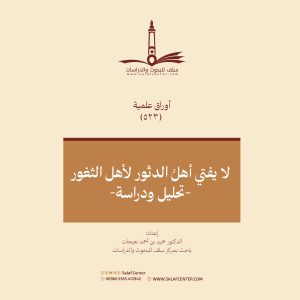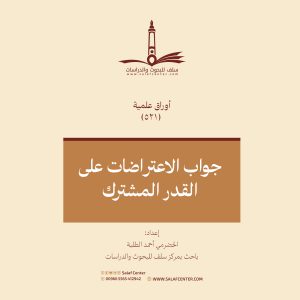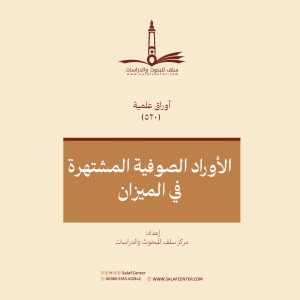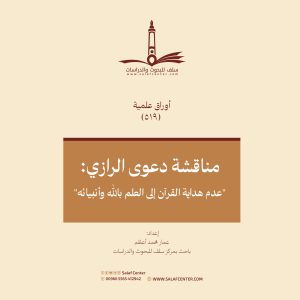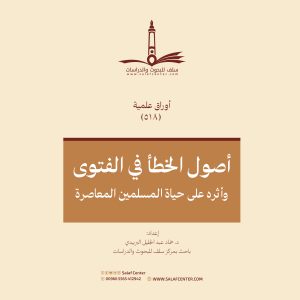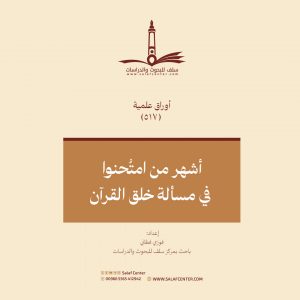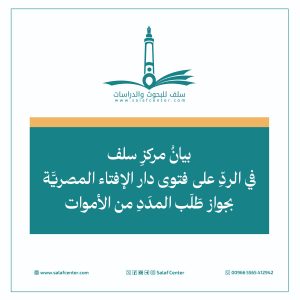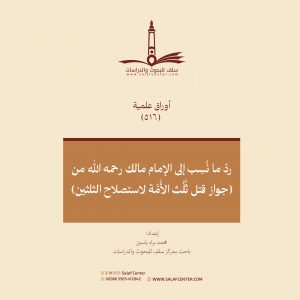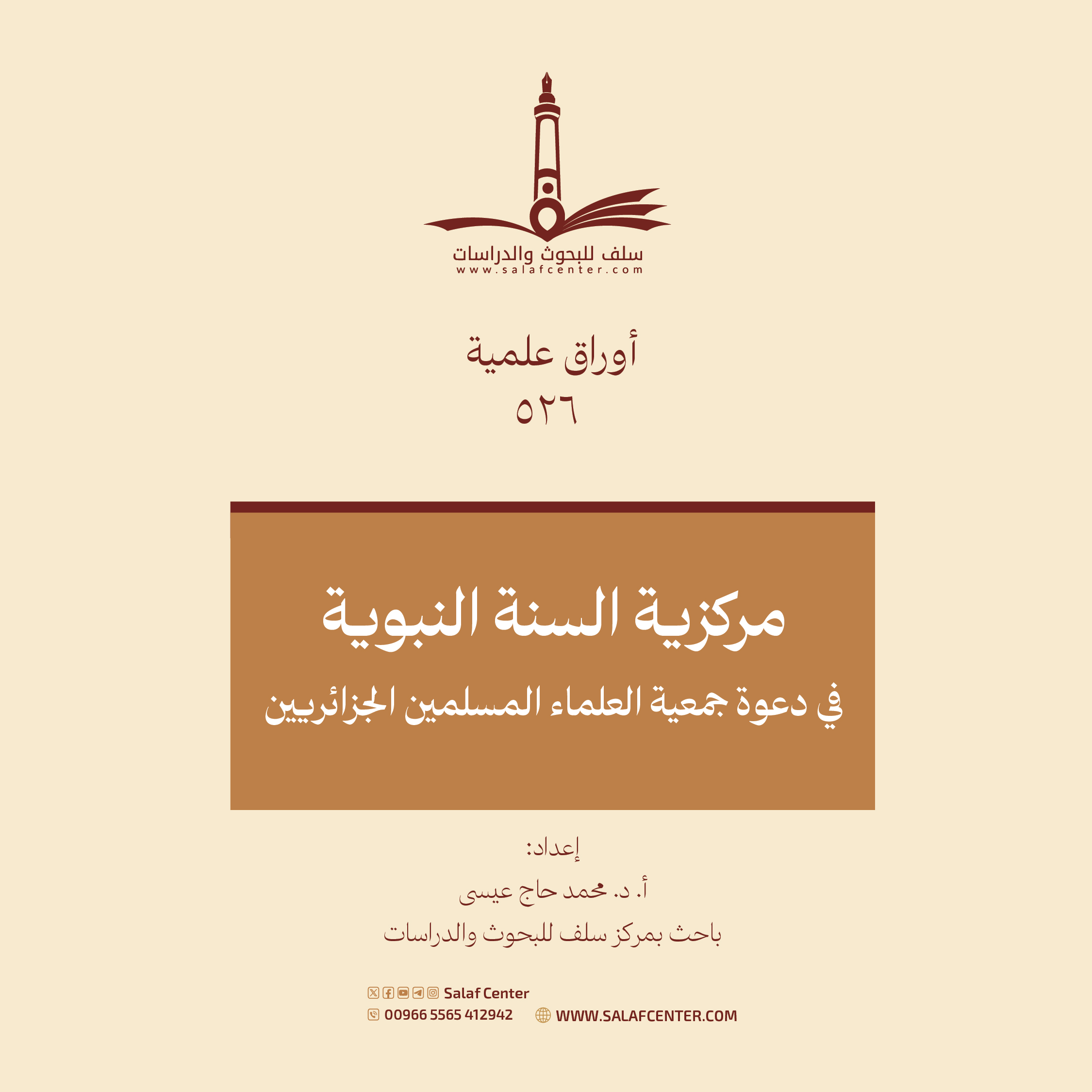
مركزية السنة النبوية في دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
مقدمة:
إنَّ الدعوةَ الإصلاحية السلفيَّة الحديثة ترتكِز على عدّة أسُس بُنيت عليها، ومن أبرز هذه الأسُس السنةُ النبوية التي كانت هدفًا ووسيلة في آنٍ واحد، حيث إن دعوةَ الإصلاح تهدف إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف من التزام الهدي النبوي من جهة، وإلى تقرير أن السنة النبوية الصحيحة هي من أهم وسائل المصلحين في بيان الحقائق الدينية من جهة أخرى، وكان من أبرز الدعوات التي ظهرت في القرن الماضي في الجهة الغربية من العالم الإسلامي دعوةُ جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، التي كان لها أثرٌ بارز في إحياء علوم الدين في الواقع وتجديده في نفوس الناس.
ورغم أنه قد كان للسنة النبوية مكانةٌ واضحة في خِطاب علماء الجمعية الدعويّ؛ إلا أن تساؤلاتٍ عدةً تُطرح لدى كثير من المهتمين بالشأن الدعوى في هذا المضمار، منها التساؤل عن مدى حضور السنة النبوية في مجالات الإصلاح الثلاثة (العقيدة، والفقه، والسلوك) عند علماء الجمعية، ومنها التساؤل عن مظاهر توظيف السنة ووسائل نشرها، ومنها التساؤل عن الأثر الذي أثمره هذا الاهتمام بالسنة النبوية. وسعيًا من مركز سلف للبحوث والدراسات للإجابة عن هذه التساؤلات رأينا أن ننجز هذه الورقة العلمية التي بعنوان: “مركزية السنة النبوية في دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين”، وفي سياق إظهار تلك القضايا العلمية والتاريخية نقدم مقدمات نأكد فيها على بناء الدعوة الإصلاحية على السنة النبوية، ونكشف فيها عن المؤهلات التي كان يتمتّع بها علماء الجمعية في مجال علوم السنة، وعن المصادر التي اعتمدوها.
وقبل الشروع في تحرير هذه الورقة العلمية نظرنا في الدراسات السابقة ذات الصلة بهذا الموضوع؛ فوجدنا دراسة بعنوان: “جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في خدمة الحديث النبوي” لعقيلة حسين، وهي في تقديرنا لم توفِّ البحث حقَّه سواء من جهة خطته العامة، أو من جهة استقراء الجهود العلمية والعملية المبذولة؛ فكان غالب البحث منصبًّا على شخصية ابن باديس، كما أنه لم يجِب عن التساؤلات التي انطلقنا منها، ووجدنا دراسةً أخرى بعنوان: “الدرس الحديثي عند الإمام ابن باديس منهجه ومقاصده” ليونس بوحمادو، وهي مذكرة ماجستير أكثر جدّيّة وتعمّقا من سابقَتها، ولكنها خاصّة بالشيخ ابن باديس دون بقية علماء الجمعية، وهي تتقاطع مع ما نسعى لتجليته في بحثنا في عنصر مهمّ وهو: منهج ابن باديس في شرح الحديث.
مركز سلف للبحوث والدراسات
المبحث الأول: بناء دعوة جمعية العلماء على السنة النبوية:
إنّ تساؤلاتِ هذه الدراسةِ تحتاج إلى مقدمات ضرورية لا بدَّ من إيضاحها وتوثيقها للبناء عليها والانطلاق منها، ومن تلك المقدّمات: بيان منزلة السنة في دعوة جمعية العلماء وحرصهم على توظيفها في خطابهم الدعوي، ومنها: بيان مؤهلات علماء الجمعية في مجال علوم السنة والمصادر التي اعتمدوها في دعوتهم، والذي يجمع هذه المعاني قولنا: بناء دعوة جمعية العلماء على السنة النبوية.
المطلب الأول: منزلة السنة وتوظيفها في الخطاب الدعوي:
الفرع الأول: مفهوم السنة ومنزلتها عند العلماء:
تطلق السنة بالمعنى اللغوي الذي يعني الطريقة المحمدية والنهج النبويّ، وهو المعنى المتداوَل في مجال الاعتقاد، ومنه أطلق لقب (أهل السنة) على الملتزمين بنهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في تلقين الاعتقاد، كما تطلق بالمعنى المتداوَل عند أهل الأصول فيرادُ بها المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله تعالى، وكلا المعنيين كان محلَّ اهتمام لدى علماء الجمعية؛ فقَولُ الشيخ العربي التبسي رحمه الله وهو يقرّظ رسالة (الشرك ومظاهره) لمبارك الميلي رحمه الله بأنه: «خدم بها الإسلام، ونصَر بها السنّة، وقاوم بها العوائد الضالة، والخرافات المفسدة للعقول»([1]) المراد به المعنى الأول الذي يقابل البدعةَ، وقوله وهو يبين مصادر التشريع: «الأدلة التي تثبُت بها الأحكام والأخلاق الدينية الكتابُ إجماعًا والسنةُ الصحيحةُ كذلك، والسنةُ: أقواله وأفعاله وإقراره وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم»([2]) المراد به المعنى الثاني الذي يقابل القرآنَ الكريم، وهذا الثاني هو المقصود بهذا البحث.
وقد احتلَّت السنة النبوية مكانةً مهمةً في دعوة جمعية العلماء، ومما يدلّ على ذلك ما دوّنه الشيخ ابن باديس رحمه الله في أصول جمعية العلماء، حيث قال في الأصل الرابع منها: «السنة القولية والفعلية الصحيحةُ تفسيرٌ وبيان للقرآن»([3]). وذلك أن “فقه القرآن يتوقَّف على فقه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وفقهُ حياته صلى الله عليه وسلم يتوقَّف على فقه القرآن، وفقهُ الإسلام يتوقَّف على فقههما” كما أوضح ابن باديس رحمه الله في موضع آخر([4]). وقد اعتبرها وحيًا منزَّلا حيث قال: “وهي وحي أيضا لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3]، وكل دليل من أدلة الشريعة فإنه يرجع إلى هذين الأصلين، ولا يقبل إلا إذا قبلاه ودلّا عليه، وكلّ شيء ينسب إلى الإسلام ولا أصلَ له فيهما فهو مردود على قائله، وقد قال النبي r: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ»([5])”([6]).
بل إن ابن باديس قد نصَّ على أن من شرط العالم أن يكون إمامًا في فقه القرآن، وإمامًا في فقه السنة، وإمامًا في اللغة العربية، وعلَّل ذلك بقوله: «إذ بدون هذه لا يفقه الإسلام، فتلك لغته التي بها أُنزل، وذلك كتابه الذي عليه يعوَّل، وتلك بيانه ممن به أرسل»([7]). وربط البشير الإبراهيمي بين هذه العناصر الثلاثة بقوله: «إن السلف تذرّعوا لفهم القرآن ذريعتين: الذوق العربي الصحيح، والسنة النبوية الصحيحة»([8]).
وكتب الشيخ الطيب العقبي أيضا عام 1925م داعيًا العلماءَ لإنشاء جماعة دينية تكون غايتُها تطهيرَ الدين من الخرافات والأوهام والرجوعَ إلى الكتاب والسنة([9]). وهو ما تحقَّق بتأسيس جمعية العلماء، والتي كانت أول جرائدها تحمل عنوان: “السنة المحمدية”، الأمر الذي يوضح بجلاء مكانةَ السنة في دعوة هذه الجمعية، وقد قال الشيخ العربي التبسي في عددها الأول: “وإني لا أدع هذه الفرصةَ تمرّ دون أن أنهيَ إلى أنصار السنة المحمدية أشهَى التهاني بهذه الجريدة المباركة على السنة وعلى أهل السنة الذين تحيا أرواحهم وتستنير بصائرهم بالعمل بالسنة… على أن هذه الجريدة ستقضي عمرها على منهج السنة، وتسير على ضوئها، وتأتمر بأوامرها، وتنتهي عند مناهيها، وتوالي من تواليه السنة، وتحب من تحبه السنة، لا تعرف للعصبية أهلا، ولا للطائفية لغة، وسيكون شعارها ودثارها ووصفها المميز لها حديثي: «البغض في الله والحب في الله أوثقُ عرى الإيمان»([10])، و«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»([11])”([12]).
الفرع الثاني: حال السنة النبوية في الأمة قبل ظهور الجمعية:
فإن قيل: ما دامت السنة النبوية من أصول التشريع؛ فلم يُزعَم اختصاصُ علماء الجمعية باعتمادها والدعوة إليها دون غيرهم؟ قيل: لأن الأمةَ الإسلاميةَ قد هجرت السنةَ في العصور المتأخرة؛ مما أدى إلى انحطاطها وانحطاط علومها، وقد وصف ابن باديس هذه الحال بعد أن بين مكانة القرآن ومنزلة السنة منه فقال: «فهجرناها كما هجرناه، وعاملناها بما عاملناه»([13])، أي: أن السنة قد هُجرت كما هُجر القرآن. ومما ينبغي التأكيدُ عليه أن وجودَ من كان يحفظ السنة لا ينفي معنى الهجران؛ لأنها قد أُبعدت عن ميدان الاستنباط والعمل إلى ميدان التبرُّك، أو صُيِّرت تابعةً لا متبوعة كما فُعل ذلك بآي القرآن الكريم([14]). فالهجران ألوان وليس لونًا واحدًا، ومن ألوانه الحفاظُ على رسوم السنة وأشكالها دون العمل بها أو الاحتكام إليها، ويقول الشيخ مبارك الميلي في وصف حال الطرقية مع الكتاب والسنة أنهم لا يرجعون في أعمالهم إلى الكتاب والسنة: «فإن اضطروا إليهما تمسكوا بمتشابه الكتاب؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وبضعيف الحديث المتداعي والموضوع الذي لا تحلّ روايته إلا للتحذير منه»([15]).
من مظاهر هجر السنة ما حكاه ابن باديس من ردّ السنن بعد العلم بها وبمدلولها كما هو حال المتعصّبين، فقال: «فإذا ذكرتَ لهم الحكمَ الشرعيَّ بدليله من الكتاب والسنة صدُّوا ونفروا، وأبوا واستكبروا، وصارحوا بالمخالفة أو سكتوا وأضمَروا الخلاف. وما هذا شأن المؤمنين»([16]).
الفرع الثالث: توظيف السنة في الخطاب الدعوي:
من أظهر الأشياء الدالة على مكانة السنة النبوية في دعوة جمعية العلماء دعوة أعلامها الوعاظَ والمدرسين إلى توظيفها في خطابهم؛ رفعا لذلك الهجر الذي عرفته وعرفه كتاب الله تعالى، ومن ذلك قول ابن باديس: «بهما يكون تذكير العباد ودعوتهم لله رب العالمين، ومن حاد في التذكير عنهما ضلّ وأضلّ، وكان ما يضر أكثر مما ينفع إن كان هنالك من نفع»([17]).
ويقول الإبراهيمي وهو يوجِّه نداء باسم الجمعية إلى الوعاظ أن يقوموا بواجب التذكير في أمسيات شهر رمضان: «تتقدم إلى وعاظها بالتوكيد على أن يطرقوا مواضيع الأخلاق الإسلامية والتربية الإسلامية؛ معتمدين على آيات الكتاب التي يفهمونها فهمًا صحيحًا، وعلى الأحاديث الصحيحة وعلى السيرة النبوية الثابتة»([18]).
وقد شمل هذا التوجيه مجال الدروس المسجدية عامة، وليس خاصا بدروس المناسبات الدينية، قال الإبراهيمي: «أما في المساجد فطريقة الجمعية في الوعظ والتذكير هي طريقة السلف، تذكِّر بكتاب الله، تشرحه وتستجدي عبره، وبالصحيح من سنّة رسول الله، تبيِّنها وتنشرها، وبسيرته العملية، تجلُوها وتدلّ الناس على مواضع التأسّي منها»([19])، وشمل هذا التوجيه مجال الصحافة، وقد ذكر الإبراهيمي أن جريدة (السنة النبوية) توجّه “همّها إلى بيان السنن النبوية وتوضيح المسائل العلمية”([20]).
وشمل أيضا الكتب ومقررات التدريس، وقد جاء في المادة: 75 من مواد القانون الداخلي لجمعية العلماء الذي سطره الإبراهيمي رحمه الله قوله: «تُعنى الجمعية وتُوصي كل مَن فيه الكفاءة بإحياء دروس الحديث من كتبه الصحيحة»([21]). وقال رحمه الله في موضع آخر: «وأما إصلاح الكتب فإن عمدة الجمعية في التذكير على كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام، ومدرسوها ما منهم إلّا من له في العلم مقام معلوم، وهم يلتزمون في تذكيرهم الأحاديث التي صحت أسانيدها ومتونها، ودواوين الحديث الصحيحة المعتمدة موجودة متوافرة، فلا عناء في هذا الباب»([22]).
الفرع الرابع: التزام الصحة في السنة النبوية:
مما تميزت به دعوة جمعية العلماء إحياؤها للنقد الحديثي، من خلال حثها على التثبت من صحة الأحاديث، والتحذير من بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي كان لها أثر سيئ على الأمة، وفي هذا الصدد يقول ابن باديس: «تقوم الدعوة الإصلاحية على أساس الكتاب والسنة، فلا جرم كان رجالها من المعتنين بالسنة القائمين عليها رواية ودراية الناشرين لها بين الناس، ومن عنايتهم تحرِّيهم فيما يستدلّون به ويستندون إليه منها، فلا يجوز عليهم إلا ما يصلح للاستدلال والاستناد، ولا يذكرون منها شيئا إلا مع بيان مخرجه ورتبته حتى يكون الواقف عليه على بينة من أمره، مما لو التزمه كل عالم -كما هو الواجب- لما راجت الموضوعات والواهيات بين الناس فأفسدت عليهم كثيرا من العقائد والأعمال»([23]).
وفي هذا السياق يندرج انتقاد الإبراهيمي لظاهرة التسليم التي كانت منتشرة بين الناس، والتي تعني تعطيل مبدأ التثبت والتبيّن، وقد جعل هذا التسليم المطلق “هو المنفَذ الواقع الذي دخلت علينا منه الخرافات والأحاديث الموضوعة والمبالغات السخيفة، والآراء المضطربة وكبائر الغلو وموبقاته”([24]).
المطلب الثاني: مؤهّلات علماء الجمعية ومصادرهم في ميدان السنة النبوية:
الفرع الأول: مؤهلات علماء الجمعية في علم الحديث:
من المقدمات المهمّة لدراسة عناية علماء الجمعية بالسنة التطرق إلى تكوينهم فيها ومؤهلاتهم التي حازوها في مرحلة الطلب في الحديث وعلومه، وسنلقي نظرة على مقررات الزيتونة والأزهر وشيء من دروس المسجد النبوي المتعلقة بالحديث.
ونبدأ بجامع الزيتونة الذي تخرج منه ابن باديس ومبارك الميلي وعدد كبير من العلماء المنتمين إلى جمعية العلماء، وقد وجدنا المقررات التي درسها ابن باديس دراسة رسمية واختُبر فيها، فكان فيها (التقريب) للنووي و(البيقونية بشرح الزرقاني في علوم الحديث)، وكان فيها (صحيح مسلم)، و(شرح البخاري) و(شرح الموطأ) وقد أجيز في جميعها([25]). وأما الإجازات العامة والخاصة التي حصّلها ابن باديس في رحلته المشرقية فلم أر فائدة في تتبعها لأنها كانت إجازات إفادة شكليّة لم يصحبها سماع أو دراسة. هذا وقد كان لشيوخ الزيتونة الإصلاحيين دروس خارج تلك المقررات الرسمية، ولا شكّ أن ابن باديس قد استفاد منها.
وقد وجدنا في مقررات الأزهر الذي تخرج منه الشيخ العربي التبسي رحمه الله في ذلك العهد في أصول الحديث: (نخبة الفكر) لابن حجر و(ألفية العراقي) و(تدريب الراوي) للسيوطي، وفي متون السنة وشروحها: الكتب الستة مع شروحها المتداولة في ذلك العصر([26])، وذكر بعضهم أن العربي التبسي درس في الأزهر (شرح الزرقاني على الموطأ) و(فتح الباري) لابن حجر و(تحفة الأحوذي) للمباركفوري، إضافة إلى (مقدمة ابن الصلاح) في أصول الحديث، وأنه درس في جامع الزيتونة (فتح الباري) و(الموطأ) و(صحيح مسلم) و(شرح بلوغ المرام)([27]).
وأما الإبراهيمي الذي كان تكوينه في المدينة، فممن أخذ عنهم أصول الحديث والجرح والتعديل وأسماء الرجال الشيخ أحمد البرزنجي الشهرزوري، وأما متون الحديث وشرحها فذكر أنه حضر للشيخ المذكور دروسًا قليلة في (شرح صحيح البخاري)، وأخذ (شرح الموطأ) من الشيخ العزيز الوزير التونسي، و(شرح صحيح مسلم) من الشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهندي، وسمع الحديث سماعا مجردا من محمد بن جعفر الكتاني ومحمد الخضر الشنقيطي وغيرهما([28]).
الفرع الثاني: مصادر علماء الجمعية في علم الحديث:
مما يبين عناية علماء الجمعية بالسنة تتبع المصادر الحديثية التي كانوا يعتمدون عليها، ولذلك نحاول أن نستقرئها ولو استقراء ناقصا لنبين تنوّعها، ونقف على شيء من جهدهم في نشر السنة، ونبدأ بالشيخ ابن باديس رحمه الله، وذلك بالنظر فيما اعتمده في شرحه للحديث وفي فتاويه المنشورة، وننبه هنا إلى قضية مهمة وهي ضرورة التمييز بين المصدر الذي نقل منه مباشرة، والذي نقل منه بالواسطة، وكثير من الباحثين لا يميزون هذا فيذكرون الجميع ضمن المصادر، وليس الأمر كذلك، ومن الباحثين من وقع في هذا في خصوص ابن باديس؛ فذكر كتبا لم تكن مطبوعة في زمانه، ولم يثبت كونها مخطوطة لديه كـ(الاستذكار) و(علل الدارقطني) و(صحيح ابن حبان) وغيرها من المصادر التي نقل عنها بالواسطة بلا ريب([29]).
فأما مصادر السنة عند ابن باديس فنجد فيها -إضافة إلى الموطأ الذي كان يدرسه- (صحيح البخاري)، و(صحيح مسلم)، و(سنن أبي داود)، و(سنن الترمذي)، و(سنن ابن ماجة)([30]). وعزا أحاديث إلى مصادر أخرى كـ(سنن النسائي)، لكن ليس ثمة قرائن تدل على اعتمادها اعتمادا مباشرا. ومن الكتب الجامعة لمتون الحديث: (منتقى الأخبار) للمجد ابن تيمية، و(مشكاة المصابيح) للتبريزي، و(الترغيب والترهيب) للمنذري، و(مجمع الزوائد) للهيتمي([31]).
ومن شروح الحديث: (معالم السنن) للخطابي، و(المنتقى شرح الموطأ) للباجي، و(القبس شرح الموطأ) لابن العربي، ولم يكن مطبوعا وإنما اعتمد على مخطوطة منه، و(شرح صحيح مسلم) للنووي، و(فتح الباري) لابن حجر، و(إرشاد الساري) للقسطلاني، و(إكمال إكمال المعلم) للأبي، و(مكمل الإكمال) للسنوسي، و(الأربعين النووية) وشروحها ولم يحددها([32]).
ويلحق بها (جامع بيان العلم وفضله) الذي اعتمده كثيرا، حتى قال: “وكل ما ننقله عنه من غير عزو إلى كتاب فمن كتابه (جامع بيان العلم وفضله)”([33]).
ونجد في فتاوى الشيخ العربي التبسي الاعتماد على (سنن الدارقطني)، و(عمل اليوم والليلة) للنسائي، و(عمل اليوم والليلة) لابن السني، و(الأذكار) للنووي، ومن الشروح: (فتح الباري) لابن حجر، و(صحيح البخاري)، و(سبل السلام) للصنعاني، و(نيل الأوطار) للشوكاني([34]).
واعتمد أبو يعلى الزواوي في فتاويه وبحوثه على (الجامع الصغير) للسيوطي، و(تيسر الوصول) لابن الديبع، و(شرح الزقاني على الموطأ)، و(شرح العيني على البخاري)، و(شرح مسلم) للنووي، و(شرح العزيزي على الجامع الصغير)، و(شرح الشبراخيتي على الأربعين النووية)([35]).
ومما اعتمده مبارك الميلي في رسالة (الشرك ومظاهره) إضافة إلى الكتب الستة المعروفة: (الأسماء والصفات) للبيهقي، و(حلية الأولياء) لأبي نعيم([36])، ومن المراجع الجامعة في الحديث: (رياض الصالحين) و(الأذكار) كلاهما للنووي، و(الحصن الحصين) لابن الجزري، و(الترغيب والترهيب) للمنذري، و(مجمع الزوائد) للهيثمي، و(كشف الخفا) للعجلوني، و(تمييز الطيب من الخبيث) لابن الديبع([37])، ومن الشروح: (معالم السنن) للخطابي، و(المنتقى) للباجي، و(شرح مسلم) للنووي، و(فتح الباري) لابن حجر، و(جامع العلوم والحكم) لابن رجب، و(الفتح المبين شرح الأربعين) للهيتمي، و(مكمل الإكمال) للسنوسي، و(سبل السلام) للصنعاني، و(نيل الأوطار) و(تحفة الذاكرين) كلاهما للشوكاني، و(شرح الزرقاني على الموطأ)، و(شرح رياض الصالحين) و(شرح الأذكار) كلاهما لابن علان([38]).
وإذا أعدنا تصنيف هذه الكتب حسب محتواها فإننا نجد فيها مصادر السنة المسنَدة، والكتبَ الجامعة للمتون، وكتبَ الشروح، وكذا كتب النقد الحديثي.
المبحث الثاني: بناء مجالات الإصلاح على السنة النبوية:
إن دعوة الإصلاح الدينية قد شملت جميع مجالات الشرع الحكيم، وفي هذا المبحث نستكشف مدى تحكيم السنة النبوية في المجالات الثلاثة: العقائد، والفقه، والسلوك، وقد رأيت أن أردف بيان الاعتماد على السنة النبوية في هذه المجالات بالتأكيد على التزام الصحة فيها؛ لأن الإصلاح كما رأينا من قبل يشمل إضافة إلى تحكيم السنة الالتزام بصحيحها واجتناب ضعيفها.
المطلب الأول: مجال العقائد:
الفرع الأول: بناء العقائد على السنة النبوية:
اعتمد علماء الجمعية في إثبات العقائد على السنة النبوية كما اعتمدوا القرآن الكريم، ولا فرق عندهم في ذلك بين المتواتر والآحاد، ولا بين ما تعلق بالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، والعبرة في ذلك بصحة السند والمتن عند أهل الحديث، فكل ما صح عندهم فهو حجة؛ فإن أجمعوا عليه كان مفيدا للقطع، وما كان صحيحا عند بعضهم فقط فهو حجة في الظاهر وتستفاد منه العقائد كما تستفاد منه الأحكام، وليست مسائل الاعتقاد كلها في رتبة واحدة، كما أنه ليست كل مسائل الفقه والحلال والحرام في رتبة واحدة.
ومن نصوص ابن باديس التي تصب في هذا السياق قوله: «فعلى كل مؤمن أن يسلك هذا السلوك، فيحضر مجالس العلم التي تذكّره بآيات الله وأحاديث رسوله؛ ما يصحّح عقيدته ويزكي نفسه ويقوِّم عمله»([39]). وقرّر في مواضع أخرى أنه يوجد في السنة وحدها ما يطهِّر العقائد من الزيغ والفساد([40])، وأنه لا نجاة للأمة من التيه الذي تعيشه إلا بالرجوع إلى القرآن والسنة في بناء العقائد والأحكام والآداب([41]). فلم يفرق بين المجالات الثلاثة العقائد والفقه والآداب.
وكان بقية العلماء على نهجه، فالإبراهيمي يقول: إن الأصول الاعتقادية لا بد أن تدرس من القرآن والحديث([42]). وقال الشيخ العربي التبسي رحمه الله معرفا بدعوة الجمعية: إنها «تتلخص في دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم، والسير على منهاج سلفهم الصالح في أخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية والعملية»([43]). وقال مبينا أحق الناس بأن يؤخذ عنهم الدين بأنهم الذين إذا تكلموا على العقائد بينوها وبينوا مآخذها وأدلتها من الكتاب والسنة([44]). وقال الميلي في مقدمة رسالته: «ولا يحفظ التوحيدَ علمٌ كعلم الكتاب والسنة»([45]). وصرح الزواوي بنحوه، بل إنه زاد على ذلك البراءة من الانتماء إلى الأشعرية وغيرها([46]).
الفرع الثاني: التزام الصحة في باب العقائد:
مما هو متفق عليه بين العلماء التزام الصحة في أخبار الآحاد التي تعتمد في العقائد، وعدم قبول الأحاديث الضعيفة أو الأخبار الإسرائيلية فيها، بل إن المجددين المصلحين يرون أن من أسباب ذيوع كثير من الخرافات والبدع الاعتقادية بين عامة المسلمين التساهل في باب الرواية، حيث إن المتأخرين من المنتسبين للعلم لم يكن عندهم تمييز بين الصحيح والضعيف، ولا بين المقبول والمنكر الباطل، ولذلك فإنهم قد دعوا إلى التزام الصحة في العقيدة، وهذا الأمر جلي في منهج الشيخ ابن باديس وتصريحاته، حيث قال: «لا نعتمد في إثبات العقائد والأحكام على ما ينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث الضعيف؛ لأنه ليس لنا به علم»([47]). وقال في هذا المعنى أيضا: «أحوال ما بعد الموت كلها من الغيب؛ فلا نقول فيها إلا ما كان لنا به علم بما جاء في القرآن العظيم أو ثبت في الحديث الصحيح، وقد كثرت في تفاصيلها الأخبار من الروايات مما ليس بثابت، فلا يجوز الالتفات إلى شيء من ذلك»([48]).
وقد حذر ابن باديس من تحسين الظن بكل ما دوّنه العلماء في كتبهم على سبيل الرواية وقصد جمعِ ما ورد في الباب من غير التزام الصحة، فقال رحمه الله: «مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أولا: أنه لا يجوز الاعتماد على كل قول ينقل في كتب التفسير؛ لأن أكثرها لم يلتزم الاقتصار على الصحيح، بل قصدت إلى جمع كل ما قيل، خصوصا التفسير المشهور عند عامة وطننا وهو تفسير الشيخ محمد الخازن رحمه الله، فلقد جمع من الإسرائيليات فأوعى، فمن اعتمد ما فيه من ذلك واتخذه عقيدة ونسبه إلى الإسلام فقد أخطأ في عقيدته ونسبته خطأ كبيرا وضل ضلالا بعيدا»([49]).
وممن طبق هذا الالتزام في الاعتقاد على وجه الخصوص الشيخ مبارك الميلي الذي أظهر في رسالة (الشرك ومظاهره) عنايته الفائقة بعلم الحديث، ودرايته بمنهاج النقد؛ حيث نقد عددا لا بأس به من الأحاديث التي بنيت عليها عقائد فاسدة، وصحح أحاديث أخرى في سياق إثبات ما يجب على المسلم اعتقاده والعمل به([50]).
المطلب الثاني: مجال الفقه:
الفرع الأول: بناء الفقه على السنة النبوية:
تدعو أيضا الحركة الإصلاحية السلفية إلى بناء الفقه على أدلته وعلى رأسها السنة النبوية، وإلى عرضه مقرونا بتلك الأدلة لا مفصولا عنها، وخدمةً لهذا المقصد ألف ابن باديس كتابا ذكر فيه أدلة العبادات من الكتاب والسنة، أملاه على طلابه، وقد طبع باسم (أصول الفقه) بمعنى أدلته، وفي الجهة النظرية التأصيلية قد انتقد ابن باديس بدعة التقليد العام التي عزلت الأمة عن الكتاب والسنة، فقال: «كما أدخلت على مذهب أهل العلم بدعة التقليد العام الجامد التي أماتت الأفكار وحالت بين طلاب العلم وبين السنة والكتاب، وصيّرتها في زعم قوم غير محتاج إليهما من نهاية القرن الرابع إلى قيام الساعة، لا في فقه ولا استنباط ولا تشريع، استغناء عنهما -زعموا- بكتب الفروع من المتون والمختصرات، فأعرض الطلاب عن التفقه في الكتاب والسنة وكتب الأئمة، وصارت معانيها الظاهرة بَلْهَ الخفية مجهولة حتى عند كبار المتصدّرين »([51]). وتبعا لهذا التأصيل وهذا المبدأ انتقد ابن باديس مناهج تكوين العلماء في المعاهد التي تخلت عن تدريس كتب السنة شرحا ودراية([52])، كما أنه انتقد يوما على علماء الأزهر إصدارهم فتوى خالية من الاستدلال بالكتاب والسنة([53])، مما يبين بجلاء المنحى والاتجاه الذي سلكه ابن باديس رحمه الله في مجال الأحكام تفقّها وإفتاء.
ويتفق الإبراهيمي مع ابن باديس في هذا الأمر حيث يقول: «ولو أن فقهاءنا أخذوا الفقه من القرآن، ومن السنّة القولية والفعلية، ومن عمل السلف، أو من كتب العلماء المستقلّين المستدلين التي تقرن المسائل بأدلّتها، وتبيّن حكمة الشارع منها، لكان فقههم أكمل، وآثاره الحسنة في نفوسهم أظهر، ولكانت سلطتهم على المستفتين من العامة أمتن وأنفذ، ويدهم في تربيتهم وترويضهم على الاستقامة في الدين أعلى»([54]).
ويتفق مع الشيخين الشيخُ العربي التبسي رحمه الله الذي خاض حربًا ضروسًا على التعصب للمذاهب؛ فكان مما خطه بيمينه هذه الكلمات القوية التي قال فيها: «وقد رأينا هذا الزاعم يقول: إن الأخذ بظواهر أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعماله اجتهاد، والاجتهاد قد تقضت أيامه وماتت رجاله، وبذلك يجب على المسلمين أن يتركوا كلّ آية من الكتاب، وكل قول وعمل من رسول الله، ولا يهتدون بشيء من كتاب ربهم ولا من سنة نبيهم، وعليهم أن يقتصروا على ما كتب في الفروع، يحلون ما أحلت، ويحرمون ما حرمت، ويوالون من والت ما داموا غير مجتهدين. هذه هي مقالة هذا المفتي المزهدة في كتاب الله، الصادة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي باطلة بإجماع المسلمين من يوم أن بعث نبيهم إلى اليوم، ذلك أن العلماء والعوام يعملون بأقوال النبي وأعماله من غير توقف على وصولهم إلى رتبة الاجتهاد، وهذا أمر معلوم في الإسلام من عصر الصحابة إلى اليوم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»([55]).
وقال أيضا محذِّرا من رد السنن لمجرد مخالفتها للمذهب: «رد السنن النبوية قولية أو عملية بمجرد مخالفتها لمذهب من المذاهب محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم… وعصيان أيضا لوصايا أئمة الإسلام الثابتة عنهم بأصح أسانيد أصحابهم إليه، وفي مقدمة أولئك الأئمة مالك بن أنس رضي الله عنه الذي روى عنه أصحابه كمعن بن عيسى أنه كان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه… والله يشهد، وأولو العلم يشهدون أن مالكا بريء من كل نابذ لسنة عملية أو قولية بدعوى المتمذهب بمذهب مالك، أو أن كتب المالكية ليس فيها ما يصدق تلك السنة. وحاشا مالكا أن يقول: صدِّقوا ما يقوله ابن شاس في (الجواهر)، واكفروا بصحيح الحديث»([56]).
وقال الشيخ العربي التبسي: “ومن المدوَّن في علم العقائد والسنن أن ردَّ النصوص استهزاء بها أو إيثارا لغيرها عليها كفرٌ، ومن المذكور في علمي الفروع والخلافيات أن ترك السنن وتقليد الرجال بدعةٌ وضلالة، ومن المدوَّن أيضا أن السلف في القرون الثلاثة كانوا يقتدون بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن [أصحاب] المذاهب الإسلامية المعتبرة كانوا يتبعون الوارد، وخلافهم في مسائلهم تابع لما بأيديهم من السنن والآثار، وإذا ثبت الحديث فهو مذهب الجميع”([57]).
الفرع الثاني: التزام صحة الحديث في الفقه:
وكذلك الأمر في باب الأحكام والحلال والحرام، فالعلماء متفقون على التزام الصحة؛ رغم وقوع الخلاف في بعض شروط الصحة نظريا أو عند التطبيق والحكم على الحديث، وفي تقرير هذا الالتزام يقول ابن باديس رحمه الله: «فكل حديث صحيح أو حسن فإنه صالح للاستدلال به في الأحكام، وكل حديث ضعيف فإنه غير صالح لذلك»([58]). وبيَّن في موضع آخر أن التثبت المطلوب من صحة الحديث لا يستدعي أن يكون المتثبت محدثًا خالصًا، وأنه يكفيه الرجوع إلى أئمة الفن الموثوق بهم، فقال: «وخطتنا الأخذ بالثابت عند أهل النقل الموثوق بهم والاهتداء بفهم الأئمة المعتمد عليهم»([59]).
وفي هذا المضمار انتقد بعض علماء المغرب الذين قرضوا رسالة فيها أحاديث موضوعة، معزوة إلى دواوين السنة المشهورة وهي ليست فيها، وقد أرجع هذه الهفوة العظيمة إلى ضعف علماء عصره في علوم الحديث وإعراضهم عن كتب السنة، وعدم اطلاعهم على المشهور منها؛ حتى صاروا كحاطب ليل ينقلون الغث والسمين، لا يميزون بين المقبول والمردود([60]).
المطلب الثالث: مجال التزكية والأخلاق:
الفرع الأول: بناء التزكية والأخلاق على السنة النبوية:
ثالث مجالات الإصلاح السلوكُ الذي يجتمع فيه تزكية النفوس في الباطن والتزام الأخلاق الحسنة في الظاهر، والذي اصطلح المتأخرون في عصور الانحطاط على تسميته تصوّفًا، وقد نص ابن باديس على لزوم بناء السلوك أو التصوف على الكتاب والسنة، فقال رحمه الله: «فكنا نجيب بأن ما كان من باب تزكية النفس وتقويم الأخلاق والتحقيق بالعبادة والإخلاص فيها فهو التصوف المقبول، وكلام أئمته فيه ككلام سائر أئمة الإسلام في علوم الإسلام؛ لا بد من بنائه على الدلائل الصحيحة من الكتاب والسنة، ولا بد من الرجوع عند التنازع فيه إليهما، وكنت أذكر ما يوافق هذا من كلام أئمة الزهد المتقدمين كالجنيد وأضرابه»([61]). وقد بين وهو يتحدث عن أفضل الذكر أن في الثابت من الأذكار ما يغني عما أحدثه أهل الطرق من أوراد([62]). ومعلوم أنَّ من أُسُس بدعة الطرق تحديد الأذكار المخترعة وتوقيتها بأوقات وأعداد معينة وإلزام أتباع الطريقة بها، والشيخ قد أبطل هذا الأساس إذ أعلن أن في المروي عن النبي r من الأذكار ما يغني ويكفي عما سواه.
وقال العربي التبسي في ذات السياق: «الأدلة التي تثبت بها الأحكام والأخلاق الدينية الكتاب إجماعا والسنة الصحيحة كذلك»([63]). فعطف الأخلاق على الأحكام، وكلامه كان في إبطال بدع الطرقية ومنها تحديد الأذكار للأتباع، وفي كلام ابن باديس جعل السنة حكما على كلام أهل التصوف وميزانا يميز به بين المقبول والمردود، وقد كان لأبي يعلى الزواوي وجهة نظر أخرى حيث قرر أن التصوف أشدُّ ضلالا من علم الكلام، وقدّر إمكانية ضبط علم الكلام بالكتاب والسنة وعقيدة السلف، ثم قال: «وقد يقال: إن التصوف ينبغي له أن يكون كذلك أي: مضبوطا بالكتاب والسنة وعقيدة السلف، ولكن هيهات هيهات!»([64]). وهذا الاستبعاد مفاده التخلي عن كلام أهله جملة وتفصيلا، والاستغناء عنه بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة. والشيخان في النهاية متفقان على تحكيم السنة في التزكية والأخلاق.
الفرع الثاني: التزام الصحة في إثبات العبادات:
وشأن قضايا السلوك لا يختلف عن غيره من أبواب الدين، فلا يجوز إثبات أي عبادة من العبادات إلا بما كان ثابتا عن الرسول صحيحا أو حسنا عند أهل الحديث، قال ابن باديس منبها إلى أنه لا يجوز أن يُعتمد كل ما جاء في كتاب (حلية الأولياء) اغترارا بكون مصنفه محدثا وأن موضوعه السلوك والفضائل، فقال رحمه الله: «ذكرنا هذا الحديث الموضوع الذي رواه أبو نعيم في كتابه (حلية الأولياء) لننبه على وضعه ونحذر قراء الحلية -وقد طبعت منها أجزاء- من الاعتماد على كل ما فيها، فإن كثيرا من المنتسبين إلى العلم يغترون باسم الكتاب واسم مؤلفه، فيتناولون كل ما فيه من الأحاديث بالقبول والتسليم؛ كأنه ثابت صحيح مع أننا نجد فيه هذا الحديث الموضوع الذي قال فيه ابن الجوزي ما قال»([65]).
وقال رحمه الله في موضع آخر تحت عنوان: (تحذير): «يجري على الألسنة ما رواه الطبراني في (الأوسط) عن عائشة مرفوعا: “لا تنزلوهن الغرف، ولا تعلمونهن الكتابة، وعلموهن الغزل وسورة النور”، قال الشوكاني: في سنده محمد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني: كذاب. وكثيرا ما تكون هذه الأخبار الدائرة على الألسنة باطلة في نفسها، معارضة لما صح في غيرها، فيجب الحذر منها»([66]).
وقضية التحذير من اعتماد كل ما يروى وكل ما هو متداول في الكتب والألسنة أمر متكرر في كتابات الشيخ رحمه الله؛ ما يدلنا على شدة اعتنائه به وعلى أنه كان مَظهرا من مظاهر التجديد التي تميز بها، والشيخ رحمه الله لا يقول للناس: كونوا محدثين، ولكن كان يقول لهم: عليكم أن تتبيّنوا بالرجوع إلى أهل الاختصاص، وإلى الكتب المصنفة في نقد الأحاديث وفي التصحيح والتعليل، وقد حمَّل أهلَ العلم والخطباء مسؤوليةَ انتشار الأحاديث الموضوعة في الأمة فقال: «ومصيبة بعض المتّسمين بالعلم والقائمين بالخطب الجُمعية في هذا أشدّ وأضر؛ لتعديها منهم إلى غيرهم ونشرهم الموضوعات الكثيرة في الناس… والكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم، والتحري فيما دونه واجب، فكيف به؟!»([67]). فالتحري فيما ينقل عن الفقهاء مثلا واجب رغم أن اجتهادهم يحتمل الصواب والخطأ، فكيف بما بنقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي جاء الوعيد الشديد في حق من كذب عليه متعمدا، وأُلحق به من حدَّث عنه بحديث يُرى أنه كذب؟!
ومما ينبغي التذكير به في هذا الموضع أن التساهل في الفضائل والترغيب والترهيب الذي أجازه كثير من العلماء من السلف والخلف لا يتنافى مع ما ذكرنا؛ لأن الجواز عندهم مقيد بعدم تشريع عبادة جديدة كما هو مشروط بأن لا يكون الضعف شديدًا، وكثير من المتأخرين قد أهمل القيد وتخطّى الشرط فوقع في المحظور المحذور، وابن باديس رحمه الله كان ممن يرى جواز رواية الضعيف في هذا الباب، ولم يهمل أن ينبّه إلى ضوابط ذلك التي أشرنا إليها فقال: «فإذا كان الحكم ثابتا بالحديث الصحيح مثل قيام الليل، ثم وجدنا حديثا في فضل قيام الليل بذكر ثواب عليه مما يرغب فيه؛ جاز عند الأكثرين أن نذكره مع التنبيه على ضعفه الذي لم يكن شديدًا على وجه الترغيب، ولو لم يكن الحكم قد ثبت لما جاز الالتفات إليه، وهذا هو معنى قولهم: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، أي: في ذكر فضائلها المرغبة فيها لا في أصل ثبوتها. فما لم يثبت بالدليل الصحيح في نفسه لا يثبت بما جاء من الحديث الضعيف في ذكر فضائله باتفاق أهل العلم أجمعين»([68]).
فتأمل نقله للاتفاق على أن ما لم يكن ثابتا أصله في الشرع لم يجز أن يروى في فضله حديث، وقبله اشتراطه أن الضعف ينبغي أن لا يكون شديدا. وقد أكد ما رآه عمليا حينما كتب في تضعيف حديث قراءة يس على الأموات الذي يزعم كثير من الناس جهلا أنه وارد في فضائل الأعمال([69]).
وللإبراهيمي عبارة توهم جنوحه إلى رأي المانعين من اعتماد الضعيف بإطلاق حيث قال: “وقد تساهل كثير من المفسرين في حشر هذا السبب في تفسيرهما، وفي حشر كثير مما لم يصح في فضائلهما، ولنا فيما صح غنية عما لم يصح”([70]). فهذه الجملة الأخيرة منقولة عن ابن المبارك، وهي عمدة الجانحين إلى منع الاحتجاج بالضعيف ولو في الفضائل سدا للذريعة، وحسما لمادة نشر الضعيف جدًّا والموضوع.
وقد ورد إلى أبي يعلى الزواوي سؤال عن حكم التوسعة على العيال في عاشوراء، فأفتى بما هو مدون في الكتب الفقهية المتداولة وهو الجواز، فرد عليه الشيخ عمر بن البسكري([71]) بجواب نقل فيه تضعيف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب للأحاديث المروية في فضل عاشوراء -غير الصوم- بما فيها فضل توسعة النفقة على العيال فيه، فكتب الشيخ أبو يعلى جوابًا على هذا الرد أقرّ فيه بوجوب التحرّي في الاستدلال بالحديث حتى لا يقع المرء في الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتذر بأن الأمر فيه صعوبة؛ لأن كتب الفقهاء قد مُلئت بما لا يصحّ من الحديث([72]). وكتب مرة معتذرا بقوله: «إني لست من علماء الحديث، ولكني كاتب متفقّه متبصّر»([73]). والمعنى أنه لا غرابة أن يقع في الغفلة في هذا الباب تقليدًا لغيره. ومما نستفيده من هذا الحوار الذي جرى أن التزام الصحة كان أمرًا متفقًا عليه، وأن ذلك لا ينفي وقوع الخطأ من العلماء؛ كما لا ينفي الاختلاف بينهم في التصحيح والتضعيف.
المبحث الثالث: الدرس الحديثي عند جمعية العلماء منهجُه وأثره في الواقع الجزائري:
بعد أن بينا شمول اعتماد السنة في جميع مجالات الإصلاح الثلاثة ننتقل إلى الحديث عن كيفية توظيف السنة أو المظاهر العملية لهذا التوظيف، ثم بيان منهجية الشرح من خلال (مجالس التذكير) لابن باديس، ونختم البحث بمحاولة الكشف عن أثر اهتمام جمعية العلماء بالسنة النبوية في الواقع الجزائري.
المطلب الأول: مظاهر توظيف السنة النبوية:
تتلخّص مظاهر التوظيف السنة النبوية في الدروس المسجدية الخاصة والعامة، ومحاضرات الرحلات الدعوية، والكتابة في الصحف، وأيضا في المؤلفات، وبيان ذلك يأتي في الفروع الآتية.
الفرع الأول: الدروس المسجدية الخاصة والعامة:
فأما أصول الحديث فقد ثبت أن الشيخ ابن باديس كان يدرّس في أصول الحديث مقررًا خاصًّا به أملاه على طلابه، وقد طبع بعناية الدكتور عمار طالبي، وكذلك الإبراهيمي كان يدرس (البيقونية) في دار الحديث([74]).
وأما شرح الحديث فوجدنا في المواد المقررة في الجامع الأخضر بقسنطينة مادة الحديث الشريف، والمقرر فيها هو (موطأ الإمام مالك)([75])، ومما هو مشهور في التاريخ أن الإمام ابن باديس كان يدرّسه بعد صلاة الصبح، وأنه قد ختمه، وقد نُشر موضوعُ آخِرِ درسٍ له في الشهاب في غرة رجب 1348هـ – أوت 1939م([76]). وذكر الشيخ أحمد حماني رحمه الله أنه حضر لابن باديس درسًا في الحديث تحت عنوان: “من جوامع الكلم النبوي”، وكان له مجلس سرد الحديث دون شرح أو تعليق من كتاب (الترغيب والترهيب) للمنذري([77])، وذكر بعضهم أنه كان يضيف إلى دروسه المألوفة التي تبلغ أحيانا ثلاثة عشر درسا في شهر رمضان درسًا في شرح (صحيح البخاري) قبيل صلاة الظهر([78]).
وكذلك قرينه الإبراهيمي كان يشرح (الموطأ) في درس عام بعد صلاة الصبح في دار الحديث([79])، وجاء في أحد أعداد البصائر هذه العبارة: “وفي هذه المدرسة ختم -حفظه الله- (صحيح مسلم) دراية”([80]).
وذكر الميلي أن من الكتب التي كانت تدرس في مجال الأخلاق كتاب (الشمائل المحمدية) للترمذي([81])، وقد كان درسه المفضَّل هو درس التفسير، ولكن كان يتخلّل ذلك دروس في (الموطأ) أو (رياض الصالحين)([82]). ومما ورد في سيرة العربي التبسي أنه كان له درس دائم في بعد صلاة العشاء يختار له موضوعا يطرقه في ظل آية قرآنية أو حديث نبوي، وكذلك الأمر في ليالي رمضان، إلا أنه فيه يلتزم المناوبة بين التفسير وشرح الحديث يوما بيوم([83]).
وحكى الشيخ حمزة بو كوشة([84]) -وهو عالم زيتوني من تلاميذ ابن باديس- أنه شرح (الأربعين النووية) في الجامع الجديد بالعاصمة عام 1930م([85]).
الفرع الثاني: محاضرات الرحلات الدعوية:
مما هو ملحق بالدروس تلك المحاضرات التي كانت تلقى في الرحلات الدعوية، وقد ألقيتُ نظرة في بعض أخبار تلك الرحلات، فوجدت من نقل عن ابن باديس شرحه لحديث «من رأى منكم منكرا» في رحلته إلى مدينة قنزات([86]). وعن الشيخ العربي التبسي شرحه لحديث «الدين النصيحة»، وحديث «من أحدث في أمرنا هذا» في رحلة قادته إلى وادي سوف، وحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» في مدينة بسكرة، وعن الميلي شرحه لحديث «قل آمنتُ بالله ثم استقم» في وادي سوف، وحديث «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» في القنطرة([87])، وقد حكى الميلي عن نفسه أنه كان يشرح الأحاديث في رحلاته الدعوية([88])، فكأنه كان ملتزمًا بذلك.
الفرع الثالث: الكتابة في الصحف:
المظهر الثالث من مظاهر التوظيف الكتابة في الصحف، وندلّل عليه بما قاله الشيخ ابن باديس عن جريدة السنة المحمدية: «فأخذنا على أنفسنا دعوة الناس إلى السنة النبوية المحمدية وتخصيصها بالتقدم والأحجية، فكانت دعوتنا -علِم الله- من أول يوم إليها، والحث على التمسك والرجوع إليها، ونحن اليوم على ما كنا سائرون، وإلى الغاية التي سعينا إليها قاصدون، وقد زدنا من فضل الله أن أسّسنا هذه الصحيفة الزكية، وأسميناها (السنة النبوية المحمدية) لتنشر على الناس ما كان عليه النبي r في سيرته العظمى وسلوكه القويم وهديه العظيم، الذي كان مثالا ناطقا لهدي القرآن، وتطبيقا لكل ما دعا القرآن إليه بالأقوال والأفعال والأحوال، مما هو المثل الأعلى في الكمال، والحجة الكبرى عند جميع أهل الإسلام، فالأئمة كلهم يرجعون إليها، والمذاهب كلها تنطوي تحت لوائها وتستنير بضوئها»([89]).
وقد عالج ابن باديس عدّة قضايا عقدية من خلال شرح الأحاديث النبوية في صفحات الشهاب، ومنها: النهي عن قول: ما شاء الله وشئت، الذي تطرق فيه لألفاظ شركية كثيرة شائعة بين الناس، وقال في آخر شرحه: “على من عرف هذا الحديث النبوي أن يعمل به في نفسه، وأن ينشره بين الناس، وأن يعالجهم به بتفهيمهم فيه وتحذيرهم من مغبّة مخالفته والإصرار على معاندته، ولأَن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم”([90]). ومن تلك القضايا: قضية بناء المساجد على القبور، وقال في آخر شرحه لحديث الباب: “ومن أعظم الإنكار تبليغ الحديث بنصّه، وتذكير الناس به، والعمل على نشره حتى يصير معروفا عند عامة الناس وخاصتهم، إذ لا دواء للبدع الشيطانية إلا نشر السنة النبوية، ولا نستعظم انتشار هذه البدعة وكثرة ناصريها، فإنها ما انتشرت وكثر أهلها إلا بالسكوت عن هذا الحديث والجهل به”([91]). ومنها أيضا: قضية تنزيل الصالحين منازل لا يعلمها إلا الله، التي تطرق لها في ظل حديث النهي عن الجزم لأحد بأنه في الجنة، وقال في شرحه: “مهما أعدنا القول في هذا، فإننا لن نفيه حقَّه من الإنكار والاستئصال؛ لما نعلمه من رسوخ هذه الضلالة وقدمها، والتهاون فيها، وعظيم التجرّي عليها، وهذا الحديث النبوي هو دواؤها القاطع لها، فليتأمله قرّاؤنا ولينشروه في المسلمين، وليذيعوه بالتلاوة والتفسير والتأكيد والتقرير، عسى أن يشفي الله به القلوب من داء الغلو والادعاء والغرور والتغرير”([92]). ومنها: قضية دعاء غير الله تعالى، وهي من أهم القضايا العقدية، عرض فيها حديث الترمذي عن ابن عباس الذي فيه «إذا سألت فاسأل الله»، وقال: “وكثير من الناس يسألون ممن يعظمون نفس العطاء وخصوصًا من الأموات رحمهم الله في قبورهم، فأرشدهم بمثل ما سمعت، وحذار أن تكون منهم”([93]).
ومما نلحظه أيضا في بعض فتاوي الشيخ العربي التبسي استهلالها بذكر الأحاديث النبوية؛ كفتوى صلاة الناس في طابق والإمام في طابق أعلى، حيث ذكر حديثين اثنين وما يستفاد منهما قبل أن يعرج على ذكر أقوال الفقهاء([94]).
الفرع الرابع: المؤلفات:
والمظهر الرابع لتوظيف السنة هو المؤلفات، ومؤلفات علماء الجزائر في الحقبة الاستعمارية قلية جدا؛ لأنّ جلّ اهتمامهم كان منصبًّا في تأليف الرجال، وذلك القليل كان له ميزاته التي تميز بها؛ سواء من جهة الشكل أو المضمون. ومن الميزات المتعلقة بالمضمون والمحتوى ما هو متعلق بالسنة النبوية.
فالشيخ ابن باديس كتب على صفحات (الشهاب) سلسلة بعنوان: (مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير)، وبمجموعها أُخرج تفسيره المشهور بـ(تفسير ابن باديس)، وقد تضمن 206 حديث نبوي، استشهد بها في 224 موضع. وذلك حسب الفهرس الذي أعده محققه أبو عبد الرحمن محمود([95]).
وكتب أيضا (مجالس التذكير من كلام البشير النذير)، وقد وظف في شرح أحاديثه 117 حديث.
وألف أيضا (العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية) الذي أملاه على الطلاب، وطبع من نُسخهم، وقد استشهد فيه بـ 35 حديثا نبويّا صحيحًا.
وأملى في أصول الفقه (مبادئ الأصول)، وقد طبع منذ عقود، وفيه 22 حديثا، وهذه الإحصاءات الخاصة بالكتب الثلاثة الأخيرة هي للباحث يونس بوحمادو([96]).
وذكرنا من قبل إملاء آخر في آيات وأحاديث الأحكام في باب العبادات، طبع أول مرة باسم (أصول الفقه)، وقد تضمن 119 حديث([97]).
ومن إملاءات ابن باديس إملاء في علوم الحديث([98]).
وأما الشيخ مبارك الميلي فقد ألف رسالة (الشرك ومظاهره)، وقد بناها على دلائل الكتاب والسنة، فذكر فيها 239 حديث وأثر، في 246 موضع، حسب فهرس أبي عبد الرحمن محمود، وأكثرها وارد في مقام الاستدلال والاستشهاد، وقليل منها ذكره ليبين ضعفه.
وهذه الإحصاءات تبين حضور مادة كثيفة من الأحاديث النبوية في هذه المؤلفات، الأمر الذي يبين مدى الاعتناء الفعليّ بالسنة وبتحكيمها في القضايا الشرعية العقدية وغيرها.
المطلب الثاني: منهجية شرح الحديث:
مما أحببتُ الوقوف عنده في هذا البحث منهجية شرح الأحاديث عند علماء الجمعية، لأن قصد العلماء من شرح الحديث هو توظيفه في معركة الإصلاح، ولا شك أن من كان قصده كذلك تكون له ميزات منهجية في الشرح، ولكننا لا يمكننا الحديث عن هذا الأمر إلا من خلال (مجالس التذكير) لابن باديس؛ لأنه الوثيقة الوحيدة التي تعدّدت فيها الأحاديث المشروحة وفق منهجية واضحة، وما دام الشيخ ابن باديس هو ملهِم غيره من أبناء الحركة الإصلاحية في الجزائر وقدوتهم في منهج الإصلاح والتدريس، فإنه يمكننا أن نعمم هذه المنهجية لبقية العلماء والمدرسين المنتمين للجمعية.
وفي هذا المضمار نقول: إن ابن باديس قد اعتمد في شرح الحديث -ومثله في التفسير- منهجية فريدة من جهة الشكل، حيث كان يضع للحديث المشروح عنوانا كبيرًا يضمنه الغاية من التعرض له، ثم يحرص على وضع عناوين جزئية أثناء الشرح تبرز المحتوى وتجلب القارئ من جهة، وترتّب وتقرّب له الأفكار من جهة أخرى، وتجعل الشارح أيضا يسير على خطة واضحة.
ومما يلاحظ أيضا اهتمام ابن باديس بالعزو ودقته، ولا سيما عندما ينقل الحديث من مصدره مباشرة وعندما تختلف ألفاظه، واهتمامه ببيان درجته إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما، وذلك باعتماد علماء الفن وعلى رأسهم الترمذي صاحب (السنن)، وهذا الأمر لم يكن مقصودا لذاته، ولكنه لا يخلو من تعليم للقارئ منهجَ التثبت في نقل السنة النبوية: التثبت من وجود الحديث في المصدر ومن لفظه فيه، ثم التثبت من صحته حتى يكون صالحا لبناء الأحكام عليه.
وإذا رجعنا إلى تلك العناوين الجزئية فإننا نلحظ كثرتها؛ حيث إنه في شرحه لـ 55 حديثا وظف نحو 212 عنوان فرعيّ دون عد العناوين الرئيسة([99]). وقد قسمها أحد الباحثين إلى عشرة أجناس هي كالآتي:
العناوين التمهيدية: ويتعرّض فيها للتخريج والأسانيد والألفاظ نحو: تمهيد، السند، سبب الورود، ألفاظ المتن، رتبة الحديث.
العناوين اللغوية: ويتعرّض فيها للمفردات والتركيب نحو: المفردات، الكلمات، التراكيب، العربية، اللغة.
العناوين التحليلية: ويتعرض فيها لشرح الأحاديث واستنباط أحكامها، نحو: المعنى، الشرح، البيان، الفوائد، الأحكام، فقه الحديث.
العناوين الإرشادية الوعظية: نحو: الاقتداء، الأسوة، إرشاد، ترغيب، الموعظة، امتثال، اهتداء، العلاج.
العناوين التحذيرية الترهيبية: نحو: تحذير، إرشاد وتحذير، ترهيب، تنبيه وتحذير.
العناوين الترجيحية التحقيقية: نحو: تفرقة، تمييز، تفريع، توجيه وتعليل، نفي التعارض، تقييد وتعميم، دفع شبهة.
العناوين الاستنباطية: نحو: تأييد، تصديق، استدلال، استشهاد.
العناوين السلوكية التربوية: نحو: الآداب، تربية، سلوك.
العناويين الاحتجاجية الإنكارية: نحو: بيت عقيدة وإبطال ادعاء، ليس الخبز كل ما نريد، الرد على المتشدّدين.
العناوين الختامية: نحو: تطبيق، استنتاج، تحصيل، العمل بالحديث([100]).
وبين بعضها تداخل كما لا يخفى؛ ولذلك لما عاد لذكر مراحل الدراسة جعل الأجناس الثمانية الأخيرة في ثلاث مراحل فقط، وهي: مرحلة التحليل وتجلية المعنى، ومرحلة استنباط الأحكام والفوائد، ومرحلة التطبيق والإسقاط على الواقع([101])، فيكون المجموع ثلاث مراحل بإضافة المرحلة التمهيدية ومرحلة الدراسة اللغوية.
وكل قارئ للكتاب يظهر له أن المقصد الأول من تناول هذه الأحاديث هو المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التطبيق والإسقاط على الواقع الذي تنبّه عليه العناوين الرئيسية، وفي هذا يقول شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد الله: «فهو يتناول الحديث ليستنتج منه نتائج وعبرا حول الحاضر والظروف السياسية والثقافية التي يعيشها العالم الإسلامي والجزائر»([102]). وقد تنوّعت القضايا التي عالجها، فكان منها قضايا دينية متعلقة بالعقيدة على وجه الخصوص، وقد سبق في البحث الإشارة إلى نماذج منها، وكان منها قضايا اجتماعية وتربوية وأخلاقية، وكان منها قضايا تدرج ضمن القضايا السياسية كالحديث عن ضرورة الاتحاد وعن الجهاد للتحرر ونحو ذلك([103]).
المطلب الثالث: أثر اهتمام الجمعية بالسنة النبوية في الواقع:
إن هذا الاهتمامَ الواضح بالسنة النبوية في دعوة جمعية العلماء قد أثمر ثماره في وقت مبكر حيث أدركه العلماء المؤسّسون للجمعية، بعد أن قضوا في الدعوة والتعليم عِقدين من الزمن، وممن شهد بتحقق تلك الآثار الشيخ الإبراهيمي الذي أطال الله عمره وكثرت كتاباته، كما شهد ببعضها أيضا الشيخ مبارك الميلي رحمه الله، وفيما يأتي شرح لتلك الآثار تحت العناوين الآتية:
الفرع الأول: رجوع الأمة إلى السنة علما وعملا:
أول أثر لهذه الجهود التي بذلت هو رجوع الأمة إلى السنة علمًا وعملًا، وقد ظهرت بوادر ذلك في عهد مبكر، وممن شهدوا ذلك ودوّنوه الشيخ الإبراهيمي حيث يقول: «وأفلحت الجمعية في تبيين السنّة النبوية المحمدية معنى ومفهومًا، وحمل الأمة على الرجوع إليها علمًا وعملًا، والتمسّك بالصحيح الثابت منها فعلًا وتركًا، والاهتداء بهدي السلف الذين هم نقلتها وتراجمتها والمؤتمنون على فهمها، والعاملون بها والواقفون عند حدودها، والناشرون لدقائقها والناصرون لحقائقها والمبلغوها سهلة سمحة إلى الأمم»([104]). وفي كلامه أن الثمرة كانت مضاعفة تضمّنت الرجوع إلى السنة وإلى التقيد في فهمها بفهم سلف الأمة أيضا.
الفرع الثاني: رواج كتب الحديث بين الناس وانتعاش رواية الحديث:
من آثار انتشار دروس الحديث النبوي في ربوع الجزائر الواسعة: رواج كتب السنة التي كانت تطبع في ذلك، ولا سيما ما كان معتمدا في التدريس أو كثر الاستشهاد به أو الإشادة به، وكذلك انتعاش مجالس رواية الحديث، وفي وصف هذه الحال يقول الإبراهيمي: «ومن بركات جمعية العلماء على هذا القطر أن أمهات التفسير الموثوق بها وكتب الحديث الصحيحة راجت بين الناس، وعمرت الخزائن، واكتسحت تلك الكتبَ التي ضللت الناس وقتلت مشاعرهم، وأن الأحاديث الصحيحة بدأت تتداول على الألسنة، وتتناول في المجالس، وترصّع أحاديث الناس في مواطن الاستدلال، وأن رواية الحديث بدأت تنتعش»([105]). وهذا الرواج كان على حساب كتب أخرى كانت رائجة من قبل، كان لها أثر في تحريف منهج التفكير وفي نشر الخرافة والأضاليل.
الفرع الثالث: شيوع النزعة الاستدلالية:
ومن أهم آثار اهتمام العلماء بنشر الحديث: شيوع “النزعة الاستدلالية” التي لم تعد قاصرة على طبقة طلبة العلم، بل تعدت إلى طبقات أدنى، وفي هذا يقول الإبراهيمي رحمه الله: «فأصبحت نفوسهم نزاعة إلى طلب الدليل في أمور دينهم، وأصبحت أبصارهم تخشع وأعناقهم تخضع إذا أقيم لهم دليل من آية قرآنية أو حديث نبوي؛ ممن يعتقدون أمانته وصدقه»، وقد بين أن هذه النزعة عرفتهم بقيمة الدليل، وأنها صارت حاجزا في طريق ما اعتاد إلقاء الباطل فيقبل منه دون تبين أو نقاش، فقال: «وكم ألقموا المبطلين حجرًا وأغصوهم بِرِيقِهِمْ حينما يلقون إليهم بباطلهم فيقولون لهم: وأين الدليل؟ وما أثقلها من كلمة على نفوس ألفت التسليم وقادت الأمة بزمامه»([106]). ولا شكّ أن شيوع النزعة الاستدلالية تسلب العصمة من الشخص المستدلّ إلى النص المستدَلّ به، وكفى بهذا هداية للناس، فالعالم لا يُتَّبع كلامُه لذاته، ولكن لما يحمله من حجَج وأدلة على ذلك الكلام.
الفرع الرابع: تغيير بعض برامج التدريس بالنسبة للعامة:
ومن الآثار التي شوهدت في وقت مبكر أيضًا تغيير برامج التدريس، ولا سيما في الدروس المخصّصة للعامة، وممن شهد على هذا التغيير الشيخ الميلي (ت 1945م) إذ يقول: «فأما العامة فكانوا يحضرون للمسجد إما لطلب الاعتقادات من كتب الكلام أمثال (صغرى السنوسي)، وإما لمعرفة العبادات من كتب الفقه كابن عاشر وخليل، وفي هذا الدور أصبحوا يحضرون لمعرفة الاعتقادات من آيات الله تعالى، ولمعرفة العبادات من كتب السنة كـ(الموطأ)، ولمعرفة الشمائل من (شمائل الترمذي) أو (الشفا)، ولسماع العظات من القرآن والحديث… والتعليم المسجدي ليس بجديد، وإنما الجديد فيه دراسة الكتاب والسنة وتوجيه العامة إليهما في اعتقاداتها وعباداتها وسلوكها»([107]). وهكذا تمت إزالة كتب علم الكلام من طريق العامة، وكذلك لما انتشرت (العقائد الإسلامية) لابن باديس وصارت مقررا فقد أزاحت أيضا كتاب (أم البراهين) من برامج الطلاب وحلَّت محله، وقد قال الإبراهيمي في تقريظه: «وهذا درس من دروسه ينشره اليوم في أصل العقيدة الإسلامية بدلائلها من الكتاب والسنة تلميذه الصالح كاسمه محمد الصالح رمضان، فجاءت عقيدة مثلى يتعلمها الطالب فيأتي منه مسلم سلفيّ، موحّد لربه بدلائل القرآن كأحسن ما يكون المسلم السلفيّ، ويستدل على ما يعتقد في ربه بآية من كلام ربه، لا بقول السنوسي في (عقيدته الصغرى)، أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم!»([108]). وقد ذكر في هذا التقريظ أن ابن باديس قد أحيا طريقة السلف، وأن جمعية العلماء سارت على نهجه بعده([109]).
وبالنسبة للفقه فقد صار البرنامج المقرر للعامة هو (موطأ الإمام مالك)، كما ذكر الميلي وعمل به ابن باديس والإبراهيمي وغيرهما، وبالنسبة للطلاب فقد ذكر الميلي أن العلماء وإن لم يغيروا المتون فقد اجتهدوا في تغيير طريقة الشرح، ومن ذلك تقديمهم لشرح المسائل قبل أن يعودوا لذكر المتن وتفكيك عبارته. ومما يدل على بذل الجهد حتى في جانب تكوين الطلاب ذلك الإملاء المتعلق بآيات وأحاديث الأحكام، وإن كان لم ينتشر انتشار العقائد في ذلك الوقت، وقد قال ابن باديس وهو يتحدث عن إصلاح التعليم في جامع الزيتونة: «وأما فرع القضاء والفتوى من قسم التخصص فيتوسع لهم في فقه المذهب، ثم في الفقه العام، وتكون (بداية المجتهد) من الكتب التي يدرسونها، ويدرسون آيات وأحاديث الأحكام، ويدرسون علم التوثيق، ويتوسعون في علم الفرائض والحساب، ويطلعون على مدارك المذاهب حتى يكونوا فقهاء إسلاميين، ينظرون إلى الدنيا من مرآة الإسلام الواسعة، لا من عين المذهب الضيقة»([110]).
الفرع الخامس: تأثر الطرقية والإباضية بالدعوة الإصلاحية:
ومن الآثار التي تجلت نتيجة اهتمام جمعية العلماء بدرس الحديث النبوي تأثّر غيرهم ممن عُرفوا من قبل بهجر السنة ومعاداة أهلها، ومنهم الإباضية والطرقية، فأما الإباضية فتجلى ذلك في فئة منهم قبلت الانضمام إلى جمعية العلماء فتأثرت بدعوتها، وكان من أعلامهم الشيخ إبراهيم بيوض([111]) الذي قاد حركة إصلاحية واسعة في صفوف الإباضية، حيث تخلى أتباعه عن قضية التكفير للمخالفين، وصاروا يصلون خلف أهل السنة، كما أوجب عليهم الترضي على جميع الصحابة رضي الله عنهم والتخلّي عن التفصيل المدون في كتبهم الكلامية، وقد وجدته يعتمد في تفسيره على أحاديث البخاري ومسلم، والإباضية لا يعتمدون عليها.
وقد نُقل عنه شروعه في شرح صحيح البخاري في المسجد الكبير بالقرارة سنة 1931م، وهي السنة التي تأسّست فيها جمعية العلماء، وقد ختمه سنة 1945م، وكان من أهم مراجعه (فتح الباري) لابن حجر([112]).
وأما الطرقية فقد رجع بعضهم إلى قراءة كتب السنة قراءةَ شرح لا تبرُّك، وقد شهد بذلك الشيخ محمد البشير الإبراهيمي فقال وهو يصف هذا التحول: «وأما السنة فلم يبقَ لها أثر إلا في المجلدات -على قلّتها- عند من يقرؤها على سبيل التبرك، ولقد أدركنا من هؤلاء مَن إذا دخل “الطبّالون” داره لمناسبة: كانت “النوبة” الأولى على (صحيح البخاري) بعد وضعه على كرسي، وقيام “المعلمين” وقوفًا إجلالًا لما بين أيديهم، وكأنهم وضعوا لهذا الغرض “نوبة” يتفنّنون في تأديتها بغير المعتاد… أما اليوم وقد عمّت الدعوة القطر كلَّه، وكان حظ تلمسان منها كبيرًا بسبب مَن اختاره الله لها، فقد كثرت دروس التفسير وكتب السنّة حتى من إخواننا الطرقيّين الذين كانوا في غفلة عنهما، مشتغلين بخلواتهم وجلواتهم، وكأنهم شعروا بضعف ما في أيديهم، فاغتنموها فرصة أضافوها إلى مذهبهم»([113]).
ولا شكّ أن بغية المصلحين ردّ الضالين عن ضلالهم إلى السنة المحضَة، فإن لم يمكن ذلك فأقلّ ما يرجونه من دعوتهم التقليل من بدعهم أو جعلهم يسكتون عن الدعاية إليها.
الخاتمة:
انطلقنا في هذا البحث من حقيقة معلومة لدى المدرسة الإصلاحية السلفية، وهي الاعتماد على السنة النبوية في خطابها باعتبارها مصدرًا من مصادر الشرع الحكيم، وجعلها في الوقت نفسه غاية يدعى إليها باعتبارها المنهاج النبوي الذي ينبغي التزامه والسير على وفقه، وتعمقنا في الكشف عن أمور تاريخية وتأصيلية مرتبطة بدعوة جمعية العلماء من خلال التساؤل عن مدى شمول بناء مجالات الإصلاح الثلاثة على السنة والنبوية، وهي مجالات العقيدة والفقه والسلوك، والتساؤل أيضا عن مظاهر توظيفهم للسنة النبوية، وكذا عن آثار هذا الاهتمام بها في الواقع، مع مقدمات كان من الضروري التمهيد بها قبل الإجابة عن تلك التساؤلات، وفي نهاية هذا البحث نسجل أهم النتائج المتوصل إليها:
1- اتفقت كلمة علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على أهمية السنة النبوية، وأنه ينبغي دعوة الناس إلى الالتزام بها، وعلى ضرورة توظيفها في الخطاب الدعوي عبر كل الوسائل التي كانت متاحة في عصرهم.
2- كان علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على أتم استعداد لنشر السنة النبوية والدعوة إليها؛ حيث ظهر لنا أن تكوينهم في المعاهد التي تخرجوا منها قد تضمن مواد مهمة متعلقة بالسنة النبوية رواية ودراية، وذلك بعد تطوير المناهج في الأزهر وجامعة الزيتونة وحلقات المسجد النبوي، إثر شيوع الفكر الإصلاحي وانبعاث دعوات التجديد في العصر الحديث.
3- ظهر لنا أن كتب السنة كانت في متناول علماء الجمعية على اختلاف فنونها من مصادر وشروح وكتب النقد، وأكثرها كان من ثمار مطابع ذلك الزمان، ووجدنا عند بعضهم الاعتماد على المخطوطات أيضا.
4- قد بين علماء الجمعية نظريّا وعمليّا ضرورة بناء العقائد على الكتاب والسنة النبوية، وضرورة اعتماد السنة في النهي عن مظاهر الشرك وغيرها من الانحرافات العقدية الرائجة، وكذلك عملوا قدر جهدهم على ربط الفقه بالدليل ومنه السنة النبوية بالنسبة للعامة والخاصة بلا فرق، ولا يختلف أمر السلوك تزكية باطنة وأخلاقا ظاهرة، فالسنة هي المصدر وهي التي يحكم بها على كلام الزهاد صحة وفسادا.
5- أكد علماء الجمعية على ضرورة تحري الصحة في الرواية، واجتناب الضعيف المنكر والموضوع فيما يبثّ من أحاديث نبوية، بل عدّوا ذلك جانبا من جوانب الإصلاح والتجديد في الأمة.
6- ثبت عن ابن باديس تجويز رواية الضعيف الذي لم يشتدّ ضعفه بشرط أن لا ينشئ عبادة جديدة، وظاهر كلام الإبراهيمي منع رواية الضعيف مطلقا حيث إنه قال: في الصحيح غنية عن الضعيف.
7- تجلى توظيف السنة النبوية في دعوة جمعية العلماء في دروسهم المسجديّة العامة والخاصة، حيث ثبت عنهم تدريس (الموطأ) و(الصحيحين)، وكتب أخرى نحو (رياض الصالحين) و(الشمائل المحمدية) و(الترغيب والترهيب) و(الأربعين النووية) وغيرها، ووظفت السنة أيضا في المحاضرات التي كانت تلقى في الرحلات الدعوية التي كان يقوم بها العلماء في مختلف مناطق البلاد، ووظفت أيضا في المقالات التي كانت تنشر في الصحف وهي أكثر الآثار الباقية، وكذا في المؤلفات التي ألفت على قلتها.
8- كان منهج شرح الحديث عند ابن باديس رحمه الله مرتكزا على بيان ثبوت اللفظ النبوي، ثم على فهمه الفهم الصحيح، ثم على تنزيله على الواقع، وكانت الغاية من اختيار الأحاديث المشروحة الوصول إلى ذلك التنزيل لمعالجة الانحرافات العقدية والأمراض الاجتماعية والأخلاقية، وبث بعض التوجيهات السياسية أيضا، وقد التزم من الناحية الشكل طريقة فريدة تعتمد على تكثير العناوين جلبا لانتباه القارئ وتقريبا للمعاني المرادة والأهداف التي يرمي عليها، وقد توسّمنا أن يكون المنهج الذي سار عليه ابن باديس هو نفسه الذي سار عليه غيره من العلماء باعتباره رئيسهم وقدوتهم في مجال الدعوة رحمه الله.
9- وقد ظهرت آثار دعوة جمعية العلماء بالسنة وإلى السنة في وقت مبكر، حيث أثمر رجوع الأمة إلى السنة علمًا وعملًا، وراجت كتب الحديث بين الناس، وانتعشت رواية الحديث، وتبع ذلك أن تغيرت برامج التدريس للعامة على وجه الخصوص، فصار الاعتماد في درس العقيدة على تفسير القرآن، والاعتماد في درس الفقه على شرح الحديث، ولما ألف ابن باديس العقائد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية جعلت برنامجا لتدريس الطلاب أيضا، وبرزت أيضا النزعة الاستدلالية التي صارت حاجزا في وجه ناشري الباطل، بل إن التأثير تعدى إلى من كان يعادي السنة، فقد أثر عن بعض الطرقية تحولهم إلى التفقه في السنة النبوية، وختَم الشيخ إبراهيم بيوض -العالم الإباضي المتأثّر بالدعوة الإصلاحية- شرح (صحيح البخاري) في عقر دار الإباضية.
وفي الأخير نحمد الله على التمام، ونسأله جل في علاه التوفيق للعمل والاتباعَ وحسنَ الختام، والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) رسالة الشرك ومظاهره لمبارك الميلي، تقديم العربي التبسي (ص: 29)، الإمام الشيخ العربي التبسي مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر القسم الأول، جمع وتوثيق شرفي أحمد الرفاعي (ص: 143).
([2]) فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين، لمصطفى صابر (ص: 45-46). وانظر: تعريف السنة في مبادئ الأصول لابن باديس (ص: 17).
([3]) آثار ابن باديس -جمع عمار طالبي- (3/ 132).
([4]) آثار ابن باديس -جمع عمار طالبي- (1/ 168). وانظر: معنى ذلك (1/ 409).
([5]) رواه البخاري ( 2697) ومسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها.
([6]) آثار ابن باديس -جمع عمار طالبي- (2/ 68).
([7]) آثار ابن باديس -جمع عمار طالبي- (4/ 128).
([8]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1/ 326).
([9]) دعوة للعلماء للمصلحين للطيب العقبي، مجلة الشهاب، العدد: 3، (ص: 15) (26 نوفمبر 1925م).
([10]) أخرجه أحمد (30/ 488) وحسنه الأرناؤوط، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (998).
([11]) أخرجه أبو داود (4607)، والترمذي (2675) وصححه، وابن ماجه (42، 43).
([12]) جريدة السنة النبوية، العدد: 1، (ص: 3).
([13]) آثار ابن باديس -جمع عمار طالبي- (1/ 409).
([14]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1/ 387، 3/ 546). وانظر أيضا: (1/ 362).
([15]) رسالة الشرك ومظاهره (ص: 287).
([16]) آثار ابن باديس -جمع عمار طالبي- (2/ 218).
([17]) آثار ابن باديس -جمع عمار طالبي- (1/ 127).
([18]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (2/ 347).
([19]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1/ 191-192).
([20]) جريدة السنّة، العدد: 7، 22 ماي 1933م.
([21]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1/ 87).
([22]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1/ 193).
([23]) مجالس التذكير من أحاديث البشير النذير (ص: 338).
([24]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1/ 147).
([25]) وثائق جديدة عن جوانب خفية في حياة ابن باديس الدراسية لعبد العزيز فيلالي (ص: 24-32). وفي البرنامج القديم الذي وضع سنة 1875م كان المقررة الكتب الآتية، ويظهر أن تغييرا طرأ عليها: “في المصطلح: (غرامي الصحيح) ثم (ألفية العراقي بشرح القاضي) ثم (مقدمة القسطلاني). في الحديث: (شرح الأربعين) للقاني، و(شرح الشمائل) للمناوي، ثم (الموطأ بشرح الزرقاني) و(البخاري بشرح القسطلاني)، و(مسلم بشرح الأبي). انظر: عبد الحميد بن باديس مرحلة التحصيل والتكوين لعبد العزيز فيلالي (ص: 160-165).
([26]) مناهج التكوين الأزهري بين جامعه وجامعته دراسة وصفية، د. محمد دهان (ص: 263). وقد حاز إجازات في الموطأ والصحيحين، انظر: الشيخ العربي التبسي مصلحا، أحمد عيساوي (ص: 181-185).
([27]) جهود الشيخ العربي التبسي وآثاره الإصلاحية، أحمد عيساوي (1/ 57-61).
([28]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (3/ 546، 5/ 275-276).
([29]) ينظر ذلك: الدرس الحديثي عند الإمام ابن باديس منهجه ومقاصده، يونس بوحمادو (ص: 170-172)، ثم تناقض واستثنى كتبا واعترف أنه نقل منها بالواسطة (ص: 177).
([30]) فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين (ص: 70، 71-72، 75، 118، 122، 129، 134، 429، 514).
([31]) فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين (ص: 79، 257، 259، 494).
([32]) الإمام عبد الحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة من خلال آثاره، للعرابي عامر (ص: 292)، فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين، لمصطفى صابر (ص: 86، 94، 160، 213، 241، 264، 266، 407، 445، 462، 494).
([33]) مجالس التذكير من حديث البشير النذير (ص: 185).
([34]) فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين، لمصطفى صابر (ص: 49، 200، 203، 222).
([35]) الشيخ أبو يعلى الزواوي وجهوده في الفقه والأصول، لبوبكر صديقي (ص: 131-132)، فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين، لمصطفى صابر (ص: 141، 174، 374).
([36]) رسالة الشرك ومظاهره (ص: 93).
([37]) رسالة الشرك ومظاهره (ص: 93، 219، 245، 275، 278، 422).
([38]) رسالة الشرك ومظاهره (ص: 55، 77، 150، 151، 187، 210، 225، 274، 326، 373، 398، 413، 438).
([39]) مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (ص: 320).
([40]) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (5/ 94) وزارة الثقافة 2007م.
([41]) مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (ص: 252).
([42]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (3/ 544).
([43]) رسالة الشرك ومظاهره للميلي تقديم الشيخ العربي التبسي (ص: 27). وانظر: الإمام الشيخ العربي التبسي مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر القسم الثاني، جمع وتوثيق شرفي أحمد الرفاعي (2/ 27).
([44]) الإمام الشيخ العربي التبسي مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر القسم الثاني، جمع وتوثيق شرفي أحمد الرفاعي (2/ 27).
([45]) رسالة الشرك ومظاهره (ص: 34).
([46]) الإسلام الصحيح (ص: 94).
([47]) مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (ص: 143).
([48]) مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (ص: 143).
([49]) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (3/ 238) وزارة الثقافة 2007م.
([50]) انظر: رسالة الشرك ومظاهره (ص: 210، 222، 223، 224، 244-245، 250، 255، 256، 257، 274، 302-303، 309-310، 324، 342، 348، 397، 407، 420، 423، 425، 434، 437)، آثار الشيخ مبارك الميلي، لأبي عبد الرحمن محمود (ص: 389).
([51]) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (5/ 38) وزارة الثقافة 2007م.
([52]) مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (ص: 251).
([53]) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (3/ 240) وزارة الثقافة 2007م.
([54]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (3/ 298).
([55]) الإمام الشيخ العربي التبسي مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر القسم الثاني، جمع وتوثيق شرفي أحمد الرفاعي (ص: 132).
([56]) الإمام الشيخ العربي التبسي مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر، القسم الثاني (ص: 123-124).
([57]) فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين، لمصطفى صابر (ص: 45-46).
([59]) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (5/ 94) وزارة الثقافة 2007م.
([60]) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (3/ 252) و(6/ 82) وزارة الثقافة 2007م.
([61]) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (4/ 261) وزارة الثقافة 2007م.
([62]) مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (ص: 32).
([63]) فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين، لمصطفى صابر (ص: 45-46).
([64]) الإسلام الصحيح (ص: 51-52).
([65]) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (3/ 49-50) وزارة الثقافة 2007م.
([66]) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (3/ 62) وزارة الثقافة 2007م، وانتقد الإبراهيمي الحديث كما في آثاره (4/ 264).
([67]) مجالس التذكير من كلام البشير النذير (ص: 119)، وانظر: (ص: 71).
([68]) مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (ص: 143)، ومثله باختصار في مبادئ الأصول (ص: 22).
([69]) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (3/ 300) وزارة الثقافة 2007م.
([70]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1/ 346).
([71]) عمر بن البسكري (1889-1968م) من تلاميذ الشيخ الطيب العقبي في مدينة بسكرة، وتولى التدريس في مدارس الجمعية ببجاية، ثم سطيف، ثم وهران، واستمر على ذلك إلى خروج المستعمر، وله عدة مقالات منشورة في الشهاب والبصائر. ينظر: من أعلام الإصلاح، لمحمد الحسن فضلاء (2/ 22). وانظر: البصائر -السنة الأولى- (ص: 44، 96، 163).
([72]) البصائر -السنة الأولى-، العدد: 20 (ص: 7)، والعدد: 21 (ص: 2).
([73]) صراع بين السنة والبدعة، لأحمد حماني (2/ 68).
([74]) ظواهر في العبادات ما كان ينبغي أن تكون، لأحمد بري (ص: 8-9).
([75]) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس (4/ 68، 100) وزارة الثقافة 2007م.
([76]) آثار ابن باديس -جمع عمار طالبي- (2/ 309).
([77]) الشيخ الصادق حماني (ص: 12-13).
([78]) الإمام عبد الحميد بن باديس جهاد ومواقف بأقلام أدباء وعلماء، لمحمد الصالح الصديق (ص: 120).
([79]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (4/ 64)، ظواهر في العبادات ما كان ينبغي أن تكون، لأحمد بري (ص: 8-9).
([80]) البصائر -السنة الثانية من السلسلة الثانية-، العدد: 93، يوم 31 أكتوبر 1949م، الموافق 9 المحرم 1369ه.
([81]) الشيخ مبارك الميلي حياته العلمية ونضاله الوطني، لمحمد بن مبارك الميلي (ص: 183-184).
([82]) الشيخ مبارك الميلي حياته العلمية ونضاله الوطني، لمحمد بن مبارك الميلي (ص: 338).
([83]) أعلام الإصلاح في الجزائر، لمحمد علي دبوز (2/ 21، 44).
([84]) هو حمزة شنوف، المعروف ببوكوشة (1909-1994م) ولد بوادي سوف، نشأ في بسكرة وتعلم فيها وتخرج من الزيتونة، وتلقى المنهج الإصلاحي من الشيخ الطيب العقبي، وتتلمذ على ابن باديس، درس في مدارس الجمعية ببومرداس وتيزي وزو، قبل أن يرجع إلى الجامع الأخضر إلى جانب ابن باديس، انتبدته الجمعية إلى فرنسا ثم رجع للتدريس في معهد ابن باديس، واشتغل بعد الاستقلال في قطاع التعليم ثم العدالة، له مقالات كثيرة في جرائد الجمعية وغيرها وعدة مؤلفات، وتوفي في الجزائر العاصمة. ينظر مقال: الشيخ حمزة شنوف المعروف بحمزة بوكوشة العالم الصحفي المميز، على الرابط:
https://mculture-ouargla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=549.
([85]) ما رأيتُ وما رويتُ، لشنوف حمزة بو كوشة (ص: 34-35) بدون دار، 2012م.
([86]) المسيرة للرائدة للتعليم العربي الحر في الجزائر، لمحمد الحسن فضلاء (1/ 199-200).
([87]) البصائر -السنة الثالثة-، العدد: 95، (ص: 5)، العدد: 96، (ص: 2)، العدد: 98، (ص: 6).
([88]) آثار الشيخ مبارك الميلي، لأبي عبد الرحمن محمود (1/ 405).
([89]) آثار ابن باديس -جمع عمار طالبي- (3/ 25).
([90]) فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين (ص: 124).
([91]) فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين (ص: 128).
([92]) فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين (ص: 133).
([93]) فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين (ص: 138).
([94]) فتاوى علماء جمعية العلماء المسلمين (ص: 186-190).
([95]) تفسير ابن باديس، تحقيق أبي عبد الرحمن محمود (2/ 455-464).
([96]) الدرس الحديثي عند الإمام ابن باديس منهجه ومقاصده (ص: 313).
([97]) طبعه سنة 1985م محمد الحسن فضلاء بدار البعث قسنطينة، ثم أعيد طبعه سنة 1440هـ – 2018م بدار اليسر الجزائر العاصمة، بعنوان: آيات وأحاديث الأحكام.
([98]) قام بطبعه الدكتور عمار طالبي.
([99]) الدرس الحديثي عند الإمام ابن باديس منهجه ومقاصده، ليونس بوحمادو (ص: 193).
([100]) الدرس الحديثي عند الإمام ابن باديس منهجه ومقاصده، ليونس بوحمادو (ص: 196-197).
([101]) الدرس الحديثي عند الإمام ابن باديس منهجه ومقاصده، ليونس بوحمادو (ص: 203-205).
([102]) تاريخ الجزائر الثقافي (7/ 46).
([103]) انظر: الدرس الحديثي عند الإمام ابن باديس منهجه ومقاصده، ليونس بوحمادو (ص: 228-291).
([104]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1/ 285).
([105]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1/ 193).
([106]) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1/ 148-149).
([107]) الشيخ مبارك الميلي حياته العلمية ونضاله الوطني، لمحمد بن مبارك الميلي (ص: 183-184).
([108]) العقائد الإسلامية لابن باديس -التقريظ- (ص: 18-19).
([109]) العقائد الإسلامية لابن باديس -التقريظ- (ص: 21).
([110]) آثار ابن باديس -جمع عمار طالبي- (3/ 183).
([111]) إبراهيم بيّوض (1899-1981م) ولد بالقرارة في ولاية غرداية حاليا، وتعلم بها على علماء الإباضية، وانضم إلى جمعية العلماء يوم تأسيسها، وأسس معهد الحياة، وتعرض لمحاولات اغتيال عدة بسبب أفكاره الإصلاحية التي رفضها الإباضية، كان له دور فعال أثناء حرب التحرير، من جهة الدعم المادي، وكذا بوقوفه ضد مشروع فصل الصحراء عن الشمال، له آثار كثيرة منها: الفتاوى والتفسير، ورسالة في الترضي على الصحابة، وأغلب آثاره عبارة عن تفريغ لدروس مسجلة، ومن آثاره إرجاع إقامة صلاة الجمعة سنة قبل وفاته، وفي تفسيره بعض التراجعات ورواسب ذكرتها في كتابي الرد النفيس على الطاعن في العلامة ابن باديس (ص: 194-195)، وانظر: الشيخ إبراهيم بيوض وجهوده في الإصلاح الاجتماعي في الجزائر للخضر بوطبة، مجلة المعارف للبحوث والدراسات (ص: 167-189)، العدد الثاني 2015م.
([112]) جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في خدمة الحديث النبوي، لعقيلة حسين (ص: 367).