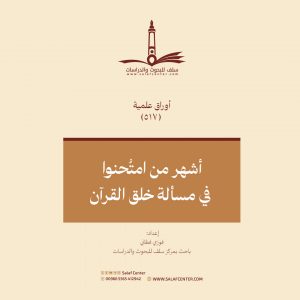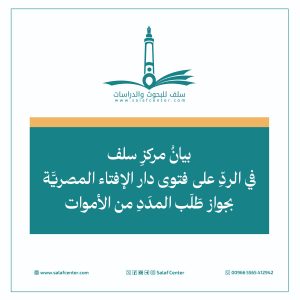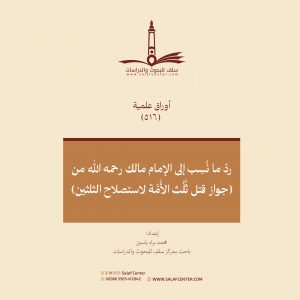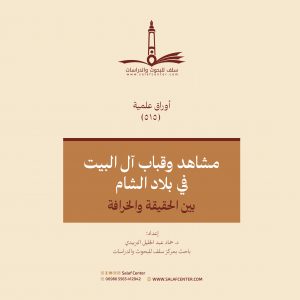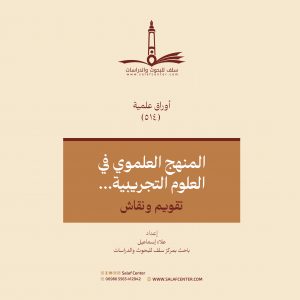أثَرُ السُّنَّة النَّبَويَّة فِي تَكوِينِ العَقلِيَّة العِلمِيَّة
المعلومات الفنية للكتاب:
عنوان الكتاب: أَثَرُ السُّنَّة النَّبَويَّة فِي تَكوِينِ العَقلِيَّة العِلمِيَّة.
اسم المؤلف: أ. د. أَحمَد قُوشْتِي عَبْد الرَّحِيم.
دار الطباعة: مَركَز إِحسَان لدِرَاسَات السُّنَّة النَّبَويَّة.
رقم الطبعة: الطَّبعةُ الأُولَى عام 1438ه – 2017م.
حجم الكتاب: غلاف في (215 ص).
· فكرة الكتاب وغايته:
لا يشك منصفٌ في تكامل المنهج العلمي الإسلامي وقوته، ولا شك أيضًا أن منهجًا مترابطًا متكاملًا لا بد وأن يكون قد نشأ على يد عقليات علمية أُعدَّت وكُوِّنت وهُيِّأت لبنائها، وعلى الرّغم من كثرة الكتابات حول العلم أو النظر العقلي أو نظرية المعرفة في القرآن أو في الإسلام عموما، إلا أن جانب دور السنة في البناء العلمي مع أهميته لم يحظَ بذلك الاهتمام.
ومن هنا سطر الباحث كتابه لتجلية دور السنة النبوية في تكوين تلك العقلية
وذلك عن طريق تتبُّع عناصر تكوينها في السنة النبوية القولية والفعلية.
وهذه العناصر هي:
1- الإعلاء الشديد من شأن العلم والحث على تعلمه وتعليمه.
2- تحديد مفهوم العلم وتوسيع مجالاته.
3- ترسيخ مجموعة من القواعد المنهجية الضابطة لطرق تحصيل العلم والمعرفة.
4- أخلاقيات العلم وآدابه.
ومن هذه العناصر التكوينيَّة نفسها كوَّن المؤلف خطة بحثه.
· خطة البحث
كما أسلفنا نسَّق المؤلف أجزاء بحثه من العناصر التكوينية للعقلية العلمية، فظهرت متناسقةً في أربعة مباحث، افتتحها بمقدمةٌ مركَّزة وملخَّصة، وختم بحثه بذكر قائمة المصادر والمراجع.
فجعل المقدمة في الحديث عن المنهجية العلمية الإسلامية والعقليات العلمية التي ساهمت في بنائها.
وافتتحه بالحديث عن تكامل المنهج العلمي الإسلامي وسبقه على كل الحضارات، وسيادته على الأمم آمادًا وقرونًا حيث غيَّرت طريقة التفكير البشري، بل وألهمت الأمم تلك المنهجية فنهلت منها البشرية على حد سواء، كل ذلك بفضل هذه المنهجية العلمية التي بُنيب داخل البيت الإسلامي.
وأكَّد المؤلف أن تقريره هذا يشهد به الشانئين للإسلام قبل الناشئين فيه.
ثم عقَّب بذكر أهمِّية البحث في عوامل تأسيس المنهجية العلمية وإيجاد العقلية العلمية.
والمقصود بالعقلية العلمية: العقلية المنهجية التي تُعلي شأن العلم، وتعوِّل على الدليل، ولا تقبل الدعاوى والخرافات، ولا تُحكِّم العواطف والظنون فيما يتطلَّب اليقين المجرد، وتسبر كل ما يُعرض عليها من قول أو رأي.
وبيَّن أن هناك اصطلاحات أخرى للعقلية العلمية؛ كالروح العلمية والتفكير العلمي.
ثم صرَّح بأن منهجيَّة التفكير العلمي أحد مميّزات العقلية العلمية، وبيَّن مقصوده بذلك فقال: “الجهد الذي يقوم به العقل -المسترشد بهداية الشرع- من أجل اكتشاف حقيقة مجهولة، أو البرهنة على حقيقة موجودة، مما يتعلق بأمور الدنيا أو الآخرة في خطوات عملية منظمة ومدروسة، ومحاطة بالتوجيه الربَّاني في قواعد كلية أو إجراءات تفصيلية”.
وأكَّد أن كل تفكيرٍ منظمٍ يُمارَسُ في الحياة اليومية بشرط بنائه على منهجية واضحة فهي طريقة منهجية وتفكير علمي، وأن كل طريقة في البحث موصلة إلى حقائق المجال المبحوث فهي طريقة منهجية وتفكير علمي، واختلاف مجالات البحث يقتضي بطبيعة الحال اختلاف طرائقها ومناهجها، وحصر المناهج في المنهج التجريبي ظاهر البطلان على هذا.
إثر ذلك طفق يعدِّد المجالات البحثية التي برع المسلمون في صياغة مناهجها؛ كتوثيق الأخبار واستنباط الأحكام والأصول الفقهية، وعلوم الكون والإنسان، وما المنهج التجريبي الذي ذاع صيت (روجر بيكون) معه إلا أحد نقلةِ ذلك المنهج عن العقلية العلمية الإسلامية.
ثم بيّن مزايا المنهجية الإسلامية عن المنهجية الغربية، وكيف أن نصوصها القرآنية المقدَّسة تتوالى على تأسيس الروح العلمية وتكوين عقلياتها؛ مما أثمر علومًا دقيقة باهرة؛ كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ثم عرض مزايا المنهج الحديثي الإسلامي وآثاره على العقلية العلمية الإسلامية.
ثم بيَّن هدفه وغايته من الكتاب ومنهجه في السير فيها وخطة عمله.
وبعد الانتهاء من المقدمة، شرع المؤلف في مباحث الكتاب الأربعة، حيث جعل لكل عنصر من العناصر التكوينية الآنفة الذكر مبحثًا.
ففي المبحث الأول: تكلم عن الإعلاء الشديد من شأن العلم والحث على تعلمه وتعليمه.
وبيَّن في فاتحته أنه لا يكاد يوجد دين اهتمَّ بالعلم وحث عليه كالإسلام، وأن أول كلمة نزلت في كتابه ودستوره هو {اقْرَأْ } [العلق: 1]، والامتنان بنعمة آلة العلم (القلم)، ثم طفق يورد النصوص الدالة على ذلك من السنة، وركَّز بحثه على النصوص التي تبيِّن العناية الشديدة بالعلم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: “طلب العلم فريضة على كل مسلم”([1])، وقوله صلى الله عليه وسلم: “فضل العالم على العابد، كفضلي على أدناكم”([2])، وغيرها من الأحاديث، بلغت عشرة أحاديث، معقبًا لها بذكر أقوال السلف التي تبيِّن مقصود البحث.
ثم ثنى المؤلف بالمبحث الثاني: وكان في تحديد مفهوم العلم وتوسيع مجالاته.
وفيه تحدث عن تباين آراء الناس في حقيقة العلم وتعريفه، وأن السَّلف لم يقفوا طويلًا عند تعريفه؛ نظرًا لوضوح هذا المصطلح وعدم احتياجه إلى الشرح، وما صحيح البخاري إلا نموذج رائع لطريقة السلف في ذلك، هذا عن مفهوم العلم في الفكر الإسلامي، بينما مفهوم العلم الفكر الغربي في الجانب الآخر، ظل قرونًا متطاولة تحت ظلمات الفلسفة لا يفرقون بين العلم العقلي والتجريبي، ثم انفصلت عن الفلسفة فأضحى لا يطلق إلا على العلم التجريبي فحسب!!
وبيَّن أن العلم في النصوص الشرعية يراد به “كل معرفة صحيحة مبنية على الحجة والبرهان”، وعقَّبه بذكر محترزات التعريف، ثم تحدث عن تقسيم العلم إلى دينية ودنيوية أو نقلية وعقلية، إنما هو باعتبار أوصافه فقط، وأن العلم في الإسلام إنما يُصنف بالشرعي وغير الشرعي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا التقسيم يقضي على النزاع الوهمي بين العلم الشرعي وغيره من العلوم كالعلوم الطبيعية والتجريبية وغيرها.
وذكر أن من غير الدقيق حصر معنى العلم في العلوم الدينية دون غيرها.
إثر ذلك أشار إلى تباين مفهوم العلم وغاياته في الإسلام عن مفهومه وغاياته في الفلسفة، حيث إن شرط العلم في الإسلام النفع والفائدة بينما ذهب بعض الفلاسفة الغربيين إلى أن قيمة العلم لا تكمن في فائدته بقدر ما في كمونها في قيمته في ذاتها.
وكان المبحث الثالث في: ترسيخ مجموعة من القواعد المنهجية الضابطة لطرق تحصيل العلم والمعرفة.
وقد ابتدأه بذكر أهمية هذا الجانب من جوانب البحث، وتبعًا لأهميته فقد أطال المؤلف الحديث فيه حيث استغرق قريبًا من نصف الكتاب، ويُعتبر هذا المبحث أطول مباحث الكتاب، وقد برَّر المؤلف سبب ذلك في مفتتح المبحث فقال: “نظرًا لما لهذه القواعد من دور مهم وجوهري في غرس النزعة العلمية، وتخريج شخصية ذات سمات منهجية واضحة في كيفية تلقي العلوم والمعارف والتعامل معها”
ثم تحدَّث عن تنوِّع مجالات هذه القواعد بدءًا بمصادر المعرفة وكيفية تحصيلها أو اكتسابها، ومرورًا بشيوع حرية التعلم وهو ما يظهر في صدر الإسلام بين العبيد والموالي.
ثم أكَّد المؤلف أصالة هذه القواعد الإسلامية، وعدم تأثرها بأي لون من ألوان الفكر البشري، ثم شرع يتكلَّم عن هذه القواعد، وذكر منها:
- ذم القول بغير علم وعدم قبول أي دعوى بلا برهان معتبر.
- حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الربط بين كلامه، وبين ما يدل عليه من آيات القرآن الكريم، مع أن كلامه وحي، وكاف في الحجة والبرهان.
- الاعتداد بسائر المصادر المعرفية المعتبرة.
- ذم الطنطنة اللفظية الفارغة التي تزيف الحقائق، وتصرف الأنظار عنها.
- الدقة في استخدام المصطلحات، وإعادة تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.
- عدم الاقتصار على ظواهر الأشياء وعوارضها، والعناية التامة بالفهم لحقائقها، والتأكيد على أن العبرة بالكيف والحقيقة، وليس بالكم والمظهر.
- التأكيد على فكرة السنن الربانية وثباتها.
- الأمر بالتدبر والتفكر في آيات الله المتلوة والمنظورة.
- الفصل بين كل من عالم الغيب والشهادة، واختلاف منهجية التعامل مع كل منهما.
- تعليم النساء وتعليم الأطفال والصبيان.
- اتخاذ الحوار وسيلة للتعليم وحل مشكلات الأمة.
- تنويع وسائل التعليم.
إلى غير ذلك من أمثال هذه القواعد التي بلغت ثمانية وثلاثين قاعدة، وقد أتبع كل قاعدة من تلك القواعد ما يدل على عناية السنة النبوية بها، وآثار السلف فيها.
وفي المبحث الرابع أَسفَر عن: أخلاقيات العلم وآدابه.
وافتتحه ببيان تفرُّد المنهج الإسلامي به من بين المناهج الأخرى، فلا يوجد بين الأمم أمة اهتمت بأخلاقيات العلم كأمة الإسلام على مرِّ العصور، فإن علماء الإسلام أقاموا فيها الدروس وأفردوا لها التصانيف؛ ومن ذلك: أخلاق العلماء للآجري، وأخبار الشيوخ وأخلاقهم للمروذي، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي، وعُنُوا أيضًا بالجانب الآخر، حيث ألَّفوا كتبًا في السلوكيات المنافية للعلم وأهله؛ كزغل العلم للذهبي وتلبيس إبليس لابن الجوزي.
ثم تطرَّق للحديث عن الحاجة الماسَّة إلى الأخلاقيات العلمية خاصة في عصرنا الذي تضاءلت فيه قيمة العلم ومكانة أهله، مع أن الثروة الحقيقة لأي أمة هي العلم كما يشهد التاريخ والواقع.
وأكَّد أن العلم وحده لا يكفي، بل لا بد معه من الأخلاقيات العلمية، وقد حفل التراث الإسلامي بالعديد من الكتابات في الآداب عامةً وفي آداب العلم خاصة، وممن أفرده بالتصنيف؛ البخاري في الأدب المفرد، وابن مفلح في الآداب الشرعية، وابن عبد القوي في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، والماوردي في أدب الدنيا والدين، وغيرها كثير.
كما أن هناك من الكتب المتخصصة في جانب من جوانب العلم؛ كتذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، وغيرها.
ثم طفق يذكر شيئًا من تلك الآداب، ومنها:
- الإخلاص
- المنهجية في الطلب
- الأدب مع الأستاذ والكتب والرفاق
- آفات يجب أن يتجنبها العالم والمتعلم
ثم ذكر قائمة المصادر والمراجع
ومما يميز هذا البحث مقدمته، فإن الباحث لخَّص فيه مسألة المنهجية العلمية الإسلامية ومزاياها وتفرِّدها، وأورد في حواشيه عددًا لا بأس به من الكتب والأبحاث والمراجع المؤلفة في هذا الشأن ممّا وقف عليه.
كما يتميِّز أيضًا بعدم اقتصاره على المنهج الإسلامي بل يردفها بمقارنتها بالمناهج الأخرى.
والكتاب في مجمله خفيف وسهل واضح ونافع على اختصاره، يجلِّي لقارئه نصاعة المنهج المعرفي الإسلامي وقوة تماسكه.
([1]) رواه ابن ماجه (224)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3913).
([2]) رواه الترمذي (2685)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4213).