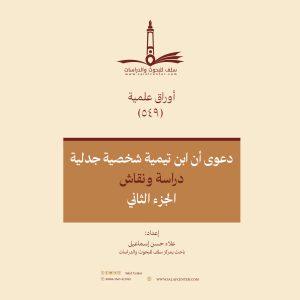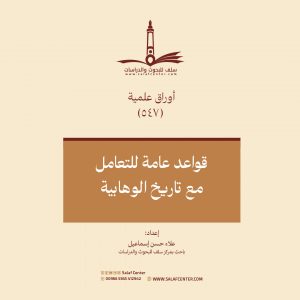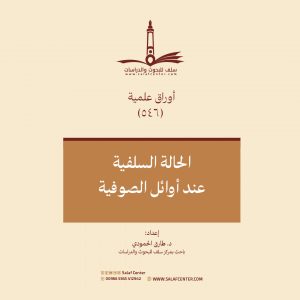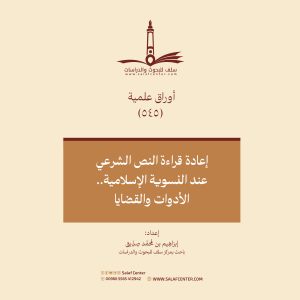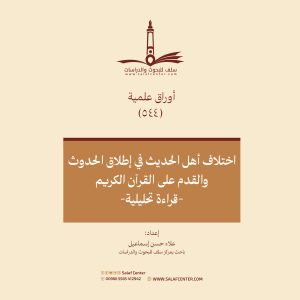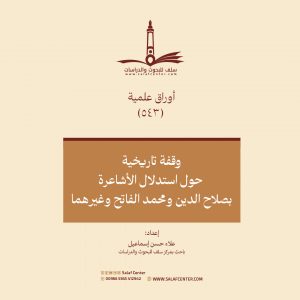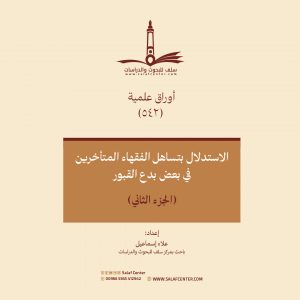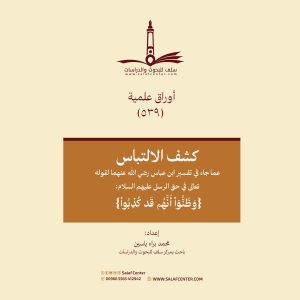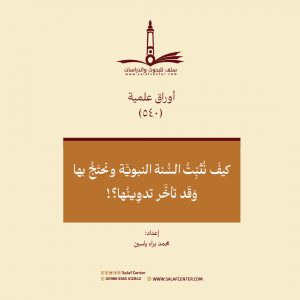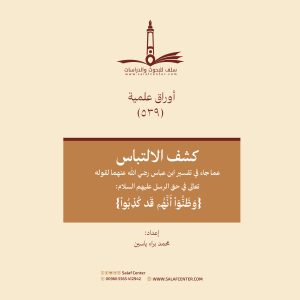مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية | للقرون الهجرية الثلاثة الأولى (1)
- تمهيد
مما لا شك فيه أن كتب التاريخ قد حملت من الأخبار والروايات ما هو صحيح وما هو باطل مكذوب، وكتَبَةُ التاريخ ورواتُه كان همهم الأول جمع الأخبار والمرويات بلا تمحيص ولا نقد، واشتغل برواية هذا النوع طائفة من الضعفاء والمتروكين، وكان لبعضهم أهواء ومشارب وبدع؛ فدُسّت فيه دسائس شوهت كثيرا من حقائق التاريخ، وشوهت العديد من أحداثه ورجاله، واستغل طائفة من المستشرقين وأتباعهم، وأصحاب الأهواء وأشباههم هذه الثغرة لتشويه التاريخ وتلفيق الأخبار، وبنوا عليها نتائج خاطئة وتحليلات باطلة= ما دفع جماعة من الباحثين إلى البحث عن ضوابط ومعايير لما يصح من الأخبار وما لا يصح، والعمل على تنقيحها وتنقيتها من الشوائب والمكذوبات، وإرجاع الحقائق إلى أصولها، والذب عن الحوادث والروايات التي لها تعلق بالأمور الشرعية والأحكام، داعين من أجل ذلك إلى تطبيق بعضَ مسالك المحدثين في نقد الروايات، وإخضاع تلك الروايات إلى موازين النقد والتمحيص.
للتحميل كملف اضغط هــنــا
وغنيّ عن القول أننا لا ندعو إلى تطبيق منهج المحدّثين في النقد بحذافيره على جميع المرويات التاريخية؛ لأن هذا مخالف لمنهج المحدثين أصلا، فقد عامل المحدثون الروايات التاريخية ومرويات السيرة النبوية تعاملا أقل صرامة في النقد، وأكثر تسمّحا في القبول والاعتبار، وجرى على ذلك عملُهم.
وكذلك لم يـُجْروا كل تلك المرويات على نمط واحد بل فرقوا بين ما كان له تعلق بالتشريع والأحكام وما لم يكن كذلك.
وكذلك نظرتهم للمرويات التاريخية لم تكن بدرجة واحدة، بل نظروا للمروي من زوايا واعتبارات مختلفة.
وقد قبلوا أخبار من كان مختصا بالتاريخ والمغازي وإن كان في غيرها غير مقبول الرواية؛ لاختصاصه بهذا الشأن، ولم ينظروا أيضا لتفرد الرواي المختص بالمغازي والتاريخ نظرا قاطعا بالرد ما لم يكن في خبره نكارة ظاهرة أو يخالف خبرا تاريخيا أوثق وأصح..
هذه معالم وصوى نضعها بين يدي استعراض مباحث هذا الكتاب، ليس المقصود منها سوى الإشارة السريعة للبحث في هذا الباب..
وفي الحق إن هذه المسألة لم تحرر التحرير الشافي، ولم ينهض الكتّاب والمؤلفون لوضعها في ميزان النقد بشكل موسع وشامل… إلا لو جمعت الجهود المتفرقة في الباب، وهذه دعوة مفتوحة لعل عملا ينهض بها..
وتكمن أهمية دراسة مثل هذا الموضوع في جانبين:
- لوضع منهج منضبط لقبول الأخبار التاريخية وردّها، والتمهيد لتدوين تاريخيّ أمين سالم من المكذوبات والموضوعات والبواطيل.
- أن الخلط في الروايات أصبح مدخلا واسعًا للمشككين في التاريخ الإسلامي في أحداثه ورموزه من علماء وخلفائه وقادته، فركب هؤلاء ثبج الأخبار الكاذبة والروايات الساقطة بحجة وجودها في كتب التاريخ التي دونها العلماء، غير آبهين بالمنهج العلمي في تناول هذه الأخبار وتثبيتها، ولا آبهين بنوعية المصادر التي ينقلون منها ولا شروط مؤلفيها… فينقلون من كتب لم يشترط أصحابها الصحة والا الثبوت، وينقلون من كتب الأدب والحكايات، وينقلون من كتب مرسلة بلا إسانيد، ويعاملون الجميع معاملة واحدة!
ولا ننسى التنويه بما للعلماء من جهود كبيرة في هذا السبيل، لو أنها جمعت وحررت لجاءت في مصنف كبير، وهذا يتمثل في كتابات كثير من النقّاد أمثال ابن حبان في “المجروحين” وابن الجوزي في “الموضوعات” وشيخ الإسلام ابن تيمية في “منهاج السنة” خاصة، والذهبي في كتبه، وابن القيم كـما في “المنار المنيف”، والتاج السبكي، وابن خلدون في “المقدمة”، والحافظ ابن حجر في “فتح الباري”، والسخاوي والسيوطي.. وغيرهم.
- دراسات حديثة:
كتب طائفة من الباحثين المعاصرين في هذه المسألة، التي عالجت موضوع نقد الروايات التاريخية، اطلع المؤلف على بعضها ككتاب “مصطلح التاريخ” لأسد رستم، وما كتبه د. أكرم العمري في مقدمة “السيرة النبوية الصحيحة”، غير أن ثمة دراسات عديدة لم يقف عليها الباحث، ومن هذه الدراسات:
1- منهج المحدثين في نقد الرواية التاريخية: دراسة تطبيقية على كتاب “المستدرك على الصحيحين” للإمام الحاكم (ت 405 ه)، للباحث إياد أحمد سلامة، وهي رسالة دكتوراه نوقشت سنة 2010م.
2- “مدرسة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه” للدكتور خالد كبير علال، طبعت بدار البلاغ – الجزائر، سنة 1424ه/2003م
وهي وإن لم تكن في جوهر موضوعنا لكن لها تعلق به كبير.
3- وهي أيضا للدكتور خالد علال وَسَمَها بـ “الأخطاء التاريخية والمنهجية في مؤلفات محمد أركون ومحمد عابد الجابري -دراسة نقدية تحليلية هادفة-“، طبعت طبعة أولى بدار المحتسب- سنة 2008م.
تطرق فيه لتطبيق منهج المحدثين في نقد الخبر، القائم على نقد الأسانيد والمتون معا، في تمحيص الروايات الحديثية والتاريخية. قال: ولم أتخل عنه إلا إذا لم أتمكن من تطبيقه، أو لم أر في تطبيقه ضرورة. كما أنني سأردُّ على الأخطاء التاريخية والمنهجية الواردة في مؤلفات أركون والجابري، سواء صدرت منهما، أو من الذين نقلا عنهم من أهل العلم.
4- “المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره”، للأستاذ الدكتور محمد رشاد خليل، طبع الطبعة الأولى بدار المنار- القاهرة، سنة 1404ه- 1984م
5- “منهج دراسة التاريخ الإسلامي” للأستاذ الدكتور محمد أمحزون، طبع الأولى بدار السلام- القاهرة، سنة 1432ه- 2011م. وفيه فصل عن منهج توثيق الأخبار.
6- نقدُ الحديث بالعَرضِ على الوقائِع والمعلومات التاريخيَّة، للدكتور سلطان العكايلة، نشر عام 2014م. في 171 ص.
7- عُقد مؤتمر عام 2013 في الشارقة عنوانه ” علوم الحديث وعلاقتها بالعلوم الأخرى (الواقع والتّطلّعات)” قدمت فيه بحوث جيدة عن علاقة علم الحديث بعلم التاريخ، وهناك دراسات وبحوث متعددة في الباب لا نطيل بذكرها ..
وهذه الدراسات لم يتطرق إليها الباحث في كتابه ولم يستفد منها، على اعتبار أن الكتاب لم يطبع إلا متأخرا بعد صدور تلك الدراسات..
ومن خلال هذا السرد الموجز لهذه الدراسات، وبعد الاطلاع على مباحثها، يتبين أنها مفيدة في بابها، ولو أن الباحث استفاد منها أو من بعضها على الأقل لاختصر كثيرا من فصول كتابه واكتفى بالإشارة إلى سابقه، بل ربما حذف فصولا كاملة لعدم تعلقها المباشر بموضوع البحث، فيكون الكتاب بذلك أقل حجما مما هو عليه، وأكثر تحريرا وضبطا في مشكلة البحث التي أنشأت الدراسة من أجلها.
- استعراض فصول الكتاب ومباحثه:
كتاب الدكتور إبراهيم الشهرزوري معنون بــ”مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية للقرون الهجرية الثلاثة الأولى”، وأصله رسالة دكتوراه في العراق في تخصص نقد التاريخ والتراث والحضارة الإسلامية وفق منهج المحدثين، وكانت في منتصف التسعينيات الهجرية، ولم تطبع إلا حديثا عام 2014م. ويقع في 818 صفحة بملاحقه وفهارسه.
قسم الباحث كتابه إلى مقدمة وسبعة فصول وخاتمة، جعل المقدمة في تسع صفحات دلل فيها على إمكانية إعادة كتابة التاريخ الإسلامي، مع تطبيق منهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية. وضرب لذلك أمثلة، وأعطى شواهد تعضد ما جنح إليه، وأثبت أن المناهج الأصولية الحديثة، والأصولية الفقهية، والفقهية، والتاريخية، قابلة للتطبيق فعلا على الروايات التاريخية، وأن هذا المنهج كفيل بتنقية كتب التاريخ وبقية كتب التراث الإسلامي، وتصحيحها مما لحق بها من التلويث والتزوير والترهات والخزعبلات، والزيادة والنقصان، والتحريف والدس.
وبالنظر في الأمثلة التي ذكر الباحث في كتابه والمحاولات المشابهة لها في الدراسات السابقة يمكن القول بأن إعادة كتابة التاريخ الإسلامي كتابة سليمة من الروايات الضعيفة والشوائب التي كدرت صفوه أمر مستطاع؛ فالمادة التاريخية والأحداث والوقائع محفوظة في بطون كتب الحديث والتاريخ والتفسير والأدب والتراجم..؛ وهذا المشروع لو تم سيعطينا مادة علمية دسمة تغطي معظم الوقائع بعيدا عن المجازفات والمغالطات التي دخلت عليه.
وقد أفصح الباحث في هذه المقدمة عن أسباب اختياره للموضوع تتلخص في إحياء مناهج المحدثين واستخدامها لكتابة التاريخ والبحوث التاريخية، خصوصا ما يتعلق بالقرون الثلاثة الأولى، تقربا إلى الله تعالى بتخليص التاريخ من روايات أساءت إلى الأمة عقيدة وشريعة وحضارة وتاريخا.
وفي الفصل الأول (ص 23- ص 148) وهو أهم فصول الكتاب، وكان من المتوقع أن يوليه الباحث عصارة جهده ومنتهى بحثه، لكنه لم يشف الغلة، وكان أغلب تقريراته نقلا عن دراسات سابقة للدكتور أكرم العمري .
تحدث الباحث عن أثر علم الحديث في المنهج التاريخي، وعن العلاقة بين التاريخ ومنهج أهل الحديث، حيث عرَّج على نقد كل من السند والمتن عند علماء الحديث، واهتمامهم بالإسناد في قبول الأخبار والروايات، مع التمثيل لذلك بأمثلة واقعية.
وفي الفصل الثاني (149- 242) كان الحديث عن أحوال الراوي والرواية مشيرا إلى خاصية الحفظ عند المسلمين، والأسباب التي ساعدت على ذلك، ومدى اهتمام طلاب الحديث بالرحلة وتجشم الصعاب في تحصيل الحديث.
كما أشار إلى الرواية بين الحفظ والكتابة، وعن أحوال الرواة قبولا وردا، ومدى دقة المحدثين في تتبع أحوال الرواة. فكان لزاما أن يتحدث عن أحوال الرواية بدءًا من تحملها إلى أدائها مع الإشارة إلى طرق كل منهما.
وأفرد الباحث الفصل الثالث (243- 355) للحديث عن الوضع والكذب، وعلاقته بالوضع التاريخي، مع الإشارة إلى أثر الوضع والاختلاف في الحديث على العقيدة والحضارة، ومدى تأثيره على الأمة ضاربا لذلك بعض الأمثلة.
أما الفصل الرابع (ص 357- 434) فتناول الحديث عن الجرح والتعديل وتطوره وأهميته وضوابطه، مشيرا في ثنايا ذلك إلى عدالة الصحابة وحكم غِيبَة الراوي، ومدى حدود الجرح الجائز، مع الكشف عن ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها.
وكان الفصل الخامس (ص 435- 519) في علم العلل وصعوبة معرفة هذا الفن، حيث عرفه وذكر ميدانه وغايته وأشهر علمائه، وعرف العلة وأسبابها مع بيان وسائل الكشف عنها، وأنواعها المتعلقة بكل من السند والمتن.
والفصل السادس (ص 521- 594) خصّه لبحث التعارض والترجيح، حيث استهله بالحديث عن مفاهيم وقواعد في التعارض والترجيح، وعن أسباب كل منهما، مع التنبيه إلى جواز وقوع التعارض في أخبارِ مَن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما حدد شروط التعارض وأركانه وحكمه، وكيفية الجمع والتوفيق بين النصوص المتعارضة ومواقف العلماء في ذلك، مع ذكره لمراتب هذا الجمع، ثم ذكر النَّسْخ وأنواعه، وبعدها بيَّن الترجيح وطرقه وأنواعه ومتى يصح؟
وختم هذا الفصل بالحديث عن قواعد الأئمة الفقهاء وصلتها بالتعارض والترجيح، مع بيان العلاقة بين التاريخ والعلوم الشرعية، وبيان ميزات التاريخ الإسلامي عن غيره، وبعد هذا مثَّل الباحث في هذا السياق بتطبيقات القواعد الفقهية على الروايات التاريخية.
والفصل السابع (ص 595- 724) استهله الباحث بتطبيقات على روايات تاريخية في عهد الصحابة رضي الله عنهم، امتزجت بأخبار ضعيفة وموضوعة. ثم انتقل الباحث إلى عصر التابعين، ذكر أوله بيان الفرق بين الخلافة والإمامة والملك، وذكر بعد هذا ثلاثَ وقائعَ طالتها أقلام المغرضين بالتشويه، واستغلت أحداثها في النيل من الإسلام وأهله. ثم ذكر بعد ذلك عصر أتباع التابعين، مع ذكر ما زُوِّرَ في ذلك، واستغله أعداء الإسلام لتشويه صورته، حتى انطلت شعاراتهم على كثير من المسلمين الذين لا يميزون الثابت الصحيح عن غيره.
وختم هذا الفصل بالحديث عن رواية مكذوبة حول كتاب المعتضد في شأن بني أمية، ولعنه لمعاوية رضي الله عنه، وإن لم يُشر الباحث في فهرس كتابه لهذه القضية مع أنه أوردها في سبع صفحات.
وفي خاتمة البحث ذكر الباحث النتائج التي توصل إليها كان منها:
– أن التاريخ الإسلامي هو ركام وأكداس من الحوادث، جمعها الأقدمون بطريق الإسناد خلال القرون الثلاثة الأولى، وفيها الصحيح وما دونه، وأن رواتها تختلف اتجاهاتهم العقدية والسياسية والاجتماعية، مع تباينهم في الدقة والاتجاه والأسلوب.
– أن المواد التاريخية رغم كثرتها فهي منتشرة ومبثوثة في ثنايا كتب الحديث والتاريخ والتراجم والتفسير والأدب، وفي صحيحها غُنية في تغطية أحداث هذه القرون الثلاثة.
– يمكن انقاذ التاريخ الإسلامي وتخليصه من الدسائس والأباطيل لتلك القرون، مع شيء من المرونة والدقة في التعامل مع مناهج المحدثين.
– يمكن تقسيم الروايات التاريخية إلى صحيح وحسن وضعيف مع معظم أحداث القرون الثلاثة.
وأعقب الباحث الخاتمة بستة ملاحق (ص 729- 754)، لم يشر في مقدمة بحثه إلى الغرض من ذكرها، ولم تظهر لنا مناسبتها لهذا البحث!
- ملاحظات إجمالية على الكتاب:
- عدم تحرير القول في تطبيق منهج المحدثين، مع أن هذا هو لب البحث.
- لم يذكر الباحث أثر الروايات المكذوبة على التاريخ.
- كان الأولى للباحث أن يفرد فصلا مستقلا يذكر فيه نماذج من تعامل العلماء مع الروايات التاريخية، وكيف طبقوا القواعد المختلفة عليها قبولا وردًّا.
- لم يتطرق الباحث إلى الدراسات السابقة في هذا الموضوع، وقد أشرنا لشيء في أول الكلام.
- أطال الباحث في بعض المباحث فيما كان حقه الاختصار أو عدم الذكر لعدم مناسبتها؛ وعلى سبيل المثال:
- المبحث الأول من الفصل الثاني، حيث توسع في النقل فيما يتعلق بالرحلة في طلب الحديث.
- كما توسع في المبحث الثالث من الفصل السابع فيما يتعلق بقضية الشراب، حيث أسهب في تعريف الخمر والشراب والنبيذ وتوسع في ذكر الخلاف الفقهي في النبيذ توسعا ملحوظا.
- أسهب الباحث في بعض التعاريف والحدود المتعلقة ببعض المصطلحات والتقسيمات التي ليست لها أهمية كبيرة في لب الموضوع.
- ذكر الباحث في الهامش ما كان حقه أن يوضع في صلب الكتاب، ومثال ذلك:
- تحديد عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم، والأقوال في ذلك، فكان الأحرى أن يخصه بمبحث مستقل لتعلقه بالقرون الثلاثة الأولى المذكورة في عنوان الكتاب، ويسلط الضوء على الراجح من المرجوح من الآراء.
- أشار إلى بطلان الخبر المتعلق بشرب إبراهيم بن ماهان الموصلي الخمر مع ابني المهدي: الهادي والرشيد، مع أن سبب إيراده لها هو تفنيدها وتطبيق منهج المحدثين النقدي عليها.
- قلة الأمثلة التطبيقية في نقد الروايات التاريخية، حيث اقتصر على مثالين في عصر الصحابة، وثلاثة في عصر التابعين، وعلى مثلها في عصر تابعيهم.
- كثرة الأخطاء الطباعية.
وبعد، فهذه إطلالة على كتاب: “مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية للقرون الهجرية الثلاثة الأولى” للدكتور إبراهيم الشهرزوري البغدادي، وعرض لفصوله وأبوابه، كان الغرض منها إبراز معالم ما قدمه الباحث في هذا السبيل، وتقويم الدراسة تقويما معتدلا بذكر أهم الملاحظات التي تخللت البحث، والتمهيد لأهمية هذا المبحث الذي لم يستوف حقه حتى الآن من وجهة نظرنا، وإن كانت الجهود المتفرقة لو جمعت لمثلت بحثا متكاملا. وذكرنا أيضا طرفا من الدراسات في الباب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.