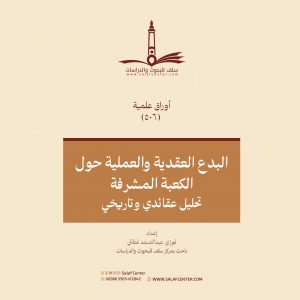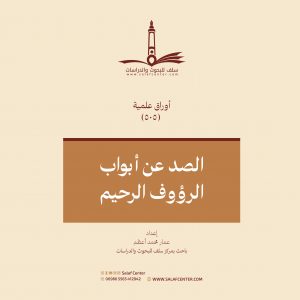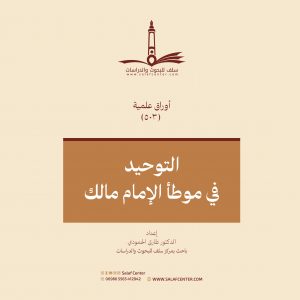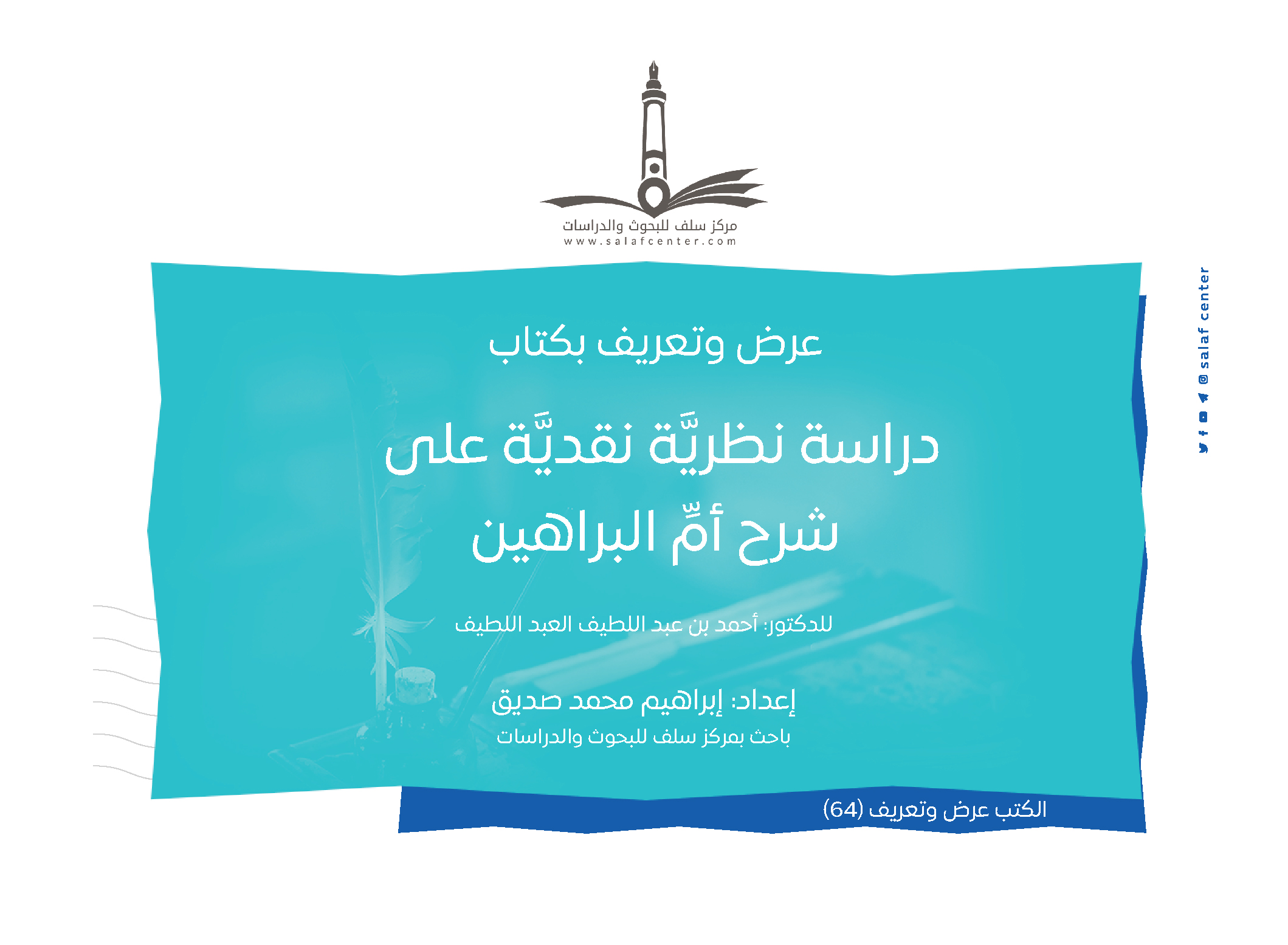
عر ض وتعريف بكتاب:دراسة نظريَّة نقديَّة على شرح أمِّ البراهين
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
تمهيد:
يعدُّ أبو عبد الله محمَّد بن يوسف السّنوسي (ت: 895هـ) أحدَ أبرز علماء الأشاعرة، وكان لكتبه الشَّأن الكبير في الدَّرس العقديّ الأشعريّ المعاصر، والمطَّلع على كتبه يجدُ أنها تمثّل متونًا عقديَّة تعليمية؛ ولذلك حظِيت باهتمامٍ كبير، وتُدَرَّس وتقرَّر في معاهد الأشاعرة المعاصرين ومدارسهم، وله مؤلّفات عديدة، من أهمَّها:
- عقيدة أهل التوحيد المخرجة بعون الله من ظلمات الجهل وربقة التقليد المرغمة بفضل الله أنفَ كل مبتدعٍ عنيد = العقيدة الكبرى.
- شرح العقيدة الكبرى.
- العقيدة الوسطى، وشرحها.
- أم البراهين = العقيدة الصغرى.
- شرح أم البراهين.
- صغرى الصغرى.
- صغرى صغرى الصغرى = الحفيدة.
وغيرها من الكتب.
ودراسة هذه الكتب لها أهميَّة بالغة للمهتمِّين بعلم العقيدة عمومًا، وللمهتمين بالمذهب الأشعريّ بالخصوص، ومن هنا جاءت أهميَّة هذا الكتاب الذي نستعرضُه هنا، فالكتاب الذي نستعرضه هو قراءة نقدية لكتاب “شرح أمّ البراهين” للسنوسي.
بيانات الكتاب:
عنوانه: دراسة نظريَّة نقديَّة على شرح أم البراهين لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني.
مؤلّفه: د. أحمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف.
اعتنى بإخراجه: د. مازن بن محمد بن عيسى.
طبعته: الطبعة الأولى، 1442هـ/ 2021م.
حجمه: مجلد واحد من 477 صفحة.
الموضوع العام للكتاب:
يظهر من عنوان الكتاب أنَّه عبارة عن دراسة نقديَّة لكتاب “شرح أم البراهين للسنوسي”، وهذا الأخير كتابٌ عقديٌّ أشعريٌّ ذكر فيه المؤلف عقيدته واستدلَّ لها، وهو شرح لكتابه أمّ البراهين المسمَّى بالعقيدة الصغرى، والكتاب لم يبوِّبه المؤلّف السنوسي، بيد أنه بعد التأمل يمكننا أن نعلم أنَّه مقسَّم إلى خمسة أقسام، وهي:
1- مقدمات.
2- صفات الله سبحانه وتعالى.
3- وجود الله.
4- النبوة.
5- الشهادتان.
فعلى هذه المحاول الخمسة يدور الكتاب، وجاء مرتبًا على هذا إلا في بعض المواضع كذكره لبعض الصفات بعد مبحث وجود الله.
وقد بدأ المعتني بالكتاب ببيان أهميَّة شرح أم البراهين للسنوي فقال: “فعقيدة السنوسي “أم البراهين” حظيت باهتمامٍ بالغٍ تمثَّل في تقريظها نظمًا ونثرًا، ومَنح الإجازات على قراءتِها وسماعها وتعلّمها، ووفرة الشروح والحواشي والتعليقات والمنظومات عليها، وكثرة الإقبال على نسخها، حتى بلغ عدد نسخها في الخزانة الحسينية فقط أربعين نسخة، وتجاوز عدد نسخ شرح مؤلّفها خمسين نسخة في الخزانة نفسها”([1]). ويبيِّن سبب الاهتمام بهذا الكتاب فيقول: “وإنَّما كان هذا الاهتمام البالغ بها لأنَّها حوت زبدةَ الكلام الأشعريّ، فيستغني من طالعها وحفظها ودرسها عن كبار الدَّواوين في علم الكلام كما يقولون”([2]).
وقد جاءت هذه الدراسة من الدكتور أحمد بن عبد اللطيف في قراءة هذا الكتاب المهم في المدرسة الأشعرية ونقده، وذلك بعرضها على الكتاب والسنة كما يقول: “ونحن سندرس ما كتبه دراسةً موضوعيَّةً بعيدةً عن التشنُّج والتعصّب، هدفنا فهمُ كلامه، ثم عرضه على الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، ومعرفة مدى قربه أو بعده عن المنهج الحق”([3]). وقد كان الدكتور أحمد يعرض قطعة من نصِّ السنوسي، ثم يبدأ بشرحها وبيان مجمل معانيها، ثم بيان ما على النص من ملاحظات بطريقة مرتّبة، ومع أن الشرح ليس هو الغرض الأساس، إلا أن الدكتور قد بسط عبارات السنوسي، وبين المعنى الإجمالي للنَّص، فهو ليس مجردَ قراءة نقدية يوقِف القارئ على مواطن النقد في الكتاب، بل هو أيضًا مساعدٌ لتصوّر المذهب الأشعري بدراسةِ واحدٍ من أهمِّ متونه وفهمه.
النظرة التفصيلية للكتاب:
مقدمة المعتني بالكتاب:
بدأ المعتني ببيان أهمية أم البراهين، وأنَّه لقي قبولًا واسعًا حتى كثرت شروحه وحواشيه، وأنَّ السنوسي له حظوةٌ واسعةٌ عند أتباعه ومريديه، ومع ذلك فقد عورض في عددٍ من المسائل؛ كمسألة إيمان المقلّد والتي عارضه فيها أحمد بن زكري التلمساني، وبيّن المعتني أنَّ هناك من يعدُّ عصر السنوسية أهمَّ مرحلة من مراحل تطوّر المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي بالخصوص؛ بل يقولون: هي مرحلة التراكم المعرفي الكبير في المؤلفات العقديَّة، بينما يرى آخرون أنَّ المرحلة السنوسيّة تمثل نوعًا من التراجع في علم الكلام الأشعريّ مع وجود تطورٍ كمِّيّ على مستوى المصنفات.
وقد بينتُ سابقًا أن الكتاب يمكن تقسيمه إلى خمسة أقسام، سأستعرض الكتاب بناءً عليها:
1- المقدمات:
تطرَّق الدكتور في المقدمة إلى مسائل مهمَّة مثل أكثرية الأشاعرة، ومدى قرب الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، كما بيَّن مراحل الأشاعرة، وذكر أنَّ الحكم عليهم كلّهم في بعض القضايا لا يمكن أن يكون دقيقًا؛ لأنَّ موقفهم اختلف من مرحلةٍ لأخرى، وبيَّن مخالفة الأشاعرة لمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال والسببيَّة وما إلى ذلك، ثم تطرق لقضية مهمَّة وهي: أنَّه يمكن أن يجتمع في الشخص علم كلام وتصوّف، وكثير من علماء الكلام كان لهم توجّه صوفي، وفي آخر هذا الكتاب يبيِّن الدكتور بوضوح أثر التصوّف على السنوسيّ نفسه عند عرضه لكلمة التوحيد وذكر فضائله وطريقة ذكره، حيث أخذ أو تأثر بالمنهج الصوفي.
ثم عرج الدكتور إلى أثر علم الكلام على العقائد، وذكر أثره السيّئ على العقيدة، وأنه مخالف لمنهج السلف، وأن علم الكلام بالنظر إلى مؤدّاه كلّه بدعيّ.
ومما يميِّز الكاتب أنَّ قراءته لشرح أم البراهين ليست مقتصرة على الجوانب التفصيلية؛ بل كثيرًا ما يذكر الدكتور الأخطاء المنهجية والتناقضات، وذكر في المقدمة أن السنوسيّ يرى أن إثبات الرسالة مبنيّ على إثبات الْمُرسِل، فالأركان عنده ثلاثة: مُرسِل ورسولٌ ورسالة، ولا يُؤخذ من الرسول إلا بعد ثبوت المُرسِل، إلا أنَّ هاهنا مأخذين كما يرى الدكتور، وهما:
1- أنَّنا سنجد خللًا يتطرق إلى منهجه عند التَّطبيق.
2- أنَّ منهجه غير واقعيّ، وبعض تقريراته تصطدم مع الواقع([4]).
ومن المسائل التي تطرق لها في المقدمات: أنَّ مؤلّف أمِّ البراهين لا يرى إلا السبب الشرعي دون العقلي([5])، وبين الدكتور أنَّ مذهبهم في إنكار هذا مكابرة منهم؛ إذ يجعلون إحراق النَّار مثلًا ليس سببًا، وإنما هو حكم عاديّ مقترن فقط، وبيَّن الدكتور بطلان مذهبهم هذا من خلال القرآن الكريم وإثبات القرآن للأسباب، ومن العجيب أنَّ السنوسي حكم على من يثبت الأسباب بأحكام عظيمة كقوله: “وقد غلِط قوم في تلك الأحكام العادية، فجعلوها عقليَّة… فأصبحوا وقد باؤوا بهوسٍ ذميمٍ وبدعةٍ شنيعةٍ في أصول الدين وشركٍ عظيم”([6])، وسيأتي أن السنوسي يذكر هذا من ضمن أصول الكفر.
ومن المسائل التي تمَّ التطرّق لها في المقدمات: قضية “الظلم” عند السنوسي، وقد بيَّن الدكتور أنَّ مفهومه عنده خطأ، والقرآن على عكس ذلك، وذلك حين جعل السنوسي تعذيب الطَّائع الذي لم يعص الله قطّ طرفة عين من الجائز النَّظري عقلًا، وهذا غير صحيح بهذا الإطلاق، فتعريف الظلم الصحيح فيه أنه: وضع الشيء في غير موضعه، والذي يجعل مذهب السنوسي خطأً هو أنه بنى مذهبه على نفي الحكمة والتعليل، أما عند أهل السنة والجماعة فحكمته تأبى عذاب الطائعين.
ومن المسائل المهمّة في المقدمات: مسألة أول واجب على المكلف، وقد ذكر السنوسي اختلاف المتكلمين في أول واجب بين النَّظر والقصد وغير ذلك. وبيَّن الدكتور أن هذا ينتابه أمران:
1- أنَّه مصادمٌ للواقع؛ فلا يوجد أحد يقول لابنه حين يبلغ: اذهب وانظر!
2- ما ترتَّب على المسألة من الاضطراب في بيان حكم من لم ينظر؛ فمنهم من يقول: هو عاصٍ، ومنهم من لا يقبل إيمانه([7]).
وقد بين الدكتور عددًا من الإشكالات في هذه القضية منها: أنَّ السنوسي يقع في الدَّور في الإيجاب الشرعي للنَّظر؛ لأنه يقول: لا يوجد إلا الواجب الشرعي، ولا وجود للواجب العقلي، والنَّظر واجبٌ قبل أن يثبت الشارع، فهذا دور، ويرى الدكتور أنَّ هذا مجرد تنظيرٍ يصطدم مع الواقع، وذلك أنَّ عامَّة الناس لا يفعلونه، فلا يوجد من يأمر ابنه عند البلوغ بالنَّظر؛ بل يأمرونه بالصلاة لسبع لأنَّ إيمانه كافٍ ومقبول، ويبين الدكتور أنَّ المتكلمين لديهم خللٌ في تصور التقليد؛ فهم يتصوَّرون أنَّ عامة الناس على التَّقليد المحض، والأمر ليس كذلك؛ بل هم على الدليل الفطري، فلديهم الفطرة الصحيحة التي تنافي مجرد التقليد؛ ولذلك ينظرون في الآيات والبراهين الكونية، ويكفيهم ذلك؛ لأن معرفة الله مغروسة في الفِطر.
وقد أطال السنوسي الكلام في النظر، وتعبه الدكتور، وبين التناقض ومصادمة كلامهم للشرع؛ لأن الشرع دعا للتوحيد لا النظر، كما أن كلامهم مصادمٌ للواقع.
2- صفات الله سبحانه وتعالى:
بدأ السنوسي بذكر صفات الله سبحانه وتعالى، وقد أطال الكلام فيها([8])، وبين الدكتور في بداية هذا الباب أنَّ ذكره للصفات هنا مخالفٌ للمنهج الصحيح في التَّأليف عند الأشاعرة بالخصوص، فإنَّه لم يُثبت أدلة وجود الله بعدُ حتى يتحدّث عن صفاته، وكان الأولى أن يقدّم كلامه عن وجود الله ثم يتكلّم عن صفاته.
وذكر السنوسي عشرين صفةً، بيَّن الدكتور أنَّها ترجع إلى سبع صفات، وفي هذا الباب تفاصيل وتقسيمات عرضها السنوسي وشرحها الدكتور وعلَّق عليها، كما ذكر السنوسي ما يناقض هذه الصفات العشرين وهي المستحيلة على الله؛ كالعدم والحدوث وطروِّ العدم والمماثلة للحوادث والجهل، وبين الدكتور ملاحظاته كلها عند عرضها.
كما تطرق السنوسي في هذا القسم إلى مسألة الصلاح وفعل الأصلح، وذلك ردًّا على المعتزلة، وبين الدكتور خطأ الطائفتين في المسألة، وبين المذهب الحقّ عند أهل السنة والجماعة.
3- وجود الله:
بدأ السنوسي بقضية وجود الله، ولم يطل فيها كما أطال في الصفات([9])، وقد بدأ بدليل الحدوث كما هو معلومٌ في استدلال المتكلمين، وقد رجع السنوسي إلى قضية السببية هنا وبين الدكتور خطأ قولهم، وأن قولهم يلزم منه بطلان إثبات وجود الله، وقد تطرق الدكتور إلى بدعية هذا الدليل ومخالفته للمنهج القرآني.
ورجع السنوسي إلى قضية الصفات، وبدأ يذكر أدلة أربع صفات وهي: القدرة والإرادة والعلم والحياة، وأن الدليل على ذلك هو أنَّه لو انتفى شيءٌ منها لما وجد شيء من الحوادث، ثمَّ ذكر أن برهان صفة السمع والبصر والكلام هو الكتاب والسنة والإجماع، وأنه لو لم يتَّصف بها لاتَّصف بأضدادها، ويذكر الدكتور أنَّه في هذا يخالف الأشاعرة، فهم يجعلون السمع والبصر أدلتها عقلية لا سمعية.
4- النبوَّة:
بدأ السنوسي بعد ذلك في بيان ما يجب للأنبياء([10])، فبين أنَّه يجب في حقهم الصدق والأمانة والتَّبليغ، ويستحيل عليهم أضدادُها، وذكر الدكتور ما وقع فيه المتكلِّمون من خطأ في موضوع العصمة، حتى نفوا أخطاء الأنبياء وتأوَّلوا ما ورد في القرآن من بيان أخطائهم؛ مثل قوله تعالى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 37]، وقوله: {وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24]، وقوله: {عَبَسَ وَتَوَلَّى} [عبس: 1].
ومن المسائل التي ذكر الدكتور خطأها قولهم: إنَّ إرسال الرُّسل من الجائزات على الله، بينما يرى الدكتور أنَّ هذا منافٍ لحكمة الله الذي يقول: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون: 115]، يقول الدكتور: “فمن قال: إنَّ هذا جائز ويمكن ألا يبعث الله رسولًا فكأنَّه يجيز نفي الحكمة عن الله… ونحن لا نقول: إنَّه واجب عقلًا كالمعتزلة، بل هو واجبٌ من مقتضى صفات الله أنَّه الحكيم”([11]).
وختم السنوسي هذا الباب بذكر المعجزة، وذكر الدكتور خطأ حصر أدلة النبوة عليها، كما بين عددًا من الأخطاء التي وقعت فيها الأشاعرة في مبحث المعجزة.
5- الشهادتان:
بدأ السنوسي بعد هذا في تفسير كلمة التوحيد “لا إله إلا الله، محمد رسول الله”، وتكلم عنها من سبع جهات، وهي: 1- ضبطها، 2- إعرابها، 3- بيان معانيها، 4- بيان حكمها، 5- بيان فضلها، 6- كيفية ذكرها على الوجه الأكمل، 7- بيان الفوائد التي تحصل لذاكرها.
وقد ذكر الدكتور بعض المآخذ على تفسير السنوسي ومباحثه حول هذه الكلمة، فمنها: أنَّ ما قرره في عقيدته من نفي الحكمة أدخله في مفهوم كلمة إله، وهذا غير صحيح.
ومنها أنَّ السنوسي قال: “حقيقة الإله هو الواجب الوجود المستحق للعبادة”([12])، قال الدكتور: “ليس هو المفهوم لمعنى الإله عند العرب… والإله هو المعبود”، وقولهم: إنَّه واجب الوجود هو معنى صحيح؛ فالإله الحقّ واجب الوجود، لكنَّا أولًا نبحث عن الكلمة عند العرب، ومعناها عند العرب: المعبود، وقد بين الدكتور -في أكثر من موضع- أنَّ المتكلمين مع الصوفية ساهموا في انتشار الشِّرك، وذلك من جهة أنَّ المتكلّمين كان جلّ اهتمامهم ينصبُّ على توحيد الربوبية لا الألوهية.
وذكر السنوسي قضية مهمة في الكتاب وهي: أصول الكفر الستة، وذكر أنها: “الإيجاب الذاتي، والتحسين العقلي، والتقليد الرديء، والربط العادي، والجهل المركّب، والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية”([13]) يقول الدكتور: “أصول الكفر التي ذكرها منها ما هو صحيح كقول الفلاسفة، ومنها ما هو باطل كإدراج مذهبه في السببية”([14]). ثم بين السنوسي هذه الست واحدة واحدة.
وبين الدكتور أن الأول منها وهو: الإيجاب الذاتي عند الفلاسفة بجعل الله علةً تستلزم معلولها دون اختيار منه؛ أنَّ هذا كفر.
أمَّا الثاني -وهو: التحسين العقلي- فقد بيَّن الدكتور أن الأشاعرة هم من وقعوا في الخطأ في نفيه بالكلية، مع خطأ المعتزلة أيضًا.
أمَّا الثالث -وهو: التقليد الرديء- فهذا خطأ من السنوسي أيضًا، فقد شبه تقليد المشركين بما عليه أهل الإيمان، وهذا غير صحيح؛ فإنَّ أهل الإيمان معهم الفطرة الصحيحة.
أمَّا الرَّابع -وهو: الربط العادي- فقد بيَّن الدكتور أنَّ هذا من خطئه البيِّن؛ لأنه أراد أن ينفي السببية ويجعل الإيمان بها سببًا للكفر؛ بل هي سبب للإيمان بالله تعالى.
أمَّا الخامس -فهو: الجهل المركب- وهذا كلام عامّ، فهو يقع منهم ومن غيرهم.
أمَّا السادس -وهو: التمسُّك بظواهر النصوص- فهذا باطل أيضًا، أي: أن يكون من أصول الكفر، بل الواجب فهم النصوص على ظاهرها.
ثم أكمل السنوسي كلامه على كلمة التوحيد، وأنَّها حوت كل شيء، والدكتور يرى أنَّ اعتقاد أنَّ كل العقائد نابعة من هذه الكلمة فيه نظر؛ لأنَّ كلمة التوحيد يراد بها إفراد الله بالعبادة، وما بعد ذلك من خصائص الله وصفاته مبثوثة في القرآن والسنة.
وختم السنوسي كتابه بذكر فضل كلمة التوحيد، وطريقة ذكره على الوجه الأكمل، والفوائد التي يحصل للإنسان عند ذكرها، وبيَّن الدكتور أن في كلامه خلطًا كبيرًا بالتصوُّف وذكرًا لطرقٍ وأعدادٍ لم ترد في الكتاب والسنة.
أفانين:
بعد استعراض الكتاب هنا بعض الوقفات معه:
أولًا: الكتاب مهمٌّ من جهة أنَّه يعطي تصورًا عن المذهب الأشعري المعاصر في هذه القضايا التي ذكرناها، وهذا يمكن الحصول عليه بدراسة المتون الأشعرية، لكن مثل هذا الكتاب مهم لغير المختص بالذات لسببين:
1- لأنَّه يقدم شرحًا مبسطًا لمسائل الكتاب، فالكتاب ليس مجردَ نقد، وإنما هو شرحٌ ثم إبداء ملاحظات.
2- أن غير المتخصّص الذي يريد الدخول إلى معرفة العقائد الأشعرية يستحسن له الدخول عبر هذه الكتب؛ لأنها تعرض المذهب وتبيّن الملاحظات عليه في آن واحد. وهذا ما تميز به كتاب الدكتور، فقد جاء شارحًا بطريقة سهلة بسيطة، كما جاء مبينًا لأبرز الملاحظات المنهجية والتفصيلية.
ثانيًا: كان الدكتور يحرص على ذكر تناقضات الأشاعرة، أو تناقضات السنوسي في كتابه، من ذلك مثلًا أنَّه يبين أنَّ السنوسي يقرر أنَّ النُّبوة لا تتوقف على إثبات السمع والبصر والكلام لله، بينما يقرر في موضعٍ آخر أنَّ النبوة لها تعلق بكلام الله([15])، ومن ذلك أنَّ السنوسي يقول: “إنَّ لله أن يفعل ما يشاء”، وذلك في قضية نفي الحكمة والتعليل، ثم يأتي ويقول: “إنَّ الله يجب عليه أن يصدق النبي بالمعجزة”([16])، وفي هذا يقول الدكتور: “ووجه الخلل أنَّه قرَّر سابقًا أنَّ فعل الله جائز ولا يجب عليه شيء، فيقال له: من أين أوجبت عليه تعالى أن يصدق النبي؟! فلو جاء كذَّابٌ وادَّعى النبوة وقال: أنا نبي وهو ساحر؛ فأنت ترى أنَّ الله تعالى يبطله ولا يمكِّنه منه، فيقال لك: من أين لك أنه يبطله ولا يمكنه منه؟! أليس جائزًا على مذهبك أن يفعل الله تعالى ما يشاء لأنَّه لا شيء واجب عليه تعالى؟!”([17]).
ثالثًا: بين الدكتور في عدد من المواضع عددًا من الإلزامات على السنوسي.
رابعًا: لم يكن قصد الدكتور نقد الأشاعرة في الأصل، ولذلك يعرض معتقد السنوسي، وقد يتعرض للأشاعرة في بيان أن السنوسي تأثر بمذهبه في مسألةٍ ما عند حكمه على مسألة أخرى، ومما يبينه في هذا الكتاب: مخالفة السنوسي للأشاعرة في بعض القضايا، مثل أن إثبات السمع والبصر والكلام لله يكون بالدليل السمعي عند السنوسي خلافا للمتكلمين الذين يرون الدليل عليه عقليًّا.
خامسًا: أنصف الدكتورُ السنوسيَّ، وقد كان يذكر له بعض العبارات التي تحتمل وحدة الوجود ثم يقول: “إنَّ السنوسي نفى ذلك في عقيدته”([18])، بل ينصف الأشاعرة عمومًا، وكان يذكر تقسيمات السنوسي في عددٍ من القضايا ويقول: “وهذه التقسيمات عمومًا صحيحة لكن بعض أمثلتها غير صحيحة”([19]).
ويقول الدكتور بعد كلامٍ للسنوسي في التحذير من كتب الفلسفة: “هذا كلامٌ جيد من المؤلف، وهو التحذير من كتب الفلاسفة ومن كتب المتكلمين الذين تأثروا بهم”([20]).
وحين ذكر السنوسي ترك صفة إدراك الله للطعوم والروائح لما فيها من خلاف، قال الدكتور: “هذا كلامٌ طيبٌ جميل؛ ولكن ليته فعل ذلك في باقي الصفات واقتصر على ما أجمعت عليه الأمة”([21]).
وبين أنَّ عرضه لدليل الحدوث اتَّسم بالبساطة، على عكس المتكلمين الذين يقدّمونه بتعقيد، إلى غير ذلك من المواضع.
سادسًا: من منهجيّته في الكتاب أنَّه لا يقتصر على الأخطاء التفصيلية، بل يذكر الأخطاء المنهجية، فيذكرها بعد النصّ مباشرة، أو يذكر الأخطاء التفصيلية ثم يقول: والخلاصة… فيذكر الأخطاء المنهجية.
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 10).
([2]) دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 10).
([3]) دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 6).
([4]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 46).
([5]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 54).
([6]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 58).
([7]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 99).
([8]) بدأ الكلام فيه من صفحة 134 إلى 268.
([9]) بدأ الباب من صفحة 272 حتى صفحة 310.
([11]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 317-318).
([12]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 370).
([13]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 402).
([14]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 402).
([15]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 320).
([16]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 330).
([17]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 330).
([18]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 28).
([19]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 62).
([20]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 132).
([21]) ينظر: دراسة نظرية نقدية على شرح أم البراهين (ص: 205).