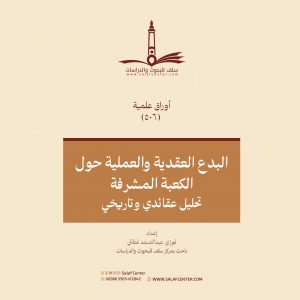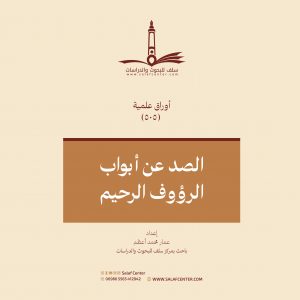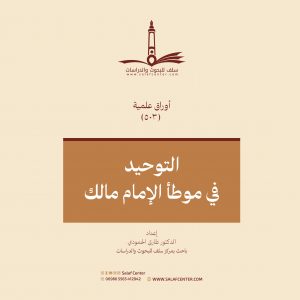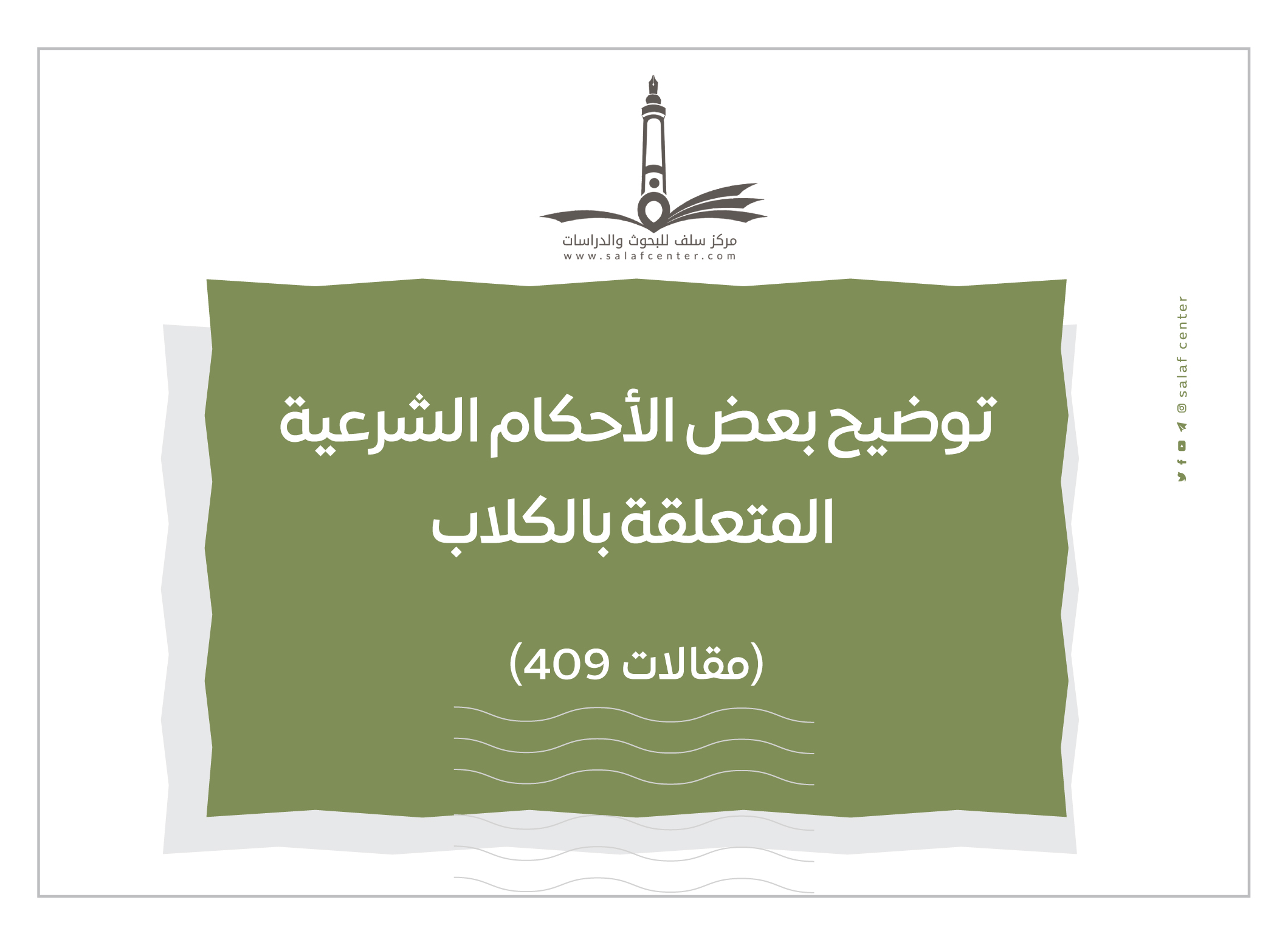
توضيح بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالكلاب
المفهومُ مِن لغة الشرع وأحكامِه تعظيمُ الأرواح واعتبارُ كلِّ أمة منها مخلوقة لله عز وجل ولحكمةٍ ما خُلِقت، علِمها الإنسان أو جهِلَها، ومن ثَمَّ فإن الشرع الحكيم ينفِي مطلقًا أن يُخلَق مخلوقٌ لشرٍّ محضٍ لا خيرَ فيه، أو أن يكون وجودُه مطلقًا شرًّا لا خير فيه، فذلك يتنافى مع حكمةِ الباري سبحانه وتعالى، وهو ما نَفَته الشريعة ونزَّهت عنه الخالق سبحانه.
والكِلاب أمَّةٌ من الأمم التي تعيش مع البشريَّة في هذه الأرض، ولها ارتباط بها من جهة كونها أليفةً، ومن جهة ما تحتاجُه البشرية فيها من صيد وحراسة وغير ذلك من المنافع، وقد أَشكَل على بعض النَّاسِ أمرُ الشارع الحكيم بقتلها أو قتل بعضِها وتحريم بَيعِها، واتَّخذ بعضُ المفتونين هذه الأحكام وسيلة للطعن في الشريعة وتكذيب النبوة، ونحن في هذا المقال بعون الله تعالى نبيِّن حقيقةَ هذه الأحكام في الشريعة؛ لنزيل ونرد المتشابه إلى المحكم. وقبل الخوض في هذا نبين بعض القواعد الحاكمة للبحث الشرعي في مثل هذه المسألة:
قواعد حاكمة للبحث الشرعي:
أولا: جميع الأحكام الشرعية منسجِمة مع القوانين الكونية الحاكمة لسير الكون وتدبيره من الله، فما خُلِق فهو لحكمة، لَن يُؤمر بإفنائه إلا لحِكمةٍ أُخرى، أو لأن الغاية من وجوده قد انتهت، سواء في ذلك البشر والحيوان والنباتات.
ثانيا: أمر الشريعة بالقتل لأي مخلوق إنسانا كان أو حيوانا هو لضرره ومفسدته، ولا يلزم من هذا أنه لا منفعة فيه مطلقا؛ لكن هذا الأمر لم يتَّجه إلى تلك الجهة بل اتجه إلى الغالب في هذا المخلوق وهو الضرر؛ ولذا أتت أوامر الشريعة آمرة بقتل الإنسان قصاصا أو حدًّا، وبقتل الحيوان المفترس ثعبانا أو أسدا أو ذئبا لهذا المعنى، أما إذا خلا منه بأن لم يكن مفترسًا أو أَلِف البشر ولم يضرَّهم فإن الشريعة لا تأمر بقتله.
ثالثا: لا بد من التفريق بين الأحكام الآنيَّة أو المخصوصة بزمان أو مكان وبين الأحكام الراتِبَة العامة، فقَد تأمُر الشريعة بأمرٍ لمصلحةٍ في وقت معيَّن ثم تنسخُه، فالعبرة بالخطاب اللاحق وليس بالسّابق، وبالحكم الراتب المحكم وليس بالحكم الآنيِّ المنسوخ.
إذا تبين هذا بقي أن نعرف حقيقةَ النهي عن بيع الكلاب وعن اقتنائها، وحقيقة الأمر بقتلهم:
حكم اقتناء الكلاب والتفصيل فيه:
لقد نهت الشريعة عن اقتناء الكلاب لعلَّة هي أذيَّتُهم للناس بإخافتهم وكثرة النّباح المزعج، فقد روى حماد بن زيد عن واصل مولى أبى عيينة قال: سأل سائلٌ الحسنَ فقال: يا أبا سعيد، أرأيتَ ما ذكر في الكلب أنه ينقُص من أجر أهلِه كلَّ يوم قيراط، بم ذلك؟ قال: لترويعِهِ المسلم([1]).
ثم أذِنت فيما فيه منفعةٌ وأخرجته من النهيِ، قال عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ كُلَّ يَوْمٍ»([2]). وقد بيَّنت الشريعة حكمَ هذا الاقتناء ومقصدَه، وهو المنفعة، فقد ورد في الموطأ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»([3]). ويدخل في معنى الزرعِ الضرعُ ومنافعُ البادية كلّها. وقد سئل هشام بن عروة عن اتخاذ الكلب للدار، فقال: لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة([4]). فيتبين بهذا أن النهي عن الاقتناء مشروط بعدم المنفعة المرجوة، فإذا وُجدت فلا نهي وهذا محل اتفاق.
حكم بيع الكلاب:
اختلف الناس في بيع الكلاب لذات العلة وهي النهي عن اقتنائها وتنصيص السنة على حرمة ثمنها، فعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ البغي، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ([5]).
فاختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب بناء على هذا الحديث، فكرهه مالك مطلقا([6])، قال ابن عبد البر: “وَأَمَّا ثَمَنُ الْكَلْبِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ قَوْلِ مَنْ نَهَى عَنْهُ وَحَرَّمَهُ، وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مالك في موطئه: أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي وَغَيْرِ الضَّارِي؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثَمَنِ الْكَلْبِ. رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ. قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الْكِلَابِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقْتَنَى كَلْبُ الصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ إِجَازَةُ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ، فَوَجْهُ إِجَازَةِ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ وَمَا أُبِيحَ اتِّخَاذُهُ مِنَ الْكِلَابِ أَنَّهُ لَمَّا قُرِنَ ثَمَنُهَا فِي الْحَدِيثِ مَعَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وحُلوانِ الكاهِنِ، وهَذا لا إبِاحةَ فِي شَيءٍ منه، فدَلَّ عَلى أنَّ الكَلبَ الَّذي نَهَى عن ثمنه ما لم يُبَح اتِّخاذُه، ولم يدخُلْ في ذَلِك ما أُبيحَ اتِّخاذُه، والله أعلم”([7]).
وقد لخَّص ابن عبد البر حُكمَ بَيعِه فقال: “صَحِيحٌ وَظَاهِرُ الحديث عندي أَنَّ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ لَيْسَ مِنْ أُجْرَةِ الْحَجَّامِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ كَنَهْيِهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَثَمَنِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ نَهْيُهُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ تَحْرِيمًا لِصَيْدِهِ كَذَلِكَ لَيْسَ تَحْرِيمُ ثَمَنِ الدَّمِ تَحْرِيمًا لِأُجْرَةِ الْحَجَّامِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ أُجْرَةَ تَعَبِهِ وَعَمَلِهِ، وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَجَائِرٌ بَيْعُهُ وَالْإِجَارَةُ عَلَيْهِ”([8]).
قال أبو بكر ابن العربي:” ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، واختلفت الرواية عن مالك وعلمائنا بعدَه على قولين، وذلك في كلبٍ يجوز الانتفاع به، فأمَّا كلبٌ لا يُنتَفَع به فلا خلافَ أنه لا يجوز بيعُه ولا تلزَمُ قيمته لمتلِفِه. وقال الشافعي: ثمنُه حرام. وقال أبو حنيفة: ثمنه جائز. ولم يزل مالكٌ عُمرَه كلَّه يقول: أكرهه، وحمل بعض أصحابنا لفظَه على التحريم، وحمله آخرون على أن تركَه خير من أَخذِه على أصل المكروه. والصحيح عندي: جواز بيعِه وحِلِّ ثمنِه؛ لأنها عينٌ يجوز اتِّخاذها والانتفاع بها، ويصحّ تملُّكها بدليل وجوب القيمة على متلِفِها، فجاز بيعُها؛ لأن هذه الأوصاف هي أركانُ صحة البيع، ولولا جوازُ بيعه مِن أينَ كان يوصَل إليه؟! كما لا يوصل إلى سائر الأموال إلّا بالبيع والهبة”([9]).
وإخراج المأذون فيه من دائرة محرم البيع مُصرَّف في كلام المحدثين والفقهاء، ولو استقرأنا كلامَهم وتتبعناه لطال بنا المقام، وحاصل ما عندهم في الباب أنَّ ما جاز اقتناؤُه والانتفاع به جاز بيعه.
قتل الكلاب:
قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمرُ بقتل الكلاب في بداية الإسلام، وذلك لكثرةِ ضرِرِهم على الناس، ثم نُسِخ ذلك الحكم مطلَقا على التحقيق من كلام العلماء، وعلَّة ذلك أنهم مثلَ البشر، خُلِقوا لغايةٍ وعلَّة، فلا يجوز إفناؤهم، قال عليه الصلاة والسلام: «لَوْلَا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ»([10])، وقد سمى الله الحيوانات أمما فقال: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} يُرِيد: أَنَّهَا مِثْلُنَا فِي طَلَبِ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ، وَابْتِغَاءِ الرِّزْقِ، وَتَوَقِّي الْمَهَالِكِ([11]).
ومع أن الحديث بيَّن العلة في ذلك، فقد نصَّ العلماء على هذا المعنى في بقاء الأممِ، قال ابنُ الجوزي: “أمّا أمره بقتل الكِلاب فقد بَقِي هَذَا مُدَّة ثمَّ نهى عَن ذَلِك بقوله: «مَا بالهم وبال الكلاب؟!». وَسَيَأْتِي فِي مُسْند جَابر قَالَ: أمرنَا رَسُول الله بقتل الْكلاب ثمَّ نهى عَن قَتلهَا، وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: «اقْتُلُوا مِنْهَا كل أسود بهيم». وَيَجِيء فِي حَدِيث: «لَوْلَا أَن الْكلاب أمَّةٌ لأمرتُ بقتلها» أَي: لاستَدَمتُ الْأَمر بذلك. وَلَو أَرَادَ الله سُبْحَانَهُ إبْطَال أمَّة لما أَمر نوحًا أَن يحمِل مَعَه فِي سفينَتِه مِن كلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، فَلَمَّا حفظ الحمائر للتناسل علم أَنه أَرَادَ حفظ كل الْأُمَم. وَيحْتَمل قَوْله: «لَوْلَا أَن الْكلاب أمَّةٌ» أَي: خلق كثير يشق استيعابها فِي كلّ الْأَمَاكِن، فَلَا يحصل استئصالها، وَإِنَّمَا أَمَر بقتلها لِأَن الْقَوْم ألِفَوها، وَكَانَت تخالطهم فِي أوانيهم، فَأَرَادَ فطامهم عَن ذَلِك، فَأمر بِالْقَتْلِ، فَلَمَّا اسْتَقر فِي نُفُوسهم تنجيسها وإبعادها نهى عَن ذَلِك، فَصَارَ النَّهْي نَاسِخا لذَلِك الْأَمر”([12]).
وقد تكلَّم العلماء في علة التنصيص على الأسود، ومعنى كونه شيطانًا، قال الخطابي: “مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ إِفْنَاءَ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ وَإِعْدَامَ جِيلٍ مِنَ الْخَلْقِ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ خَلْقٍ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا وَفِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْحِكْمَةِ وَضَرْبٌ مِنَ الْمَصْلَحَةِ: يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا وَلَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِنَّ فَاقْتُلُوا شِرَارَهُنَّ، وَهِيَ السُّودُ الْبُهْمُ، وَأَبْقُوا مَا سِوَاهَا لِتَنْتَفِعُوا بِهِنَّ فِي الْحِرَاسَةِ”([13]).
وقال أبو العباس القرطبي: “«الكلب الأسود شيطان» حمله بعض العلماء على ظاهره، وقال: إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود، ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «اقتلوا منها كل أسود بهيم». وقيل: لما كان الكلب الأسود أشدَّ ضررًا من غيره وأشدّ ترويعًا كان المُصَلِّي إذا رآه اشتغل عن صلاته؛ فانقطعت عليه لذلك، وكذا تأوَّل الجمهور قوله: «يقطع الصلاةَ المرأةُ والحمار»؛ فإن ذلك مبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات؛ وذلك أن المرأة تفتن، والحمار ينهق، والكلب يروِّع، فيتشوَّش المُتفَكّر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد، فلما كانت هذه الأمور تفيد آيلةً إلى القطع جعلها قاطعة؛ كما قال للمادح: «قَطعتَ عُنق أخيك» أي: فعلت به فعلا يُخاف هلاكه فيه كمن قطع عنقه”([14]).
والشريعةُ نصَّت على الأجر في الكلاب وفي غيرها، ولم تخصَّ أسودَ من غيره، قال ابن عبد البر: “وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ شَيْءٍ مِنِ الْكِلَابِ إِلَّا الْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَقَالُوا: أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ بِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا، وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ» فَذَكَرَ مِنْهُنَّ «الْكَلْب الْعَقُور»، فَخَصَّ الْعَقُورَ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَعْقِرُ الْمُؤْمِنَ وَيُؤْذِيهِ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ فَوَاجِبٌ قَتْلُهُ، وَقَدْ قِيلَ: الْعَقُورُ ههنا الأسد وما أشبه، مِنْ: عَقَّارَة سِبَاعِ الْوَحْشِ، قَالُوا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ضَرَبَ الْمَثَلَ بِرَجُلٍ وَجَدَ كَلْبًا يَلْهَثُ عَطَشًا عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ، فَاسْتَقَى فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ فَغَفَرَ لَهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَفِي مِثْلِ هَذَا أَجْرٌ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ دَلِيلٌ» عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَّا مَا أَضَرَّ بِالْمُسْلِمِ فِي مَالٍ أَوْ نَفْسٍ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَدُوِّ الْمُبَاحِ قَتْلُهُ، وَأَمَّا مَا انتفع به المسلم من كل ذي كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يُؤْجَرُ الْمَرْءُ فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ كَذَلِكَ يُؤْزَرُ فِي الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا حَدَّثَنَا… عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدِ ادَّلَعَ لِسَانُهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمَوْقِهَا فَغُفِرَ لَهَا». قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَسْبُكَ بِهَذَا فَضْلًا فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْكَلْبِ، فَأَيْنَ قَتْلُهُ مِنْ هَذَا؟! وَمِمَّا فِي هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ؛ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا»، فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا”([15]).
وحاصل ما للعلماء في المسألة مما دلّ عليه الدليل الشرعي هو حرمةُ قتل الكلاب وحرمة اقتنائها وبيعها إلا فيما يباح استعمالها له ككلاب الصيد للصيد وكلاب الحراسة للحراسة ، أما كلاب القنية في البيوت والزينة والاصطحاب فعلى الأصل من عدم الجواز، أما الإحسان إليها وإطعامها وإسقائها فلا بأس به وقد وردت السنة برحمتها ، إلا ما كان عقورًا يضرّ بالناس، فإنه يُقتل أو يُنفى أو يُعلَّم. والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) ينظر: شرح البخاري لابن بطال (5/ 390).
([4]) ينظر: شرح البخاري لابن بطال (5/ 390).
([8]) التمهيد (2/ 225). بتصرف في أول الكلام بما لا يخل بالمعنى.
([10]) أخرجه أبو داود (2845)، والترمذي (1479)، والنسائي (4280)، وابن ماجه (3205)، وصححه البغوي في شرح السنة: (6/ 17)
([11]) ينظر: مختلف الحديث (ص: 207).