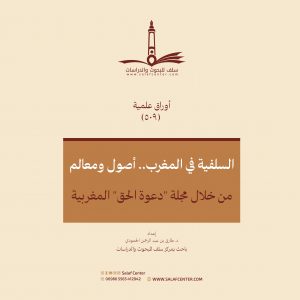حديثُ الوصيَّة وشبهات الطاعنين
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
من الأحاديث التي تناولها الشيعة فبثّوا شبهاتهم، وكثرت حوله افتراءاتهم، وانتهزوها فرصة للطعن في خير سلفٍ لهذه الأمّة، وجعلوه مغمزًا متى سنحت لهم المناسبة في ذلك: حديثُ الوصيّة التي قال النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها: «هلمُّوا أكتبْ لَكُم كتابًا لا تضلوا بعده»، فسموه حديث الرزيّة. وسنعرض في هذه الورقة العلمية المطاعن والشبهات التي أثاروها حول هذا الحديث، ثم نثنّي بالردّ عليها من أقوال العلماء الأجلاء، مع توضيح مقاصد الحديث إن شاء الله تعالى.
نصّ الحديث:
لمّا مرض النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أتاه بعض أصحابه، وكان ذلك يوم الخميس قبل موته بثلاثة أيام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «ائتوني أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعدي»، فقال عمر بن الخطاب: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وحسبنا كتاب الله، فقال بعض الصحابة بقول عمر رضي الله عنه، وقال بعضهم إنكارًا عليهم: أهَجَرَ رسول الله؟! -أي: أهذَى رسول الله؟!- وهو استفهام استنكاري منهم للذين يقولون: حسبنا كتاب الله، فتنازعوا في ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من عنده لما حصل منهم ذلك.
وفي رواية قال لهم: «دعوني، فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث…».
فكان ابن عباس يتحسَّر على عدم كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب.
ولنا مع هذا الحديث ثلاث وقفات:
أولًا: تخريج الحديث:
يعدّ هذا الحديث من أحاديث الصحيحين، فقد أخرجه البخاري عن عبيد لله بن عبد الله عن ابن عباس أنّه قال: لما اشتدَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم وجَعُه قال: «ائتوني بكتاب أكتبْ لكم كتابًا لا تضلوا بعده»، قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتابُ الله حسبنا. فاختلفوا، وكثر اللغط، قال: «قوموا عني؛ ولا ينبغي عندي التنازع». فخرج ابنُ عباس يقول: إنَّ الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه([1]).
ورواه أيضًا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يومُ الخميس وما يوم الخميس! ثم بكى حتى خضب دمعُه الحصباء، فقال: اشتدّ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعُه يوم الخميس فقال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا». فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هـجرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «دعوني، فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه». وأوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجيزهم»، ونسيتُ الثالثة([2]).
ورواه أيضًا عن سعيد عن ابن عباس باختلاف في بعض ألفاظه: فقالوا: ما له؟ أهـجرَ؟ استفهموه، فقال: «ذروني…»، وفي آخره: والثالثة إما أنْ سكتَ عنها، وإما أن قالها فنسيتُها([3]).
وفي رواية أخرى زاد: فذهبوا يردُّون عليه فقال: «دعوني… »([4]).
وروى أيضًا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجالٌ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلموا أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده»، فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهـلُ البيت واختصموا، فمنهم مَنْ يقول: قربوا يكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قوموا». قال عبيد الله: فكان يقولُ ابن عباس: إن الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم([5]).
وزاد في رواية أخرى: وفي البيت رجالٌ فيهم عمر بن الخطاب…([6]).
ووزاد في رواية أخرى أيضًا: فمنهم مَنْ يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا لن تضلوا بعده، ومنهم مَنْ يقولُ ما قال عمر([7]).
وروى الإمام مسلم هذ الحديث أيضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنُ عَبَّاسٍ قال: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ! ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ فَقَالَ: «ائْتُونِي اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدِي»، فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ.، وَقَالُوا: مَا شَاْنُهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ.، قَالَ: «دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ، أُوصِيكُمْ بِثَلاَثٍ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ»“. قَالَ: وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأُنْسِيتُهَا([8]).
ورواه أيضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ باختلاف في بعض ألفاظ الحديث، وفيه: ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَّى رَأيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأنَّهَا نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e: «ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ -أوِ: اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ– أكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أبَدًا»، فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَهْجُرُ([9]).
ثانيًا: عرض الشبهات التي أثيرت حول ثبوت الحديث والإجابة عنها:
ومع أنّ الحديث مخرّج في الصحيحين إلا أنّه لم يسلم من ألسنة الطاعنين، فقد انتقدوا صحيح الإمام البخاري بعدّة انتقادات في هذا الحديث:
الاعتراض الأول: وجود تفاوت في اللفظ واختلاف في رواية الحديث مما يدلّ على عدم الدِّقة في النَّقل.
والجواب على هذا الاعتراض الأوّل بما هو متقرّر عند علماء الحديث، فإنّ من تكلّم في غير فنّه أتى بالعجائب، ومن تِلكم العجائب الاعتراضُ الذي ذكروه؛ فإنّ علماء مصطلح الحديث قد عقدوا في كتبهم مبحثَ رواية الحديث بالمعنى، وملخّص ما ذكروه أنّ جمهور المحدّثين أجازوا ذلك إن كان المحدث عالما بما يحيل المعنى، وقد كان للعلماء مذاهب شتى في إجازتهم للرواية بالمعنى، وجزم القاضي أبو بكر ابن العربي بأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم حيث قال: (إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى، فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدّل ما نقل، وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه، فيكون خروجا من الأخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذاك، فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان: أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة، الثاني: أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين، ألا تراهم يقولون في كل حديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يذكرون لفظه؟! وكان ذلك خبرًا صحيحًا ونقلا لازما. وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه)([10]).
وقد قال ابن الصلاح في مقدّمته: (ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره. والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعًا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس -فيما نعلم- فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظًا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص، لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره)([11]).
هذا مجمل ما ذكره العلماء في ما يتعلّق بمبحث رواية الحديث بالمعنى، (والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة -أو أكثرهم- كانوا يروون بالمعنى، ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم)([12]).
ولا شكّ أنّ من يقرأ هذه النقول بإنصاف سيفهم الجواب على الاعتراض الذي يتعلّق بتفاوت الألفاظ في رواية الحديث، فإنّ جمهور العلماء قد أجازوا الرواية بالمعنى بشرط معرفة رواي الحديث بما يحيل المعنى منه.
وأمّا الاعتراض الثاني: فهو عدم تعليق الإمام البخاري على شيء من تلك الاختلافات ممّا يوهم أنّ ذلك من الرواة!
فهذا مبني على الاعتراض الأوّل، وقد بيّنا أنّه قد جوّز ذلك جمهور العلماء المحدّثين، وأمّا من احتجّ بحديث: «إنّما الأعمال بالنيّات» فإنّه احتجاج على الإسقاط وليس على التصرّف، فإنّ الإمام البخاري رحمه الله لمّا استفتح كتابه الصحيح أورد الحديث بلفظ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»([13]).
فكلّ طالب مبتدئ يعلم أنّ هناك جملة ساقطة في الحديث وهي قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله»، فذكر الحافظ ابن حجر نقولات عن الأئمّة يجزم بعضهم بأنّ الإسقاط كان من الإمام البخاري ولم يكن من شيخه. قال الداودي: (الإسقاط فيه من البخاري، فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدلّ على ذلك)([14]).
لكن فات على المعترض ما ذكره العلماء من اللطيفة التي أرادها الإمام البخاري من هذا الإسقاط؛ فإنّ الحافظ أبا محمد علي بن أحمد بن سعيد قد ذكر في أجوبة له على البخاري أنّ من أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: “لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدرا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية ردّ علمها إلى الله، فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بِنِيّته، ونَكب عن أحد وجهَيِ التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام”([15]).
فانظر -رعاك الله- كيف هو ثمرات حسن الظنّ بالعلماء، فقد قاد الحافظ أبو محمد إلى أن يستظهر مقصدًا من مقاصد المؤلّف يستشعر القارئ بأنّ عليه نورًا، فرحم الله الحافظ، ورحم الله الإمام.
وهذا احتجاج على الإسقاط لا على التصرّف كما ذكرنا ذلك آنفًا.
ثالثًا: عرض المطاعن التي استدلّوا بها من الحديث على افتراءاتهم والإجابة عنها:
أولًا: الطعن في أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه لاعتراضه على كتابة الوصيّة.
والجواب: أن العلماء ذكروا توجيهات لاعتراض عمر على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك:
أ- أن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان الأصل فيها الوجوب، إلا أن الأمر قد يرد للإباحة أو للتخيير، كما هو مقرر في علم الأصول وفي علم المعاني، ويفهم ذلك بقرائن الأحوال، ولعل عمر -ومَنْ أقرَّه من الصحابة على ما قال- فهموا من هذا الأمر أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُردْ به الإيجاب، بل التخيير.
ب- وأن عمر لما رأى ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجع خشي أن يشقّ عليه إملاء الكتاب، وأن يتعبه فقال ما قال إشفاقًا عليه صلى الله عليه وسلم، وإيثارًا لراحته، يؤيد ذلك قولُه: (إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا)([16]).
ج- وأن عمر لم يقل: حسبنا كتاب الله، ردًّا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ردًّا على مَنْ نازعه من الصحابة.
وليس هذا بغريب على ابن الخطّاب؛ فإنّه صاحب رأي ومشورة ومبادرات مشهورة، فقد كان يَقترحُ فيها على رسول الله أمورًا، ويطلبُ منه أمورًا، ويسأله عن أمور، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرُّه على ما فيه الصواب، ويردُّه عن الخطأ، فلا يبعد أن تكون هذه القصّة هي من جنس تلك الآراء العمريّة، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ائتوني بكتاب أكتب لكم» اقترحَ عليه عمر -على عادته التي عوَّده الرسولُ إياها- أن يكتفي بكتاب الله. فأقرَّه الرسولُ صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كان يريد الكتابةَ لأسكتَ عمرَ، ولأمضى ما يريد([17]).
ومما يستأنس به على ذلك أن العلماء عدّوا هذا الحديث من مناقبه لا من مثالبه كما هو ظاهر الاعتراض المذكور، قال الإمام النووي في شرح مسلم: “وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورًا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، فقال عمر: حسبنا كتاب الله لقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ}، وقوله: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه، فأمن الضلال على الأمة، وأراد الترفيه على رسول الله e، فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه”([18]).
ثم إنّ المتأمّل في كلام عمر يجد أنّ قوله: (حسبنا كتاب الله) إنما قاله لسبب وهو قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن)، أي: أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد زاد عليه الألم، ونخشى يؤذيه طول الكتابة، وهو بهذه الحالة فلا مانع من تأجيل ما يريد كتابته إلى أن يصح من وعكته من باب الرفق به صلى الله عليه وسلم، فليس في الحديث ما يدلّ على رفضه للوصيّة([19]).
ويبيّن هذا حديث عائشة رضي الله عنها لما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» قالت: هم في انتظارك يا رسول الله، فقربوا إليه الماء فاغتسل، ثم قام يريد أن يذهب إلى الصلاة فسقط مغميًّا عليه، ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» قالوا: هم في انتظارك يا رسول الله، فقال: «قربوا لي ماء»، فأتوه بالماء فاغتسل، ثم قام يريد أن يذهب للصلاة فسقط، فلما سقط الثالثة ثم أفاق قال: «أصلى الناس؟» قالوا: هم في انتظارك، قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». وهو كذلك من أحاديث الصحيحين([20]).
ومما يستأنس به أيضًا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ»، فهذا يدلّ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير مبتدئ بل مسؤولا، وأنّ رجوعه عن كتابة الوصيّة وإرسال الأمر وتركهم على ما هم عليه خير لهم من الاستمرار فيه([21]).
ثانيا: الطعن في أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه لقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه هجر)، وفي رواية: (إنّ النبيّ يهجر)، وفي أخرى: (إنّه ليهجر).
والجواب: أن الأحاديث كما هي واردة في الصحيحين لم يَنسب واحدٌ منها إلى عمر أنه قال: هجر، وإنما عبارته: (إن رسول الله قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله).
ثمّ الروايات التي ذكر فيها لفظ الهجر لم يذكر فيها اسم عمر مطلقًا، بل لم تصرح بالقائل، بل جاءت بصيغة الجمع: (فقالوا)، أو بصيغة الاستفهام: (أهجر؟ استفهموه).
وقد فسّر العلماء رواية (أهجر) بالهمز -أي: بالاستفهام- اعتراضًا على من رفض الكتابة للرسول صلى الله عليه وسلم، أي: هل يمكن أن يهذي حتى تمتنعوا من أن تحضروا دواة ليكتب لنا الكتاب؟!([22]).
وهناك رواية أوردها الشيخ المفيد في الإرشاد، وهي: (وبكى المسلمون، وارتفع النحيب من أزواجه وولده والنساء المسلمات ومن حضر من المسلمين، فأفاق صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم، ثم قال: «ايتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتابًا لا تضلُّوا بعده أبدًا»، ثُمَّ أُغمي عليه، فقام بعض من حضر يلتمس دواة وكتفا، فقال له عمر: ارجع فإنه يهجر، فرجع)([23]).
وهذه الرواية من مصدر شيعي، بل هي مروية من غير إسناد، فلا توقُّف في ردّها.
والشيعة ينسبون إلى عمر أعظم من ذلك، فقد روى ابن أبي حديد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه دخل على عمر في أوَّل خلافته… فسأله فقال: يا عبد الله، عليك دماء البدن إن كتمتنيها، هل بقي في نفسه -أي: عليّ رضي الله عنه- شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم، قال: يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصّ عليه؟ قلت: نعم وأزيدك، سألت أبي عما يدّعيه فقال: صدق، فقال عمر: لقد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ذرو من القول لا يثبت حجة ولا يقطع عذرا، ولقد كان يزيغ في أمره وقتًا ما، ولقد أراد في مرضه أن يصرِّح باسمه، فمنعت من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام، لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبدا([24]).
فانظر إلى بشاعة هذه الرواية واحتوائها على افتراءات ينبو عنها ذو العقل السليم، فضلًا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسلم الناس عقيدة وأكثرهم فهمًا وعقلًا، فقد تضمّنت الرواية السابقة زيادة مهمّة متعلّقة بحديث الوصيّة وهي استخلاف عليّ رضي الله عنه، وقد “اتفقت الإمامية على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخلف عليّا رضي الله عنه في حياته، ونص عليه بالإمامة بعد وفاته، وأنَّ من دفع ذلك دفع فرضًا من الدين”([25]).
لكن يقال: إنّ عليا رضي الله عنه قد قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضلّ أمته من بعده. قال: فخشيت أن يموت قبل أن يأتيه الكتاب، فقلت: يا رسول الله، إني أحفظ وأعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم»([26]).
ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موصيه بوصيّة لأوصاه حينئذ؛ فإنّ عليًّا كان أمامه، فلمْ يوصه بالإمامة.
ثمّ إنّه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الكتاب النَّص على خلافة علي في ذلك الوقت المتأخر من حياته، لدل هذا على عدم نصه عليها قبل ذلك، إذ لا معنى للنص عليها مرتين، وإذا ثبت باتفاق المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكتب ذلك الكتاب بطلت دعوى الوصية من أصلها([27]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن توهم أنَّ هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليًّا كان هو المستحق للإمامة فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصًّا جليًّا ظاهرًا معروفًا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب)([28]).
ثالثًا: الاستدلال بقول ابن عبّاس: (الرزّية كل الرزية) على ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمّة تخبط في عشواء إلى يوم القيامة، وهذا ظاهر من تسميتهم للحديث بحديث الرزيّة وهي الفجيعة.
والجواب من أوجه:
1- لا بدّ أن يعلم الزمان الذي حدّث فيه ابن عبّاس بهذا الحديث، فإنّ ابن عباس رضي الله عنهما ما قال ذلك إلا بعد ظهور أهل الأهواء والبدع من الخوارج وغيرهم. وأيضًا فقول ابن عباس هذا قاله اجتهادًا منه، وهو معارض بقول عمر واجتهاده، وقد كان عمر أفقه من ابن عباس قطعًا([29]).
وأيضًا هناك تنبيه عن اللفظ الوارد في البخاري ونصُّه: لما اشتدَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم وجَعُه قال: «ائتوني بكتاب أكتبْ لكم كتابًا لا تضلوا بعده»، قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتابُ الله حسبنا. فاختلفوا، وكثر اللغط. قال: «قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع». فخرج ابنُ عباس يقول: إنَّ الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه([30]).
فإنّ الخروج هنا ليس من بعد انفضاضهم من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنّما خرج من الْمَكَان الَّذِي كَانَ بِهِ يحدّث هَذَا الحَدِيث، وقد علّق الإمام العيني بكلام مهم ينبغي نقله إتمامًا للفائدة حيث قال: “قوله: (فخرج ابن عباس يقول) ظاهره أن ابن عباس رضي الله عنه كان معهم، وأنه في تلك الحالة خرج قائلا هذه المقالة، وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر، بل قول ابن عباس إنما كان يقول عندما يتحدث بهذا الحديث، ففي رواية معمر في البخاري في الاعتصام وغيره قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول، وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد، ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله بهذا الحديث خرج من المكان الذي كان به وهو يقول ذلك، ويدل عليه ما رواه أبو نعيم في المستخرج: قال عبيد الله: فسمعت ابن عباس يقول… إلخ، وإنما تعين حمله على غير ظاهره لأن عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتها؛ لأنه ولد بعد النبي عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة، ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى”([31]).
2- تخصيص الرَّزيّة بمن شك في خلافة الصديق واشتبه عليه الأمر، كما قال ابن تيمية رحمه الله في معناه: (يقتضي أن الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شكّ في خلافة الصديق، واشتبه عليه الأمر، فإنه لو كان هناك كتاب لزال الشك، فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه، ولله الحمد)([32]).
ثمّ إنا نحن المسلمين قد أخبرنا الله تعالى في كتابه -ومن أصدق من الله قيلا- فقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد»([33]). فما بقي شيء في الدين لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ختامًا: فإنّ أحاديث الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما لا يعترض عليهما بلا حجة أو برهان، فإنّ الأمّة قد اتفقت على قبول أحاديثهما، قال ابن القيسراني: “أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في الصحيحين لأبي عبدالله البخاري ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه”([34]).
فلا مجال لمن يرد أحاديث الصحيحين بمجرد التشهي أو دعوى مخالفة العقل أو التذرع بذلك لرد الاحتكام إلى السنة النبوية بأكملها؛ إذ العبرة في كل فنّ بأهله؛ لذا كان العبرة في هذا الباب بأهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، ولا عبرة بمن عداهم ما لأهل التخصّصات الأخرى، فضلًا عمن لم يشتغل بالعلم الشرعي أصلًا؛ يقول أبو إسحاق الإسفراييني: “أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها… فمن خالف حكمه خبرًا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول”([35]).
وقد عد بعض العلماء من يقلل من شأن الصحيحين من المبتدعة، يقول ولي الله الدهلوي: “أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يُهوِّن أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين”([36]).
والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب كتابة العلم (114).
([2]) صحيح البخاري: كتاب الجهاد، باب جوائز الوفد (3053).
([3]) صحيح البخاري: كتاب الجزية والموادعة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (3168).
([4]) صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (4431).
([5]) صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (4432).
([6]) صحيح البخاري: كتاب المرض، باب قول المريض: قوموا عني (5669).
([7]) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنة، باب كراهية الاختلاف (7366).
([8]) صحيح مسلم: كتاب الوصية، باب تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شيء يُوصِي فِيهِ (4319).
([9]) صحيح مسلم: كتاب الوصية، باب تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شيء يُوصِي فِيهِ (4321).
([10]) أحكام القرآن (1/ 10). وانظر: الباعث الحثيث (ص: 84).
([11]) معرفة أنواع علوم الحديث (ص: 322)، وانظر: الباعث الحثيث (ص: 84).
([12]) الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث، للعلّامة أحمد شاكر (ص: 84).
([14]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 15).
([15]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 15).
([16]) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم (114).
([17]) انظر مقالًا بعنوان: حديث «هلموا أكتب لكم» في صحيح البخاري، د. عبد الحكيم الأنيس، موقع الألوكة.
([18]) شرح صحيح مسلم (11/ 90).
([19]) مقال بعنوان: كشف كذب وافتراء الشيعة الروافض على الفاروق عمر في حديث رزية يوم الخميس، عادل عطاف.
([20]) صحيح البخاري كتاب الأذان، باب حدّ المريض أن يشهد الجنازة (664)، صحيح مسلم كتاب الصّلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (418).
([21]) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 381).
([22]) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 380).
([23]) الإرشاد (1/ 182، 185)، رحاب أئمة أهل البيت، السيد محسن الأمين (1/ 302).
([24]) شرح نهج البلاغة (١٢/ ٢١).
([25]) أوائل المقالات، للشيخ المفيد (ص: 44).
([26]) أخرجه أبو داود (٥١٥٦)، وابن ماجه (٢٦٩٨) مختصرًا، وأحمد (٦٩٣) واللفظ له، والضياء في المختارة (٢/ ٣٨٠)، وحسن إسناده أحمد شاكر في تخريج المسند.
([27]) انظر مقالًا بعنوان: رزية الخميس، موقع فيصل نور.
([29]) انظر: فتح البارى (8/ 134).
([30]) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم (114).
([31]) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (2/ 172).
([33]) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٣)، وأحمد (١٧١٤٤)، وصححه الترمذي وغيره.
([34]) صفوة التصوف، نقلًا عن أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين للشيخ ثناء الله الزاهدي، ضمن مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (18/ 294).
([35]) ينظر: فتح المغيث (1/ 72-73).
([36]) حجة الله البالغة (1/ 232)، وينظر للاستزادة مقال بعنوان: إجماع الأمة على صحة أحاديث الصحيحين والردّ على المشكّكين، مركز سلف للبحوث والدراسات.