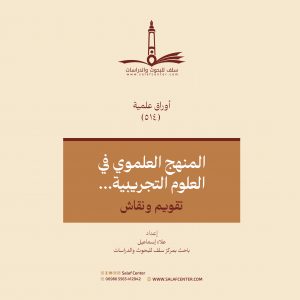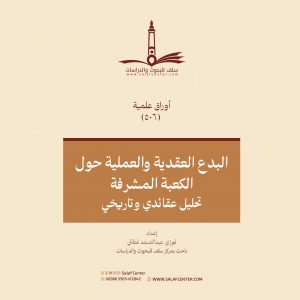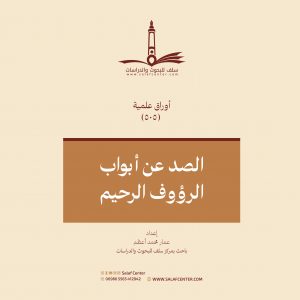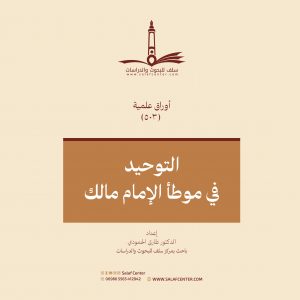التَّقليدُ في العقائد عند الأشاعِرَة (1) – أصول الأشاعرة في مسألة التقليد في العقائد –
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
مقدمة:
التقليدُ في العقائد من المسائل المهمة التي دار -ولا يزال يدور- حولها جدلٌ كبير داخلَ الفكر الإسلامي، وحتَّى داخلَ الفكر السُّنّي أحيانًا وإن كان النزاع في الأصل هو بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلّمين عمومًا والأشاعرة بالخصوص، وأهمِّية المسألة تكمن في الآثار المترتبة عليها، مثل قبول إيمان المقلّد، ووجوب النظر على كلّ أحد، وطلب اليقين في كل مسائل الاعتقاد، وتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وغير ذلك من المسائل المهمّة المبنية على مسألة التقليد في العقائد، وفي هذه الورقة اختصارٌ لمذهب الأشاعرة في التقليد في العقائد، مع مناقشة أصولهم التي اعتمَدوا عليها، وذكر أبرز أثر ينبني على قولهم، وهو: حكم إيمان المقلد؛ لنقف على حقيقة القول، وهل قولهم موافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبُه الكرام؟ وهل كانت إجابتهم مقنِعة في إيمان المقلد أو لا؟ وسيكون الحديث عن المسألة من خلال الآتي:
أولا: تعريف التقليد:
التقليد في اللغة يأتي بعدّة معانٍ، منها:
1- الليُّ، يقول أبو منصور الهروي: “القلْدُ: ليُّ الشَّيْء على الشَّيْء”([1]).
2- الضمُّ والجمع([2]).
3- التعليق، وسميت القلادة قلادة لأنها تعلق، ومنه قول الله تعالى: {وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ} [المائدة: 2]، يقول الخليل الفراهيدي: “وتقليد البدنة: أن يعلق في عنقها عروة مزادة ونعل خَلِق، فيعلم أنها هدي”([3]).
4- اللزوم([4]).
والمعاني كلها ترجع إلى هذا الأخير، أي: اللّزوم، فالجمع والضم والتعليق وليُّ الشيء بعضه على بعض كلها معانٍ تفيد لزوم الشيءِ الشيءَ الآخر.
أما التقليد اصطلاحًا فقد عُرف بتعريفات كثيرة، كلها ترجع إلى: قبول قول الغير بغير دليل. ومجمل الأقوال ترجع إلى هذا القول، وقد نص عليه العكبري([5])، هو مجمل ما قاله ابن حزم([6])، وقاله ابن تيمية([7])، وكذا قاله الخطيب البغدادي([8])، وأبو إسحاق الشيرازي([9])، وأبو المظفر السمعاني([10])، وابن جُزَي([11])، والجرجاني([12])، وكذا قال الباجوري([13])، ونعمان الألوسي([14])، ومحمود شكري الألوسي([15])، ومحمد الحجوي ([16])، ومحمد الأمين الشنقيطي([17])، وكذا قال البشير المراكشي([18]).
وبعد الاطلاع على هذه التعريفات نجد أنها مجموعة تحتوي على المحدَّدات الآتية:
1- أنَّ التقليد يكون من عامّيٍّ، سواء كان عامّيًّا في كل أحواله، أو في مسألة خاصَّة.
2- أن هذا العاميّ يأخذ بقول غيره ويعتقده ويعمل به.
3- أنه لا اهتمام له بالدليل فلا يعرفه، أو لا يعرف وجه الاستدلال.
ثانيا: حكم التقليد عند الأشاعرة:
اختلف المسلمون عمومًا في حكم التقليد، وكان موقف مجمل الأشاعرة هو المنع من التقليد وإيجاب النظر، فالأشاعرة قد حرّموا التقليد في كلّ مسائل الاعتقاد، وأوجبوا النظر والاستناد إلى الدليل العقليّ الكلاميّ في تأسيس الإيمان بالله وكلّ العقائد الأخرى، يقول الجويني (ت: 478هـ): “اعلم أنَّ هذا الباب يرسم الكلام فيه في فنِّ الكلام، بيدَ أنا نذكر ما يقع به الاستقلال، فلا يسوغ لأحدٍ أن يعوِّل في معرفة الله تعالى وفي معرفة ما يجب له من الأوصاف ويجوزُ عليه ويتقدَّس عنه على التقليد، وكذلك القول في جملة قواعد العقائد، بل يجب على كل معترفٍ أن يستدلّ في هذه الأصول، ولن تقع له العلوم فيها إلا عقب النَّظَر الصحيح”([19]).
ويقول أبو المظفر الإسفراييني (ت: 741هـ): “كلُّ ما يجب معرفتُه في أصول الاعتقاد يجب على كل بالغٍ عاقلٍ أن يعرفه في حقِّ نفسه معرفة صحيحةً صادرة عن دلالةٍ عقليَّة، لا يجوز له أن يقلِّد فيه، ولا أن يتَّكل فيه الأب على الابن، ولا الابن على الأب، ولا الزوجة على الزوج، بل يستوي فيه جميع العقلاء من الرجال والنساء”([20]).
وبهذا قال مجمل الأشاعرة وأعيانهم، فقال به الرازي([21])، والآمدي([22])، وابن الحاجب([23])، وهذا القول ظاهرٌ جدًّا عند السنوسيّة من الأشاعرة، وعلى هذا استقرَّ المذهب الأشعري المعاصر، يقول السنوسي (ت: 895هـ) في أم البراهين([24]): “وَيجب على كلِّ مُكلَّف شرعًا أن يعرف ما يجب في حقّ مولانا جل وعز وما يستحيل وَمَا يجوز، وَكَذَا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حقّ الرسل عليهم الصلاة والسلام”([25])، ويقول في شرح هذا النص: “يعني أنَّه يجب شرعًا على كلّ مكلف -وهو البالغ العاقل- أن يعرف ما ذُكر؛ لأنَّه بمعرفة ذلك يكون مؤمنًا محققًا لإيمانه على بصيرة في دينه، وإنَّما قال: يعرف، ولم يقل: يجزم، إشارة إلى أنَّ المطلوب في عقائد الإيمان المعرفة، وهي الجزم المطابق عن دليل، ولا يكفي فيها التَّقليد، وهو الجزم المطابق في عقائد الايمان بلا دليل، وإلى وجوب المعرفة وعدم الاكتفاء بالتقليد ذهب جمهور أهل العلم؛ الشيخ أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وإمام الحرمين، وحكاه ابن القصار عن مالك أيضًا”([26]).
ويقول الملَّالي التلمساني (ت: 897هـ) -تلميذ السنوسي- في شرح أم البراهين: “يعني أنَّ الشارع أوجب على المكلف -وهو البالغ العاقل- أن يعرف ما ذُكر، وحقيقة المعرفة هي الجزم بالشيء الموافق لما عند الله تعالى، بشرط أن يسبق ذلك الجزم دليلٌ أو برهانٌ قبله، وأمَّا الجزم بالشيء من غير دليل ولا برهان لا يسمَّى معرفة؛ سواء كان موافقًا لما عند الله أم لا، ومن هنا نعرف أنَّ التقليد لا يصحّ في علم التوحيد على مذهب كثيرٍ من العلماء”([27]).
وخلاصة الأمر: أن الأشاعرة يرون وجوبَ النظر، ويحرِّمون التقليد، وقد بنوا قولهم هذا على أصول عديدة سأذكر مجملها وأناقشها، وأهمّ أصل عندهم هو الأول، وباقي الأصول ترجع إليه.
ثالثا: أصول الأشاعرة في قولهم بمنع التقليد في العقائد:
استند الأشاعرة إلى عددٍ من الأصول في منعهم التقليد، أهمها ثلاثة أصول، وهي:
الأصل الأول: وجوب النظر:
وهذا الأصل هو الذي عليه تدور كتاباتهم وتأصيلاتهم وشروحاتهم واستدلالاتهم، ذلك أنَّه متى ما أوجبت الشريعة النَّظر على كلّ حال ولكل أحد فإنَّه يعني المنع من التقليد بأي حال، فكل من يقرّ بأن الله سبحانه قد أوجب النظرَ على كل أحد، فإنه سيمنع من التقليد بلا شكّ، وكثيرٌ من الأدلة الأخرى التي يذكرونها هي في الحقيقة تابعة لهذا الأصل، وفي إيجاب النظر عدة مسالك يقرّرون من خلالها وجوبَ النظر، ويمكن إجمالها في مسلكين:
المسلك الأول: إيجاب الشارع للنظر:
أصحاب هذا المسلك يقرِّرون أنَّ الشارعَ قد أوجب النظر على كل أحد في مسائل أصول الدين، وبناء عليه فلا يجوز التقليدُ فيها، وإيجاب الشارع للنظر كان من جهة الأمر به في الكتاب والسنة، ومن جهة الوعيد لمن تركه، ومن جهة بيان أن الأنبياء قد قاموا به.
وقد استند إلى هذا المسلك في إيجاب النظر كثيرٌ من علماء الأشاعرة، يقول الآمدي (ت: 631هـ): “النَّظر واجب، وفي التقليد تركُ الواجب فلا يجوز، ودليل وجوبه أنَّه لما نزل قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 190] قال عليه الصلاة والسلام: «ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها»([28]) توعَّد على ترك النظر والتفكر فيها، فدلَّ على وجوبه”([29])، ويقول أيضًا مبينًا طريقة إيجاب الشرع للنظر: “أجمع أكثر أصحابنا والمعتزلة وكثيرٌ من أهل الحق من المسلمين على أنَّ النظر المؤدِّي إلى معرفة الله تعالى واجب، غير أنّ مدرك وجوبه عندنا الشرعُ، خلافًا للمعتزلة في قولهم: إن مدرك وجوبه العقلُ دون الشرع. وقد احتج أصحابنا على وجوبه من جهة الشرع بمسلكين:
المسلك الأول: التَّمسّك بظواهر النُّصوص الدَّالة على وجوب النَّظر، منها قوله تعالى: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ} [يونس: 101]، ومنها قوله تعالى: {فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الروم: 50] أمرَ بالنظر، والأمر ظاهر في الوجوب، وأيضًا لما نزل قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 190] قال النبي ﷺ: «ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكَّر فيها» توعَّد بترك الفكر والنظر فيها؛ وهو دليل الوجوب. إلى غير ذلك من الأدلَّة، وموضع معرفته: أنَّ صيغة (افعل) للأمر، وأنَّ الأمر للوجوب؛ فلا يفي بأصول الفقه. وعلى كل تقدير فهي غير خارجة عن الحجج الظاهرية والأدلة الظنية”([30]).
وقد نقل الإيجي (ت: 756هـ) الإجماع على أنَّ النظر واجب، وبيَّن وجه الوجوب ودليله فقال: “النظر في معرفة الله واجبٌ إجماعًا، واختلف في طريق ثبوته؛ فهو عند أصحابنا السمع وعند المعتزلة العقل.
أمَّا أصحابنا فلهم مسلكان: الأول: الاستدلال بالظواهر، نحو قوله: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ} [يونس: 101]، وقوله: {فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الروم: 50]، والأمر للوجوب، ولما نزل: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 190] قال عليه الصلاة والسلام: «ويلٌ لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها»، فهو واجب”([31]). وهو ما قرره السنوسي([32]).
المسلك الثاني: أن معرفة الله نظرية:
يستدلُّ القائلون بوجوب النظر بكون معرفة الله سبحانه وتعالى نظرية مكتسبة لا ضرورية فطرية، ومعرفة الله واجبة على الخلق كلهم، فالله سبحانه وتعالى قد طلب العلم به، وما دام أن معرفة الله واجبة ولا يمكن معرفته إلا بالنظر، فالنظر واجب، فهذا المسلك قائم على أن معرفة الله واجبة، ولا يعرف إلا بالنظر، فوجب النَّظر.
وكون معرفة الله سبحانه وتعالى واجبةً لا نختلف عليها، فإنَّ معرفته واجبة بلا شكّ ولا ريب، فالمقدمة الأولى صحيحة متَّفق عليها، ولكن النزاع في المقدمة الثانية، وعليها تدور استدلالاتهم، وهي أنَّ معرفة الله لا يمكن الوصول إليها إلا بالنظر، وقد اعتمد على هذا المسلك كثير من الأشاعرة، يقول القاضي الباقلاني (ت: 403هـ): “وأن يعلم أنَّ أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد: النَّظر في آياته، والاعتبار بمقدوراته، والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار، ولا مشاهد بالحواس، وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة والبراهين الباهرة”([33]).
واستدل بذلك الجويني (ت: 478هـ) أيضًا مقررًا أنَّ معرفة الله ليست ضرورية وإنما هي نظرية، فقال: “فإن قال قائل: فما الدليل على وجوب النظر من جهة الشرع؟ قلنا: الدليل عليه إجماع المسلمين على وجوب معرفة الله، مع اتفاقهم على أنها من أعظم القرب وأعلى موجبات الثواب، ولا يقدح في هذا الإجماع مصير بعض المتأخرين إلى أن المعرفة ضرورية… فإذا ثبت الإجماع فيما قلناه وثبت بدلالات العقول أنَّ العلوم المكتسبة يتوقف حصولها على النظر الصحيح، وما ثبت وجوبه قطعًا فمن ضرورة ثبوت وجوبِه وجوبُ ما لا يُتوصّل إليه إلا به”([34]). فالجويني يقرر وجوب النظر من جهة أن معرفة الله واجبة، ومعرفته نظرية، فالنظر واجب.
- وملخص الكلام في هذا الأصل: أنه هو الأصل الأعظم الذي استند إليه المتكلمون في منع التقليد في العقائد، ولذا جعله كثير منهم أولَ واجب على المكلف، حتى من لم يجعله منهم أول واجب قد أوجبه، وبيّن أنه هو السبيل الوحيد الموصل إلى المعرفة، وذلك عند مجمل المتكلمين وإن كان هناك من خالف وبيّن أن المعرفة تكفي([35])، لكن ما ذكرناه هو الاتجاه العام للمتكلمين.
الأصل الثاني: ذم التقليد:
استدلَّ عددٌ من الأشاعرة بهذا الأصل على منع التقليد، وهو من أكثر الأصول التي استدلُّوا عليها من الكتاب والسنة؛ لوفرة الأدلة التي ذمَّت التقليد وإن كانت تلك الآيات لا تحقِّق لهم مرادهم وهو منع التقليد بالكلية.
يقول الآمدي (ت: 631هـ) في بيان أدلة منع التقليد وحرمته: “التَّقليد مذموم شرعًا، فلا يكون جائزًا، غير أنَّا خالفنا ذلك في وجوب اتّباع العامي للمجتهد، وفيما ذكرناه من الصُّور فيما سبق لقيام الدليل على ذلك، والأصل عدم الدليل الموجب للاتباع فيما نحن فيه، فنبقى على مقتضى الأصل، وبيان ذمّ التقليد قوله تعالى حكاية عن قوم: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23] ذكر ذلك في معرض الذم لهم”([36]).
وقد ذكر السنوسي (ت: 895هـ) استدلالَ موجبي النظر بهذا الدليل، فقال في شرحه لمنظومة الزواوي: “وقد كثر في الكتاب والسنة الأمر بالتفكر والنظر فيما يحصل المعرفة بالله تعالى… وكثر ذمُّ من قلد في أصول الدين آباءه أو غيرهم”([37]).
- وملخص هذا الأصل هو أن يقال: إنَّ كل ما جاء في الكتاب والسنة من ذمٍّ للتقليد فهو دليلٌ على تأكيد هذا الأصل، وما دام أنَّ التقليد مذموم فهو محرم، ولا يجوز الاعتماد عليه في كل مسائل الاعتقاد.
الأصل الثالث: عدم الوصول إلى اليقين:
اعتمد المانعون من التقليد في العقائد على هذا الأصل في تقرير أنَّ العقائد لا يجوز فيها التقليد؛ إذ إنَّ العقائد عندهم يجب أن تُبنى على اليقين، والتقليدُ غير موصل إليه بل يوصل إلى الشكّ، فهذا الأصل إذن مبنيّ على مقدمتين: أنَّ العقائد يُطلب فيها اليقين، وأنَّ التقليد غير موصل له، ونتيجة ذلك أنه لا يجوز التقليد في العقائد.
يقول السنوسي (ت: 895هـ) في شرحه لمنظومة الزواوي وهو يقرر أنَّ التقليد لا يوصل إلى اليقين بل يورث الشك: “حاصل ما ذكر في التقليد في أصول العقائد أربعة أقوال:
الأول: أنه لا يصحّ فيها التقليد، وهو مذهب الجمهور، وبعضهم يحكي الإجماع عليه، ودليل هذا القول: أنَّا مكلَّفون بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسله، وما يحصل للمقلد لا يسمَّى علمًا ولا معرفة، إذ المعرفة والعلم بمعنى واحدٍ، وهو الجزم الذي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، والعقد التقليديّ يحتمل النقيض والتزلزل عند تشكيك المشكك”([38]).
ويذكر السنوسي أنَّ التقليد يورث الشكَّ، وبوجوده لا يصحّ الإيمان، يقول: “والعقد التقليدي يحتمل النقيض والتزلزل عند تشكيك المشكك”([39]).
- وخلاصة هذا الأصل: أنَّ العقائد كلَّها يُطلب فيها اليقين، والتقليد غير موصلٍ إليه، فيُمنع.
هذه مجمل الأصول التي استدلّ بها الأشاعرة على منع التقليد في كلّ مسائل الاعتقاد، وسأناقشها باختصار في الآتي:
- مناقشة الأصل الأول وهو: وجوب النظر:
ذكرت أن الأشاعرة قدِ اعتمدوا على هذا الأصل اعتمادًا كبيرًا، وكانت كتاباتهم وتقريراتهم وتأصيلاتهم لهذه المسألة تدور حول هذا الأصل، وأن لهم في تقريره مسلكين، سأناقشهما:
- المسلك الأول: أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب النظر:
وقد استدلّوا على ذلك بأدلة كثيرة، بعضها تُظهِر الأمر بالتفكر، وبعضها تحذِّر من التقليد، والبعض الآخر تخبر أن الأنبياء قد نظروا، وخاصة إبراهيم عليه السلام حين ناظر قومه، وقد سبق الحديث عن إيجاب المتكلّمين للنظر واستدلالهم عليه بالأدلة القرآنية في ورقة علمية في مركز سلف بعنوان: “إيجاب النظر عند المتكلمين من خلال الآيات القرآنية، مناقشة وبيان”([40])؛ لذا لا أريد الإطالة في هذا الموضوع، وإنما أشير إلى بعض الآيات التي يستدلون بها، مثل قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران: 190، 191]، وقوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [البقرة: 164]
وهذه الآيات فيها بيانٌ لأهمية العقل وإعماله، وبيان أن الآيات التي وضعها الله في الكون إنما هي لقوم يعقلون، يقول الطبري: “{لِّقَوْمٍ يَعْقِلُون}: لمن عقل مواضع الحجج، وفهم عن الله أدلته على وحدانيته. فأعلم -تعالى ذكره- عباده بأن الأدلة والحجج إنما وضعت معتبرًا لذوي العقول والتمييز دون غيرهم من الخلق، إذ كانوا هم المخصوصين بالأمر والنهي، والمكلفين بالطاعة والعبادة، ولهم الثواب، وعليهم العقاب”([41]).
وعلى كلّ حل فإنّ المتأمل في تلك الآيات يجد أنها لا تدلّ على إيجاب النظر وعلى منع التقليد، وإنما غاية ما فيها أنَّها تدلّ على التفكر والتأمل في مخلوقات الله، والنظر فيها للتوصل إلى وحدانيته واستحقاقه للعبادة، ومدح صفةٍ مَا لا يعني إيجابها، بل وإيجابها لا يعني عمومها وإيجابها على الكلّ، فالدليل أخصّ من المدلول؛ فإن أهل السنة والجماعة لا ينكرون النظر والتأمل في مخلوقات الله وآياته.
أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 190] فإني أخصُّها بالذكر لأنّ المتكلمين قد ربطوها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن فيه دلالة على وجوب النظر، يقول الآمدي (ت: 631هـ): “النظر واجب، وفي التقليد ترك الواجب فلا يجوز، ودليل وجوبه أنه لما نزل قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} الآية، قال صلى الله عليه وسلم: «ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها» توعَّد على ترك النظر والتفكّر فيها، فدلَّ على وجوبه”([42]).
وهذا الحديث بهذا النصّ ذكره المتكلمون، وذكره بعض المفسرين([43])، لكني لم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ، إلا أنه قد ورد حديث مقارب له، فقد قيل لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: «يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي»، قلت: والله، إني لأحبّ قربك وأحبّ ما سرَّك، قالت: فقام فتطهَّر ثم قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلَّ الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبدا شكورًا؟! لقد نزلت عليَّ الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} الآية كلها [آل عمران: 190]»([44]).
وكما هو بيِّنٌ وواضح من الحديث، فإن التحذير الوارد ليس فيه دلالة على وجوب النظر، وإنما فيه دلالة على تدبّر الآية وما انطوت عليه من معانٍ، وهي بلا شكّ تحث على التفكر في مخلوقات الله والتدبر فيها، لكنها ليست خاصة بالنظر في حدوث العالم ليُستدل به على وجود الله، ولا يدل هذا الحديث على وجوب النظر لكل أحد، ويدل على ذلك أمور:
1- أنه قال: «ويل» والويل في اللغة العربية يراد به الزجر والذم، وكذلك الهلاك والعذاب، يقول الفراهيدي (ت: 170هـ): “الوَيلُ: حلول الشّرّ”([45]).
وقال أبو بكر الأنباري (ت: 328هـ): “قال الكلبي: الويل: الشدة من العذاب. وقال الفراء: الأصل فيه: وي للشيطان، أي: حزن للشيطان، من قولهم: وي لِمَ فعلت كذا وكذا”([46]).
ويقول ابن الأثير (ت: 606ه): “الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب”([47]).
فالويل نفسُه ليس المراد منه الذمّ دائما، يقول ابن الجوزي (ت: 597هـ): “وَقد ترد كلمة الويل لَا فِي مستقبح، قَالَه رَسُول الله فِي حقّ رجل: «ويل إِنَّه مسعر حَرْب» يصفه بالإقدام ويتعجب مِنْهُ”([48]).
وإن كان الويل المذكور في الحديث قد جاء للذمّ بلا شك ولا ريب، لكن لا يدل على الوجوب دلالة واضحة، وإن كان دلّ على الوجوب فهو وجوب مقيّد كما سيأتي بيانه.
2- لا يشترط أن تكون كلّ جملة ورد فيها (ويل) يكون الفعل محرمًا أو يجب عكس ذلك الفعل، ولا شكّ أن هناك آيات عديدة وردت في القرآن فيها كلمة الويل، وقد بلغت كلمة الويل ومشتقاتها قرابة خمسة وعشرين موضعًا، وليست كلها في أمر محرم، بل وردت في أمور ليست محرمة، مثل: {قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ} [المائدة: 31]، فالويل هنا المراد به الذم والهلاك، ولم يكن عدم مواراة الميت محرّما في ذلك الوقت، ومن ذلك: {قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ} [هود: 72]، وقد ورد مثل هذا كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «ويل أمه؛ مسعر حرب لو كان له أحد»([49])، يقول ابن حجر (ت: 852هـ) معلقًا على هذا الحديث: “وهي كلمة ذمّ تقولها العرب في المدح، ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم؛ لأن الويل الهلاك، فهو كقولهم: لأمِّه الويل، قال بديع الزمان في رسالة له: والعرب تطلق (تربت يمينه) في الأمر إذا أهمّ، ويقولون: (ويل أمه)، ولا يقصدون الذم، والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر، وقد تقدم شيء من ذلك في الحجّ في قوله للأعرابي: «ويلك». وقال الفراء: أصل قولهم: (ويل فلان): وي لفلان، أي: فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها”([50]).
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه»، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟! قال: «نعم إذا كثر الخبث»([51]).
وهذا الحديث أيضًا فيه دلالة على أن الويل ليس المراد منه مطلقًا تحريم ما جاء فيه، فليس هنا تحريم لشيء، وإنما تحذير من يأجوج ومأجوج، يقول بدر الدين العيني (ت: 855هـ): “قوله: «ويل للعرب»: كلمة ويل للحزن والهلاك والمشقة من العذاب، وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل”([52]).
فغاية ما في قوله «ويل لمن قرأها» التحذير، من باب الحث على التفكر والتأمل، لا الوجوب والتحريم.
3- الوجوب لمن قرأ الآية، وقد بيّنتُ أنَّ الحديث فيه حثٌّ لا الوجوب، وإن قلنا: إن فيه وجوبًا فإن الوجوب على من قرأ الآية لا على كل أحد، وهذا بنصّ قوله عليه الصلاة والسلام: «ويل لمن قرأها»، فلم يربط النبي بين النظر والتكليف، ولا أوجب ذلك على المكلّفين كما يقرر المتكلمون، وإنما ربط ذلك بمن قرأ الآية للتفكر فيما ورد فيها.
4- التفكر ليس بالضرورة هو النظر، فكل نظر تفكّر وليس العكس، فالنظر هو ترتيب شيء على شيء للوصول إلى نتيجة كما مرّ بنا، والتفكر ليس كله كذلك، وقد سئل الأوزاعي فقيل له: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: “يقرأهن وهو يعقلهن”([53]).
وحتى إن قلنا: إن التفكر هو النظر، فإنه النظر المطلوب هو النظر في مخلوقات الله والتأمل فيها ليزداد المؤمن إيمانًا، وليتوصل الكافر به إلى الإيمان، وليس المراد منه النظر الكلامي، فالحديث ليس فيه وجوب النظر في حدوث الكون للتوصّل إلى وجود الله بالطريقة الكلامية، وإنما فيه نظر عامّ في التفكر في مخلوقات الله والتأمّل فيها، والعمل بمقتضى ذلك، ولا شكّ أن من رأى هذه الآيات ولم يؤمن فإنه داخل في الوعيد، فدلالة الحديث على أن من رأى الآيات ولم يؤمن، وليس في إيجاب النظر لكلّ أحد، ويدل عليه أنه حتى بعد نزول هذه الآيات لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل من يأتي ليسلم أن يتفكّر وينظر.
وخلاصة القول: أن هذه الآيات التي تحثّ على النظر هي آيات في الحثّ على التفكر لا في إيجاب النظر، فإن قالوا: بل هناك آيات في إيجاب النظر مثل قوله تعالى: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ} [يونس: 101]، يقال: هذه الآيات أولا موجهة إلى المشركين الذين أقروا بوجود الله، فجاءت الآيات دالة على وجوب إفراد الله بالعبادة وإبطال عبادة الأصنام، لكن حتى إن جعلنا الآيات عامّة فإن النظر المطلوب هنا ليس واجبًا على كلّ الناس، وأهل السنة والجماعة لم يمنعوا النظر بإطلاق، بل أنكروا النظر الكلاميّ المبني على دليل الحدوث، وأنكروا وجوبه على كل أحد.
فالمسلك الأول الذي استدلّوا به على وجوب النظر غير صحيح؛ لأنه مبني على أدلة لا تفيد مرادهم ، خاصة وأن المسألة من أصول مسائل الدين التي تتعلَّق بالإيمان والكفر، وسأناقش المسلك الثاني مع الأصول المتبقية في الجزء الثاني.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) تهذيب اللغة، لأبي منصور الهروي (9/ 47-48)، العين، للفراهيدي (5/ 116-117). وينظر في نفس المعنى: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (6/ 312)، ولسان العرب، لابن منظور (3/ 366)، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي (ص: 312)، وتاج العروس، للزبيدي (9/ 64).
([2]) العين، للفراهيدي (5/ 117). وينظر: تهذيب اللغة، لأبي منصور الهروي (9/ 47).
([3]) العين، للفراهيدي (5/ 117)، وتهذيب اللغة، لأبي منصور الهروي (9/ 47).
([4]) العين، للفراهيدي (5/ 117).
([5]) رسالة في أصول الفقه (ص: 74).
([6]) الإحكام في أصول الأحكام (6/ 60).
([7]) المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية (ص: 462).
([8]) الفقيه والمتفقه (2/ 128).
([9]) اللمع في أصول الفقه (ص: 125).
([10]) قواطع الأدلة في الأصول (2/ 340).
([11]) تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص: 138).
([13]) حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد المسماة: تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص: 76).
([14]) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص: 204).
([15]) غاية الأماني في الرد على النبهاني (1/ 561).
([16]) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/ 470).
([17]) مذكرة في أصول الفقه (ص: 373).
([18]) شرح منظومة الإيمان (ص: 84).
([19]) التلخيص في أصول الفقه (3/ 427-428).
([20]) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص: 180).
([22]) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 223).
([23]) تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب، لأبي عبدالله البكِّي (ص: 86).
([24]) وهو المعروف بالعقيدة الصغرى.
([25]) شرح أم البراهين، للسنوسي (ص: 14).
([27]) شرح أم البراهين لأبي عبدالله محمد التلمساني ضمن أم البراهين (ص: 56-57).
([28]) سيأتي تخريجه عند المناقشة.
([29]) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 223).
([30]) أبكار الأفكار في أصول الدين (1/ 155).
([32]) شرح الكبرى (ص: 8). وينظر: المنهج السديد في شرح كفاية المريد، للسنوسي (ص: 48).
([33]) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (1/ 21).
([34]) الشامل في أصول الدين (ص: 119-120).
([35]) يقول الآمدي: “قلنا: نحن إنما نقول بوجوب النظر في حق من لم يحصل له العلم بالله تعالى بغير النظر، وإلا فمن حصلت له المعرفة بالله تعالى بغير النظر؛ فالنظر في حقّه غير واجب”. أبكار الأفكار في أصول الدين (1/ 164).
([36]) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 224).
([37]) المنهج السديد في شرح كفاية المريد (ص: 48).
([38]) المنهج السديد في شرح كفاية المريد (ص: 48).
([40]) ينظر الرابط: https://salafcenter.org/7628/
([42]) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 223). وينظر: أبكار الأفكار في أصول الدين (1/ 155)، والمواقف للإيجي (ص: 28-29).
([43]) ينظر: تفسير أبي السعود (2/ 128)، والسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، لمحمد الخطيب الشربيني (1/ 274)، وتفسير الزمخشري (1/ 453)، وتفسير الرازي (9/ 109).
([44]) أخرجه ابن حبان (620)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (68). وذكر هذا النص أيضا عدد من المفسرين. انظر: تفسير النسفي (1/ 320)، وتفسير البيضاوي (2/ 54).
([46]) الزاهر في معاني كلمات الناس (1/ 137).
([47]) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 236).