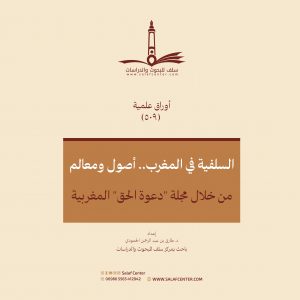هل رُوح الشريعة أولى منَ النصوص؟
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
يتداول العلمانيون في خطابهم مفاهيم متعدّدة مثل: المقاصد، والمصالح، والمغزى، والجوهر، والروح، والضمير الحديث، والضمير الإسلامي، والوجدان الحديث، والمنهج، والرحمة([1]). وقد جعلوا تلك الألفاظ وسيلة للاحتيال على الأوامر والنواهي الربانية، حتى ليخيَّل للمرء أن الأحكام الشرعية أحكام متذبذبة وأوصاف إضافية نسبيّة منوطة بما يراه المكلَّف ملائمًا لطبعه أو منافرًا، أي: بما يراه لذيذًا أو مؤلِمًا، دون أن يكون للشرع سلطان ولا حُكم عليه في رؤيته تلك. وهذا في حقيقته إسقاط للأمر والنهي ونقضٌ لعُرى الشريعة.
وفي المقابل: أفضى هذا التصوّر بفئام من الناس إلى النفرة من هذه الألفاظ مطلقًا، فإذا قال له الفقيه: إن هذا الأمر منوط بالمصلحة، يظنّ أن الفقيه يتنصّل بذلك من النص أو الأمر الصريح، ويلقيه في مهامِهَ واسعةٍ لا سلطان فيها لأحد على أحد.
وحقيقة الأمر أن المصلحة عند الأئمة والفقهاء لا تعدو كونها فهمًا للشرع بالشرع، وتحكيمًا للنص على النص، ذلك أن الشريعة جاءت بمقاصد كلية، وجاءت في كل باب بمقاصد جزئية، ولا يُراد بتعليق الحكم بالمصلحة إلا أن يختار الفقيه في تنزيله للأحكام على الواقع القولَ الأليقَ بهذه المقاصد.
مثال ذلك: أن من القواعد الفقهية المقررة: أن تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فإذا رمتَ فهم المصلحة التي أنيط بها تصرف الإمام رجعت إلى مقاصد الشريعة في هذا الباب، فوجدتها بالاستقراء راجعةً إلى حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، أو كما يقول شيخ الإسلام: (والمقصودُ الواجب بالولايات: إصلاحُ دين الخلق الذين متى فاتهم خسروا خسرانًا مبينًا، ولم ينفعهم ما نَعِمُوا به في الدنيا، وإصلاحُ ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم)([2]).
فيكون معنى قولهم: تصرُّف الإمام على الرعية منوطٌ بالمصلحة: أن الإمام يختار في تصرفاته ما يكون محقّقًا لمقصد إصلاح دين الخلق وحراسته.
فالإحالَةُ إلى المصلحة إذًا إحالةٌ إلى الشريعة نفسها، لكن غاية ما يُرَادُ منك في تفقُّهِك في الأحكام المنوطةِ بالمصلحة أن تَرجِعَ بضع خطوات إلى الوراء لتستَشرف المقاصد الكُليَّة للشريعة، لتهتدي بهديها، فتصيبَ مُراد خالقك بمنه وتوفيقه.
يقول العلمانيون: (يخطئ الكثيرون عندما يظنون أن تطبيق الشريعة يعني تطبيق أحكامها وتفاصيلها، والحقّ أنه تطبيق روحها، وروحها هو المنهج الذي يتقدَّم باستمرار، أما تفاصيل المعاملات وغيرها فليست هي الشريعة، وإنما هي أحكام الشريعة).
ويقولون: (إن تطبيق الشريعة يعني إعمال الرحمة في كل شيء؛ لأن القرآن يقوم على منهج الرحمة أو التجديد والمعاصرة، ومن هنا ما دامت الرحمة هي المنهج والمنهج هو الرحمة فـإن القانون المصري بكـل فروعه المدنية والتجارية الآن موافـق لشريعـة الإيمان وروح القرآن. ونظام الربا في الإسلام يؤكد ذلك، فقد تغير الحال ولم يعد الأمر كما كان استغلالًا لحاجة المدين يؤدي إلى إعساره وإفلاسه، ولم يعد ثمة نظام للربا، وإنما نظام لحساب الفوائد على الديون في مجتمع يقوم فيه المشرع بدور الرقابة على المعاملات، ويحدد الفائدة بحيث لا تغني الدائن ولا تستغل المدين).
ويقولون أيضًا: (إن نظام الحدود في الإسلام يؤكد ذلك أيضًا، فالشروط التي وضعها الفقهاء لإدانة السارق أو الزاني وإقامة الحد عليه يصعب أن تتحقَّق، كما أن تطبيق حد الرجم يبدو أنه من خصوصيات الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضًا فإن هذه العقوبات لا تتفق مع روح الإسلام وأحكامه؛ لأنها تقرنه بالعنف والتشدد والقسوة أمام الرأي العام العالمي، ولذلك فتطبيق هذه العقوبات باسم القرآن خيانة له، وأقوَم الطرق أن نبحث عن الجوهر؛ إذ لا يجب التمسك بحرفية النصوص وإنما بروحها ومغزاها ومقاصدها، وهو ما يكفل لنا الحفاظ على مصداقية الإسلام وصلاحه لكل زمان ومكان، ووفائه لمقتضيات الضمير الحديث والوجدان الحديث ، دون خوف من معارضة المسلَّمات بدعوى أنها من المعلوم من الدين بالضرورة، ما دام الوفاء لجوهر الرسالة المحمدية قائمًا، وما دام التشبع بروح الإسلام حاصلًا)([3]).
ويمكننا في توضيح ما في هذا الكلام من تلبيس وتضليل بيان بعض الضوابط التي تعين في فهم العلاقة بين المصلحة والنصوص([4]):
أولًا: معرفة المقاصد ليست مُنفكَّة عن إدراك أحكام الشريعة التفصيليَّة:
فقد تستبطِن بعض العقول فكرة غير صحيحة، وهي أنَّ معرفة المقاصد عمليَّة مُنفكَّة عن إدراك أحكام الشريعة التفصيليَّة.
والواقع أنَّ الحديث عن مقاصد الشريعة يجِب أنْ يكون مُنطلِقًا منَ الشريعة ذاتها أصولًا وفروعًا، كليَّات وجزئيَّات، لا أنْ يتصور المرء من عِنديَّاته مقاصدَ ثم ينسُبها إلى الشريعة، ثم يجعَل مقاصدَه هذه حاكمةً على فروع الشريعة، بل عِلم مقاصد الشريعة عِلم كاشف عن مقاصد الشريعة بالنظر إلى الشريعة ذاتها، وما حدَّدَته منَ المقاصد نصًّا، أو ما يُمكن تحصيلُه منها عن طريق النظر والاستقراء لجزئيَّاتها، وهو مَقام عِلمي رفيع، يجِب أنْ يتحلَّى صاحبه بالعِلم الوافر، والاستقراء التام، والورَع الشديد خوفًا أنْ يقول على الله وشريعته بلا عِلم.
ويُقال تَفريعًا على هذا: إنَّ رد الأحكام الجزئيَّة يؤول في حقيقته إلى التشكيك في الأحكام الكُليَّة، فإنَّ الكُليَّات إنَّما حصَلَت باستقراء الجُزئيَّات.
ثانيًا: التشريعات التفصيليَّة مقاصد جزئية أيضًا، أو وسائل مقصودة لمقاصد الشريعة:
يكفي ادِّعاء إمكانيَّة معرفة تفاصيل المَقصِد الشرعي لتلك الأحكام وحدودها، ثم ادِّعاء أنَّ ثمَّةَ وسائل تُحقِّق عين الْمَقصِد الذي تطلَّبَته الشريعة بتلك التشريعات، وأنَّ هذه الوسائل يُمكن الاستغناءُ بها عنِ الوسائل التي قرَّرتها الشريعة.
ولنا أنْ نسأل مَن يدَّعي ذلك أنْ يُخبِرنا عنِ البَديل الذي يتحقَّق به مقصودُ الشريعة من أنصبة الزكاة، أو أعداد ركَعات الصلَوات، أو مواقيتها.
والقول بأنَّ هذه التشريعات التفصيليَّة مجرَّد وسائل ليس قولًا صحيحًا في نفْسه، بل جملة من هذه التعبُّدات مطلوبة لذاتها؛ لأنَّها محبوبة لله تعالى، وتحقيق ما يُحبه الله تعالى هو أجلُّ المقاصد والمطالب، ولا ينحصِر ذلك في التعبُّدات المَحْضة كالصلاة والصيام، بل حتى أحكام المُعامَلات ليست مجرَّد وسائلَ يُمكن الاستعاضة عنها بغيرها، بل هي أيضًا فيها معنى التعبُّد.
فلو قيل للقاضي مثلًا: لمَ لا تحُكم بين الناس وأنت غضبانُ؟ فأجاب بأنِّي نُهِيت عن ذلك، كان مُصيبًا، كما أنَّه إذا قال: لأنَّ الغضب يُشوِّش عقلي، وهو مَظِنَّة عدم التثبُّت في الحُكم، كان مُصيبًا أيضًا، والجواب الأول جوابُ التعبُّد المَحْض، والجواب الثاني جواب الالتفات إلى المعنى، وإذا جاز اجتماعهما وعدم تَنافيهما جاز القصدُ إلى التعبُّد([5]).
وهذا المثال الذي ذكره الإمام الشاطبي يوضِّح أنَّ المعنى التعبُّدي في الشريعة الإسلامية لا ينحصِر في العبادات المَحْضة.
ثالثًا: الله تعالى هو الذي شرع المقاصد والأحكام، وهو العليم بمصالح العباد، الحكيم المنزّه عن العبث والسّفه:
الله تعالى هو واضع المقاصد والتشريعات، وهو يعلم معنى كلامه وأحكامه ومآلاتها وتغيرات الزمان، فالذي وضع هذه الأحكام لم يكن جاهلا بتغير الزمان، بل وضع أحكاما عظيمة صالحة لكل زمن تقرأ فيه نصوصها.
فالله تعالى أنزل الكتاب وأوحى بالسنة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعتهما، فما داما يُقرآن فهو قد علم أن المصلحة في طاعتهما مدى الزمان.
يقول أبو المعالي الجويني: (ولو كانت قضايا الشرع تختلِف باختلاف الناس وتناسُخ العصور لانحَلَّ رِباط الشرع، ورجَع الأمر إلى ما هو المحذور من اختصاص كل عصر ودهر برأي، وهذا يُناقِض حِكمةَ الشريعة في حملِ الخَلْق على الدعوة الواحدة)([6]).
رابعًا: شأن المصالح الأُخرويَّة في النظر الشرعي أعمق وأكبر من شأن المصالح الدُّنيويَّة:
فالحديث عن رُوح الشريعة ومقاصدها العُليا لا ينبغي أنْ يكون مُختَزلًا اختزالًا شديدًا، بحيث يشمَل في نهاية المَطاف المُتطلَّبات الماديَّة الدُّنيويَّة، بل شأن المصالح الأُخروية في النظر الشرعي أعمق وأكبر.
جاء في الوحي بيانُ المحور الأساس من دعوة الأنبياء، وحِكْمة الله تعالى من إرسال الرسل، وهي إرشاد الخلق إلى حِكْمة الرَّب من خَلْقِهم: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36]، وقال تعالى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا} [الأنعام: 130].
وجاء ما يؤكد على أن الدنيا إنما هي موضوعة لأجل الابتلاء والاختبار، والآخرة هي دار الجزاء، قال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الكهف: 7]، وقال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2]، وقال تعالى: {إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ} [يونس: 4].
بل جاء في القرآن ما يؤكد أن التمكين في الشأن الدنيوي يجب أن يُتخذ وسيلة للتمكين لأحكام الشريعة من السريان في الواقع، قال الله تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} [الحج: 41].
وجاء في القرآن ما يدلّ على الاحْتِفَاءِ بالمنْجَزات الأخروية في مقابل المنْجَزات الدنيوية: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} [الشورى: 20]، وقال تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} [الإسراء: 19].
وجاء ذمُّ مَن قَلَب المعادلة فقَدَّم العاجلة على الآخرة فقال تعالى: {كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ} [القيامة: 20، 21]، وقال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} [الإسراء: 18، 19].
ولا يفهم من هذا الحطُّ من المصالح الدنيوية؛ بل الأمر كما قال الله تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [القصص: 77]. وإنما المقصود التأكيد على وجود مفهوم المصالح الأخروية أولًا، والتأكيد على تقدمها في الرتبة والمنزلة ثانيًا.
وهذا ما عبّر عنه أبو المعالي الجويني بقوله: (الدنيا إنما تُرعَى من حيث يستمدّ استمرار قواعد الدين منها، فهي مَرعيَّةٌ على سبيل التبعِيَّة، ولولا مسيسُ الحاجة إليها على هذه القضية لكانت الدنيا الدنية حريَّة بأن نضرب عنها بالكلية)([7]).
تقديم روح الشريعة على النصّ والاجتهادات العمرية:
يوظِّف العلمانيون اجتهادات سيدنا عمر رضي الله عنه للقول بأن المقاصد أو المصالح هي الحاكمة على النص القرآني، وأن النص يدور معها وجودًا وعدمًا، أو يُوقف أو يُعطّل إذا حصل تعارض بينهما، وأن الاجتهادات الجريئة التي صدرت من عمر في القضايا المستجِدة أبلغ دليل على ذلك، مثل إيقافه لحد السرقة عام الرمادة، وإيقافه لسهم المؤلفة قلوبهم، وإمضائه الطلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاثًا . ونشير هنا إلى بعض ما يقوله الخطاب العلماني في ذلك:
– لقد فعل عمر ذلك عملًا بنور العقل المنهجي.
– عمر ألغى بعض الفرائض وأوقف بعض الأحكام.
– ألغى عمر حصة المؤلفة قلوبهم اتباعًا لمقاصد الشرع.
– عمر أوقف العمل بنصوص ثابتة.
– يمكن للاجتهاد المطلق أن يخصص العام ويقيد مطلقه، وأن يوقف العمل بنصوص ثابتة، وقد فعل عمر ذلك.
– لقد أبطلَ عمرُ القطعَ عام المجاعة، وقطع سهم المؤلفة قلوبهم، وأبطل قول المؤذن: الصلاة خير من النوم.
– ألغى عمرُ حدَّ السرقة، وسهم المؤلفة قلوبهم.
– حَكَم عمر بما لا يطابق النص القرآني.
– أصبح عمر أكثر مرونة في التعامل مع النصوص.
– لقد أوقف عمر بن الخطاب حد السرقة، وسهم المؤلفة قلوبهم.
– وعمر لم ينصع للآيات في سهم المؤلفة قلوبهم وحد السرقة.
– عمر أبطل مفعول آيتين من القرآن، وهو موقف مستنير.
– خرج عمر إلى المسلمين بتأويل في قضية الزواج بالكتابيات وأحله محل التشريع.
– لقد غير عمر شرائع ثابتة في القرآن والسنة مثل حد الخمر وحد السرقة وسهم المؤلفة قلوبهم.
-الخطاب الديني يتجاهل مقاصد الشريعة كما جاءت في أفعال عمر بن الخطاب عندما ألغى حد السرقة وسهم المؤلفة قلوبهم، وهي ثابتة بالنص.
– أوقف عمر حد السرقة عام المجاعة وسهم المؤلفة قلوبهم مع أن النصوص ثابتة لم تنسخ([8]).
فهذا ما ادّعاه العلمانيون بشأن الاجتهادات العمرية.
فهل كان عُمر بن الخطاب رضي الله عنه يُقدِّم المصالحَ العُليا للشريعة على الأحكام الجزئيَّة؟([9])
إن من الواجب علينا جميعًا أنْ نُدرِك أنَّ جيل الصحابة -الذي يَنتمي له عُمر بن الخطاب رضي الله عنه- هو أعظم أجيال أُمة الإسلام، وأكثرهم عملًا بالمقاصد العُليا للشريعة الإسلامية، وكان صلاح حالهم وعظيم منزلتهم إنَّما هو بتعظيمهم للوحي.
وهذه الشبهة تتضمَّن انتقائيَّة في النظر في مواقف عمر رضي الله عنه وسيرته، فمَن نظَر في سيرة الفاروق رضي الله عنه نظرة شاملةً وجَد أنَّه كان وقَّافًا عند حدود الله، وقد دلَّت على ذلك مواقفُ كثيرة.
منها: ما جاء عن عابس بن ربيعةَ، عن عُمر رضي الله عنه أنَّه جاء إلى الحَجَر الأسود فقبَّله، فقال: «إنِّي أعلَمُ أنَّكَ حَجرٌ لا تضُرُّ ولا تنفَعُ، ولولا أنِّي رأيتُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقبِّلُكَ ما قبَّلْتُكَ»([10]).
ومنها: ما جاء عن سعيد بن المُسيِّب أنَّ عُمر رضي الله عنه قال: (الدِّيَة للعاقلة، ولا ترِث المرأة من دِيَة زوجها)، حتى أخبَره الضحَّاك بن سُفيان الكِلابي أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليَّ: (أنْ أُورِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَة زَوْجِها)، فرجَع عُمر عن قوله([11]).
ومنها: ما جاء عن سعيد أيضًا أنَّ عُمر رضي الله عنه جعَل في الإبهام خَمسَ عَشْرةَ، وفي السبَّابة عَشْرًا، وفي الوُسطى عَشْرًا، وفي البِنصَر تِسعًا، وفي الخِنصَر سِتًّا، حتى وجَدْنا كتابًا عند آل حَزْم، عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «أنَّ الأصابعَ كلَّها سَواءٌ، فأخَذ به»([12]).
وهذه المواقف الكثيرة ممَّا لا يُلقي لها أصحاب هذه الشبهة بالًا، وهذا مخالف للمَنهج العِلمي.
أما التطبيقات الفقهيَّة التي يستدل بها الخطاب الحداثي على تقديم المصلحة على النصّ فإنها إذا أُعطيت حقَّها منَ الدَّلالة كانت دليلًا على فِقه عُمر، وعميق تعظيمه للوحي والنصوص، لا على ضد ذلك من تعطيل النصوص وهدرها:
أ- فتعطيل حد السرقة في عام الرمادة:
هو في حقيقته ناشئٌ عن قيام الشبهة المانِعة من إقامة الحد، فمجرَّد السرِقة غير موجِب لإقامة الحد، حتى تتوافَر شروطُه الشرعيَّة وتنتَفي الموانع.
فمما اشترطته الشريعة لوجوب القطع: أنْ يبلُغ المسروق نِصابًا، وأنْ يكون من حِرْز، وألَّا يكون فيه شُبهة تملُّك، وألَّا يكون آخِذُه مُحتاجًا لسدِّ رَمَقه.
والشرط الأخير كان حاضرًا في مَشهَد عام الرمادة، فقامتِ الشبهة في تلك الظروف بأنَّ الشخص إنَّما سرَق من مَجاعة مُضطَرًّا، فقال عُمر رضي الله عنه: «لا قَطعَ في عِذْق، ولا في عام السِّنَة»([13]).
قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: المجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟ قال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ قال: لا، إذا حملته الحاجة إلى ذلك، والناس في مجاعة وشدة([14]).
قال ابن القيم: (وقد وافق أحمدَ على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعيُّ.
وهذا محض القياس ومقتضى قواعد الشرع؛ فإن السَّنة إذا كانت سَنة مَجاعةٍ وشدّةٍ غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يَسلَم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسدُّ به رمقَه، ويجب على صاحب المال بذلُ ذلك له، إما بالثمن أو مجَّانًا، على الخلاف في ذلك؛ والصحيح وجوب بذله مجّانًا؛ لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع، وهي أقوى من كثير من الشُّبه التي يذكرها كثير من الفقهاء، بل إذا وازنتَ بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت، فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد، وكون أصله على الإباحة، وشبهة القطع به مرة، وشبهة دعوى مِلْكه بلا بينة، وشبهة إتلافه في الحِرز بأكل أو احتلاب من الضرع، وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريق ثم إخراجه، وغير ذلك من الشُّبه الضعيفة جدًّا إلى هذه الشبهة القوية؟! لا سيَّما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسدُّ رمقَه. وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميّز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحدُّ بمن لا يجب عليه، فدُرِئَ. نعم، إذا بانَ السارق لا حاجةَ به وهو مستغنٍ عن السرقة قُطِع)([15]).
وإذا كانت الشبهة قائمةً فالشريعة تَدْرأ الحدَّ بها كما هو معلومٌ مُستَفيض فيها، بحيث نصَّ على ذلك غيرُ واحد من الصحابة، حتى عُمر نفْسه رضي الله عنه حيث يقول: «لأنْ أُعطِّل الحدود بالشبُهات أحبُّ إليَّ من أنْ أُقيمَها بالشبُهات»([16]).
وهو أصل مُطَّرِد طبَّقه عُمر في غير هذه الواقعة، كما جاء عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أصاب غِلمان لحاطب بن أبي بَلتَعةَ بالعالية ناقةً لرجُل من مُزَيْنةَ، فانتَحَروها واعترفوا بها، فأرسَل إليه عُمر، فذكَر ذلك له، وقال: هؤلاء أعبُدُكَ قد سرَقوا وانتَحَروا ناقةَ رجُل من مُزَيْنةَ واعتَرَفوا بها، فأمَر كثيرَ بنَ الصَّلْت أنْ يقطَعَ أيديَهم، ثم أرسَل بعدما ذهَب فدَعاه وقال: لولا أنِّي أظُنُّ أنَّكم تُجيعونَهم حتى إنَّ أحدَهم أتى ما حرَّم الله عز وجل لقطعْتُ أيديَهم، ولكنْ واللهِ لئن تركتُهم لأُغرِّمَنَّكَ فيهم غرامةً توجِعُكَ، فقال: كم ثمنُها؟ للمُزَنيِّ، قال: كنتُ أمنَعُها من أربع مئة، قال: فأعْطِه ثمانِ مئة([17]).
ب- وأمَّا تركُ إعطاء المؤلَّفة قلوبُهم منَ الزكاة:
فعن عَبيدة قال: جاء عيينةُ بن حصن والأقرعُ بن حابِس إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه، فقالا: يا خليفةَ رسولِ الله، إنَّ عندنا أرضًا سَبِخَةً، ليس فيها كلأٌ ولا منفعةٌ، فإنْ رأيتَ أن تُقطعناها. قال: فأَقطَعَها إيَّاهما، وكَتَب لهما عليه كتابًا، وأَشهَدَ عمرَ وليس في القوم، فانطَلَقَا إلى عمرَ ليُشهِدَاهُ، فلمَّا سَمِعَ عمرُ ما في الكتاب تناولَهُ من أيديهما، ثم تَفَلَ فيه فمَحَاهُ، فتَذَمَّرا وقالا له مقالةً سيِّئةً. فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَتَألَّفكما والإسلامُ يومئذٍ قليلٌ، وإنَّ اللهَ قد أعزَّ الإسلامَ، فاذهَبَا فاجْهَدَا جهدَكُما، لا أرعى اللهُ عليكما إنْ أرعيتُمَا. ثم أتى أبا بكرٍ فقال له: أكُلَّ المسلمينَ رَضُوا بهذا؟ فقال له أبو بكرٍ رضي الله عنه: قد قلتُ لك: إنَّكَ أقوى على هذا الأمرِ منِّي([18]).
فما قام به عُمر رضي الله عنه هو تركُ إعطاء الأقرَع بن حابس وعُيَيْنةَ بن حِصن من ذلك السهم؛ لعدم تحقُّق مَناط الإعطاء في الحالة التي طلَبا فيها ذلك؛ إذِ المَناط هو تأليف القلوب، وكان ذلك مُنتَفيًا في حالتهما، فقال لهما عمر رضي الله عنه: «إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يتألَّفُكما والإسلامُ يومَئذ ذليلٌ، وإنَّ اللهَ قد أعزَّ الإسلامَ».
وقد أخرج الإمام البيهقي هذا الحديث في (بابِ سُقُوط سهمِ المؤلَّفَة قلوبهم وتركِ إعطائهم عندَ ظُهُور الإسلام والاستغناء عن التألُّف عليه).
وذكر عن الشعبي أنه قال: (لم يبقَ من المُؤلَّفَة قلوبُهم أحد، إنما كانوا على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استُخلِفَ أبو بكر رضي الله عنه انقطَعتِ الرشا). وعن الحسن قال: (أما المؤلفة فليسَ اليوم).
وقال الإمام الشافعي: (لم أرَ أن يُعْطَى أحَدٌ مِنْ سهمِ المؤلَّفَةِ، ولم يَبْلُغْني أنّ عمرَ ولا عثمانَ ولا عليًّا أعْطَوْا أحَدًا تألُّفًا على الإسلامِ، وقد أغْنَى اللهُ -وله الحمدُ كثيرًا- الإسلامَ عن أن يُتَألَّفَ عليه رجالٌ)([19]).
ج- أمَّا قتل الجماعة بالواحد:
فإنَّ النصَّ يدُلُّ على ما قام به عُمر رضي الله عنه؛ لأنَّ الله تعالى قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، والتعريف في النفْس يُراد به الجِنس لا المُفرَد، والباء للسببيَّة، أي: إنْ كان نفْس شارَكت في القتل تُقتل بالنفْس التي قُتِلت، أي: بسبب هذه النفْس المقتولة.
والمخالفون في هذه المسألة -كالظاهرية- لم يكن مأخذهم أن في المسألة تعطيلَ نص للمصلحة، وإنما هو اختلافٌ في فهم النص، حيث فهموا من الآية أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة، واحتج سائر الفقهاء عليهم بإجماع الصحابة في المسألة، فلم يكن لمسألة المصلحة مدخل لأحد من الفريقين.
فالحاصل أن كثيرًا ممَّن يوظِّف هذه الاجتهادات من العلمانيين في سياق هَدْر أحكام الشريعة التفصيليَّة إنَّما يوظِّفُها لا قناعةً بهذه الاجتهادات؛ وإنَّما لأنَّه يجِد فيها الأداة الأنسَب لتمرير المشروع العَلماني في بيئة لا يُمكن أنْ تُمرَّر فيها القِيَم العَلمانية إلا بغطاء شرعي؛ ولذلك تظهَر عدمُ الجدِّيَّة والصدق في التعامُل مع تلك الوقائع، وذلك بعدم الاهتمام بدفع الأجوِبة العِلميَّة على الاحتجاج الباطل بها، وإنَّما يتِمُّ ذِكرها وعلى الطرف المُقابِل تقديمُ الإجابات، ثم لا يهتمُّ أصحاب الشبهة بمضمون تلك الإجابات، وكأنَّه حوارٌ من طرَف واحد.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) «العلمانيون والقرآن الكريم» د. أحمد إدريس الطعان (ص: 382).
([2]) «السياسة الشرعية» (ص: 30).
([3]) هذا كلام عدد من العلمانيين في هذا العصر، انظر مواطن كلامهم وأسماءَهم في كتاب: «العلمانيون والقرآن الكريم» د. أحمد إدريس الطعان (ص: 391-392).
([4]) انظر: «ينبوع الغواية الفكرية» لعبد الله العجيري (ص: 292-323)، «زخرف القول» لعبد الله العجيري وفهد العجلان (ص: 103-113).
([6]) «نهاية المطلب» (17/ 364).
([8]) هذه النصوص لمجموعة من العلمانيين مثل القمني، وحسين أحمد أمين، ومحمد جمال الباروت، وفتحي القاسمي، والصادق بلعيد، وعبد الهادي عبد الرحمن، وطيب التيزيني، وأنور خلوف، ونائلة السليني، ونصر أبو زيد، وغيرهم، انظر مواطنها في كتبهم في كتاب: «العلمانيون والقرآن الكريم» د.أحمد إدريس الطعان (ص: 393-394).
([9]) انظر: «ينبوع الغواية الفكرية» لعبد الله العجيري (ص: 324-329).
([10]) رواه البُخاري (1597)، ومُسلم (1270).
([11]) أخرَجه أبو داودَ (2929)، والتِّرمِذيُّ (2110)، وابن ماجه (2642).
([12]) أخرَجه عبد الرزَّاق (17698).
([13]) أخرجه عبد الرزَّاق (18990).
([14]) ينظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم (3/ 442)، و«البدر المنير» لابن الملقن (8/ 679).
([15]) «أعلام الموقعين» (3/ 443-444).
([16]) أخرَجه ابن أبي شَيْبةَ (29085).
([17]) أخرَجه البَيْهَقي (17064).
([18]) أخرَجه البَيْهَقي (12968)، وانظر: «مسند الفاروق» (ص: 384).