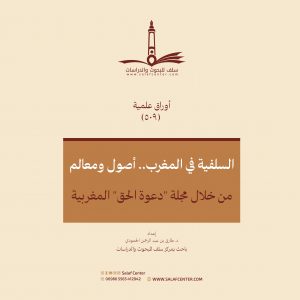المعاهدة بين المسلمين وخصومهم وبعض آثارها
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
باب السياسة الشرعية باب واسع، كثير المغاليق، قليل المفاتيح، لا يدخل منه إلا من فقُهت نفسه وشرفت وتسامت عن الانفعال وضيق الأفق، قوامه لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف، والإنسان قد لا يخير فيه بين الخير والشر المحض، بل بين خير فيه دخن وشر فيه خير، والخير الموجود المتاح قد لا يكون هو المطلوب، بل المطلوب خير الخيرين ودفع شر الشرين، وهذا الباب لنفاسته وندرة البحث فيه صار الوالج له أقرب إلى صاحب التعدين، فهو يحفر الأمتار تلو الأمتار ليحصل على مثقالٍ من بُغيته، وذلك أن باب السياسة الشرعية خلط بأدب الملوك، وكَتَبَه قديما وزراء الحكام أو وُلَاتُهم، فكانوا يراعون قوة الدولة ووجود السلطان؛ فغلب على تنظيرهم فقه المطلوب، وإغفال الممكن، أو عدم الإطناب فيه؛ لأنهم كانوا حين يكتبون يكتبون الصورة المثلى للشريعة، والتي ينبغي للحاكم أن يسعى إليها ويطبقها، ويتركون الممكن إلى اجتهاد الحاكم وأمانته في دينه.
ومن الدواهي في السياسة التي يتهيبها المفتون ويفر منها الأمراء المقسطون باب المعاهدات؛ لأنه على شفا حفرة من النار، فبين القضاء على المسلمين بعهد ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب يخاف الفقيه، ويخر القاضي، وينكسر الأمير خوفا من تنزيل مصلحة موهومة مكان مظنونة، أو درء مفسدة مظنونة بأخرى محققة، فتغلب العاطفة، فيفتي الفقيه بورعه، ويتبع الحاكم عاطفته، وقد يصفق الدهماء لموتٍ محقَّق وكفرٍ أبلَق؛ ظنًّا منهم أن ورع الفقيه في أمر العامة ديانة، وسياسة الناس بالعاطفة شجاعة، فيتخيّلون قوة عاد وسطوة ثمود، ثم يتفاجؤون ببأس لا قبل لهم به، وهلاك لم يأخذوا الأسباب في دفعه.
ومع ذلك ظلّت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم صادقة، وخبره متحقّقًا في وجود طائفة قائمة بأمر الله، فلكلّ داهية أبو الحسن، فكانوا يقولون بمقتضى الدين، ويرفقون بأمتهم، ويحملونهم على المعهود الوسط، وقد تناول العلماء موضوع المعاهدات وقواعدها، وما يجب على جماعة المسلمين فيها، منطلقين في ذلك من قاعدة التفريق بين الواجب والقدرة عليه، وبين الحكم الأصلي المأمور به، وبين المقدور عليه منه في حدود قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا} [التغابن: 16].
وفي هذه الورقة سنتناول المعاهدات من حيث المفهوم، وبعض الأحكام، وما يترتب على مفهومَي الرد والتسليم، وذلك في المباحث التالية:
المبحث الأول: مفهوم المعاهدات في الإطلاق الشرعي والقانوني:
القرآن والسنة مليئان بالحديث عن العهد والميثاق والعقد، وهي ألفاظ متقاربة، تأتي بمعنى العهد، ووجوب الوفاء بها واجب على الجميع لكل من وقع منه أو عليه، ومن ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] أي: بِالْعُهُودِ، كما فسّرها ابن عباس ومجاهد([1]).
وقال مقتل بن سليمان: “يعني: بالعهود التي بينكم وبين المشركين”([2]).
والأصوب حملها على جميع العقود من عهد وأمان ونصرة ونكاح وبيع([3])، ففي الحديث: «فوا بحلف الجاهلية؛ فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفًا في الإسلام»([4]).
ومنه قوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا} [الإسراء: 34]. وغيرها من الآيات التي تتحدث عن العهد بمعناه العام.
وثمة آيات وأحاديث أخر تتحدّث عن العهد بالمعنى الخاص، وهو ما يعطى للكافر من أمان وغيره، ومن ذلك قوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِين} [التوبة: 4].
وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَخَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي بِسَيْفِهِ فَيَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مُؤْمِنًا لِإِيمَانِهِ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ بِعَهْدِهِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ، أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ، أَوْ يَدْعُو إِلَى الْعَصَبِيَّةِ، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ»([5]).
ولفظ مسلم: «وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ»([6]).
والذي يعنينا هو العهد بمعناه الخاص الذي يقع بين طرفين مسلمِين وكفارٍ، وهذا الأخير عرفه الفقهاء بعدة تعريفات، كثير منها لا يفرق بينها وبين المهادنة والموادعة والصلح والمسالمة، وعلى هذا الأساس مورد هذه التعاريف:
قال ابن الهمام الحنفي: “الموادعة: المسالمة، وهو جهاد معنى لا صورة”([7]).
وقال عنها الزرقاني: “أي: صلح الحربي مدة ليس هو فيها تحت حكم الإِسلام”([8]). وبنحو قوله قال أبو البركات الدردير وعليش من تلامذة العدوي([9]).
وقال عنها ابن الرفعة الشافعي: “مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة، بعوض أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينه ومن لا يقر، كما قاله الماوردي في كتاب السرقة. وهي مشتقة من الهدون، وهو السكون؛ فإنه إذا صالحهم سكنت ثائرة الفتنة وهدأت، وهذا العقد يسمى: مهادنة، ومعاهدة، ومسالمة، وموادعة”([10]). وبنحو قوله قال ابن الملقن وغيره من الشافعية([11]).
وعرفها ابن قدامة: “أن يعقد الإمام أو نائبه عقدًا على ترك القتال مدة بعوض، وبغير عوض، ويسمى: مهادنة، وموادعة، ومعاهدة”([12]). وبنحو قوله قال المرداوي([13]).
وهذه التعريفات لم تخلُ من تسامح مردُّه إلى الطريقة الفقهية الجارية على طريقة العرب في الإفهام بالرسم والمثال بدل الحد الجامع المانع؛ ذلك ما يجعل الباحث قد لا يجزم باحتكار بعض المعاني داخل الحيز الموضوعي لها، فقد يطلق الفقهاء الصلح والعهد على ما يقع بين المسلمين والكفار، والموادعة يخصونها بالحرب، ومثلها المهادنة، والحاصل أن المعاهدة بالمعنى الذي نتكلم عنه تقع على نحو تكون فيه أعم من الصلح ومن الموادعة، ومرد ذلك إلى موضوعها؛ لأنها في الحقيقة قد لا تقف عند حد المتاركة في الحرب، بل قد تتجاوزه إلى ما هو أعم من ذلك من تجارة ومعاملات، ومن ثم كانت المعاهدات محددة عند الفقهاء من حيث المشروعية بالمصلحة الغالبة تحقيقا أو ظنا، والغلبة في المصلحة تفهم بوجود مفسدة مغمورة في جانبها، فذكرها لا يضر، إذ لا تخلو المعاهدات بمعنى الذمة من إقرار على الكفر، وبمعنى الموادعة وغيرها بالسماح للطرف الثاني من الخروج من أحكام الإسلام، والمعتمد في المذاهب الأربعة عدم محدوديتها بالزمن أو اشتراط قوة المسلمين؛ لأنها وإن جازت في حالة قوتهم فهي في حالة ضعفهم أولى، وهذا ما يقتضيه الفقه ومناط الحكم، ولا يخفى كذلك أنها بالمعنى العام لا تأتي إلا من حاكم أو نائبه؛ لما فيها من الإلزام لعامة الناس، وحيث قيل بجوازها لزم مقارنتها بغيرها، وهي الاتفاقيات المعدة سلفا خارج حكم الشريعة وغير مراعية لها، وهو ما يسمى بالاتفاقيات الدولية، وهي في جوهرها تعني: “الاتفاقيات الدولية العامة ذات الطابع السياسي، كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف وما شابه”([14]).
وهي ملزمة للمتعاقدين إذا لم يتحفظ أحد منهما على بعض البنود، وهذه الاتفاقيات هي في نفسها ملزمة للداخلين فيها، ويترتب على الإخلال بها عقوبات اقتصادية وسياسية، وأحيانا عسكرية، ومن ثم لزم الكلام عليها، وعلى حكمها، وعلى الالتزام بها فيما ظاهره مخالفة الشرع تغليبا للمصلحة أو مراعاة للحاجة.
المبحث الثاني: حكم الدخول في المعاهدات:
من نافلة القول أن نعيد الحديث في وجوب الوفاء بالعهد، وما ورد في ذلك من أدلة؛ إذ الكلام في هذا حزٌّ في غير مفصل، وتكلّم في المتفق عليه، وإنما الكلام على ذات المعاهدات وصورها الموجودة في الشرع، هل هي حوادث أعيان، أم أنها وسائل وأساليب شرعية ذات أحكام معللة يقاس عليها نظيرها؟
واعلم -رحمك الله- أن الكلام عن أحكام الاستضعاف في الشريعة ليس تشريعا للاستضعاف، ولا تسويغا لدوام الآثار المترتبة عليه، وإنما هو فقه مرحلة يقدَّر بقدره، وحكم شرعي كسائر أحكام المشقة المنوطة بمظنتها، ومن نظر في حال الإسلام وتدرجه في فقه الاستطاعة والتفريق بين الممكن والمطلوب وبين الواجب والقدرة عليه لم يجد المكلَّف بدًّا من الاعتراف بأن مبدأ التعامل مع الواقع أمر مستساغ شرعًا، ومنسجم مع ما تدعو إليه الشريعة، من اعتبار الظنون ومراعاة الأحوال، ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحلاف، واستفاد من أخرى، وعمل بمبدأ تفويت الفرص؛ انطلاقا من التجاوب مع المعاهدات ذات الأمد البعيد التي لا يظهر أثر حكمتها بادي الرأي؛ لأن فائدة المعاهدات هي إحلال السلام مكان الحرب، والعدل مكان الظلم، والخير مكان الشر، هذا هو المقصود الأصلي وهو المطلوب إن أمكن؛ فإن لم يمكن فالمتاح ليتفرغ الناس لدينهم ومعايشهم، وتتاح لهم فرصة التفكير من جديد، والعمل من جديد في واقع أقل قلقا من واقع ما قبل المعاهدات، وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على جواز الدخول في المعاهدات:
- القرآن الكريم:
– قال سبحانه: {بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِين} [التوبة: 1]. وهذه الآية نزلت “في خزاعة ومدلج ومن كان له عهد من غيرهم، وذلك أنه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج، ثم قال: «إنه يحضر البيت مشركون يطوفون بالبيت عراة، فلا أحب أن أحج حتى أحج وليس معي مشرك»، فأرسل أبا بكر بن أبي قحافة وعلي بن أبي طالب، فطافا بالناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها كلها وبالموسم كله، فآذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة أشهر، وهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات -عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر- أن لا عهد لهم، فآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا”([15]).
– وقال الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال: 72].
فقد دلت الآية بمنطوقها أن الميثاق والعهد مانعان من النصرة في الدين.
- السنة النبوية:
دلت السنة على مشروعية العهد والمصالحة، ومن ذلك عهد النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ومصالحتهم في المدينة، وكذلك صلحه مع المشركين في الحديبية، فقد أخرج البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا، وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا، أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ([16]).
وفي صلح الحديبية وغيره من المعاهدات من التفصيل ما يخدمنا فيما نحن فيه، من أن مدار الجواز على المصلحة الراجحة، والتي تغمر في بعض المسائل التي قد تكون بالنسبة للبعض مداهنة أو إعطاءَ دنية في الدين؛ وذلك أن مدار التكليف هو القدرة والاستطاعة، قال شيخ الإسلام: “الأمر والنهي -الذي يسميه بعض العلماء: التكليف الشرعي- هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل، ولا تجب على من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد، وكما لا تجب الطهارة بالماء والصلاة قائما والصوم وغير ذلك على من يعجز عنه. سواء قيل: يجوز تكليف ما لا يطاق أو لم يجز؛ فإنه لا خلاف أن تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في الشريعة، بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف وإن كان تكليفه ممكنا، كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وإن كان له فهم وتمييز؛ لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه، ولأن العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا وهم يختلفون فيه، فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ”([17]).
فحيث عجز المسلم عن إقامة كل الدين أو نصرة المستضعفين فعل ما يقدر عليه من ذلك وسقط عنه الباقي، ويحمل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه؛ مما يبعث به من الشبهات» أو: «لما يبعث به من الشبهات» هكذا قال([18]).
وقوله عليه الصلاة والسلام عن يأجوج ومأجوج: «أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرّز عبادي إلى الطور»([19]). قَالَ الْعُلَمَاءُ: “مَعْنَاهُ لا قدرة ولا طاقة، يقال: ما لي بهذا الأمر يد، وما لي بِهِ يَدَانِ؛ لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد، وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه. ومعنى «حرزهم إلى الطور» أي: ضمهم واجعله لهم حرزا، يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازا: إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ”([20]).
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في فوائد صلح الحديبية: “أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيم على المسلمين جائزةٌ للمصلحة الراجحة ودفعِ ما هو شرٌّ منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما”([21]).
وقد ذكر شيخ الإسلام في معرض حديثه عن الفرق بين تطهير الأرض من الكافر وتطهيرها من الساب كلاما مفيدًا، وهذا نصُّه: “وجواز إقرار أهل الكتابين على دينهم بالذمة ملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليهم لا ينافي إظهار الدين وعلو الكلمة، وإنما تجوز مهادنة الكافر وأمانه عند العجز أو المصلحة المرجوة في ذلك”([22]).
وفي الحديث: «ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوًّا من ورائكم»([23]). وفيه جواز الدخول في حلف معهم، والقتال لرفع راية الإسلام، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في تحالفات مع المشركين لدفع الصائلين، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حماية المطعم بن عدي، ودخل أبو بكر رضي الله عنه في حماية ابن الدغنة، وأمر أصحابه بالذهاب إلى ملك الحبشة، ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وقد اقترح النبي على الصحابة رضوان الله عليهم مصالحة المشركين على نصف ثمار المدينة، وهذا وإن لم يفعلوه فإن اقتراحه من النبي صلى الله عليه وسلم يدلّ على مشروعيته وجوازه، ولو أخذوا بالعزيمة، قال ابن القيم: “ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عُيينة بن حِصن والحارثَ بن عوف رئيسَي غطفان على ثُلُث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار السَّعدَين في ذلك، فقالا: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعًا وطاعةً، وإن كان شيئًا تصنعه لنا فلا حاجة لنا به، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمَعون أن يأكلوا منها ثمرةً إلا قِرًى أو بيعًا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزَّنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: «إنما هو شيء أصنعه لكم؛ لما رأيتُ العرب قد رمتكم عن قوسٍ واحدة»“([24]).
وفي هذا كفاية لمن أراد الله به الهداية وفقه المسألة من بابها، ولعل في التنزيل على أحكام الرد والتسليم مزيد بيان كما في المبحث الثالث.
المبحث الثالث: حكم التسليم والرد في المعاهدات:
لا يخفى أن العهد إذا أبرم مع الكفار وكانت مصلحته راجحة لزم المسلمين الوفاء به شرعا، ومن ضمن بنود العهود المقلقة والتي لا يتأتى للمسلم الركون إليها وقبولها في الحالة العادية قضية التسليم والرد للمسلم الفار من الكفار، وهاهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن هذه الأحكام محلّ الحديث عنها الضرورات الشرعية وليست الحاجات العادية، ومحل تسويغ وقوعها غلبة الظن أن الجهة الموقّعة للعهود موثوقة مؤتمنة لا فاجرة ظالمة، أو متهتّكة خائنة، فَتَسْتَسْهِل أحكام الشرع، وتستهين بالمسلمين وبأعراضهم ودينهم، وأن يكون القائم بذلك إماما له سلطة شرعية وشوكة معتبرة، فهذه الأحكام لا تناط بالجماعات، ولا بالتنظيمات، ولا بالأحزاب، والموقِّع منهم لمثلها مفتات على الأمة، وحيث وجد السلطان القائم بأمر الله والذي تقوم به مصالح الناس، ويدين له أهل الشوكة والمنعة من أهل البلاد التي تحت سلطانه بالطاعة؛ فإنه يجوز له توقيع أي اتفاق يعلي من شرع الله، ويحقق للمسلمين مصالحهم دنيا وأخرى، كما يحقّ له مراعاة ضعفهم وتفويت بعض مصالحهم لبقاء ما هو أهم منها، ومن هنا جاء الحديث عن توقيع الاتفاقيات التي يتخلى فيها هو عن نصرة من لا يستطيع نصرته ممن ليس تحت سلطانه، أو في نصرته ضرر أعظم من تركه قد يترتب عليه زوال مصالح المسلمين، وإحلال الذلّ بديارهم مع فتنتهم في دينهم، وقد فرق الفقهاء في حالتي الاتفاقيات بين قضيتين مهمتين هما التسليم والرد، وقبل ذلك لا بد من مراعاة ضوابط:
أنه لا يقبل الاتفاق الذي ظاهره المفسدة إلا إذا تحقق أن قبوله يرفع الضرر، وأنه محل تعين لا مندوحة عنه، وأن يسعى المكلف إلى رفع العجز المفضي إلى المفسدة.
ومن نظر في كتب الفقه لن يجد فيها لفظ التسليم للمسلم بهذا المصطلح، ربما لثقل الحمولة الثقافية للكلمة، وما تحمله من رضا؛ ولكنه عمليا يطلق في الاصطلاح الحديث على: “الإجراء الذي تسلم به دولة استنادا إلى معاهدة أو تأسيسا بالمثل عادة إلى دولة أخرى شخصا تطلبه الدولة الأخيرة لاتهامه، أو لأنه محكوم عليه بعقوبة جنائية”([25]).
وهاهنا أمور خارجة عن محل الخلاف، وهو تسليم المسلم لدولة إسلامية جنى عليها، فالخلاف إنما يقع في تسليمه لدولة كافرة، والذي وقفت عليه من كلام أهل العلم تصريحا هو حرمة التسليم، وذلك أن التسليم صورته أن يأخذ المسلم من بلاد المسلمين ويسلم للكفار بدون تمكينه من أي وسيلة للدفاع عن نفسه، وجل أهل العلم حرم هذه الصورة؛ لأنها من الهوان، وللنص عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة»([26]).
قال ابن حجر: “وقوله: «ولا يسلمه» أي: لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من ترك الظلم، وقد يكون ذلك واجبا، وقد يكون مندوبا بحسب اختلاف الأحوال”([27]).
وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز تسليم المسلم للكفار بالصورة التي ذكرنا، وإنما اختلفوا في الرد وهو التخلية بين المسلم والكفار يطلبونه دون أن يسلم إليهم، أو ينزع منه سلاح يدفع به عن نفسه، واستثنوا من ذلك رد المرأة المسلمة والصبي لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [الممتحنة: 10].
فبعضهم جعل النساء مستثنيات من صلح الحديبية، وبعضهم رأى أن الآية ناسخة لرد النساء في الصلح([28])، ونصوا على أن المرأة المسلمة لا ترد للكافر، ولو كان زوجَها، واختلفوا في تعويضه صداقها([29]).
أما رد الرجل المسلم البالغ القائم بأمر نفسه، فالذي عليه المحقّقون جوازه، وبعضهم خصه بالعشيرة، والذي دلت عليه النصوص هو الجواز بشرط عجز المسلمين، قال بعض الفقهاء: “شرط رد المسلم إلى الكفار فاسد يفسد الصلح، إلا إذا كان بالمسلمين خور وعجز ظاهر؛ ولذلك شرطه -صلوات الله عليه- في صلح الحديبية”([30]). وأجازه فقهاء الحجاز للإمام الأعظم، لا لمن هو دونه([31]).
وكلام ابن القيم أتى على فقه المسألة من أصلها حين ذكر في فوائد صلح الجديبية: “ومنها: أن شرطَ ردِّ من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلمًا إلى غير بلد الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه ردُّه بدون الطلب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردَّ أبا بصير حين جاءه، ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاؤوا في طلبه مكَّنهم مِن أخذه، ولم يُكرهه على الرجوع”([32]).
وبيّن المسألة في موضع آخر من الباب وجمع شتاتها فقال: “وَمِنْهَا: جَوَازُ صُلْحِ الْكُفَّارِ عَلَى رَدِّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَلَّا يُرَدَّ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ، هَذَا فِي غَيْرِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ رَدِّهِنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، وَهَذَا مَوْضِعُ النَّسْخِ خَاصَّةً فِي هَذَا الْعَقْدِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى دَعْوَى النَّسْخِ فِي غَيْرِهِ بِغَيْرِ مُوجِبٍ”([33]).
فتحصّل من كلامه الجواز بالشروط التي ذكرنا مع عدم وجوب طلب المسلم، أو تضمينه ما أتلف، كما نص عليه بعض الفقهاء، وهذا الباب عسر وليس بالهين، ولا فيه قول فصل يمكن للباحث أن يجعله سنة متبعة للناس، بل هو تابع للأحوال من قدرة وعجز، وديانة يتسم بها أطراف الصلح، وقد اقترح بعض الباحثين المعاصرين عدة مخارج للخروج من مأزق الرد؛ وذلك بفعل أحد الإجراءات التالية:
- إذا كان الغرض من التسليم أو الرد إكمال إجراءات التحقيق؛ فإنه من الممكن دعوة فريق للتحقيق، وبحضور فريق من الدولة المسلمة؛ لأنه لا توجد نصوص في القوانين الدولية تجبر الدول على تسليم رعاياها، أو توجب التحقيق في مكان الحادث.
- التعويض بالمال بدل التسليم أو الرد.
- محاكمة الشخص في الدولة الإسلامية، وتطبيق قوانينها عليه، وإلزامه بالمعاهدة.
- إخراجه من الدولة الإسلامية بدل تسليمه، وذلك بتخييره بالخروج إلى أي بلد يطمئن إليه([34]).
والغرض من كل ما سبق تنبيه طالب العلم أن باب السياسة الشرعية مبني على الرفق بالناس، وتحقيق المصالح، ودرء المفاسد، وآية ذلك دراسة التجارب البشرية، وفقه النصوص الشرعية، وإعمال الظنون المعتبرة، ومن ظنه بابا يمكن إعمال العاطفة فيه، أو تغييب صوت العقل؛ فليتركه ترك قلى، فليس من أهله، ولن يهتدي فيه سبيلا.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([2]) تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 448).
([5]) رواه الإمام أحمد (8061).
([7]) فتح القدير على الهداية (5/ 456).
([8]) شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 263).
([9]) الشرح الكبير للدردير (2/ 206)، ومنح الجليل محمد عليش (3/ 228).
([10]) كفاية النبيه في شرح التنبيه (17/ 105).
([11]) عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (4/ 717)، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني (6/ 86).
([12]) الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 573).
([14]) أبو هيف علي صادق، القانون الدولي (ص523). وللاستزادة ينظر: الأحكام الفقهية في المعاهدات النبوية.
([15]) تفسير مجاهد (ص363)، وتفسير مقاتل بن سليمان (2/ 156)، تفسير الطبري (8/ 25).
([17]) مجموع الفتاوى (10/ 345).
([20]) شرح صحيح مسلم (18/ 68).
([25]) الوسيط في قانون السلام (ص435).
([28]) تفسير البغوي (5/ 75)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 149).
([29]) المعلم بفوائد مسلم (3/ 38).
([30]) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (9/ 788)، ونقله البيضاوي في تحفة الأبرار (3/ 61).
([31]) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (21/ 324).
([34]) ينظر: كتاب الاستضعاف وأحكامه، لزياد بن عابد المشوخي (ص322) وما بعدها، وقد أفرد المسألة ببحث مستقل بعنوان: تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي، فلينظر.