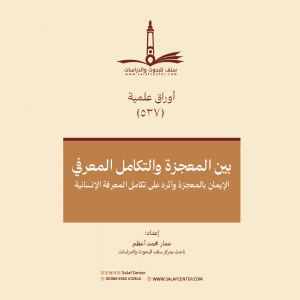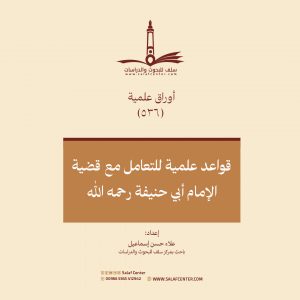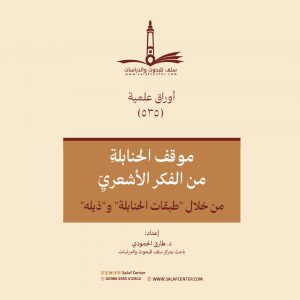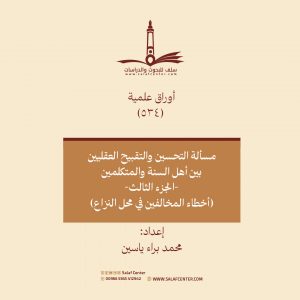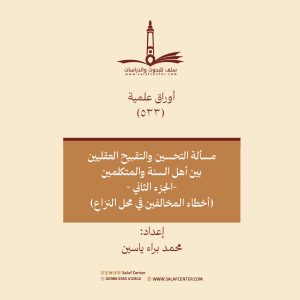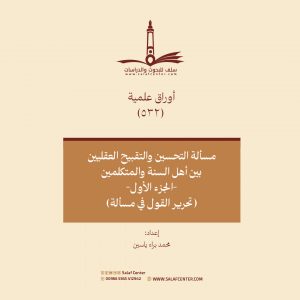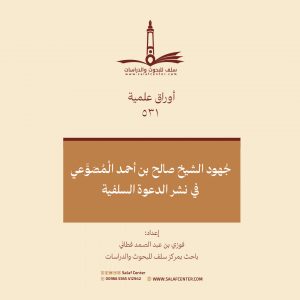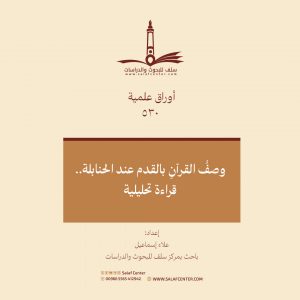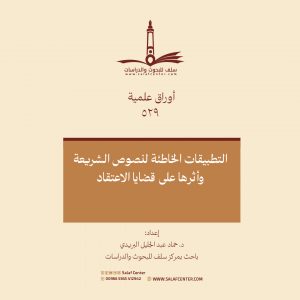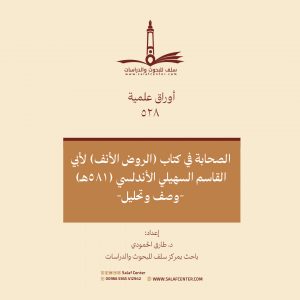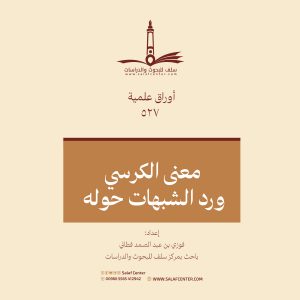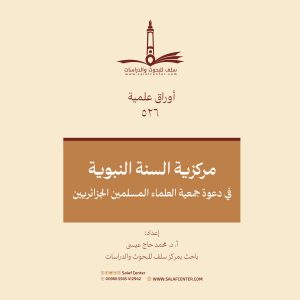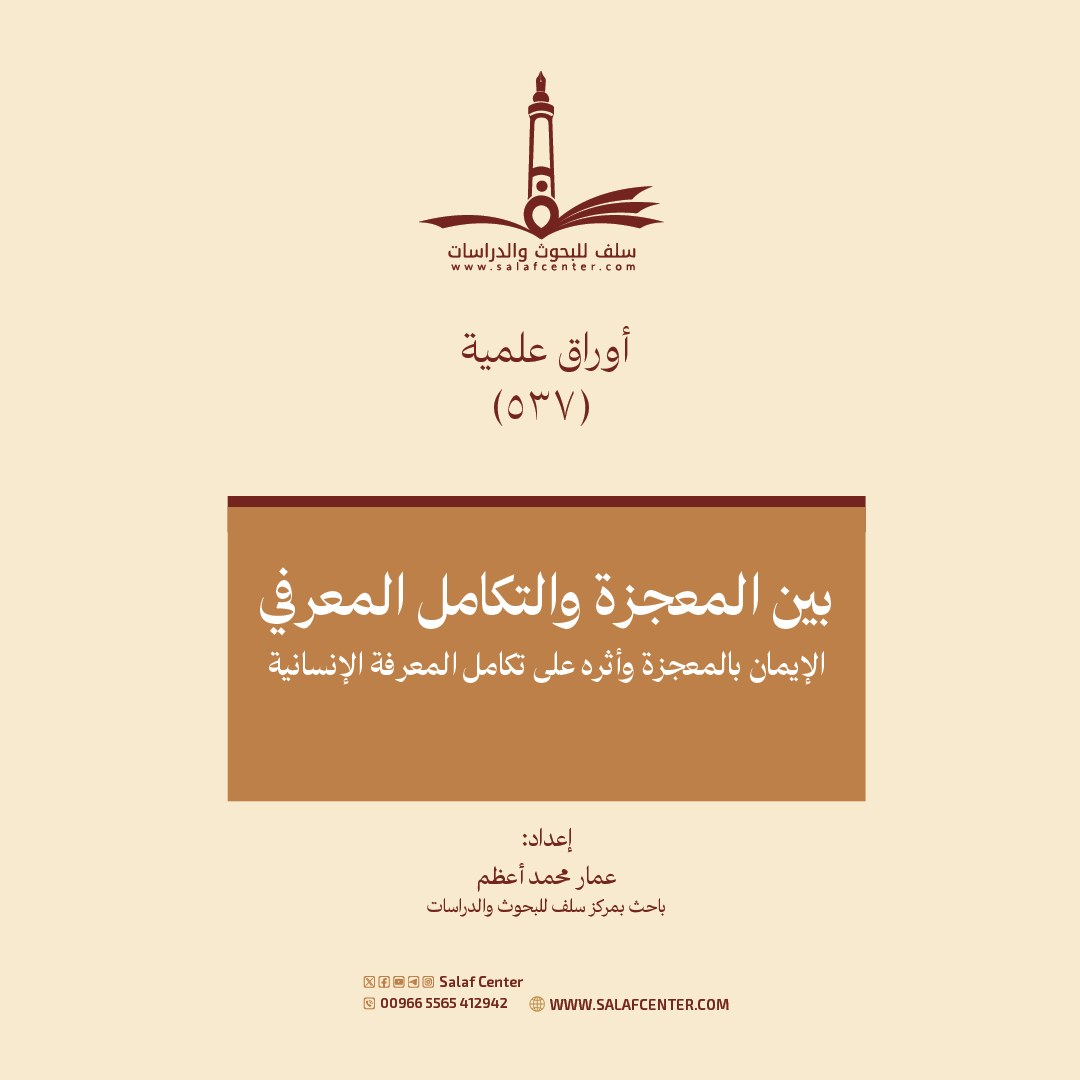
بين المعجزة والتكامل المعرفي.. الإيمان بالمعجزة وأثره على تكامل المعرفة الإنسانية
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
مقدمة:
لقد جاء القرآن الكريم شاهدًا على صدق نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل وعلى صدق الأنبياء كلهم من قبله؛ مصدقًا لما معهم من الكتب، وشاهدا لما جاؤوا به من الآيات البينات والمعجزات الباهرات.
وهذا وجه من أوجه التكامل المعرفي الإسلامي؛ فالقرآن مادّة غزيرة للمصدر الخبري، وهو في ذات الوقت يرشدنا إلى فسح المجال لكل مصدر من المصادر المعرفية في مجاله، ويمتاز بكونه ينظر إلى المصادر المعرفية كلها (الخبر الصادق – العقل – الحسّ والتجربة) على أنها تمثل نوعًا من التكامل فيما بينها بما يحقّق الانسجام والتواؤم المعرفي التامّ، ويحقق للإنسان أعلى ما يمكن من المستويات المعرفية، ولا يصدّ ولا يغلق دونه أيّ باب من أبواب المصادر المعرفية، سواء بدعوى التعارض بين مصادرها أو غيرها من الدعاوى، فلا يمكن أن يتعارض الوحي الصحيح الثابت بما في العقل الصريح؛ لأن الدلائل القطعية لا تتعارض.
ولكن العجيب بعد هذا التكامل المعرفي أن يُرمى أهل الأديان عموما والدين الإسلامي خصوصا بتهمة الحجر على المنظومات المعرفية وإغلاق الأبواب دون مصادرها من عقل وحسّ، مع أنه أكثر وأدق المنظومات المعرفية مصادرَ سواء الخبر أو العقل أو الحس، فنجد من يقول بأن الإيمان بالمعجزات إغلاق لأبواب المعرفة العقلية أو الحسية وإفساحٌ للمجال أمام الخرافة والتكهنات والخيالات والجهل!
ومن هنا كانت هذه الورقة العلمية من مركز سلف للبحوث والدراسات لتجلية التكامل المعرفي في المنهج الإسلامي خصوصا، وعدم مناقضة الإيمان بالمعجزات لسائر المصادر المعرفية، وإنزال كل مصدر منها منزلته.
مركز سلف للبحوث والدراسات
قصة باحث عن النبوة الحقة:
بينما كان ملكٌ من ملوك الروم يتنعَّم بما أُوتي من نعيم سَمع بأن رجلًا من بائسي الحال في صحراء الجزيرة العربية القاحلة شديدة الحرارة صيفًا شديدة الحاجة إلى ما تزوده بها مدنه الشامية من غذاء ومتاع؛ سمع أن رجلًا من هؤلاء يزعم أنه مرسل من عند إله العرب والروم والفرس، بل وإله العالمين أجمعين.
لقد كان الملك يؤمن بالله، ويؤمن بما تواتر عن الأمم وأنبيائهم من الآيات الباهرات التي جاؤوا بها، بل كان يعرف أحوالهم وأوصافهم وما يدبِّر الإله الحق لرسله الصادقين كي تميِّز البشرية بينهم وبين المتنبئين الكاذبين؛ ولما كانت تلك الأدوات البحثية بيديه طفق يبحث جادًّا صادقا في بحثه مستخدما تلك الأدوات والأدلة البحثية.
لقد بدأ ملك الروم هرقل بحثه بالسؤال عن حال هذا الرجل ومقارنة حاله بما يعرف من أحوال الأنبياء الصادقين وصفاتهم؛ فجاء بمن كان في الشام من أقرب الناس إلى ذلك الرجل، فوجد ألدَّ أعدائه آنذاك وهو أبو سفيان، فجعل يسأله عن حال ذلك الرجل، وأعمل تلك الدلائل والأدوات البحثية التي تميز له النبيّ الصادق من غيره من المتنبئين الكذابين الأفاكين، فإنّ حال النبي لا يشتبه مع حال الكاذب، وكان مما سأله هرقل فيما حكى أبو سفيان: قال: كيف نسبه فيكم؟ قلتُ: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا، قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا، قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم، قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا، قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا، قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، قال أبو سفيان: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم، قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة([1]).
وهنا أدرك الملك أنه نبيّ حقًّا، واستدلّ هرقل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحواله وأموره؛ لأن حال الأنبياء وأصولهم معروفة، ودلائل النبوة كثيرة متضافرة، لا تتوقف على نوع أو نوعين من الأدلة، وطرق معرفة النبوة ودلائلها كثيرة جدا؛ فإن التمييز بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب أسهل من التمييز بين الشاعر الصادق والكاذب من الناس، وقد بين هرقل ملك الروم هذا لأبي سفيان بما بقي بعده أسوة لكل باحث جادّ صادق عن النبوة الحقة الصادقة والنبي الصادق([2]).
النبوة خبر يعتمد على المصدر الخبري والتعامل معه كغيره من الأخبار:
النبوة: مصدر من التنبُّؤ وهو يرجع إلى الخبر، إذن النبوة خبرٌ من الأخبار.
ولئن كان الأمر كذلك فإننا اليوم وفي وقتنا الراهن نتلقى في اليوم الواحد -بل وفي الساعة الواحدة- عددا كثيفًا من الأخبار، فكيف يتعامل معها الإنسان؟ وكيف يتحقق من صحتها؟
إن مهارة فحص الخبر والتعامل معه وتمييز حقه من باطله من المهارات الحياتية الضرورية التي لا تخفى على الناس؛ فهم يميزون الصادق من الكاذب، ويسبرون الأخبار ويعرفون المبهرج المزيف منها من الحق الصادق مهما كان عظم ذلك الطلاء الذي غطي به البهرج، فهذه المهارة وهذه القضية بالنسبة للبشرية مهارة ضرورية لتستقيم أمورهم وتنضبط أعمالهم ومصالحهم في الحياة؛ وإلا فكيف يتعايش الناس ويتعاملون فيما بينهم إن كانوا لا يميزون بين الأمور الصادقة الحقيقية وبين القضايا المزيفة المكذوبة؟!
إن البشرية منذ فجر التاريخ وحتى يوم الناس هذا تدرس الأخبار بشتى الوسائل والطرق، وتميِّز صحيحها من زيفها، وتصل إلى اليقين الحق في ذلك، ومن المستحيل ألَّا يميز الناس بين الكذب والصدق من الأخبار والقضايا ويختلط عليهم ذلك حتى لا يكادون يميزون بينهما ولا يعرفون الحق فيهما، إنك وإن اختلط عليك في الوهلة الأولى إلا أنك تميز بين الحبيب وصدقه في حبه لك وبين من يدَّعي الحب والحب منه براء، كما أنك تميز بين الخبير العالم الحق الصادق وبين من يدَّعي الخبرة والعلم والمهارة وهو منه خواء، وكذلك الناس يميزون بين الطبيب وصدقه في مهارته الطبية وبين الشاعر وصدقه في شاعريته ولو بعد حين، فكذلك التمييز بين أخبار النبي الصادق والكاذب؛ “ذلك أن للحقيقة قوة غلابة تنفذ من حجب الكتمان، فتقرأ بين السطور وتعرف في لحن القول، والإنسان مهما أمعن في تصنّعه ومداهنته لا يخلو من فلتات في قوله وفعله تنم على طبعه إذا أحفظ أو أخرج أو احتاج أو ظفر أو خلا بمن يطمئن إليه”([3]).
إذن؛ فحص الخبر والتأكد من صحته وصدقه يقوم على أمور ودلائل وبراهين كثيرة يستخدمها الواحد منا في يومه وليلته؛ فالثقة بالمصدر الناقل (الراوي) من دلائل صدقه، والتزام المصدر الناقل بالصدق في عامة أخباره أيضا مما يدل على صدقه؛ فمن لم يجرب الناس عليه كذبا طوال عمره لا يمكن أن يكذبوه، ومن ذلك أيضا الخلو من الدوافع الباعثة على الكذب كالانتصار والانحياز لشيء ما أو جهة أو مذهب أو جماعة، وكذلك الازدراء بشيء ما أو مذهب، ومنها تبيّن صدقه للناس فيما يخبر به وتتابُع ذلك، ومنها مطابقة الخبر للواقع.
ولئن كان الأمر كذلك في عامة الأخبار فإن النبوة خبر من الأخبار يستحيل أن يخفى على الناس حقّه من باطله، وألا يميزوا بين الأنبياء الصادقين المرسلين من رب العالمين وبين المتنبئين الكاذبين، كيف وهو أهم خبر وأعظم نبأ تحتاج إليه البشرية لتتصل بخالقها ومولاها، وتدرك به حقيقة وجودها بدايته ومنتهاه وخلقه وجزاؤه والغاية التي خُلق من أجله؟!
ولما كانت النبوة بهذه المثابة لم يقتصر أمرها على الدلائل والحجج والبراهين التي يُعرف بها صدق الأخبار عموما، بل أُردفت بجملة كبيرة من الدلائل والبراهين سواء القرائن المحتفّة بالنبي الذي جاء به أو القرائن المنوطة بالخبر الذي جاء به أو غيرها، “فما ظنك بهذه الحياة النبوية التي تعطيك في كل حلقة من حلقاتها مرآة صافية لنفس صاحبها؛ فتريك باطنه من ظاهره، وتريك الصدق والإخلاص ماثلًا في كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله. بل كان الناظر إليه إذا قويت فطنته وحسنت فراسته يرى أخلاقه العالية تلوح في محياه ولو لم يتكلم أو يعمل”([4]).
المعجزات من دلائل صدق الأنبياء:
ومن أهم تلك الدلائل المعجزاتُ التي خص الله بها أنبياءه لتكون شاهدة على صدقهم، وحجة على أقوامهم وخصومهم ومكذبيهم، فالمعجزة: أمر خارق للعادة، يُجْريه الله تعالى على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ تأييدًا لهم وتصديقًا، وتحدّيًا لأقوامهم وحجة عليهم([5]).
والأمثلة على المعجزات كثيرة جدًّا، وقد جاءت الأنبياء بكثير منها، ولكنها في النصوص الشرعية وعند السلف كانوا يصطلحون على تسميتها بالآيات والبينات والبراهين، ومن أهم المعجزات:
أولا: تحويل العصا إلى حيَّة -وهي من معجزات موسى عليه السلام-:
أخبر المولى سبحانه أن معجزة موسى عليه السلام التي حاجّ بها خصمه فرعون وتحدَّاه بها هي العصا، وكان فرعون قد اتهمه بالسحر، فجمع له السحرة في يوم من أيام احتفالهم، “فقال لهم موسى: السحر الذي وصفتم به ما جئتكم به من الآيات أيها السحرة، هو الذي جئتم به أنتم، لا ما جئتكم به أنا”([6])، فكان أن واجه موسى بعصاه سحر السحرة، وأبطله أمام الجمع كلهم حيث تحولت إلى ثعبان يتلقفه، حتى لم يبق منه شيء، فآمن به جميع السحرة الذين جاء بهم فرعون، قال تعالى: ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ * فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 43-47]، ولم تكن هذه المعجزة الوحيدة ولا الآية الوحيدة لموسى، بل تعددت الآيات والدلائل على صدق نبوته ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق.
ثانيًا: إحياء الموتى ورد بصر الأعمى، وهي من معجزات عيسى عليه السلام:
عني القرآن بذكر آيات الأنبياء، ولذا لا نعجب أن نجد شاهدا لكل مثال من أمثلة المعجزات والآيات، ومن معجزات عيسى عليه السلام التي أخبر عنها إحياؤه الموتى وإبراء الأكمه، قال تعالى: {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ} [المائدة: 110].
ثالثا: القرآن المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم:
لئن كان القرآن قد ذكر عامة المعجزات والآيات التي أيد الله بها أنبياءه فقد جمع الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أنواع المعجزات والآيات والبراهين التي جاء بها الأنبياء من قبله، سواء المعجزات العلمية الخبرية كالأخبار الماضية والقصص التاريخية والغيوب المستقبلية والعلوم الإلهية والعوالم الغيبية والأحوال الأخروية وإخبار الأنبياء والكتب السابقة عنه وإخبار الجن والكهنة عنه، أو المعجزات الحسية التي هي من باب القدرة والتأثير كاللغة واللسان، والمعجزات الجوية والأرضية سواء التي حصلت مع الإنسان أو الحيوان أو النبات أو حتى الجماد من جبل وحجر وجذع شجر وغيرها، ونصر الله لأمته وجعله الغلبة لهم وتغير وجه التاريخ وخريطة العالم على أيديهم في مدة وجيزة، وبقاء دينهم وأثرهم حتى يوم الناس هذا بعد عشرات القرون وبعد عشرات الدول والممالك التي تعاقبت عليها([7]).
وبالجملة فكل دليل -سواء معجزة أو غيرها- من دلائل النبوة دلت على نبوة نبي فقد ثبت مثله وأقوى منه حجة وأبصر منه دلالة وأعظم منه برهانا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل “من جعل المعجزات دليلا على نبوة نبي وقال: المعجزة هي الفعل الخارق للعادة المقرون بالتحدي السالم من المعارضة، ونحو ذلك مما يذكر في هذا المقام، وجعلوا ذلك دليلا على نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، قيل له: إن كان هذا دليلا فهو دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن دليلا لم يكن دليلا على نبوة موسى وعيسى، فإنه قد ثبت عن محمد من المعجزات ما لم يثبت مثله عن غيره، ونقل معجزاته متواتر أعظم من نقل معجزات عيسى وغيره، فيمتنع التصديق بآياته مع التكذيب بآيات محمد صلى الله عليه وسلم([8]).
ثم إن أهم معجزة موجودة اليوم بين يدينا وستبقى إلى آخر الزمان حتى يرفعها الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم؛ وهو مشتمل على عامة أنواع الإعجاز العلمي كأخبار الأمم الماضية والأخبار الغيبية المستقبلية والمعارف الإلهية والأنبياء والكتب السابقة وأخبار العوالم الغيبية والأحوال الأخروية، وهو أيضا معجزة حسية بين أيدينا، فهو كلام الله محفوظ في الصدور وفي السطور وبين العالمين في المشرق والمغرب بلا تحريف منذ ألف وأربعمائة عام، وقد أخبر بهذا منذ ذلك الوقت وهو اليوم كما أخبر: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، ووعد به النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: «ما من الأنبياء نبيّ إلا أُعطي ما مثلُه آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيت وحيًا أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعًا يوم القيامة»([9])، وكان ما أخبر؛ فبقي الوحي محفوظا وغدا أتباعه عدد حبات المطر، ورجاله ملء السمع والبصر، وهذا من أوجه كونه معجزة، يقول ابن تيمية (728هـ) رحمه الله: “والقرآن يظهر كونه آية وبرهانا له من وجوه: جملة وتفصيلا، أما الجملة فإنه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم علما متواترا أنه هو الذي أتى بهذا القرآن، وتواترت بذلك الأخبار أعظم من تواترها بخبر كل أحد”([10]).
فالقرآن فيه الدعوة والحجة، وقد تحدى كل من جاء بعده أن يأتوا بمثله وأنهم لم ولن يأتوا بمثله مع أنه كلام عربي وبلغتهم، قال تعالى: {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88]، “فعم بالخبر جميع الخلق معجزا لهم، قاطعا بأنهم إذا اجتمعوا كلهم لا يأتون بمثل هذا القرآن، ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك، وهذا التحدي والدعاء هو لجميع الخلق، وهذا قد سمعه كل من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام، وعلم -مع ذلك- أنهم لم يعارضوه، ولا أتوا بسورة مثله، ومن حين بعث، وإلى اليوم، الأمر على ذلك، مع ما علم من أن الخلق كلهم كانوا كفارا قبل أن يبعث، ولما بعث إنما تبعه قليل، وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله، مجتهدين بكل طريق يمكن، تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من الغيب… وتارة يجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه… فتارة يقولون: مجنون. وتارة يقولون: ساحر. وتارة يقولون: كاهن. وتارة يقولون: شاعر… إلى أمثال ذلك من الأقوال التي يعلمون -هم وكل عاقل سمعها- أنها افتراء عليه”([11]).
التكامل المعرفي في معجزة الإسلام:
ولا نريد أن نطيل الكلام أكثر مما طال عن القرآن، ولو تركنا المجال لبلغ المجلدات، ولكن المقصود أنه إلى جانب تنوع إعجازه العلمي والحسي فقد جاء بالتكامل في المنظومة المعرفية؛ فالقرآن يرشدنا إلى فسح المجال لكل مصدر من المصادر المعرفية في مجاله، ويمتاز بكونه ينظر إلى المصادر المعرفية كلها (الخبر الصادق – العقل – الحس والتجربة) على أنها تمثل نوعًا من التكامل فيما بينها بما يحقّق الانسجام والتواؤم المعرفي التامّ، ويحقق للإنسان أعلى ما يمكن من المستويات المعرفية، ولا يصد ولا يغلق دونه أي باب من أبواب المصادر المعرفية سواء بدعوى التعارض بين مصادرها أو بين جزئياتها، بله العقل والخبر الصادق كلاهما مصدران من مصادر المعرفة في الإسلام، ولا يمكن أن يتعارض الوحي الصحيح الثابت مع ما في العقل الصريح، ولا يمكن أن يدل العقل الصريح على ما يتعارض مع الخبر الصادق الصحيح، بل كل ما ورد في الوحي يجب التسليم به؛ لأن ما دلّ عليه لا بد وأن يكون حقًّا، وما كان كذلك لا يمكن أن يدلّ العقل على استحالته وعدم إمكانه، فإما أن يكون حقًّا فلا يكون باطلا، وإما يكون باطلا فلا يكون حقًّا، والدلائل القطعية لا تتعارض([12]).
وكما أن التعارض بين الخبر الصادق والعقل لا وجود له في الحقيقة في معجزة الإسلام، فكذلك التعارض بين العقل والتجربة والحس الصادق لا وجود له في المعجزة الإسلامية؛ لأن كلًّا من العقل والحس هو مقتضى الفطرة البشرية السوية، فالمدركات الحسية للجزئيات الواقعية لا بد أن تكون صحيحةً؛ لأنها مقتضى الفطرة، والمدركات العقلية الضرورية هي أيضا مقتضى الفطرة، فلا تعارض بينهما، وإنما “يستند إثبات هاتين الدلالتين مع الجزم بعدم تعارضهما إلى أنّ لكل منهما وجهًا من الدلالة يختص به لا يعارض الوجه الآخر، فالحواسّ إنما تدرك الوقائع الجزئية في الخارج، ولا يمكن أن تدلّ على التصورات والأحكام الكليّة الضرورية، كما أنه لا يمكن إدراك الوقائع الجزئية في الخارج بمجرد الغريزة العقلية وما تقتضيه من التصورات والأحكام الضرورية، وبذا يكون الشك في أحدهما مقتضيًا للشك في الآخر”([13]).
ومن هنا ندرك خصوصية معجزة الإسلام عن غيره من الأديان والمذاهب والفلسفات؛ لأن عامة الملل والنحل بُليت إما بخبر كاذب، أو صادق لكن محرف متلاعب فيه غير محفوظ، وإما بإغلاق باب الخبر على نفسها مطلقا فهي بذلك ترد الأخبار بالكلية حقها وباطلها، وفي الواقع تقبل ما وافق هواها من الأخبار؛ وإلا فمن منهم ينكر وجود كبار الفلاسفة كالفيلسوف أرسطو؟! وهل يملك من يثبت وجوده إلا خبرًا؟!
وإما أن تغلق باب العقل، وبذلك تفقد حقلًا عظيما من الحقول المعرفية المهمة؛ فالعلوم النظرية إنما تُبنى على المعارف العقلية الضرورية، وعلى القياس بشتى أنواعه وأسمائه.
وإما أن تغلق باب الحس والتجربة، فتعيش عصور الظلام السوفسطائي، وتنكر الحقائق، وتشكك في وجود الشمس في وضح النهار وهي تلهبه بلهيبها وتعمي عينيه بضوئها.
وهذا حال عامة الملل والنحل والفلسفات والمنظومات المعرفية عموما، وأما المنظومة المعرفية القرآنية فتؤمن بالتكامل المعرفي بين جميع المصادر المعرفية، وتمنع دعوى التعارض فضلا عن التناقض بين الحق الصحيح منها؛ وهذا ما يمكن استنباطه من الحديث الآنف الذكر -وهو وجه من أوجه الإعجاز القرآني- حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «ما من الأنبياء نبيّ إلا أُعطي ما مثلُه آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيت وحيًا أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعًا يوم القيامة»([14]).
فالمعجزة القرآنية تختص بكونها الخبر والدليل على صحة الخبر في آن واحد؛ فهو قد جاء بمنظومة متكاملة مُحكَمة من حيث الدلائل والمسائل، ودلائله ومسائله مجتمعة في المصدر المعرفي الذي يمتاز به وهو الوحي؛ وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم الذي هو {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الواقعة: 80]، فكل ما عند المسلم من مسائل فالتسليم بها قائم على البرهان العقلي، سواء من جهة دلالة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا التسليم بكل ما أخبر، أو من جهة دلالة الوحي على أفراد المسائل ذاتها.
أضف إلى ذلك أنه يختصُّ بجملة من المعارف اليقينية الخبرية التي لا توجد في أي نحلة ولا ملة؛ فالمصدر الخبري القرآني أصدق المصادر المعرفية سواء في باب العلوم الإلهية أو النبوية أو الغيبية أو العقدية الفكرية التي لا بد منها لكل صاحب فكر ومبدأ، أو أخبار الأمم الغابرة وأنبيائهم، أو التشريع الذي لا بد منه لأي اجتماع بشري؛ فما يختص به لا وجود له في غيره من الأديان الباطلة والمنسوخة والفلسفات والعلوم والحقول المعرفية جمعاء؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى ميَّز القرآن المبين بكونه مصدرًا خبريًّا حقًّا من مصادر المعرفة، إضافة ما تملكه البشرية من مصادر معرفية أخرى، ومن هنا فإن المسلم يدرك ويعلم كل ما تؤمن به البشرية من معارف ناتجة عن الحس أو العقل، ثم هو أيضا يؤمن بما أخبره به الله سبحانه وتعالى وأخبر به نبيه من علوم ومعارف في الوحي المبين؛ ذلك أن اختصاص المسلم بمعجزة القرآن يقتضي أن يكونَ لمنظومته المعرفية مجالات تختصّ بها؛ ولا يمكن الاستناد في ذلك إلى العهدين القديم والجديد ولا غيرها، فقد ثبت بالدلائل وقوع التحريف فيها، ثم إن المعجزة القرآنية تجاوز حدود المعرفة البشرية ومنظوماتها المعروفة اليوم؛ سواء المدرسة الحسية التي لا تجاوِز المحسوس، أو المدرسة العقليّة التي لا تسلِّم بالغيبيات وإن وصلت إلى شيء ضئيل منه بالاستدلال العقلي؛ فمن المعارف الغيبية ما لا يمكن إدراكه إلا من جهة المصدر الخبري الحق من العلوم الإلهية والعوالم العلوية والأخبار السابقة والمستقبلية، بله “التشريع؛ إذ لا يمكن للبشر أن يشرِّعوا لأنفسهم ما فيه صلاحُهم، لغلبة الجهل والهوى عليهم، وإنما يتوقَّف ذلك على التشريع بالوحي، فاليقين في الغيبيات والهداية في التشريعات مما تختصّ به المعرفة في الإسلام عن جميع الأديان والمذاهب الفلسفية”([15]).
ولكن العجيب أن يُرمى الدين الإسلامي بتهمة الحجر على العقول وإغلاق المصادر والمنافذ المعرفية، مع أنه أكثر وأدق المنظومات المعرفية مصادر سواء الخبر أو العقل أو الحس، كدعوى أن الإيمان بالمعجزات إغلاق لأبواب المعرفة العقلية أو الحسية وإفساح المجال أمام الخرافة والتكهنات والخيالات والجهل!
هل الإيمان بالمعجزات إغلاق لأبواب المعرفة؟
تبين لنا مما سبق أن هذا السؤال في الواقع قلب للحقيقة عما هي عليه، ويمكننا الإجابة عن هذا السؤال ومناقشته بما يأتي:
أولا: الواقع أن المعجزة في الدين تفتح أبوابًا للعلم والمعرفة لا توجد عند غيرهم من الأمم؛ لأن المعجزة دليل للعلم بصدق النبي عليه السلام؛ وبالتالي فهو مفتاح وباب لموثوقية جميع ما جاء به الأنبياء؛ فإن ثبت حصول المعجزة فهو يفتح باب العلم والمعرفة النبوية وما يخرج من مشكاته من علوم إلهية وعلوم غيبية وأخروية وتشريعات وعقائد وغيرها، فالواقع أن المعجزة مفتاح ودليل على الوثوق بمصدر من المصادر المعرفية الخبرية لا العكس.
ثانيا: المعجزة القرآنية متعالية على هذه الدعوى، بل على العكس المعجزة القرآنية جاءت بالتكامل المعرفي والاعتبار بجميع المصادر المعرفية؛ فهو بذاته خبر وهو بذاته دليل على صحة الخبر؛ ومن ذلك إعجازه في حفظه وفي التحدي بالإتيان بمثله، بل بعشر سور من مثله، بل بسورة.
ثم هو يدعو إلى إعمال العقل والتفكّر والتدبر والاعتبار بالعلوم العقلية والنظرية دون إفراط ولا تفريط؛ ويستنكر على من يعطل العقل ويغفل دوره.
كما أنه ينكر على من يطمس نور الحس مع أنه مصدر من المصادر المعرفية الضرورية؛ فالمعجزة القرآنية لا تقلل من شأن أي مصدر من المصادر المعرفية، بل يدعو إلى التكامل في المنظومة المعرفية، ويفسح المجال لكل مصدر من المصادر المعرفية في مجاله، ما يمثل نوعًا من التكامل المعرفي الذي يحقّق الانسجام والتواؤم المعرفي التامّ، ويبلغنا أعلى ما يمكن من المستويات المعرفية، ولا يصد ولا يغلق دونه أي باب من أبواب المصادر المعرفية سواء بدعوى التعارض بين مصادرها أو بين جزئياتها([16]).
ثالثا: أن الإيمان بالمعجزات يزيدنا مصدرًا من المصادر المعرفية الخبرية ولا يغلق دوننا أبواب المعرفة؛ بل إن المعجزة القرآنية تضمَّن علوما وأخبارا لا يمكن حصولها من غيره من المصادر المعرفية الأخرى؛ كالأخبار الماضية التفصيلية والغيوب المستقبلية وكثير من المعارف الغيبية وكثير من المعلومات الدقيقة في كل نوع من أنواع هذه العلوم، فمدة مكث أصحاب الكهف في كهفهم ومكث نوح عليه السلام في قومه لا يمكن أن نعرفه إلا من خلال القرآن، ومثله عدد الحجج التي قضاها موسى مقابل مهر زواجه، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، ثم إن التشريع الذي جاء به القرآن ليس ثمة مثله لا من قبل ولا من بعد، فهو أكمل الشرائع، والعلوم الإلهية الواردة في القرآن أكمل العلوم، ليس ثمة مثله في أي مصدر معرفي آخر.
رابعًا: أن من يقرّ بالمعجزات ويؤمن بها لا يقرّ بفوضوية المنظومة المعرفية، ولا يناقض ما توصّل إليه البشرية بالحس والتجربة والعقل من انتظام الكون واتساق قوانينه وسننه، ولا يزعم التناقض بين اتساق النظام الكوني وبين حصول المعجزة التي هي خارقة للعادة وتغيير للنظام الكوني، بل يقولون بالتوافق بين الأمرين؛ لأن الخالق الذي خلق النظام وخلق الكون هو من خرق العادة والنظام من أجل إثبات صدق رسوله الذي أرسله، وبذلك تتكامل المعارف العقلية والحسية بالمعارف الخبرية الصادقة الصحيحة.
خامسًا: من يقر بمعجزات الأنبياء والرسل هو مقر بوجود الله سبحانه وتعالى، وهو مقر بسننه وقوانينه الكونية التي أودعها في خلقه وفي العالم، ويؤمن بأن الله هو من خلق الكون وقوانينه وسننه التي لا تتبدل ولا تتحول، فهم لا يقولون بفوضوية النظام الكوني، بل على العكس يقررون ويؤكدون أن الأصل في الكون هو النظام والدقة، ولكن قد تقتضي حكمته وإرادته أن ينخرق هذا النظام لإثبات صدق رسوله، فالمعجزات بالنسبة إلى انتظام الكون حالة استثنائية وليست هي الأصل إذن؛ “فتجويز انخرام قوانين الكون عند المؤمنين بالنبوة ليس أمرا عبثيا ولا فوضويا، وإنما هو محكوم بإرادة الله وحكمته وعلمه ورحمته، وهو محكوم أيضًا بالبقاء على الأصل، وليس هو الغالب ولا الأكثر، فحقيقة ما يقوله المؤمنون بالنبوة: أن الكون محكوم بقوانين تضبط أحداثه وتحكم مشاهده، وأن ذلك هو الأصل المطرد فيه، ولكن الله قد يحدث انخرامًا في بعض تلك القوانين إذا اقتضت حكمته وإرادته ذلك”([17]).
سادسًا: أن إثبات وجود المعجزات هو المتسق مع العمل بجميع المصادر المعرفية؛ فإن كان العقل قد دلنا على انتظام الكون وعدم انخرامه وأن الإله هو الخالق الذي خلق هذا النظام وأنشأه إنشاء، فما المانع أن يكون الخالق هو الذي سمح بانخرام النظام في بعض الأحيان لحكمة؟! فإن التغيير في المخلوق بعد إنشائه ليس بأصعب من خلقه من العدم، ومن خلق النظام لا يعجزه أن يغيره لحكمة.
سابعًا: ليس في إثبات المعجزات أي مناقضة للمصدر المعرفي العقلي ولا الحسي؛ فأما العقل فإن من يثبت المعجزات لا ينكر العلوم الضرورية العقلية مثل كون كل حادث له محدث وكون النقيضين لا يجتمعان، بل يؤكدون أن المعجزة حادث أحدثه الله سبحانه متسقا مع حكمته، وليس ذلك بأمر مستحيل عقلا؛ فالمعجزات خرق للعادة وللنظام الكوني من خالق النظام الكوني، وليس دعوى بإمكان المستحيل عقلا.
ثامنا: أن من ينكر على مثبتي المعجزات وقع في مشكلة القياس مع الفارق، فهو يحكم -بالنظر إلى قدرة الإنسان وطاقته- باستحالة خرق القانون والنظام الكوني ثم ينزل ذلك الحكم على خالق الكون وخالق نظامه؛ وأين قدرة الخالق من قدرة المخلوق المحكوم بنظام الكون؟! فمن خلق النظام والقانون قادر على تغييره وعلى خلق غيره بلا شك.
تاسعًا: لا شك أن نظام المعجزات مخالف لنظام الكون وقانونه وإلا لما كانت المعجزة معجزة، ولكن ما دام أننا نقول: إن خالق المعجزات هو نفسه خالق الكون وقوانينه، فما المانع أن يكون نظام المعجزات إحدى أنظمة كونه؟! فكما أن الخالق خلق الكون وجعل له نظاما وقانونا فهو الذي أرسل الرسل وجعل لتصديقهم قانونًا، وجعل قانون الكون متناسبا متغيرًا من أجلهم في وقت الحاجة إليه؛ فالخالق هو خالق الكون وقانونه وهو خالق المعجزات وقانونها، ولا يمكن أن يتعارض خلقه مع خلقه، وهو أحكم الحاكمين وهو لطيف خبير.
عاشرًا: أن هذه الدعوى فيها مغالطة رجل القش، فهو يصوِّر لجمهوره ومن يستمع لقوله أن من يثبت المعجزات ينكر وجود القوانين الصارمة الضابطة لنظام الكون وأحداثه المحافظة على وجوده وثباته، وأن الأصل في الكون هو الفوضوية وعدم الاطراد وانعدام القانون والنظام، وأن الإيمان بالمعجزات إيمان بدوام انخرام القانون الكوني واطراد ذلك كل حين، وكأن المؤمن بالمعجزات خرافي أو مجنون لا عقل له. ثم هو يهاجم هذا التصور وهذا الزعم الذي زعمه، وليس هو قول المؤمنين بالمعجزات في الحقيقة.
حادي عشر: أن حدوث المعجزات أمر يقيني حقيقي وليس افتراضا علميا أو احتمالا رياضيا، فنزول القرآن على نبي الإسلام ووصوله إلينا متواترا وبقاؤه محفوظا من ألف وأربعمائة عام في الصدور وفي السطور رغم تكالب الأعداء وتعاقب الدول والأجيال بمختلف الآراء والأفكار لهو من أقوى الحجج اليقينية اليوم على وجود المعجزة وحصولها، والمعجزات عموما شاهدها وأحس بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منقولة إلينا بالتواتر المفيد لليقين.
ثاني عشر: الواقع أن هذه الشبهة إسقاط لمشكلة يعاني منها مدعوها الناقدون للأديان لا العكس؛ فعامة الناقدين للأديان تبنوا مناهج معرفية أغلقوا دون الناس أبوابا معرفية واسعة وأقلقوا المنظومة المعرفية الإنسانية وحجبوا دونها كثيرا من العلوم والحقائق؛ فمنهم من تبنى مصدرية العقل للمعرفة وأنكر مصدرية الخبر؛ وزعم أن العقل وحده هو الموصل للحقائق، وأنكر بذلك القضايا المتواترة، فلا يؤمن بوجود الأنبياء مع أن كثيرا منهم يسلم بوجود الفلاسفة القدماء ويسلم بوجود ما وجد من الممالك والأمم البائدة مثلا، ومنهم من تبنى مصدرية الحس والتجربة وحسبُ بعد أن ساد الصراعُ على أي المصادر المعرفية يُعتمد حين لم يجدوا من القول بمصدرية العقل وحده كثيرَ فائدةٍ، وأما الدين ومصادره فقد ضربوا به عرض الحائط لما لقوه من الطغيان الكنسي، ومن هنا تبنّوا القول بفكرة العلموية التي تدعو إلى حجر العقول البشرية على ما يتوصّل إليه العلم التجريبي وحسب، ومحو جميع المصادر المعرفية الأخرى من وحي وخبر وعقل، وكأنه لا وجود لمصادر يُوثق بها سوى العلم التجريبي([18]).
وبهذا أنكروا المبادئ الفِطرِيَّة البَدَهيَّة والمقدمات العقلية الضرورية؛ كالقول بأن لكل حادث محدِث ولكل فعل فاعل، وأن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين وأن النقيضين لا يجتمعان، وأنكر الحقائق المطلقة وساد بينهم القول بنسبية المعرفة ونسبية الحقيقة، وعادوا بالناس إلى عصور السفسطة المظلمة، وأغلقت دون البشرية أبواب العلوم العقلية والخبرية الصحيحة، وغَلَت في الحس والتجربة.
ولا يحتاج المرء العاقل إلى كبير عناء لردّ هذا التضييق على عقول البشر وعلى المنظومة المعرفية الإنسانية بأن هذا القول غير مبني على العلم التجريبي، فهي فكرة تنقض نفسها بنفسها.
هذا فضلًا عن أن مجال العلم التجريبي هو العالم المادي المحسوس، ولا يتجاوز إلى غير ذلك من مجالات العالم الفسيح الذي يدرك بالعقل والذي يدرك بالخبر، وإلى ذلك يشير إروين شرودنجر بقوله: “الصورة التي يقدّمها العلم عن الواقع من حولي صورة ناقصة جدًّا… إنه (أي: العلم الطبيعي) لا يتكلم ببنتِ شفة عن الأحمر والأزرق، المرّ والحلو، الألم واللذة، إنه لا يعرف شيئًا عن الجميل والقبيح، الحسن والسيئ، الله والخلود؛ يتظاهر العلم أحيانًا بأنه يجيب على أسئلة في هذه المجالات، ولكن غالبًا ما تكون إجاباته سخيفة للغاية، إلى درجة أننا لا نميل إلى أخذها على محمل الجد”([19]).
ففي هذه الفكرة إغلاق لباب مهم وإطاحةٍ لقسم من أقسام الفلسفة، وهو فلسفة الوجود (الأنطولوجيا) وحصره في فلسفة العلوم (الإبستمولوجيا) وإعدام فلسفة الوجود من الوجود تمامًا مع أنه هو الأصل الذي منه ولدت فلسفة العلوم([20]).
بل إن هؤلاء بإنكارهم الضرورات العقلية يهدمون منهجهم القائم على اكتشاف الأسباب واطِّرادها، بحيث إن “التجريبيين ينكرون الضرورة العقلية مطلقا؛ بناء على قولهم بأن الحواس هي المصدر الوحيد للمعرفة؛ إذ لو سلموا بالضرورة العقلية لالتزموا أن العقل هو مصدر تلك الضرورة، وهذا يتناقض مع مذهبهم الحسي في مصدر المعرفة”([21]).
إذن؛ الواقع والحقيقة أن الناقدين للأديان والمنكرين على مثبتي المعجزات هم من يشكلون خطرًا على المنظومة المعرفية، وهم من يغلقون الأبواب دون المصادر العلمية والمعرفية ويضيقون على الناس منافذ العلم والمعرفة لا العكس.
إن هذا التضييق والحجر على المنظومة المعرفية التي تفرضها التيارات العلموية الإلحادية تعود بذاكرة التاريخ الأوروبي إلى ما فعلته الكنيسة تمامًا؛ فلا يختلف الحال تماما وإن اختلفت الأدوار والأدوات والوسائل والمصدر الذي ضيَّقت عليه.
فالكنيسة ضيَّقت على العقول البشرية، وأغلقت دون المصدر الحسي التجريبي، وضيقت كلّ سبل العمل وطرق التفكير غير طريقها؛ زاعمة أنها حاملة مشعل النور والخبر الإلهي الحق الذي لا تحريف فيه والنبأ اليقين الذي لا زيغ فيه ولا غلط ولا كذب ولا دخن فيه، ولكن كان الواقع غير ذلك، ولكن الأمر كما تقول القديسة كاترينا السيانية: “إنك أينما وليت وجهك -سواء نحو القساوسة، أو الأساقفة، أو غيرهم من رجال الدين، أو الطوائف الدينية المختلفة، أو الأحبار من الطبقات الدنيا أو العليا، سواء كانوا صغارا في السن أو كبارا- لم تر إلا شرّا ورذيلة، تزكم أنفك رائحة الخطايا الآدمية البشعة؛ إنهم كلهم ضيقو العقل، شرهون، بخلاء، تخلّوا عن رعاية الأرواح… اتخذوا بطونهم إلها لهم، يأكلون ويشربون في الولائم الصاخبة، حيث يتمرغون في الأقذار، ويقضون حياتهم في الفسق والفجور”([22])، واليوم تعيد العلموية ذات الفعل وذات المشكلة العلمية والمعرفية التي مارستها الكنيسة؛ فلا زالت جوهر مشكلة الكنيسة حاضرة وإن اختلفت التسمية([23])، فالعلموية تغلق اليوم طرق العلم إلا طريقها.
ويمكننا القول في الختام قبل إعادة القلم إلى غمده:
عانت البشرية مع عامة النظم والمناهج والفلسفات والأديان من إغلاقها للمنافذ وحجبها المصادر المعرفية وتضييقها كثيرا من طرقه ومسالكه، سواء العلموية الإلحادية اليوم أو المنهج العقلي الفلسفي قريبا أو السفسطة في كثير من العصور والأزمان، والواقع أنه لا توجَد منظومة معرفية أنجع ولا أنفع ولا أتقن ولا أمتن من المنظومة المعرفية الإسلامية التي جعلت لكل مصدر معرفي مكانته ومنزلته ومجالاته، واختصت بالخبر الحق الصادق الصحيح الذي هو أول تلك المصادر في الدين الإسلامي، وله مجالاته التي لا يُتوصل إليها بغيره، ولكنه في نفس الوقت لا يتعارض مع المصادر المعرفية الأخرى، بل علاقتها بمصدر العقل والحس هي علاقة تواؤم وانسجام وتكامل واتّفاق، فالوحي هو الذي دعا المسلمين المؤمنين بالمعجزات إلى النظر والتفكر في نظام الكون وقوانينه وعجيب خلقه في السماوات والأرض بالحسّ والعقل لاكتشاف سننه وأسراره ومكنوناته؛ وهو من بعث أنبياءه ورسله وأيدهم بالمعجزات الخارقة لسننه الكونية ليثبت صدقهم، ولا تعارض بين هذا المصدر المعرفي وذاك، وهذا جانب من جوانب جمال الدين الإسلامي وكماله.
وصلَّى الله وسلم على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([2]) شرح العقيدة الأصفهانية (ص: 137).
([3]) النبأ العظيم، محمد دراز (ص: 64). وينظر: النبوات لابن تيمية (2/ 721)، شرح الأصفهانية (ص: 539 وما بعدها)، الجواب الصحيح لابن تيمية (5/ 349).
([5]) ينظر: النبوات لابن تيمية (1/ 129)، مجموع الفتاوى (11/ 311).
([7]) ينظر: مجموع الفتاوى (11/ 315).
([8]) الجواب الصحيح لابن تيمية (2/ 43).
([9]) أخرجه البخاري (4981)، ومسلم (152).
([10]) الجواب الصحيح (5/ 422).
([11]) الجواب الصحيح لابن تيمية (5/ 426).
([12]) ينظر: المعرفة في الإسلام، عبد الله القرني (ص: 23).
([13]) ينظر: المعرفة في الإسلام، عبد الله القرني (ص: 24).
([14]) أخرجه البخاري (4981)، ومسلم (152).
([15]) المعرفة في الإسلام، عبد الله القرني (ص: 25).
([16]) ينظر: المعرفة في الإسلام، عبد الله القرني (ص: 23).
([17]) ظاهرة نقد الدين، سلطان العميري (2/259).
([18]) ينظر: ظاهرة نقد الدين، سلطان العميري (2/ 460).
([19]) نقلا عن محاضرة: العلموية، سامي عامري، https://youtu.be/cP2TMrCtekg.
([20]) نقلا عن محاضرة: العلموية، سامي عامري، https://youtu.be/cP2TMrCtekg.
([21]) المعرفة في الإسلام، عبد الله القرني (ص: 450).
([22]) ينظر: قصة الحضارة، ول ديورانت (٢١/ ٨٥)، تاريخ الفلسفة الغربية، برتراند رسل (1/ 182).