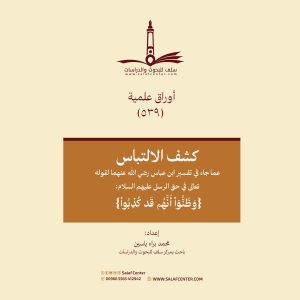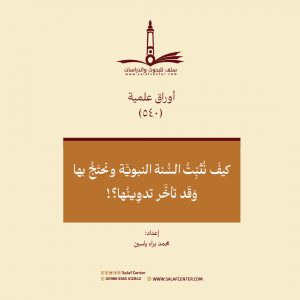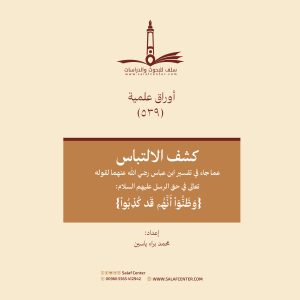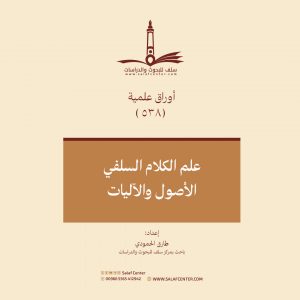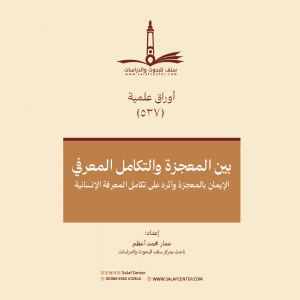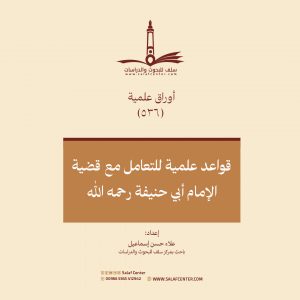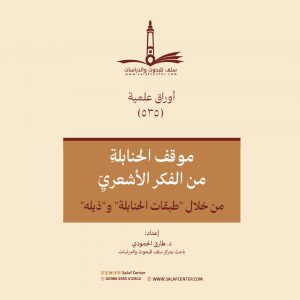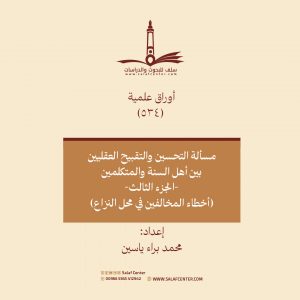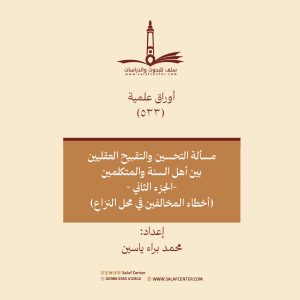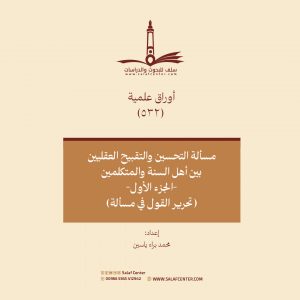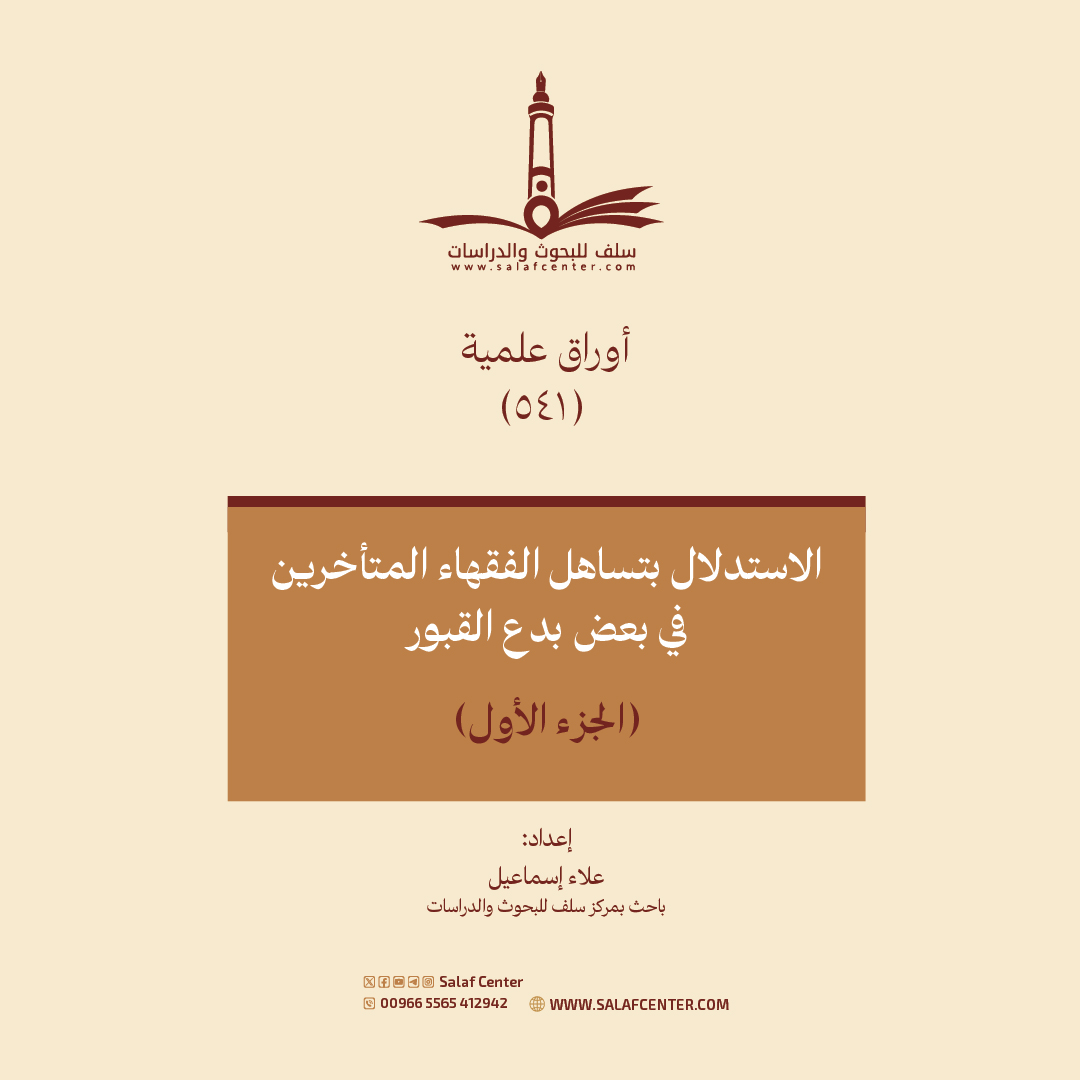
الاستدلال بتساهل الفقهاء المتأخرين في بعض بدع القبور (الجزء الأول)
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
مقدمة:
من المعلوم أن مسائل التوحيد والشرك من أخطر القضايا التي يجب ضبطها وفقَ الأدلة الشرعية والفهم الصحيح للكتاب والسنة، إلا أنه قد درج بعض المنتسبين إلى العلم على الاستدلال بأقوال بعض الفقهاء المتأخرين لتبرير ممارساتهم، ظنًّا منهم أن تلك الأقوال تؤيد ما هم عليه تحت ستار “الخلاف الفقهي”، بينما هذه الاستدلالات لا تخرج عن ثلاثة أمور:
الأول: سوء فهم لكلام الفقهاء أو تأويل خاطئ لكلامهم، وهو الأغلب الأعم كما سنعرف إن شاء الله.
الثاني: اجتهادات فقهية متنازع فيها، لا تمس قضية التوحيد بشكل مباشر، ويكون قول بعض الفقهاء مرجوحًا.
الثالث: زلات فردية من بعض المتأخرين وأصحاب الحواشي في القرون المتأخرة، وخالفهم فيها غيرهم. ومعلومٌ أنه إذا اختلف العلماء في مسائل فإن ترجيح أحد الأقوال ليس بأولى من ترجيح الآخر، فلا ينبغي -والحال كذلك- نصب أقوال الفقهاء لمعارضة النصوص المحكمة من الكتاب والسنة.
لذا رأينا في مركز سلف للبحوث والدراسات أن نسلّط الضوء على أبرز هذه الاستدلالات، ونبيّن مواضع الخطأ فيها، حتى يتَّضح الحق وتتجلى الحجة.
مركز سلف للبحوث والدراسات
أولًا: الاحتجاج بذيوع الأضرحة في الأمة كدليل على إقرار الفقهاء لها:
احتج المخالفون بذيوع بناء القباب والمساجد على قبور الصالحين، واتخاذ المشاهد والأضرحة مزارات منذ سبعمائة سنة، مع وجود الاستغاثات والمنكرات على مرأى ومسمع من العلماء ومع ذلك فهي موجودة حتى الآن. ثم يبني المخالف نتيجة مغلوطة وهي أن هذه الممارسات متلقاة بالقبول عند الأمة، ولا تصل إلى حدّ الشرك الأكبر.
ومن ذلك ما يقوله الشيخ سليمان بن عبد الوهاب محتجًّا على أخيه: “ومعلوم عند العامّ والخاصّ أن هذه الأمور التي تكفِّرون بها قد ملأت بلاد المسلمين من أكثر من سبعمائه عام كما تقدّم نقله… والناس يسافرون إليها من جميع الأمصار أعظم مما يسافرون إلى الحج”. ثم يقول بعد ذلك مستنكرًا: “فمن أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إذا دعا غائبًا أو ميتًا أو نذر له أو ذبح لغير الله أو تمسح بقبر أو أخذ من ترابه أن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه؟!”([1]).
وهذه الحجة ضعيفة؛ إذ لو سلمنا أن العلماء سكتوا عن هذه المنكرات -مع كوننا لا نُسلم بهذا- فلا يصح الاحتجاج بسكوت العلماء، فهذا الحاكم النيسابوري بعد روايته لحديث النهي عن الكتابة على القبر استدلّ بعمل الأمة فقال: “وليس العمل عليها؛ فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوبٌ على قبورهم، وهو عملٌ أخذ به الخلف عن السلف“. فردّ العلماء استدلاله، ومنهم الحافظ الذهبي حيث قال: “ما قلتَ طائلًا، ولا نعلم صحابيًّا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي”([2]).
وقال الأبي رادًّا على الحاكم: “وما ذكر من أنه عملٌ أخذه الخلف عن السلف لا يُسلَّم؛ لأن أئمة المسلمين لم يُفتوا بالجواز، ولا أوصَوا أن يُفعل ذلك بقبورهم، بل تجد أكثرهم يُفتي بالمنع، ويكتب ذلك في تصنيفه. وغاية ما يُقال: إنهم يُشاهدون ذلك ولا يُنكرون، ومن أين لنا أنهم يرون ذلك ولا يُنكرون وهم ينصون في كتبهم وفتاويهم على المنع؟!“([3]).
وقال الهيتمي مُتعقّبًا الحاكم: “وبفرضها فالبناء على قبورهم -أي: الصالحين- أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبلة كما هو مُشاهد، لا سيما في الحرمين ومصر ونحوها، وقد علموا بالنهي عنه، فكذا هي، فإن قلت: هذا إجماعٌ فعلي، وهو حجة كما صرحوا به، قلتُ: ممنوع، بل هو أكثري فقط؛ إذ لم يُحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون منعه، وبفرض كونه إجماعًا فعليًّا فمحل حجيته -كما هو ظاهر- إنما هو عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تعطَّل ذلك من منذ أزمنة“([4]).
فانظر كيف أبطل الهيتمي الاستدلال بالواقع العملي، واحتجَّ بأن البناء على القبور منتشر في الحرمين ومصر، والعلماء يعلمون بالنهي عنه ولا ينكرون، ومع ذلك لا اعتبار بسكوتهم؛ لأن الاستدلال بالإقرار العملي إنما هو عند صلاح الأزمنة؛ وقد تعطَّل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ أزمنة.
فإذا كان الهيتمي أبطل الاستدلال بسكوت الفقهاء في زمن الحاكم النيسابوري -وهو في القرن الرابع- فكيف يصح الاستدلال بسكون الفقهاء المتأخرين؟! مِن هذا تعلَم فساد حجة مخالفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن هذه الأبنية موجودة والعلماء لا يُنكرون.
وقد قال ضياء الدين المقبلي -وهو يسبق الوهابية بأكثر من قرن- بعدما حكى استغاثات أهل زمانه وانتشار ذلك في الحرمين: “ومن أنكر هذا قالوا: جلمود مخذول، ولا يحب الأولياء، أو نحو ذلك من عبارات لهم، فهؤلاء زادوا على من قال: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَاّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}”([5]).
والمقصود: أنه لا يُحتجّ بالواقع العملي، ولا بتلقّي ذلك بالقبول جيلًا بعد جيل؛ لأن من العلماء من ينكر ذلك في بطون الكتب، وإذا قُدّر أنهم لا ينكرون فليس بشيء؛ لأن الاستدلال بالإقرار العملي إنما هو في وقت صلاح الأزمنة، مثل زمن الصحابة كما قال ابن حجر الهيتمي.
ثانيًا: التفرقة بين البناء على المقابر المسبلة والمملوكة:
احتجّ المخالفون في تخصيص الشافعية تحريم البناء في المقابر المسبّلة وكرهوا ذلك في المملوكة. وعلة تفرقة الشافعية بين الملكية الخاصة والمُسبلة يرجع للتيسير على الناس في الانتفاع بأملاكهم في بناء البيوت ونحوها، فلا تتعطل مصالح الناس، مع إثبات الكراهة للبناء في المملوكة أيضًا.
وهو خلاف ليس تحته كبير عمل؛ وذلك لأن أكثر أضرحة الأولياء داخلة في المقابر المسبلة؛ لأنها ليست ملكية خاصة كما قال ابن حجر الهيتمي -وسيأتي كلامه-، فاحتجاج المخالفين بهذا التقسيم مجرد تمويه للتشغيب على محل النزاع.
بل قد انتصر الإمام الأذرعي -أحد مجتهدي المذهب- للتحريم مطلقًا سواء في المسبلة أو غيرها، فقال رحمه الله: “الوجه في البناء على القبور هو ما اقتضاه إطلاق ابن كَجٍّ من التحريم، من غير فرقٍ بين ملكه وغيره؛ للنهي العام ولِما فيه من الابتداع بالقبيح، وإضاعة المال والسرف والمباهاة ومُضاهاة الجبابرة والكفَّار، والتحريم يثبت بدون ذلك”([6]).
نعم، إن الوجه الذي رجَّحه الأذرعي ليس هو المعتمد في المتأخرين، وقالوا بالتفريق بين المسبلة والمملوكة، لكن غرضنا هو بيان أن السلفيين مسبوقون بعدم التفصيل من أصحاب الوجوه، وليس قولهم شاذًّا كما يصوّره المناوئون، وقد ذكرنا أن التفريق ليس تحته كبير عمل.
ولذلك لم يتردّد ابن حجر الهيتمي بالإفتاء بهدم القباب والمساجد المبنية على القبور في قرافة مصر، فقال: “وجب على ولاة الأمر هدم الأبنية التي في المقابر المُسبلة، ولقد أفتى جماعةٌ من عظماء الشافعية بهدم قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه، وإن صرف عليها ألوف من الدنانير؛ لكونها في المقابر المُسبلة، وهذا -أعني المقابر المسبلة- مما عمَّ وطمَّ، ولم يتوقّه كبير ولا صغير، فإنا لله وإنا إليه راجعون”([7]).
قال ابن حجر الهيتمي: “ومن المسبلة قرافة مصر… وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بُني فيها، وقد أفتى جمعٌ بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية، حتى قبة إمامنا الشافعي التي بناها بعض الملوك، وينبغي لكل أحدٍ هدم ذلك ما لم يخش مفسدة، فيتعيَّن الرفع للإمام”([8]).
وقال الهيتمي رادًّا على من فرَّق بين قبور الصالحين وغيرهم: “المنقول المعتمد كما جزم به النووي في (شرح المهذب) حرمة البناء في المقبرة المسبلة، فإن بُني فيها هدم، ولا فرق في ذلك بين قبور الصالحين والعلماء وغيرهم، وما في (الخادم) مما يخالف ذلك ضعيف لا يُلتفت إليه، وكم أنكر العلماء على باني قبة الإمام الشــافعي وغيرها، وكفى تصريحهم في كتبهم إنكارًا.. فاعتمد ذلك ولا تغتر بما يُخالفه“([9]).
وهذا من غيرة ابن حجر الهيتمي وأمانته على الشرع، لا كصنيع المنحرفين الذين يتتبعون كل ساقطة ولاقطة في الكتب ليشجعوا الناس على هذه المنكرات؛ لمحض المناكفة مع السلفيين.
وقال الهيتمي أيضًا: “الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانًا، والطواف بها، واستلامها، والصلاة إليها”([10]).
وقال أيضًا: “وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها. والقول بالكراهة محمول على غير ذلك؛ إذ لا يُظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنُ فاعله، وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار”([11]).
وقال الهيتمي رادًّا على من زعم أن سكوت العلماء دليل على الإقرار: “فالبناء على قبورهم -أي: الصالحين- أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبلة كما هو مُشاهد، لا سيما في الحرمين ومصر ونحوها، وقد علموا بالنهي عنه، فكذا هي. فإن قلت: هذا إجماعٌ فعلي، وهو حجة كما صرحوا به. قلتُ: ممنوع، بل هو أكثري فقط؛ إذ لم يُحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون منعه، وبفرض كونه إجماعًا فعليًّا فمحل حجيته -كما هو ظاهر- إنما هو عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تعطَّل ذلك من منذ أزمنة“([12]).
في النقل السابق يُبيَّن الهيتمي أنه لا يجوز الاستدلال بعدم إنكار العلماء (الإقرار العملي)؛ لأن الاستدلال بذلك يكون عند صلاح الأزمنة فقط. وفيه رد على من احتجوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن هذه الأمور موجودة في الأمة منذ سبعمائة سنة.
قال الدميري: “فمن المُسبَّل قرافة مصر؛ فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالًا جزيلًا، وذكر أنه وجد في الكتاب الأول: أنها تربة الجنة، فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك، فكتب إليه يقول: إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين، فاجعلها لموتاهم. وقد أفتى الشيخ بهاء الدين ابن الجميزي وتلميذه الظهير التزمنتي بهدم ما بُني بها”([13]).
وقال ابن النحاس الشافعي: “ومنها: البناء في المقبرة المُسبلة، وقد تقدم أن ذلك حرام يجب هدمها باتفاق العلماء، وأنه لا يُمكن أحد من البناء فيها… وأما البناء على القبر في غير المُسبلة فهو بدعة مكروهة, قال ابن بشير المالكي في كتابه: وليست القبور موضع زينة ولا مباهاة، ولهذا نهى عن بنائها على وجهٍ يقتضي المباهاة. والظاهر أنه يحرم مع هذا القصد، ووقع لمحمد بن حكم فيمن أوصى أن يبنى على قبره أن تُبطل وصيته، ويُنهى عنها ابتداءً”([14]).
وقال أيضًا: “ومنها: ما يُفعل عند القبر كالصندوق والدربزين، وذلك بدعة مخالفة للسنة، وأكثر ما يفعلون ذلك ي قبور الصالحين الذين هم أولى الناس باتباع السنة”([15]).
قال المُناوي: “فإن كان في مُسبلة أو موقوفة حرُم بناؤه والبناء عليه، ووجب هدمه، قال ابن القيم: والمساجد المبنية على القبور يجب هدمها حتى تسوى الأرض؛ إذ هي أولى بالهدم من الغاصب. اهـ. وأفتى جمعٌ شافعيون بوجوب هدم كل بناءٍ بالقرافة، حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله عنه التي بناها بعض الملوك”([16]).
وفي (عمدة المفتي والمستفتي) ما نصه: “ما عمَّ الابتلاء به من التقرب إلى الأولياء في قبورهم بأنواع الطاعات، وتعظيم نحو حائطٍ أو عمودٍ أو شجرٍ رجاء شفاءٍ أو قضاء حاجة، وهذا القسم أعظم وأشد من الذي قبله، ويخشى منه الوقوع في الكفر، إذا تقرر هذا فالرايات والأعلام التي تنصب على قبور الأولياء والصالحين من جملة البدع التي لم تكن في خير القرون، ولا جرى على فعلها السلف الصالح، ولا يعود على الولي نفعٌ أخرويٌّ بوضعها”([17]).
ثالثًا: الاستدلال بقول الفقهاء في بعض بدع القبور بالكراهة:
يستدلّ المخالف بقول بعض الفقهاء على بعض البدع -كبناء المساجد على القبور واستقبال القبر بالصلاة- بأنه مكروه فقط، ونحن نقول: هذا صحيح؛ فإن بعض هذه الأمور قال فيها بعض المذاهب بالكراهة، لكن هذا لأن الفقهاء التزموا بلفظ إمام المذهب -كما سيأتي-، لا لكونها ليست من المنكرات عندهم، وتصرفات الفقهاء دلَّت على النهي والتحذير الشديد، ومن ذلك أن الهيتمي جعل البناء على القبور من الكبائر في كتابه (الزواجر)([18]) كما سبق النقل عنه، مع أنها مكروهة في كتب المذهب.
وقال ابن المُلَّقن: “في الحديث دليل أيضًا على منع بناء المساجد على القبور، وهو منع يقتضي التحريم، كيف وقد ثبت في الحديث لعن الله اليهود… وقد استجاب الله دعاءه فله الحمد والمنة، وأما الشافعي والأصحاب فصرّحوا بالكراهة”([19]).
وقال القسطلاني في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: «أؤلئك شرار الخلق عند الله»: “ومقتضاه التحريم، ولا سيما وقد ثبت اللعن فيه، لكن صرح الشافعي وأصحابه بالكراهة”([20]).
قال المُناوي: “في خبر الشيخين كراهة بناء المسجد على القبور مطلقًا، والمراد قبور المسلمين؛ خشية أن يُعبد فيها المقبور؛ لقرينة خبر: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد». وظاهره أنها كراهة تحريم، لكن المشهور عند الشافعية أنها كراهة تنزيه”([21]).
حتى الإمام النووي قال: “قال أصحابنا: ويُكره أن يُصلي إلى القبر، هكذا قالوا: يُكره! ولو قيل: يحرم لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم يَبعد“([22]).
وقال أبو العباس القرطبي: “وجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبُّه بمن كان يُعظِّم القبور ويعبدها، وباعتبار هذه المعاني وبظاهر النهي، ينبغي أن يُقال: هو حرام، كما قال به بعض أهل العلم“([23]).
فلو تأملت استدراك كل هؤلاء الفقهاء، وعدم رضاهم بحكم الكراهة، تعلم من ذلك تلبيس المخالفين، حيث يُظهرون السلفيين وكأن لديهم مجازفات وميلًا إلى التشديد حينما يختارون الحرمة.
والظنّ بالإمام الشافعي رحمه الله أنه أراد الكراهو التحريمية لا التنزيهية -كما سبق من كلام الهيتمي- ثم تساهل فقهاء المذهب في نقل الكراهة التزامًا منهم بألفاظ الإمام الشافعي الذي أراد التحريم.
وفي ذلك يقول الغزالي: “كثيرًا ما يقول الشافعي رحمه الله: (وأكره كذا) وهو يريد التحريم”([24])، وقال مثله الرازي([25]).
يقول ابن القيم في كلامٍ جليل: “وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدًّا في تصرفاتهم ; فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة، وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه، ولا أقول: هو حرام، ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان، وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز… وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله، قال الله عز وجل: {حُرِّمَت عَلَيكُمُ الميْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللهِ بِهِ}، فتأمل كيف قال: (لا يعجبني) فيما نص الله سبحانه على تحريمه”([26]).
رابعًا: استدلالهم بإباحة النذر لقبور الصالحين:
تمسك المعاصرون بقول بعض الفقهاء الشافعية أنه يُقبل النذر للأضرحة أو للبقع المباركة، فظن بعض المتأخرين -ممن عارضوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- أن بعض الفقهاء يبيحون النذر لذوات الأولياء، ولا يرونه شركًا أكبر، كما استدلوا بكلام لابن تيمية يعتبر فيها النذر للقبور معصية.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “وكذلك النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور -كالنذر لإبراهيم الخليل أو للشيخ فلان أو فلان أو لبعض أهل البيت أو غيرهم- نذر معصية لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة الدين؛ بل ولا يجوز الوفاء به؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»… فمن نذر زيتا أو شمعا أو ذهبا أو فضة أو سترا أو غير ذلك ليجعل عند قبر نبي من الأنبياء أو بعض الصحابة أو القرابة أو المشايخ فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وهل عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء”([27]). ويقول ابن تيمية أيضًا: “أما إذا كان النذر لغير الله فهو كمن يحلف بغير الله، وهذا شرك. فيستغفر الله منه، وليس في هذا وفاء، ولا كفارة”([28]).
فاستدل مناوئو الدعوة بأن ابن تيمية يرى أن النذر لغير الله ليس شركًا أكبر. وممن زعم هذا الزعم ابن داود واعتبر النذر للأولياء من الشرك الأصغر كالرياء ونحوه([29])، وكذلك سليمان بن عبد الوهاب([30])، وتابعهم ابن جرجيس وغيره.
وهذا غلط في فهم كلام ابن تيمية، وغلط أيضًا على بعض الشافعية ممن أجازوا هذا النذر؛ فإن كليهما لم يقصدا النذر تقربًا إلى الولي نفسه، بل قصدوا النذر لمصالح البقعة أو القبر أو الفقراء القاطنين هناك -كما سيأتي من كلامهم-، من جنس قول القائل: سأذبح لهذه المدينة، أي: لمصالح هذه المدينة، أو سأذبح للقرية، يعني سأوزع اللحم على هذه القرية؛ ولأجل كون النذر لمصالح القبور بدعة وذريعة إلى الشرك جعلها ابن تيمية نذر معصية في مواضع، أما الذبح للولي نفسه فهو شركٌ أكبر عند ابن تيمية -كما سيأتي-.
وفيما يلي تبرئة العلماء مما فهمه المخالفون:
أولًا: بالنسبة لكلام ابن تيمية:
فإنهم تركوا المحكم من كلامه الذي فيه أن النذر للأولياء شرك أكبر، ومن ذلك: قول شيخ الإسلام: “والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوقٍ لم ينعقد نذره، ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ كمن نذر للشيخ جاكير وأبي الوفاء أو المنتظر، أو الست نفيسة… ولا يجوز أن يُعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مُشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله“([31]).
وقال أيضًا: “فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه: بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تُباح ذبائحهم بحال“([32]).
ففي هذه المواضع جعل ابن تيمية النذر للأولياء شركًا أكبر، أعظم من الحلف بغير الله، فكان ينبغي على المخالفين جمع كلامه في الباب.
أما قول ابن تيمية الذي استدلوا به: “أما إذا كان النذر لغير الله فهو كمن يحلف بغير الله، وهذا شرك. فيستغفر الله منه، وليس في هذا وفاء، ولا كفارة”([33])، فيُحتمل أنه مثله في عدم الكفارة وعدم الوفاء به -وهو الظاهر من كلامه-، لا لكونه يراه مثل الحلف بغير الله من كل وجه.
ثانيًا: بالنسبة لقول بعض فقهاء الشافعية:
كما أسلفنا أن بعض الفقهاء قصدوا قبول النذر لمصالح البقعة أو القبر أو الفقراء، فإن قول القائل: (نذرتُ للبقعة) اللام هنا يُحتمل أنها لمصالح البقعة، من جنس: نذرت للقرية، وهذا صحيح لغةً.
وهنا يجب أن نفهم طبيعة الواقع الذي تكلّم فيه الفقهاء، فإن بعض قبور الصالحين في القرافة كان يعتني بها السلاطين للتسهيل على الزائرين ممن يقرؤون لهم الفاتحة على الطريقة الشرعية. فكان بعض الزائرين يُخصص مالًا أو زيتًا أو شمعًا لهذا المكان أي: لإنارته وتنظيفه. فصار بعض الفقهاء يُلحقونه بمن نذر للمسجد، أو للقرية، أو للضيف ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه تساهل -وسيأتي نقضه من كلام الأذرعي وغيره-، لكن مرادنا هو براءة الفقهاء مما نسبه إليهم القبورية.
وهذا التفصيل في مقصود الناذر -هل مراده التعظيم أم لا؟- هو تقسيمٌ صحيح في أصله ويقول به السلفيون أيضًا:
يقول الشيخ ابن عثيمين: “الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: أن يذبح لغير الله تقربًا وتعظيمًا، فهذا شركٌ أكبر مخرجٌ من الملة، وأن يذبح لغير الله فرحًا وإكرامًا، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانًا وغير مطلوبة أحيانًا، فالأصل أنها مباحة”([34]).
لكن لما كان الذبح للقبور مشتبهًا، ويتعذَّر فيه هذه التفرقة اللغوية، والعامة إنما يقصدون التقرب لصاحب القبر نفسه، كان إبطال النذر هو الصواب، ولهذا تعقّب مجتهد الشافعية الشهاب الأذرعي هؤلاء الفقهاء، وأبطل النذر لهذه القبور مطلقًا، وتابعه المحققون.
يقول مجتهد الشافعية الإمام الأذرعي: “أما النذور للمَشاهد التي بُنيت على قبر ولي أو شيخ.. إن قصد بنذره -وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة- تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دُفن بها ممن ذكرنا أو نُسبت إليه أو بُنيت على اسمه؛ فهذا نذر باطل غير منعقد؛ فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات لا تُفهم، ويرون أنها مما يُدفع به البلاء، ويُستجلب به النماء، ويُستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأشجار لما قيل: إنه جلس عليها أو استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج أو الشموع أو الزيت… ومن ذلك نذر الشموع الكبيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركًا وتعظيمًا ظانًّا أن ذلك قربة.. فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع هناك أم لا؛ لأن الناذر لم يقصد ذلك ولا مر بباله؛ بل غرضه ما أشرنا إليه، فهذا الفعل من البدع الفاحشة التي عمت بها البلوى، وفيها مضاهاة اليهود والنصارى الذين لُعنوا في الحديث الصحيح على تعاطيهم ذلك على قبور أنبيائهم، وإنما أوضحت فساد ذلك مع وضوحه خشيةَ أن يتمسك جاهل بقول المصنف: (في مسجدٍ أو غيره) وليس ذلك مراده”([35]).
والإمام الأذرعي هو من أجلّ تلامذة تقي الدين السبكي؛ وقد استدلّ بالأحاديث الدالة على لعن اليهود والنصارى في تعظيم قبور الأنبياء، إذن فالقضية متفق عليها بين العلماء، وليس لابن تيمية خصوصية بها.
وقد نقل ابن حجر الهيتمي كلام الأذرعي مُلخّصًا، ثم قال: “إذا قصد به مجرد التنوير وكان هناك من ينتفع بذلك النور فإن هذا قصد صحيح فيلزم.. فإن أمكن أن يتأتّى فيه أنه قصد بهذا النذر التقرب لمن في القبر بطل؛ لأن القُرَبَ إنما يُتقرب بها إلى الله تعالى لا إلى خلقه، على أن محل هذا كله حيث لا عُرف مطرد في زمن الناذر أو الواقف، وأما حيث اطرد العُرف بأن الشموع والأموال التي تأتي لهذا القبر تُصرف في مصالحه أو مصالح المسجد أو لأهل البلد الذي هو فيه، ولم يقصد بالنذر التقرب لمن في القبر، فإن ذلك صحيح لا يسع الأذرعي ولا غيره المخالفة في ذلك.. والأذرعي إنما قال ذلك فيما ذكره الرافعي في قبر جُرجان، هذا كلام مضلة؛ لأنه فهم أن الرافعي يقول بالصحة وإن قصد التقرب للقبر، وليس كذلك، بل كلام الرافعي مصرح أن الناذر لم يقصد ذلك”([36]).
تأمل قول الهيتمي: (لأن القُرَب إنما يُتقرب بها إلى الله تعالى لا إلى خلقه). وهنا قد وصف الهيتمي هذا الفعل بأنه من القُربات، أي: من العبادات التي لا تجوز إلا لله، وهو ما يُبطل قول القبورية أنه ليس شركًا.
ثم قد وضَّح الهيتمي مراد الفقهاء كالرافعي وغيره من قبول هذا النذر، وهو أنهم قالوا بصحة النذر باعتبار أن النذر لم يُقصد به التقرب إلى المقبور نفسه، كما أن الهيتمي وافق على كلام الأذرعي ببطلان النذر بنية التقرب والتعظيم لصاحب القبر.
نعم، لاشك أن بعض فقهاء المتأخرين تساهلوا في قضية تنوير بعض المشاهد وقبول تلك النذور، لكنَّ هذا مبحث آخر، وإنما نقطة البحث هو بيان مراد الفقهاء من قبول النذر، وأنهم لم ينفوا شركية الذبح لذوات الأولياء -كما فهم المخالفون-.
صواب قول الأذرعي واعتماد قوله عند متأخري الشافعية:
لا شك أن قول الأذرعي هو الصواب؛ لأن الواقع يؤيد ذلك؛ فإنه يتعذّر على العامي التفرقة بين النذر لفقراء البقعة، أو النذر للولي نفسه؛ لذلك تعقب المحقق الشافعي أبو بكر الخطيب الحضرمي كلام الهيتمي وغيره بقوله: “وأنت خبير بأن العامي الجاهل الصرف يخفى عليه ملاحظة أن هذا التصدق لا يعتقد إلا في القُرب ومعرفة ما هو قربة، فليتنبه لما يجيئون به للولي أو قبره أو مشهده وهو ميت؛ فإن الغالب أنهم يقصدون به تعظيم ذات الولي أو قبره أو مشهده، وذلك باطل كما تقدم، والله أعلم بالصواب”([37]).
وكذلك انتصر البجيرمي للإمام الأذرعي، واعتمد قوله دون أن يتعقَّبه، فلما قال الخطيب الشربيني: (لو نذر زيتًا أو شمعًا لإسراج مسجد أو غيره… صح النذر والوقف وإن كان يدخل المسجد أو غيره ما يُنتفع به) علق البجيرمي قائلًا: “وإن قصد به -وهو الغالب من العامة- تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دُفن فيها أو نُسبت إليه، فهذا نذر باطل غير منعقد، فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لا تُفهم ويرون أن النذر لها مما يدفع البلاء”([38]).
والملاحظ هنا أن البجيرمي -صاحب الحاشية- حشَّى على هذه العبارة بعبارة الأذرعي دون عزو، ودون أن يتعقّبه، بل اقتصر على قوله، فهذا دليل أنه يعتمد هذا القول، وحاشيةُ البجيرمي من معتمدات المتأخرين.
وفيما يلي جملة من علماء المذاهب جعلوا النذر لغير الله شركًا:
قال البربهاري: “ولا يخرج أحد من الإسلام حتى يردّ آية من كتاب الله، أو يردّ شيئًا من آثار رسول الله، أو يصلّي لغير الله، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئًا من ذلك فقد وجب عليك أن تُخرجه من الإسلام”([39]).
وأكده فقيه الحنابلة عبد الوهاب الشيرازي -وهو ناشر مذهب أحمد في الشام-: “ولا يخرج من الإسلام إلا من رد على شيء من الأوامر والنواهي، وصلى لغير الله أو ذبح لغير الله“([40]).
قال الرازي: “قال العلماء: لو أن مسلمًا ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدًّا، وذبيحته ذبيحة مرتد”([41]).
وقال السويدي الشافعي: “فقد تبيَّن لك من هذه النقول كلها أن ما يُقرِّب لغير الله تقربًا إلى ذلك الغير ليدفع عنه ضرًّا أو يجلب له خيرًا تعظيمًا له من الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان عليه الأولون”([42]).
وقال صنع الله الحنفي: “من ذكر غير اسم الله على ذبيحته فهي ميتة يحرم أكلها.. نعم لو قال: هذا النذر لله، يُذبح في مكان كذا، ويصرف على جماعة فلان أو على أهل رباط فلان فلا بأس، كما في الوقف على فلان وفلان؛ فإن الوقف لله ملك له، وتصرف علته على من عينه الواقف، فكذا هنا”([43]).
وقال قاسم الحنفي في شرح الدرر -الذي تتابع الأحناف على نقله واعتماده-: “وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائبٌ أو مريضٌ أو له حاجة ضرورية، فيأتي بعض الصلحاء، فيجعل سترة على رأسه فيقول: يا سيدي فلان إن رُدّ غائبي أو عُوفي مريضي أو قُضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو من الزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه.. منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون للمخلوق، ومنه أن المنذور له ميت، والميت لا يملك”([44]).
والشاهد أنه جعل تعليل تحريم النذر للأولياء كونَه عبادة، وهو ما لا يختلف عن تعليل السلفيين بكونه شركًا في العبادة.
ونقل كلامه الطحطاوي ثم قال: “اللهم إلا أن يقول: يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة.. والنذر لله عز وجل“([45]).
ونقل كلامه علاء الدين الحصفكي ثم قال: “وقد ابتُلي الناس بذلك، ولا سيما في هذه الأعصار“. قال العلامة ابن عابدين: “(قوله: ولا سيما في هذه الأعصار) ولا سيما في مولد السيد أحمد البدوي“([46]).
وسُئل خير الدين الرملي الحنفي عن النذور المتعلقة بالأنبياء والأولياء، فأجاب: “هذه المسألة جعل فيها شيخ الإسلام الشيخ محمد الغزي رسالة، حاصلها أن النذر لا يصح إلا إذا كان من جنسه واجب مقصود؛ إذ ليس للعبد أن ينصب الأسباب ويشرع الأحكام.. وفي شرح الدرر للعلامة قاسم: وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام كأن يقول: ياسيدي فلان -يعني به وليًّا من الأولياء أو نبيًّا من الأنبياء- إن رُد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة.. فهذا باطلٌ بالإجماع لأنه نذرٌ لمخلوق وهو لا يجوز؛ لأنه -أي: النذر- عبادة فلا تكون لمخلوق، والمنذور له ميت، والميت لا يملك… يا الله، إني نذرتُ لك إن فعلت لي كذا أن أطعم الفقراء بباب السيدة نفيسة أو الشافعي ونحوهما… أقول: قد استباح هذا المحرَّم المُجمع على حرمته جماعة يزعمون أنهم متصوفة يُقال في حقهم قدوة المسلمين ومربي المريدين!”([47]).
ويوضح خير الدين الرملي الحنفي المسألة بأوضح بيان قائلًا: “فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها، فتُنقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم لا إلى الله تعالى، فحرامٌ قولًا واحدًا بإجماع المسلمين، ما لم يقصدوا الفقراء الأحياء قولًا واحدًا“([48]).
ويُفهم من كلام الرملي أن المسألة إجماعية، وإنما حصل الاشتباه في اللفظ، لا كما زعم ابن داود وابن جرجيس أن التقرب للأولياء للذبح من الشرك الأصغر، ونسبوا ذلك لابن تيمية!
ويقول صنع الله الحنفي -وهو يسبق الوهابية بقرن من الزمان- حيث أنكر ممارسات القبورية في زمنه فقال: “أما كونهم جوَّزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيها الأجور فيُقال: هذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله فيكون باطلًا”. ثم استدل بالآيات والأحاديث، ثم قال: “وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والذبائح والنذر واليمين… ومن ذكر غير اسم الله على ذبيحته فهي ميتة يحرم أكلها… فالحاصل: أن النذر لغير الله فجورٌ، فمن أين لهم الأجور؟!”([49]).
وممن قرر أن الذبح للقبور شرك: الصنعاني، حيث يقول: “فإن قال قائل: إنما نحرتُ لله، وذكرت اسم الله عليه، فقل: إن كان النحر لله فلأي شيءٍ قرَّبت ما تنحره من باب مشهد من تُفضِّله وتعتقد فيه؟! هل أردتَ بذلك تعظيمه؟! إن قال: نعم، فقل له: هذا النحر لغير الله تعالى، بل أشركت مع الله غيره، وإن لم تُرد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟! أنت تعلم يقينًا أنك ما أردتَ ذلك أصلًا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدًا له”([50]).
وكذلك قرره الشوكاني فيقول: “وكذلك النحر للأموات عبادة لهم، والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم، والتعظيم عبادة لهم، كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة عبادة لله بلا خلاف، ومن زعم أن ثمَّ فرقًا فليهده إلينا، ومن قال: إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنع؟!”([51]).
بل الأبلغ من ذلك: أنه قد ذهب الحنفية إلى تحريم الذبح للأحياء إن دلَّت قرينة على التعظيم، ومن ذلك: لو ذبح لقدوم ضيف ثم وزع اللحم على الناس دون أن يأكل منها الضيف، كان ذبحًا لغير الله؛ لأن عدم تقديم الأكل له قرينة أن الذبح كان تعظيمًا لذاته.
يقول الحصفكي الحنفي: “إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله، والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح، وإن لم يقدمها ليأكل منها، بل دفعها لغيره كان لتعظيم غير الله، فتحرم، وهل يكفر؟ قولان”([52]).
ويقول ابن قاسم العبادي الحنفي: “الذبح عند مرأى الضيف تعظيمًا له لا يحل أكلها، وكذا عند قدوم الأمير أو غيره تعظيمًا؛ لأنه أُهل لغير الله”([53]).
هذا كلام الفقهاء بشأن من ذبح للأحياء في الأمور العادية مثل الولائم وغيرها، ومع ذلك حكم الفقهاء بحرمتها إن كانت هناك قرينة تدل على الذبح لذات الضيف نفسه، فكيف يُظن بالفقهاء أنهم أجازوا الذبح للأموات؟!
على أن السلفيين لم يتشددوا هذا التشدد بشأن الذبح للأحياء، بل أجازوا هذا الذبح دون احتراز.
ويظهر مما سبق:
أن السلفية مسبوقون بإلحاق النذر للقبور بالأمور التعبدية الشركية، بل هناك إطباقٌ على ذلك، والخلاف الذي توهمه المعاصرون إنما كان تقديره الذبح لمصالح الناس في تلك البقعة، والجميع اتفق على أن الذبح لتعظيم الميت محرم ومن صور العبادة.
ثم يبقى البحث أن معظم الفقهاء لم يُكفِّروا فاعل ذلك، مع إنكارهم تلك الممارسات، وهذا لا إشكال فيه، وجوابه من وجهين:
1- أن بعض الفقهاء ذكر أن علة التحريم هي العبادة كابن قاسم الحنفي، وبعضهم جعل العلة كونها قربة كالأذرعي والهيتمي، وبهذا يظهر أن العلة هي الشرك، فضلًا عن ابن تيمية الذي جعلها شركًا أكبر كما مر بيانه.
2- انتشار الجهل في عموم المسلمين يمنع من التكفير، فليس من الضرورة أن يحكم الفقيه على الأعيان؛ لعدم قيام الحجة عليهم، وإنما وظيفة الفقيه هو بيان الحق في المسألة.
وصلِّ اللهم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. (يتبع)
ـــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) الصواعق الإلهية (ص: 6-7).
([2]) تلخيص المستدرك (1/ 370).
([3]) إكمال إكمال المعلم (3/ 98).
([5]) الأبحاث المسددة في فنون متعددة (ص: 158-165).
([6]) ينظر: الفتاوى الكبرى، للهيتمي (2/ 16).
([8]) تحفة المحتاج بحاشية الشبراملسي (3/ 198).
([14]) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص: 482).
([15]) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص: 522).
([17]) عمدة المفتي والمستفتي (1/ 182).
([19]) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (2/ 447).
([26]) إعلام الموقعين (1/ 33).
([27]) مجموع الفتاوى (27/ 112).
([28]) مجموع الفتاوى (11/ 275).
([29]) الصواعق والرعود (ص: 150).
([30]) الصواعق الإلهية (ص: 8).
([31]) مجموع الفتاوى (33/ 13).
([32]) اقتضاء الصراط المستقيم (ص: 260).
([33]) مجموع الفتاوى (11/ 275).
([34]) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 214).
([35]) قوت المحتاج شرح المنهاج (10/ 535).
([36]) الفتاوى الكبرى (4/ ٢٨٦).
([37]) الفتاوى النافعة في مسائل الأحوال الواقعة (ص: 249).
([38]) حاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني (5/ 303).
([40]) الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة (2/ 1050).
([42]) العقد الثمين (ص: 123-124).
([44]) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم (2/ 319).
([45]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 693).
([46]) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 396).
([47]) فتاوى خير الدين الرملي الحنفي (1/ 17-18).
([48]) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم (2/ 319).
([50]) تطهير الاعتقاد (ص: 33).