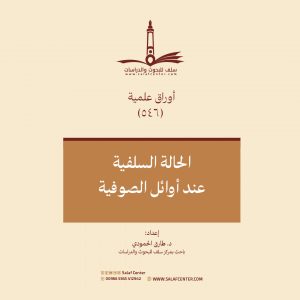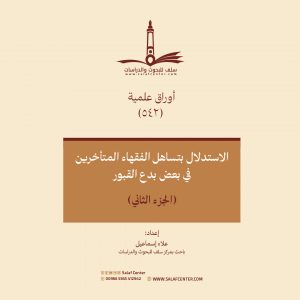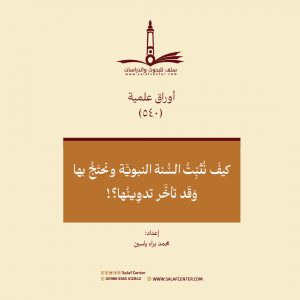الموقف السلفي من التراث
قضية التراث قضية حية في الوجدان العلمي لكل الثقافات والمناهج، ومع أن الأصل اللغوي للكلمة يدل على ما يخلِّفه الإنسان خلفه ثم ينتقل إلى غيره بسبب أو نسب، ومع غلبته في المال ولأشياء؛ إلا أن ذلك لم يمنع من إطلاقه في معاني معنوية كالثقافة وغيرها، وقد وُجدت نصوص شرعية تُطلق التراث أو الوراثة على الإنجاز العلمي وبقاياه التي يتعلمها الناس بعد موت صاحبها، من ذلك قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِير} [سورة فاطر:32].
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يُوَرِّثوا دينارًا ولا درهمًا، ورَّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»([1]).
وقوله عليه الصلاة والسلام: «كونوا على مشاعركم فإنكم على إرثٍ من إرث إبراهيم»([2]).
ونظرا لما يحمله مصطلح التراث عند بعض المتأخرين من صفة قدحية؛ فإن ذلك قد أدَّى إلى نواع من التحفظ والمحاذرة في تبنِّي المصطلح، وفي هذا المقال سوف نناقش مفهوم التراث عند السلفية وطريقة التعامل معه:
السلفية والتراث: السلفية والتراث اسمان متقاربان من ناحية المعنى، فالسلفية تعني الانطلاق من مرجعية منضبطة في التفاعل مع التراث، وتمثل هذه المرجعية مرتكزًا أساسيًّا في الموقف من التراث وغيره، وهذه المرجعية ملخصها تبني الوحي الإلهي كتابًا وسنةً، واعتبار الصحابة تحققًا عمليًّا ونموذجًا يُقتدى به، ومعيارًا لضبط التنازع التأويلي الذي يمكن أن يقع في فهم لكتاب والسنة، وذلك لعدة مقومات، منها علم الصحابة الكامل بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، واكتمال أدواتهم المعرفية، وإلى هذا يشير الشافعي فيقول: ” فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامًّا وخاصًّا، وعزمًا وإرشاداً، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وآراؤهم لنا أحمد، وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يُرضى أو حُكِي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول، ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله([3]).
ويقول ابن تيمية: “فمن بنى الكلام في العلم: _الأصول والفروع_ على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى”([4]).
فهذا التراث الذي هو الوحي كتابًا وسنة، ثم فهم الصحابة رضي الله عنهم؛ يُعدُّ تراثًا مُلهِمًا بالنسبة للسلفية؛ لأنه داخل ضمن المرجعية الْمُشْكِّلَةِ الفكرة، ولذلك لا يجدون غضاضة في تقديسه وتمجيده، والدراسة السلفية للتراث بهذا المعنى تشمل ناحيتين؛ الناحية الأولى: ناحية الحفظ، والناحية الثانية: ناحية الفهم والاستفادة، فيهتم السلفيون بهذا التراث وتَتَبُّعه واستخراجه حتى لا يضيع منه شيئًا، ولذلك اعتنوا قديمًا وحديثًا بالآثار تمييز صحيحها من سقيمها، كما اعتنوا بدراستها وفهمها وتنقيحها وتبيين مواردها، ومنزع كل قول، وكيف تشكَّل عبر مجموعها منهجية معرفية متكاملة البناء، وقد أرادوا من خلال ذلك القضاء على خلل الفوضى المنهجية التي تصيب الأمة أحيانًا في بعض التصورات، كما أرادوا أيضًا إيجاد معيار يتحاكمون إليه في درأ التعارض، وتصويب الأقوال، وتقديم بعضها على بعض حتى من داخل المدرسة السلفية، فهذا ابن القيم رحمه الله يشرح كتاب الهروي منازل السائرين بكتاب أسماه مدراج السالكين، وأثناء هذا الشرح لم يستنكف ابن القيم وهو يشرح كتاب لإمام من نفس المدرسة الفقهية والعقدية التي ينتمى إليها أن يقوِّمه ويردَّه إلى المنهج الأقوم، فكان يمر على بعض عباراته فَيَتَجَرَّعَها ولا يكاد يسيغها، ثم مع أدب جم يبين أن سبب صعوبة استساغة هذه العبارة كونها لم تَجْرِ على السَّنن المتعاهد عليه في المنهج السلفي، فهي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولا عن أحد من السلف، فمن هنا دخلها الاشتباه، ومع هذه النظرة النقدية التي لا تُسلِّم كل ما يرد عن المؤلف عن عبارات لم تكن موافقة للمنهج؛ إلا أن ذلك لم يكن المراد منه هدم المؤلف ولا تحطيم إنجازاته، وإنما كان المراد منه تنقية التراث حتى يبقى مُلْهِمًا صافيًا لم يختلط بشيء، ولذلك يعتذر ابن القيم عن المؤلف في أخطائه، ويبين عذره، كما يشير إلى نوع الخطأ الذي قد يقع لبعض القرّاء فيقول:” فيقال: هذا ونحوه من الشطحات التي تُرجى مغفرتها بكثرة الحسنات، ويستغرقها كمال الصدق، وصحة المعاملة، وقوة الإخلاص، وتجريد التوحيد، ولم تُضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس:
إحداهما: حُجبت بها عن محاسن هذه الطائفة، ولُطف نفوسهم، وصدق معاملتهم، فأهدروها لأجل هذه الشطحات، وأنكروها غاية الإنكار. وأساؤوا الظن بهم مطلقًا، وهذا عدوان وإسراف. فلو كان كل من أخطأ أو غلط تُرك جملة، وأُهدرت محاسنه، لفسدت العلوم والصناعات والحُكم، وتعطلت معالمها.
والطائفة الثانية: حُجبوا بما رأوه من محاسن القوم، وصفاء قلوبهم، وصحة عزائمهم، وحسن معاملاتهم؛ عن رؤية عيوب شطحاتهم، ونقصانها، فسحبوا عليها ذيل المحاسن، وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها، واستظهروا بها في سلوكهم”([5]).
وهذا يعكس الرؤية السلفية للتراث؛ لأن الموقف من تراث غير السلف يعني تقييم العناصر، وإعطاء كل عنصر قيمة تليق به في ميزان الشرع، من أجل إنقاذ الأمة من صور الخلل، وإقامتها علميًّا ودينيًّا على المنهج السويِّ الذي يحقق نهضتها ومجدها، ويضبط حركتها فكريًّا وثقافيًّا، والسلفية في رجوعهم للتراث ينطلقون من مبدأ التكامل والبناء والتأسيس، لأن أي أمة لا ترتكز على تراثها، فإنها تضمحل وتهون وفي المقابل لا بد أن يكون هذا التراث ممحصًّا وطاهرًا من جوانب الزيف، ولذلك عمدوا إلى قراءة جميع جوانب التراث سواء ما كان مُلْهِمًا بإطلاق وهو الوحي وفهم الصحابة، وما يمكن أن يكون مُلْهِمًا لكن بقيد، فكل هذا تعاملوا معه بمنهج الفحص والتدقيق، فلم يقبلوا في كلا الجانبين إلا ما صح ثبوته نقلًا، فلم يكتفوا بالروايات التاريخية ودمجها ضمن تراثهم واعتبارها جزء من عقليتهم المعرفية أو مناهجهم المعيارية؛ بل طلبوا صحة السند فيها وثبوتها، ثم بعد ذلك يتعامل مع وفق المنهجية العامة القائمة على مراعاة المنظومة العلمية والانسجام بين الجزئيات والكليات، ولذلك ركز السلفيون في دراستهم للتراث على الجوانب الشرعية في الفقه والاعتقاد وعلوم السنة، فقاموا بتحقيق هذه المجالات وتقريبها وتفسيرها وحصر المأثور فيها، كما قاموا بتنقيتها من كل ما هو سقيم وضعيف، وقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية دورا كبيرا في تنقيح التراث وتنقيته من الشوائب، فتعرض لأغلب ما أُثر من مقالات السلف وقرَّره وقرَّبه للناس ودعاهم إليه، كما قام بنقد المقالات التاريخية للمتكلمين وعرضها على منهج السلف، وإقرار ما وافقه، ودفع وإبطال ما خالفه، ونظرة في معالجته لقضايا الاعتقاد والفقه والسلوك عند كل من الرازي والغزالي تؤكد مدى عمق الرجل وإدراكه لحقيقة ما يقوم به، فقد ألّف في مناقشة فكر الغزالي كتابه الموسوم بـ”بغية المرتاد”، وناقش الغزالي في قضاياه التي طرح في الفقه والاعتقاد والسلوك، وبيَّن مواردها وحكم عليها حكمًا شاملًا، ملخصه أن الغزالي كان طالبًا للحق؛ لكن أضرَّ به ضعفه في علوم السنة، وعدم إلمامه بالمأثور عن السلف([6])،كما طرح قانونا لمعالجة الأطروحات الكلامية يظهر أهمية الاطلاع على التراث الإسلامي بشقيه الوحي والممارسة؛ لتبيين المصطلحات وتطوراتها التاريخية، فالمصطلح أحيانا يبدأ مقبولا ثم ينتهي به المطاف إلى الرفض نتيجة لغلبته في ممارسة غير شرعية، ومن هنا لم يعد للمصطلح قيمته التي كان يتمتع بها من قبل، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:” فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما توَلَّد فيه من أعظم العلوم نفعًا، إذ المرء ما لم يُحط علمًا بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. وكان “للزهاد” عدة أسماء: يُسمَّون بالشام “الجوعية”، ويُسمَّون بالبصرة “الفقرية” و”الفكرية “، ويُسمَّون بخراسان “المغاربة “، ويُسمَّون أيضًا “الصوفية” و”الفقراء”. والنسبة في “الصوفية” إلى الصوف؛ لأنه غالب لباس الزهاد. وقد قيل هو نسبة إلى “صوفة” بن مر بن أد بن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يجاورون حول البيت. وأما من قال: هم نسبة إلى ” الصُفَّة ” فقد قيل: كان حقه أن يقال: صُفِّيَّة، وكذلك من قال: نسبة إلى الصفا؛ قيل له: كان حقه أن يقال: صفائية. ولو كان مقصورًا لقيل صفوية؛ وإن نسب إلى الصفوة قيل: صفوية. ومن قال: نسبة إلى الصَّفّ المقدم بين يدي الله. قيل له: كان حقه أن يقال: صَفِّيَّة، ولا ريب أن هذا يوجب النسبة والإضافة؛ إذا أُعطي الاسم حقه من جهة العربية. لكن “التحقيق” أن هذه النسب إنما أطلقت على طريق الاشتقاق الأكبر والأوسط دون الاشتقاق الأصغر؛ كما قال أبو جعفر: “العامة” اسم مشتق من العمى؛ فراعوا الاشتراك في الحروف دون الترتيب وهو الاشتقاق الأوسط أو الاشتراك في جنس الحروف دون أعيانها وهو الأكبر. وعلى الأوسط قول نحاة الكوفيين “الاسم” مشتق من السِّمَة. وكذلك إذا قيل الصوفي من “الصفا”، وأما إذا قيل هو من “الصفة ” أو “الصف” فهو على الأكبر. وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الأئمة: كأحمد بن حنبل وغيره.
وقد تكلم به أبو سليمان الداراني وغيره، وأما الشافعي فالمنقول عنه ذم الصوفية وكذلك مالك -فيما أظن -، وقد خاطب به أحمد لأبي حمزة الخراساني وليوسف بن الحسين الرازي ولبدر بن أبي بدر المغازلي، وقد ذمَّ طريقهم طائفة من أهل العلم ومن العُبَّاد أيضًا من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الحديث والعباد، ومدحه آخرون. و”التحقيق” فيه: أنه مشتمل على الممدوح والمذموم كغيره، وأن المذموم منه قد يكون اجتهاديًّا وقد لا يكون، وأنهم في ذلك بمنزلة الفقهاء في “الرأي”، فإنه قد ذم الرأي من العلماء والعُبَّاد طوائف كثيرة، و”القاعدة ” التي قدمتها تجمع ذلك كله، وفي المتسمِّين بذلك من أولياء الله وصفوته وخيار عباده ما لا يُحصى عدُّه. كما في أهل “الرأي” من أهل العلم والإيمان من لا يُحصي عدده إلا الله. والله سبحانه أعلم. وبهذا يتبين لك أن البدعة في الدين -وإن كانت في الأصل مذمومة كما دل عليه الكتاب والسنة-سواء في ذلك البدع القولية والفعلية. وقد كتبت في غير هذا الموضع أن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» متعين، وأنه يجب العمل بعمومه، وأن من أخذ يصنف “البدع” إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى عدم جعل بالبدعة داخلة في النهي؛ فقد أخطأ، كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة؛ إذا نهوا عن “العبادات المبتدعة” و”الكلام في التدين المبتدع” ادعوا أن لا بدعة مكروهة إلا ما نُهي عنه، فيعود الحديث إلى أن يقال: “كل ما نهي عنه” أو ” كل ما حرم ” أو ” كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة “، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان، بل كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلالة. وما سُمِّي “بدعة” وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد “الأمرين” فيه لازم: إما أن يقال: ليس ببدعة في الدين وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة. كما قال عمر: “نعمت البدعة هذه”، وإما أن يقال: هذا عام خُصَّت منه هذه الصورة لمعارض راجح، كما يبقى فيما عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة”([7]).
فهذه المنهجية التي كشف عنها شيخ الإسلام في هذا النص هي المنهجية المتبعة في طريق معالجة التراث، وتكمن في الاهتمام بكل ما ورد أو كل ما يريد الباحث معالجته وربطه بنظائره التاريخية، وكيف عالجه السلف، ثم النظر في بُعد آخر وهو ما قد يطرأ على المصطلح أو المسمى من تطور دلالي لا يمكن التعرف عليه إلا بالرجوع إلى الجذور التاريخية واللغوية للكلمة، ثم بعد التوصل إلى المعنى هل هو مطابق للمأثور أم لا يتم الحكم عليه، وإعطاؤه الموقف المناسب شرعا واللائق به، أما رفض التراث واعتبار الرجوع إليه نكسة علمية ورجوعا بالعقل إلى الوراء؛ فإن ذلك استلاب ثقافي وانسحاب فكري بالنسبة للسلفية، وفي المقابل يلزم التفريق بين الممارسات التاريخية التي هي محل اعتبار وهي ممارسات السلف ومن تبعهم وبين الممارسات الأخرى التي تتم محاكمتها للتحققات الأولية للتاريخ فليس كل ما هو تاريخي يكون مقبولًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) سنن أبي داود ح (3641) قال الشيخ الألباني: صحيح.
([2]) سنن الترمذي ح (883) قال الشيخ الألباني: صحيح.