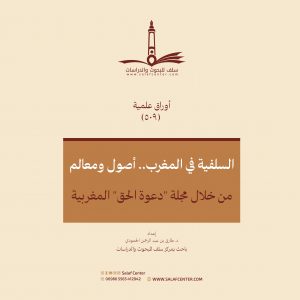رسالة في الكلام الذي ذمَّه الأئمَّة والسَّلف
للتحميل كملف pdf اضغط هنا
فصل([1])
الكلام الذي ذمَّه ونهى عنه الأئمَّة والسَّلفُ الصالح، كما هو مشهورٌ متواتـرٌ عنهم في كتب السُّنَّة والحديث والتصوُّف وكلام الفقهاء وغيرهم، وقد جمع فيه شيخُ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور، ولمالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوصٌ مشهورة = قد حصل فيه اضطراب؛ فإن من الناس من يعتقدُ أنهم نَـهَوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول الدين، ثم تحزَّبوا حزبين، بل ثلاثـة:
* حزبٌ رأوا ذلك عجزًا وتفريطًا، وإضاعةً لواجب الدين أو مُسْتَحَـبِّه، بل إضاعةً لأصوله التي لا يتم إلا بها؛ فطعنوا في السَّلف ومن اتبعهم، ورأوا لنفوسهم الفضلَ عليهم، مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتمل على الجهل أو الظلم.
وهذه طريقة كثيرٍ من أهل الكلام المتفلسفة، لا سيما المتكلمون الذين لا يعظِّمون أهل الفقه والحديث، مثل كثيرٍ من المعتزلة والمتفلسفة؛ فإن لهم في هذا الضلال مجالًا رحبًا.
* وحزبٌ رأوا أن ما فهموه من كلام الأئمَّة والسَّلف هو الصواب، لِمَا علموه من فضلهم؛ فأعرضوا عن جنس النظر والاستدلال في ذلك، وعن جنس المحاجَّة والمجادلة، ورأوا ذلك هو السَّلامة والورع والاتباع، فوقعوا في التفريط في جنب الله، وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه، ولزم من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم وعلى المسلمين، فوقعوا هم في الجهل البسيط، ووقع أولئك ومن اتبعهم في الجهل المركَّب.
وكان من سبب ذلك أنهم فهموا من كلام السَّلف أعمَّ مما أرادوه، كما قررتُ نظير ذلك في «قاعدة السُّنَّـة والبدعة».
وقد يؤول بهم الأمر إلى الإعراض عن آيات الله تعالى، وترك اتباع هدى الله، فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونها ولا يسمعونها، وإما أن يكتفوا بمجرَّد قول اللفظ وسماعه من غير تدبرٍ له ولا فقـهٍ فيه، ويرون أن عدم معرفة معاني الكتاب والسُّنَّة هي الطريقة التي سلكها السَّلف وأمَروا بها وعَنَوها في مواضع.
* وحزبٌ ثالث اعتقدوا فضلَ الأئمَّة والسَّلف، واعتقدوا الحاجة والانتفاع والاستحسان لِمَا خاضوا فيه من الكلام في أصول الدين؛ فقالوا: الذي نهى عنه السَّلف هو الكلام الذي انتحله أهلُ البدع من المعتزلة ونحوهم ممن يخالفُ السُّنَّة، لا الكلام الذي تُنْصَرُ به السُّنَّة. وهذه طريقة البيهقي([2]).
أو قالوا: الكلام يُنهى عنه في غير وقت الحاجة، ومع من يُـفْسِدُه الكلام، ويؤمر به وقت الحاجة، ومع من ينفعُه الكلام. وهذه الطريقة قد يشير إليها ابن بطه، والقاضي، والغزالي، وآخرون.
فصل
والتحقيق أن الذي نهى عنه السَّلف هو الكلام المبتدَع الذي لم يَشْرَعه الله ولا رسوله، كما قد قـرَّرتُ في «قاعدة السُّنَّة والبدعة» أن البدعة هي ما لم يُشْرَع من الدين.
وغلبةُ اسم «الكلام» على الكلام المبتدَع كغلبة اسم «السَّماع» على السَّماع المبتدَع؛ فإن ناسًا لما أحدثوا سماع القصائد والتَّغبير، لتحريك قلوبهم وصلاحها، وإثارة مقاصدها ومَواجِدها، وأحدثَ آخرون كلامًا ونظرًا، لعِلْم قلوبهم، وصلاح عقائدهم، وتحقيق مقالهم = كان هؤلاء فيما أحدثوه من الأصوات المسموعة شبيهًا بهؤلاء فيما أحدثوه من الحروف المنطوقة.
وعبَّروا هم والمسلمون عن ذلك بأعمِّ صفاته، وهو السَّماع، والكلام، فإذا أُطلِق اسمُ «السَّماع» عند كثيرٍ من الناس، أو قيل: فلانٌ يحضر السَّماع، أو يقول به، وفلانٌ ينكر السَّماع وينهى عنه، انصرف الإطلاقُ إلى السَّماع المُحْدَث الذي هو موردُ النزاع.
وإن [كان]([3]) السَّماع المشروع المأمور به، الذي هو واجبٌ تارةً ومستحبٌّ أخرى، هو سماعًا أيضًا، بل هو السَّماع المعروف في كلام من حَمِدَ السَّماعَ وأثنى عليه من المُحْتَـذِين طريقة السَّلف .
وكذلك إذا أُطلِق لفظُ «الكلام» الذي يذمُّه وينهى عنه قوم، ويمدحُه ويأمر به آخرون، فإنه عندهم هو الكلام المُحْدَث.
وإن كان الكلامُ الذي أنزله الله تعالى هو أصدقَ الكلام وخيرَه وأفضلَه، وكلامُ النبي ﷺ والصَّحابة والتابعين والأئمَّة كلامًا([4]).
لكن خُصَّ المُحْدَثُ من النوعين باسم «الكلام» و«السَّماع»؛ لأن هذا الاسم بمجرَّده تعبيرٌ عنه، لا يدلُّ على حمدٍ ولا ذم، ولا أمرٍ ولا نهي، واللام فيه تنصرفُ إلى المعهود.
بخلاف ما كان من الكلام والسَّماع مشروعًا، فإن ذاك يُعَـبَّر عنه بأخصِّ أسمائه، مثل: عِلم، وقرآن، وسماع القرآن، ونحو ذلك؛ لأن من عادة العرب وغيرهم في الخطاب: إذا كان تحت الجنس نوعان عبَّروا عن أشرفهما باسمه الخاصِّ، وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح، كما فعلوا ذلك في مثل لفظ: دابة، وحيوان، وذوي الأرحام.
وقولنا: «كلام» أو «سماع» إنما هو تعبيرٌ عنه بالاسم المشترك بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغيِّ والرشاد، فإذا كان عندهم متميزًا بما يدل على أنه حقٌّ وهدًى ورشادٌ عبَّروا عنه بالاختصاص، كما أنه إذا كان متميزًا بما يقتضي أنه باطلٌ وضلالٌ وغيٌّ عبَّروا عنه بالاختصاص.
ولا ريب أن المُحْدَث من النوعين ليس حقًّا وهدًى ورشادًا من كلِّ وجه، ولا باطلًا وضلالًا وغيًّا من كلِّ وجه.
وهذا باتفاق جميع الطوائف؛ فإن القائلين بالكلام والسَّماع المُحْدَثَـيْن يسلِّمون أن فيه([5]) ما هو باطلٌ وضلال، وأن كثيرًا من أهل الكلام ضلَّ، وكثيرًا من أهل السَّماع غوى، ويميِّز هؤلاء الكلامَ الصوابَ بصفاتٍ قد يكون في بعضها نزاعٌ بينهم، كما يميِّز أولئك السَّماعَ النافعَ بصفاتٍ يكون في بعضها نزاعٌ عند بعضهم.
والمنكرين للسَّماع والكلام المُحْدَثَـيْن لا ينكرون أن في كلام المتكلمين ما قد يكون حقًّا وصوابًا، وأن السَّماع قد تحصُل به رقةٌ ومنفعةٌ للقلب، وإن كان تحصُل به أيضًا مضرَّة، كالخمر والميسر التي قال الله فيهما: ﴿ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 219].
ولهذا يقولون: فلانٌ صاحبُ علم، وفلانٌ صاحبُ كلام. وهذا كثيرٌ في كلامهم، مثل قول الإمام أحمد عن ابن أبي دؤاد: «لم يكن يعرفُ العلم ولا الكلام»([6])، وقوله: «عليكم بالعلم».
فصل
إذا عُرِف هذا، فالكلام المبتدَع المذموم هو الذي ليس بمشروعٍ [ولا] مسنون، وليس بحقٍّ ولا حسن، وهذان الوصفان متلازمان، فإن كلَّ مشروعٍ مسنونٍ فهو حقٌّ حسن، وكلَّ ما هو حقٌّ حسنٌ فهو مشروعٌ مسنون، وكذلك بالعكس.
وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء، وإخبار.
فأما الإنشاء، فمثل: الأمر والنهي، فكلُّ أمرٍ ونهيٍ لا يكون موافقًا لأمر الله تعالى ونهيه فهو ضلالٌ وغيٌّ.
وأما الإخبار، وهو الغالبُ على فنِّ الكلام المتنازع فيه، فإنه إخبارٌ عن حقائق الأمور الموجودة والمعدومة، كالإخبار عن الله تعالى وصفاته وأفعاله، وعن المعاد وما يكون بعد الموت، وعما مضى قبلنا، وما سيكون بعدنا.
والإخبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبًا فهو المسائل والأحكام، وإن كان طريقًا إلى المطلوب فهو الوسائل والأدلة.
فالكلام يشتمل على هذين الصنفين: المسائل، والدلائل، والذمُّ والنهيُ واقعٌ في هذين الجنسين:
* أما المسائل، فكلُّ جواب مسألةٍ خالف الكتابَ والسُّنَّة وما كان عليه السلف فهو بدعةٌ وضلالة، وهو من الكلام المذموم المنهيِّ عنه، سواءٌ كانت المسألة نفيًا أو إثباتًا، مثل: إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتابُ والسُّنَّة، وإنكار قَدَر الله وقدرته ومشيئته، أو إنكار محبَّـته ورضاه وخُلَّته وتكليمه وعلوِّه على عرشه، أو إنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والحوض والميزان والشفاعة والصراط ونحو ذلك من عقود أهل السُّنَّة التي أثبتتها نصوص الكتاب والسُّنَّة وآثار السَّلف.
ثم المُنْكِر لذلك أو بعضه هو مفترٍ، ولهذا كان السَّلف يسمُّونهم: «أهل الفِرَى»([7])، ويتأوَّلون فيهم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ [الأعراف: 152]، قال أبو قلابة: «هي لكلِّ مفترٍ من هذه الأمة إلى يوم القيامة»([8]).
وهو مفترٍ من وجهين:
أحدهما: نفيُ ما أثبته الكتابُ والسُّنَّة، أو إثبات ما نفاه.
والثاني: تحريفُ النصوص بما يوافقُ ظـنَّه وهواه، ودعواه أن ذلك هو معناها.
فهو مخبرٌ عن الأمور بخلاف ما هي عليه، ومخبرٌ عن النصوص بخلاف ما دلَّت عليه، فافترى في الوجودَين: العيني، والعِلْمي.
* وأما الدلائل، فإنهم كثيرًا ما يستدلُّون ويحتجُّون على الحقِّ الذي جاء به الكتابُ والسُّنَّة بحججٍ مُحْدَثةٍ باطلة، ثم تلك تُوقِعُهم في البدع المخالفة للكتاب والسُّنَّة، بمنزلة الذي يجاهد الكفَّار بقتالٍ محرَّم في الشريعة، فيزيل باطلًا بباطل.
ولهذا كان السَّلف إذا قيل: فلانٌ يردُّ على فلان، قالوا: بكتابٍ وسنة؟ فإن قال: «نعم» صوَّبوه، وإن قال: «لا» قالوا: ردَّ بدعةً ببدعة([9]).
وكثيرًا ممَّا أوقعهم ــ أو أكثر ما أوقعهم ــ في البدع المخالفة للكتاب والسُّنَّة احتجاجُهم لنوعٍ من الحقِّ بحجَّة مبتدعةٍ اعتقدوا أنها لا تَسْلَمُ من المناقضة والمعارضة إلا بما التزموه لتصحيحها من اللوازم التي قد يخالفون بها الكتابَ والسُّنَّة.
وكان مبدأ ذلك تكلُّمهم في «الجسم، والجوهر، والعَرَض»، وظنُّهم أن بهذا التقسيم والترتيب يَـثْـبُت لهم وجودُ الصانع، وحدوثُ العالم، ونحو ذلك.
فلم ينكر السَّلفُ مجرَّد إطلاق لفظٍ له معنًى صحيح، كما يعتقده قومٌ من الناس من أهل الكلام وغيرهم؛ فإنَّا عند الحاجة إلى الخطاب نخاطبُ الرجل بالفارسية والـرُّومية والـتُّركية.
والنبيُّ ﷺ لما كتب إلى أهل اليمن، كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون بها، وليست هي لغة قريش.
ولما قَدِمت أمُّ خالدٍ من أرض الحبشة، وكانت قد سمعت لغتهم، قال لها لما أعطاها الخَمِيصة: «يا أم خالد، هذا سَنَا»([10])، والسَّنا بلسان الحبشة: الحَسَن، أراد مخاطبتَها بذلك إفهامًا لها وتطييبًا لنفسها.
ولا بأس أن يخاطِبَ المسلمُ كلَّ قومٍ بلغتهم التي يعرفون؛ لِقَصْدِ إفهامهم، إذا لم يحصُل المقصودُ بخطابهم بالعربية.
لكن كَـرِه السَّلفُ والأئمَّة، كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطبَ بغير العربية لغير حاجة([11])؛ لأنها شعارُ أهل القرآن والإسلام، وبها يَعْرِفون ما أُمِروا بمعرفته من أمر دينهم، ولمعاني أُخَر ذكرتُها في «اقتضاء الصِّراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم»([12]).
فلم تكن كراهةُ السَّلف لمجرَّد اللفظ.
ولا كَرِهوا أيضًا معنًى صحيحًا يكون دليلًا على حقٍّ، كما يتوهَّمه أيضًا هؤلاء، ويقولون: «إن كُرِه اللفظُ فهو اصطلاحيٌّ كاصطلاحات سائر العلماء من الفقهاء والنحاة، وإن كُرِه المعنى فلا يريد([13]) إلا الدلالة على أصول الدين، مثل: ثبوت الصانع، ووحدانيته، وصحة الرسالة والنبوة»([14])؛ فإن هذا المعنى لم يكرهه السَّلف، ولا يكرهه مؤمنٌ عليم.
كيف والقرآن من أوله إلى آخره إنما هو في تقرير هذه المعاني التي هي أعلامُ علوم الدين، وأشرفُ مقاصد الرسل؟!
وقد صرَّف الله في القرآن الدَّلالات بوجوه المقاييس، وضرب الأمثال، وأنواع القصص، وغير ذلك مما هو دليلٌ ومرشدٌ إلى الإيمان بهذه الأصول.
وكيفَ وعلمُ الإيمان بهذه الأصول هو أفضلُ علمٍ في الدين، والكاملون فيه هم خلاصةُ الأمة؟!
وبمثله بـرَّز السابقون والمقـرَّبون، وقيل في الصدِّيق رضي الله عنه صدِّيق الأمة: «ما سبقهم أبو بكرٍ بفضل صلاةٍ ولا صيام، ولكن بشيءٍ وَقَـر في قلبه»([15]).
وقد مدح الله أهلَ العلم به في غير موضع، وقال فيهم: ﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [آل عمران: 18]، وقال فيهم: ﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [سبأ: 6]، إلى غير ذلك مما ليس هذا موضعه.
فكيف يكره السَّلفُ معانٍ إما هي واجبةٌ وإما مستحبَّـة؟!
وكيف وهؤلاء السَّلف لهم من الدلائل والبراهين في مسائل السُّنَّة والردِّ على أهل البدع ما ليس هو لمن ذمُّوه من أهل الكلام؟! وإن أنكروا الطرق والدلائل المُحْدَثة المبتدَعة؛ لما فيها من الفساد والتناقض، وأنها من جنس الكذب والخطأ.
فتدبَّـر هذا؛ فإنه فرقانٌ يفـرِّق الله به بين الحقِّ والباطل.
وإنما أضربُ لك أمثلةً من أدلتهم وحججهم الفاسدة، كما ضربتُ لك أمثلةً من مسائلهم الفاسدة.
وذلك أن أهل الكلام من أهل قبلتنا يأخذون كثيرًا في الردِّ على من خالف المسلمين([16]) من المشركين والمجرمين واليهود والنصارى، ويأخذ كثيرٌ منهم في الردِّ على من خالف السُّنَّة في بعض المواضع، وإن كان الرادُّ قد يخالفُ هو السُّنَّة في موضعٍ آخر.
فيريدون أن يثبتوا وحدانية الصَّانع وكماله، ويثبتون([17]) نبوَّة محمد ﷺ، ويسمُّون هذه المطالب «العقليات»؛ لاعتقادهم أنها لا تـثبتُ إلا بالعقل الذي ادَّعوه وكانوا مختلفين في طرقه!
وقد يعتقدون أن الكتابَ والسُّنَّة لم تبيِّن أدلة هذه المطالب الشريفة! والقرآن مملوءٌ منها.
ولم يعلموا أن [كون] العقل قد يعلمُ صحَّتها لا يمنع أن يكون الشرعُ دلَّ عليها وأرشد إليها، فهي شرعيةٌ عقلية، بل ما يبيِّنه الكتابُ والسُّنَّة من أدلة هذه المطالب فوق ما في قُوى البشر، ولم يأت أهلُ الفلسفة والكلام من ذلك إلا بحقٍّ قليلٍ مخلوطٍ بباطلٍ كثير، فلـبَسُوا الحقَّ بالباطل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) الرسالة مستلة من جامع المسائل – المجموعة التاسعة ص5 -17، طبعة دار عالم الفوائد، وأبقينا الضروري من التعليقات فقط.
([2]) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (1/454).
([4]) أي: وإن كان كلام النبي ﷺ والصَّحابة والتابعين والأئمَّة يسمى كلامًا.
([6]) انظر: «محنة الإمام أحمد» لحنبل (47).
([7]) ورد عن قتادة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/2780).
([8]) أخرجه ابن جرير (13/135).
([9]) روي عن عبد الرحمن بن مهدي. انظر: «ترتيب المدارك» (3/208).
([10]) أخرجه البخاري (5823) من حديث أم خالد.
([11]) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (13/402)، و«المدونة» (1/161) .
([14]) انظر: «إحياء علوم الدين» (1/96، 97).
([15]) أخرجه أحمد في «فضائل الصَّحابة» (118).