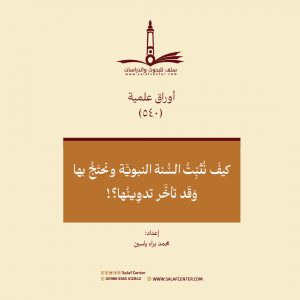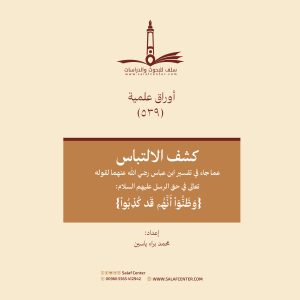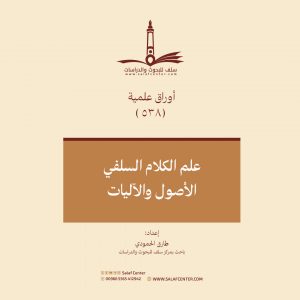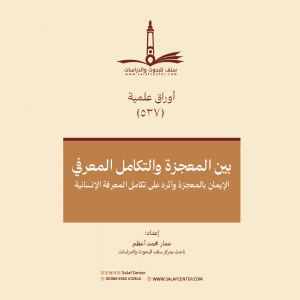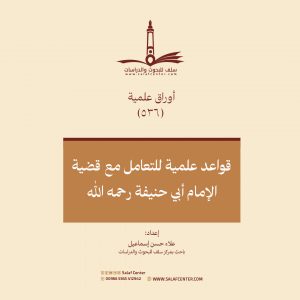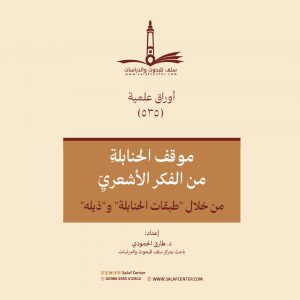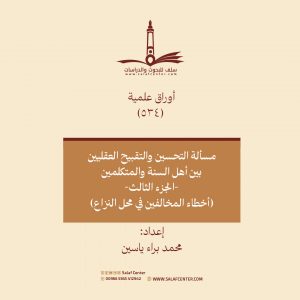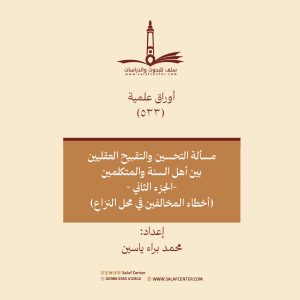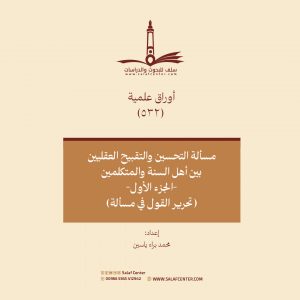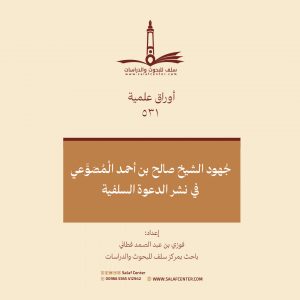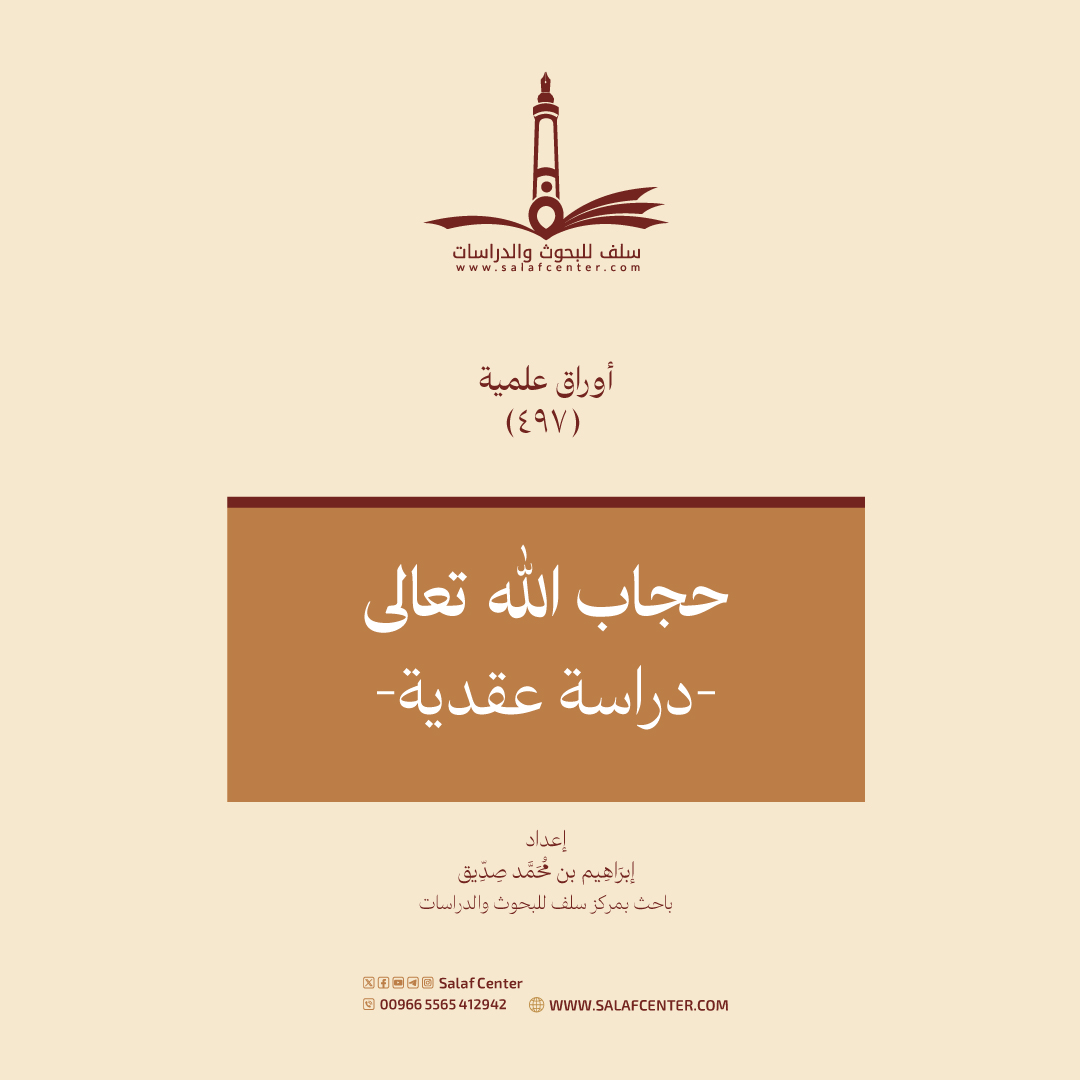
حجاب الله تعالى -دراسة عقدية-
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
مقدمة:
معرفة الله سبحانه وتعالى هي قوت القلوب، ومحفِّزها نحو الترقِّي في مقامات العبودية، وكلما عرف الإنسان ربَّه اقترب إليه وأحبَّه، والقلبُ إذا لم تحرِّكه معرفةُ الله حقَّ المعرفة فإنه يعطب في الطريق، ويستحوذ عليه الكسل والانحراف ولو بعد حين، وكلما كان الإنسان بربه أعرف كان له أخشى وأخشعَ، يقول ابن تيمية رحمه الله: “وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان: أحدهما: العلم به نفسه؛ وبما هو متَّصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى، وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، فإنه لا بد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته، ويعاقب على معصيته، كما شهد به القرآن والعيان”([1])، ويقول رحمه الله: “من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني: بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوقَ منها إلى معرفة هذا الأمر”([2]).
والتفكُّر في أسماء الله وصفاته وعظيم خلقه هو الذي يورث المراتب العالية في تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، قال ابن القيم: “معرفة الله سبحانه نوعان: معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، والثاني: معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه؛ وهذه هي المعرفة الخالصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه، وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم، وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها، وقد قال أعرف الخلق به: «لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك»، وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن.
ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها، والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة، وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه، وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها، وتفرده بذلك، وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيهًا في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم”([3]).
وحرصًا من مركز سلف للبحوث والدراسات على تقرير مذهب أهل السنة والجماعة، وإبراز محاسن هذه العقيدة الصافية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والبعيدة عن تأويلات المتكلِّمين وتخرُّصات الصوفية والباطنية، كانت هذه الورقة العلمية التي تتناول مسألة من المسائل التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى، وضلَّ فيها أقوام بالتأويل، وهي مسألة حجاب الله سبحانه وتعالى، وفيها يقدِّم مركز سلف بيانا لمذهب أهل السنة والجماعة في الحجاب، كما يعرض الآراء المخالفة ويضعها في الميزان العلمي.
مركز سلف للبحوث والدراسات
أولا: أدلة الحجاب:
ورد الحجاب في عدّة نصوص شرعية من القرآن ومن السنة، منها:
1- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الشورى: 51].
2- قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15].
3- قوله تعالى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} [الأعراف: 143]، قال ابن تيمية: “وأيضًا فذكره لتجليه للجبل يدل على أنه كان محتجبًا فتجلى”([4]).
4- عن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: «يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟» قلت: يا رسول الله، استشهد أبي، وترك عيالا ودينا، قال: «أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟» قال: بلى يا رسول الله، قال: «ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال: يا عبدي، تمنَّ عليَّ أُعطِكَ»([5]).
5- عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: «إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور –وفي روايةٍ: النار-، لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»([6]).
6- عن صهيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة»، قال: «يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟! ألم تدخلنا الجنة وتنجِّنا من النار؟!» قال: «فيكشف الحجاب، فما أُعطُوا شيئا أحبَّ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل»([7]).
7- عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو وسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دُونَ اللَّهِ سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ، وَسَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ، وَمَا مِنْ نَفْسٍ تَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ حَسِّ تِلْكَ الْحُجُبِ إِلَّا زَهَقَتْ نَفْسُهَا»([8]).
قال ابن تيمية عن هذا الحديث: “وأما الخبر الثاني الذي ذكر أنه مروي في الكتب المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله سبعين حجابًا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدركه بصره فهذا الحديث لا يوجد في شيء من دواوين الإسلام فضلًا عن أن يكون في الكتب المشهورة”([9]).
الحجاب مخلوق من مخلوقات الله، ورد في الشرع كونُه من نور أو نار، وإِضافته إلى الله إضافة تشريف.
ولا منافاة بين كونه نورًا ونارًا، فالنار نورٌ كما قال ابن الموصلي وهو يختصر كلام ابن القيم رحمه الله: “النص قد ورد بتسمية الربّ نورا، وبأن له نورًا مضافًا إليه، وبأنه نور السماوات والأرض، وبأن حجابه نور، هذه أربعة أنواع… والرابع كقوله: «حجابه النور» فهذا النور المضاف إليه يجيء على أحد الوجوه الأربعة، والنور الذي احتجب به سمِّي نورًا ونارًا، كما وقع التردّد في لفظه في الحديث الصحيح، حديث أبي موسى الأشعري وهو قوله: «حجابه النور -أو: النار–»، فإن هذه النار هي نور، وهي التي كلم الله كليمه موسى فيها، وهي نار صافية لها إشراق بلا إحراق، فالأقسام ثلاثة: إشراق بلا إحراق كنور القمر، وإحراق بلا إشراق وهي نار جهنم، فإنها سوداء محرقة لا تضيء، وإشراق بإحراق وهي هذه النار المضيئة وكذلك نور الشمس له الإشراق والإحراق، فهذا في الأنوار المشهودة المخلوقة، وحجاب الرب تبارك وتعالى نور وهو نار، وهذه الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبها، فنور وجهه حقيقة لا مجاز، وإذا كان نور مخلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة فكيف يكون نوره الذي نسبة الأنوار المخلوقة إليه أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس؟! فكيف لا يكون هذا النور حقيقة؟!”([10]).
الإيمان بأن لله خلقا من نار أو نور، وهو حجاب له سبحانه وتعالى كما ورد في النصوص الصحيحة الصريحة، ونور هذا الحجاب نور مخلوق ليس هو نور الله سبحانه وتعالى.
ولا يُخاض في صفات الحجاب مما لم يرد في الشرع، بل يجب الإثبات والتسليم، قال الدارمي: “من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها؟! ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا؟!”([11]).
رابعا: مسائل متعلقة بالحجاب؟
1- الحجاب رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: «نورٌ، أنى أَراه؟!»([12])، ولو كان هذا النور هو نور الله سبحانه وتعالى لكان قد رأى الله.
وفي تقرير هذا يقول ابن القيم رحمه الله: “فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: معناه: كان ثَمَّ نور، أو حال دون رؤيته نور فأنى أراه؟! قال: ويدلّ عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نورًا»… ويدل على صحة ما قاله شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: «حجابه النور». فهذا النور هو -والله أعلم- النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه: «رأيت نورا»“([13]).
وقال رحمه الله أيضًا: “وفي صحيح مسلم بأن أبا ذر سأله: هل رأيت ربك؟ فقال: «نورٌ أنى أراه؟!»، وفي صحيح مسلم أيضًا من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»، وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المقدَّم، وهو كالتفسير له”([14]).
وقال ابن أبي العزّ رحمه الله: “حَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي كِتَابِهِ (الشِّفَا) اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي رُؤْيَتِهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْكَارَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنْ يَكُونَ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنِ رَأْسِهِ… وَقَالَ جَمَاعَةٌ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها… وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربَّه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه. ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نصّ، والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحقّ، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة؛ إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نصّ بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدلّ على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه؟!»، وفي رواية: «رأيت نورا». وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام…». فيكون -والله أعلم- معنى قوله لأبي ذر: «رأيت نورا»: أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله: «نور أنى أراه؟!»: النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، «فأنى أراه؟!» أي: فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟! فهذا صريح في نفي الرؤية. والله أعلم”([15]).
2- المسائل المقترنة بالحجاب، وأعني: أن علماء أهل السنة كثيرًا ما يقرنون الكلام عن الحجاب بهذه المسائل، وهي:
- الرؤية، وهو ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: «يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟!» قال: «فيكشف الحجاب، فما أُعطُوا شيئًا أحبَّ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل»([16]).
- نور الله سبحانه وتعالى، فالحجاب نوره مخلوق، وهو يختلف عن نور الله سبحانه، يقول ابن تيمية: “فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أن له حجابًا من النور أو النار، وهذا ليس هو نور وجهه الذي لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه”([17]).
- أن الله بائن من خلقه، يقول الدارمي: “ففي هذا أيضا دليل أنه بائن من خلقه، محتجب عنهم، لا يستطيع جبريل -مع قربه إليه- الدنو من تلك الحجب، وليس كما يقول هؤلاء الزائغة: إنه معهم في كل مكان، ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى؛ لأن الذي هو في كل مكان، لا يحتجب بشيء من شيء، فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه؟! فليس لقول الله عز وجل: {مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ} [الشورى: 51] عند القوم مصداق”([18]).
3- ممن بوَّب للحجاب ونقل فيه نصوصا:
- أبو سعيد عثمان الدارمي (ت: 280هـ) في كتابه (الرد على الجهمية)([19]).
- ابن أبي يعلى (ت: 458هـ) في كتابه (إبطال التأويلات)([20]).
خامسا: آراء ونقاش حول الحجاب:
ذهبت الأشاعرة إلى تأويل الحجاب، وأنه ليس بحجاب مخلوق بين الله وخلقه، وأولوه بتأويلات عديدة، ومن ذلك:
1- القول بأن الحجاب هو حَجبُ المخلوق عن الخالق:
أي: لا يوجد حجاب حقيقيّ، بل هو أمر عدميّ.
وتأويلهم للحجاب مبنيّ على نفيهم لصفة للعلوّ، ونفيهم الجهة، ولتوهُّمِهم أن ذلك يقتضي التجسيم كما توهَّموا في سائر الصفات، قال ابن فورك (ت: 406هـ): “اعلم أن كل ما ذكر فيه الحجاب من أمثال هذا الخبر فإنما يرجع معناه إلى الخلق؛ لأنهم هم المحجوبون عنه بحجاب يخلقُه فيهم، لا يجوز أن يكون الله عز وجل محتجبًا ولا محجوبًا لاستحالة كونه جوهرًا أو جسمًا محدودًا؛ لأن ما يستره الحجاب أكبر منه، ويكون متناهيًا محاذيًا جائزا عليه المماسة والمفارقة، وما كان كذلك كانت علامات الحدث فيه قائمة، وذلك أن الموحِّدين إنما توصَّلوا إلى العلم بحدث الأجسام من حيث وجدوها متناهية محدودة محلًّا للحوادث، فكان تعاقبها عليها دليلا على حدثها، ولن يجوز أن تقوم دلالة الحدث على القديم الذي لم يزل موجودًا، وإذا كان هذا الأصل صحيحًا بما كشفنا عنه وجب أن يحمل ذلك على النوع الذي بيناه وقررناه، ويشهد لذلك ويؤيِّده قوله عز وجل: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15]، فجعل الكفار محجوبين عن رؤيته بما خلق فيهم من الحجاب والمنع منها، ولم يصف نفسه بالاحتجاب ولا بأنه هو المحجوب”([21]).
وقال القاضي عياض (ت: 544هـ): ” قال الإمام [أي: المازري]: الهاء في «وجهه» تعود على المخلوق لا على الخالق، إذ الحجاب بمعنى الستر إنما يكون على الأجسام المحدودة، والباري -جلت قدرته- ليس بجسم ولا محدود، والحجاب في اللغة: المنع، ومنه سمي المانع من الأمير حاجبا؛ لمنعه الناس عنه، ومنه الحاجب في الوجه؛ لأنه يمنع الأذى عن العين، والإنسان ممنوع من رؤية الخالق في الدنيا، فسمّى منعه حجابا، ولما كان النور والنار مانعين في العادة من الإدراك -وهما من أشرف الأشياء المانعة- أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو كشف عن النار والنور المانعين من الإدراك في العادة لأحرقت وجوه المخلوقين، وإن الباري سبحانه لا تقابله الأنوار وتقابل المخلوقين وتمنعهم من الرؤية”([22]).
وقال النووي (ت: 676هـ): ” وأما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر، وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة، والله تعالى منزَّه عن الجسم والحدّ، والمراد هنا المانع من رؤيته، وسمّي ذلك المانع نورًا أو نارًا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما”([23]).
ويقول بدر الدين ابن جماعة (ت: 733هـ): “اعْلَم أَن كل مَا جَاءَ فِي الحَدِيث من الْحجاب أَو الْحجب فَمَعْنَاه رَاجع إِلَى الْمَخْلُوق لَا إِلَى الْخَالِق تَعَالَى؛ لأَنهم هم المحجوبون عَنهُ بحجاب خلقه لَهُم، وَأما الرب تَعَالَى فيستحيل أَن يكون محتجبًا أَو محجوبًا لِأَنّ الْحجاب أكبر من المحجوب، وَإِلَّا لم يستره، وأصل الْحجب الْمَنْع، وَمعنى حجب الْكَافرين عَن رُؤْيَته مَنعهم من رُؤْيَته”([24]).
2- أن الحجاب هو منع الرحمة:
وقد ذكر ابن أبي يعلى بعض التأويلات ورد عليها، منها ما ذكرته في النقطة الأولى، وكذلك هذه، قال ابن أبي يعلى: “اعلم أنه غير ممتنع إطلاق حجاب هو نور من دون الله، لا على وجه الإحاطة والحد والمحاذاة، كما أجزنا رؤيته سبحانه لا على وجه الإحاطة به والجهة والمقابلة، وإن كنا لا نجد في الشاهد مرئيا إلا في جهة المقابلة، وكما جاز إطلاق وصفه بالاستواء على العرش لا على وجه الجهة والحد والانتقال، وكما قال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ} [الأنعام: 30]، فأثبت الوقوف عليه لا في جهة، ويعضد ذلك قوله: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الشورى: 51]، فوصف نفسه بالحجاب كذلك ههنا.
فأما قوله: «كل شيء أدركه بصره من خلقه» معناه: أن نور وجهه يحرق ما يدركه من خلقه. وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة في كتاب (الإبانة) قال: أبو بكر عبد العزيز قال: أبو بكر أحمد بن هارون قال: سألت ثعلبا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لأحرقت سبحات وجهه» فقال: السبحات: يعني من ابن آدم الموضع الذي يسجد عليه.
فإن قيل: الحجاب راجع إلى الخلق؛ لأنهم هم المحجوبون عنه بحجاب يخلقه فيهم، وهو عدم الإدراك في أبصارهم، ولا يجوز أن يكون الله سبحانه محتجبًا ولا محجوبًا بحجاب لأن ما ستر بالحجاب، فالحجاب أكبر منه ويكون متناهيا محاذيا جائزا عليه المماسة، ومنه قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15] فجعل الكفار محجوبين عن رؤيته لما خلق فيه من الحجاب، ويبين هذا أنه لم يضف الحجاب إلى الله تعالى بل أطلق ذكر الحجاب.
ويبين صحة هذا ما روى علي -كرم الله وجهه- رواه عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ أنه مر بقصّاب وهو يقول: لا والذي احتجب بسبعة أطباق، فقال علي رضي الله عنه: (ويحك يا قصاب! إن الله لا يحتجب عن خلقه)، وفي لفظ آخر: (إن الله لا يحتجب عن خلقه بشيء، ولكن حجب خلقه عنه).
قيل: هذا غلط، لما بينا أننا نثبت حجابا لا يفضي إلى التناهي والمحاذاة والمماسة، كما أثبتنا رؤيته لا على وجه التناهي والمحاذاة وقوله: (لم يضف الحجاب إليه) غلط لأن في حديث أبي موسى: «حجابه النور» وهذا صريح في الإضافة.
وأما قوله: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} فلسنا نمنع أن يكونَ الخلق في حجاب عن ربهم، ولا نمنع أن يكونَ دونه حجاب من نور لورود الشرع بذلك، فليس في الآية ما ينفي ذلك، وأما ما روي عن علي فإنما أنكر على القصاب حجابا معقولا، لأن القصاب قال: احتجب بالسموات، فرجع الإنكار إلى ذلك، ونحن لا نصف الحجاب بذلك، وعلى أنه يعارض قول عليّ ما ذكره أحمد بن سليمان النجاد بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: (والذي نفسي بيده، إن دون الله يوم القيامة سبعون ألف حجاب، إنَّ منها حجابًا من ظلمة ما ينفذها شيء، وإن منها لحجابا من نور ما يستطيعه شيء، وإن منها حجابا لا يسمعها أحد لا يربط الله على قلبه إلا انخلع فؤاده).
فإن قيل: قوله في حديث ابن سمرة: «بينه وبين الرب حجاب» المراد به حجاب العبد من رحمة الرب، يعني أنه كان ممنوعا من الرحمة، وقوله: «أدخله على ربي» معناه: في رحمة ربي، قيل: من سبق في عمله أنه يرحمه لم يجعل بينه وبين رحمته حجاب، وكذلك من سبق في عمله عذابه لا يجعل بينه وبين العذاب حجاب.
وأما تأويلهم الدخول على الدخول في الرحمة فلا يصحّ كما لم يصح تأويل قوله: «ترون ربكم» على رؤية رحمته.
فإن قيل: قوله: «لو كشفها عن وجهه» معناه: لو كشف رحمته عن النار، «لأحرقت سُبُحات وجهه» أي: أحرقت محاسنَ وجه المحجوب عنه بالنار، فالهاء عائدة على المحجوب لا إلى الله تعالى، قيل: قد بينا أن السبحات صفة لوجهه سبحانه، وأن الإحراق يكون لجميع ما يدركه نوره.
فإن قيل: لا يصح أن يكون المحدث ولا القديم محجوبا بشيء من سواتر الأجسام المغطية المكتنفة المحيطة، وإنما يقال لهذه الأجسام الساترة: إنها حجاب عن رؤية المحدث لما رآه، من أجل أن المنع من الرؤية يحدث عنده، فيسمى باسم ما يحدث عنده، وعلى هذا ما نقوله: إن البارئ سبحانه لا نراه في الدنيا لأنه في حجاب على طريق المجاز، وإنما المانع من رؤيته ما يحدثه من المنع، وإنما كان كذلك لأن المانع من معرفة الشيء ورؤيته ومعاينته ما يمنع من وجود معرفته ومعاينته، وما يمنع من ذلك فهو الذي يضادّ وجوده، وذلك لا يصح إلا في العرضين المتضادين المتعاقبين، ولا يصحّ أن يكون الجسم منها ولا مانعا من عرض أصلا؛ لأنه لا يصح أن يكون بين العرضين والجسم تناف وتضاد قيل: هذا لا يمنع من إطلاق اسم الحجاب على القديم سبحانه كما لا يمنع من إطلاقه على غيره، وإن كان هذا المعنى الذي ذكروه موجودا فيه”([25]).
3- أن الحجاب هو آيات لو ظهرت للمخلوق كانت معرفتهم به كمعرفة العيان:
يقول ابن فورك: “ومعنى الإضافة في الحجاب إليه من طريق الجعل والخلق، وهو أن جعل الخلق محجوبا به لأنه يحتجب به.
فإن قالوا: فعلى ماذا تحملون ما روي عن ابن عمر أنه قال: (احتجب الله من خلقه بأربع بنار وظلمة ونور وظلمه)؟ قيل: قد ذكر بعض أهل العلم في ذلك تأويل أن معناه: أن الله عرَّفنا نفسه بآياته ودلائله، فقال: له آيات لو ظهرت للخلق كانت معرفتهم به كمعرفة العيان كما ذكر في قوله سبحانه {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} [الشعراء: 4].
وقال محمد بن شجاع الثلجي: معنى قوله: (احتجب بالنار) أي: خلقها دون تلك الدلالات التي تبهر العقول وتدل على معرفته حتى تصير كمعرفة العيان، وهذا الخبر إذا حمل تأويله على ما ذكر الثلجي كان معنى الاحتجاب عن الخلق أنه جعل دلالة فوق دلالة، ودلالة أظهر من دلالة، ويرجع في التحقيق إلى ما قلنا أنه يحجب الخلق بما يخلقه فيهم من موانع المعرفة والربوبية، لا أنه يحتجب احتجاب استتار كالاستتار بالأجسام الحاوية لما يحيط بها ويكتنفها”([26]).
مناقشة هذه التأويلات:
رد ابن تيمية رحمه الله ردودًا طويلة على هذا القول([27])، وسأختصر كلامه على شكل نقاط حتى لا يطول البحث، فمن الأوجه التي ذكرها:
1- أن قولهم: إن الحجاب عَدَم خَلْقِ الرؤية أمرٌ عدميّ، والحجاب وصف بالنور وأنه يكشف، والعدمي لا يوصف بأنه يكشف.
2- ورد أنه بين المخلوقات وبين أن ينظروا إلى ربهم الحجابَ، فكيف يكون عدما؟!
3- لم يرد في اللغة تسميةُ العدم حجابا، فـ”تسمية مجرد عدم الرؤية مع صحة الحاسة وزوال المانع حجابًا أمر لا يعرف في اللغة، لا حقيقة ولا مجازًا؛ ولهذا لا يقال: إن الإنسان محجوب عن رؤية ما يعجز عنه مع صحة حاسته وزوال المانع وكالأشياء البعيدة، ولكن يقال في الأعمى: هو محجوبُ البصر؛ لأن في عينه ما يحجب النور أن يظهر في العين”([28])
4- قالوا: لا يقال هو محجوب، لأنه يشعر بالعجز والذلة، قال ابن تيمية: “وقوله: الحجب يشعر بالعجز والذل إنما ذاك إذا حجبه غيره كما في المثال الذي ذكره من قولهم: فلان حجب عن الدخول على السلطان، أما لو قيل: إن السلطان قد حجب نفسه أو وكّل من يحجبه أو جعل حاجبًا يحجبه لم يكن ذلك مشعرًا بالذلة والعجز بل بالقوة؛ ولهذا يسمون الذي يحجبهم من الناس حاجبًا ويقولون: إنه يحجب الأمير، وسُمّي حاجب العين حاجبًا لأنه يحجب العين”([29]).
5- قول القائل: فهم محجوبون عنه بحجاب يخلقه فيهم وهو عدمُ الإدراك في أبصارهم كلام باطل؛ لأن العدم لا يخلق([30]).
6- وصف الحجاب بالنار والنور، ولا يوصف العدم بذلك([31]).
7- قال: «حجابه النور –أو: النار- لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه»، ولو كان الحجاب عدمَ خلق الرؤية لم يكن كَشفُ ذلك -وهو خلق الرؤية في العبد- يحرق شيئًا من الأشياء؛ فإن المؤمنين إذا رأوا ربّهم في عرصات القيامة ثم رأوه في الجنة مرة بعد مرة لا يُحْرَقُ شيء من الوجه”([32]).
8- قولهم: لا يضاف الحجاب إلى الله لأن هذا يلزم منه كونه جسما، يقال: ” هذا بعينه وارد في كل ما يضاف إلى الله عز وجل من أسمائه وصفاته”([33]).
9- الحجاب مانع من الرؤية بلا نزاع، ومعلوم أن المانع من الشيء لا يكون عينَ عدمِه، فإن مجرد عدم الشيء ليس مانعًا من وجوده؛ إذ المانع لا يعقل مانعًا إلا عند وجود المقتضي لوجود الشيء، والعدم ليس بشيء أصلًا حتى يكون مانعًا، ولو كان عدم الشيء مانعًا من وجوده لما وجد شيء من المحدثات؛ لأن عدمها سابق على وجودهاـ فعلم أنه لا بد أن يكون الحجاب المانع من الرؤية شيئًا غير عدم خلق الرؤية، فإن كان ذلك محالًا لم يكن للرؤية مانع أصلًا، فكان يجب رؤية الله عز وجل عند صحة البصر وسلامته؛ لأن المقتضي موجود والمانع مفقود كما في رؤية سائر الأشياء([34]).
10- قال الله: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الشورى: 51]، والعدم لا وراء له ولا قدام([35]).
11- أنه حملٌ للفظ على ما لا تحتمله اللغة بوجه من الوجوه، وهو تبديلٌ للغة كما أنه تبديل للقرآن وتحريف له.
12- أن ألفاظ الحديث صريحة في الحجاب المانع من الرؤية كقوله صلى الله عليه وسلم: «فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئًا أحبَّ إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة»، وفي رواية: «فيتجلى لهم»، ولا يجوز تفسير النظر هنا بالإحسان لقوله: «فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» ولأن اقتران كشف الحجاب بالنظر صريح في الرؤية، وكذلك قول: «وما بين قوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» هذا صريح في أنه حجاب مانع من النظر لا من الإحسان([36]).
وأخيرا:
فالحجاب مخلوق من مخلوقات الله، ونوره ليس بنور الله، بل هو نور مخلوق، ولا نخوض في تفاصيل هذا المخلوق، ولا نؤوّله، ولا ننفيه، بل نثبته كما أثبته الكتاب والسنة، وكما اقتضاه المنهج السليم الذي سار عليه أهل السنة والجماعة.
والحمد لله ربّ العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([2]) الفتوى الحموية الكبرى (ص: 183).
([4]) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (8/ 82).
([5]) أخرجه الترمذي (3010)، وابن ماجه (190)، وحسنه الألباني في التعليقات الحسان (6983).
([8]) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (788)، وأبو يعلى (7525)، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (13/ 1142).
([9]) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (8/ 99).
([10]) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 423).
([11]) الرد على الجهمية -ت: الشوامي- (ص: 75).
([13]) اجتماع الجيوش الإسلامية (2/ 47-49).
([14]) التبيان في أقسام القرآن (ص: 256).
([15]) شرح الطحاوية -ط: الأوقاف السعودية- (ص: 163).
([17]) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ 490).
([18]) الرد على الجهمية -ت: الشوامي- (ص: 75).
([19]) الرد على الجهمية -ت: الشوامي- (ص: 73 وما بعدها).
([20]) إبطال التأويلات (ص: 271 وما بعدها).
([21]) مشكل الحديث وبيانه (ص: 213-214).
([22]) إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 535).
([24]) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص: 188).
([25]) إبطال التأويلات (ص: 276-279).
([26]) مشكل الحديث وبيانه (ص: 216-217).
([27]) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (6/ 335-336).
ثم مطولا في: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (8/ 82-163).
([28]) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (8/ 123).
([29]) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (8/ 119-120).
([30]) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (8/ 121).
([31]) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (8/ 121).
([32]) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (8/ 122).
([33]) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (8/ 124).
([34]) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (8/ 125).