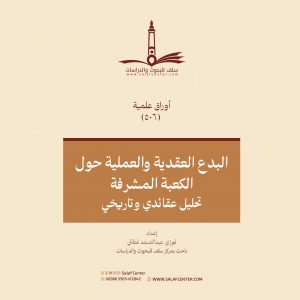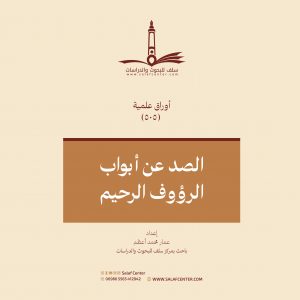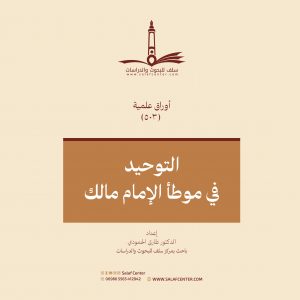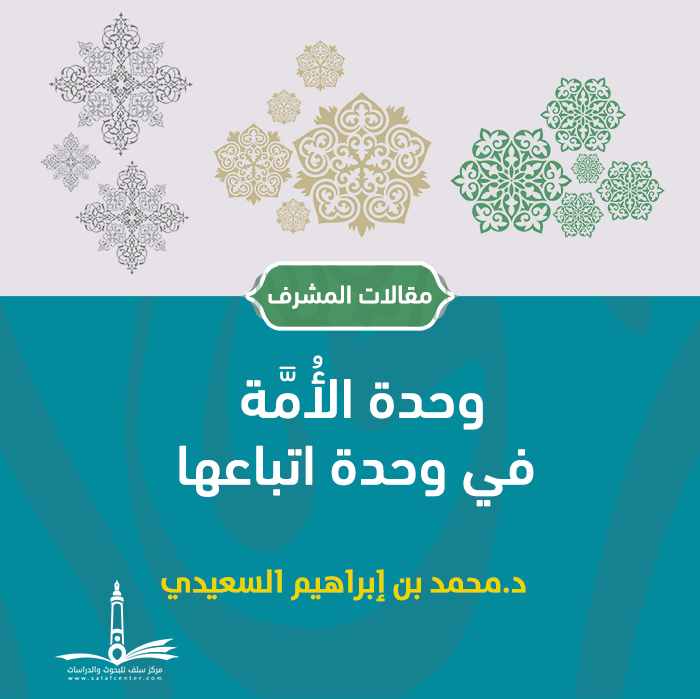
وحدة الأُمَّة في وحدة اتباعها
تابعت كملايين المسلمين خطبة يوم عرفة والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس شؤون الحرمين([1])، وكانت كما هو المتوقع من فضيلته جامعة مانعة نافعة مظهرة لحقيقة الإسلام الذي كادت البدع والأهواء والتحزبات أن تلقي به خلف ظهرها وتخفيه عن العالمين، لولا لطف الله –عزَّ وجلَّ– وإظهاره دينه ولو كره المجرمون.
وأبرز المعاني التي تضمنتها هذه الخطبة، هو المعنى الذي استطلعها به الشيخ، وهو معنى عظيم يستحق لو أن الحديث عنه استغرق الخطبة بأسرها، وهو معنى وحدة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الوحدة التي لن تقوم للأمة قائمة ما لم تلتفت إليها كما ينبغي أن يكون الالتفات، وهو وحدة اتِّباعها لكتابها وسنة نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام.
ذلك أن من القواعد المُسَلَّمَة عند أكثر الفرق المنتسبة إلى الإسلام من حيث التنظير وإن كان كثير منهم عمليًا يجنح عنها دون مبالاة: أن الدين الذي بعث الله به جميع الأنبياء -عليهم السلام- من لدن نوح حتى نبينا محمد واحدٌ في أصوله التي لا يصح أن تختلف فيها الأديان من استحقاقه العبادة وحده، وكمال ربوبيته في الكون، وتفرده -سبحانه- بالخلق والرزق، واتصافه بجميع صفات الكمال، وتنزهه عن جميع صفات النقص، ووجوب الإيمان بما أخبر به -سبحانه- من الغيب، وأن شرائعه التي ابتعث بها الأنبياء -وإن اختلفت فيما بينها- فهي متضمنة أكمل المقاصد وأوفاها بحاجة العبد لعمارة دنياه وآخرته، كما نص عليه قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} [الشورى: 13]، فهذه الآية نصٌ في وِحْدَةِ الدين الذي جاءت به الرُّسُل، ونصٌ في حُرْمَة التفرق فيه، أي التفرق في إقامته، فيقيمه بعض الناس على الوجه الذي أراده الله تعالى وهم أهل الحق، ويقيمه آخرون على غير ما أراده الله؛ إما بزيادة فيه كمن قال تعالى عنهم: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: 21]،
أو بنقصان منه كمن قال تعالى فيهم: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ } [المائدة: 14].
أو بتأويل كلام الله على غير ما تحتمله معانيه؛ ليأخذوا منه ما يوافق أهواءهم ويردوا ما يخالفها، {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ} [النساء: 46]، قال ابن عاشور: “فهو على هذا تحريفُ مراد الله في التوراة إلى تأويلات باطلة، كما يفعل أهل الأهواء في تحريف معاني القرآن بالتأويلات الفاسدة”([2]).
فهذا هو التفرق في الدين، وهو لا يقل ضررًا عن التفرق عن الدين، أي تركه بالكلية إلى أديان أخر على الأمة، بل ربما كان التفرق في الدين أضر على الأمة من التفرق عن الدين؛ لأن التفرق فيه أشد إضعافًا لأهله، وأقدر على إثارة الشحناء والبغضاء بينهم.
ولذلك كثُرت الآيات التي تؤكد وحدة الطريق إلى الله تعالى وحرمة التفرق عنها: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: 108].
فالسبيل كما نصت الآية: الطريق إلى الله -عزَّ وجلَّ- وهو واحدٌ غير متعدد، قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 153]، فبينت هذه الآية بالدلالة القطعية التي لا يختلف في فهمها اثنان: أن الطريق إلى الله واحدٌ غير متعدد، وأن ما سوى هذه الطريق سُبُلُ ضلال لا تُجدي شيئًا سوى إبعاد الناس عن الطريق الذي اختاره الله لعباده وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم- بالدَّعوَة اليه؛ حيث قال عزَّ من قائل عليمًا: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [النحل: 125].
فأكدت هذه الآية أن السبيل واحدٌ، وأن من تجاوزه فقد ضلَّ، وأن من لزمه فقد اهتدى.
وهذا المعنى مُتَكَرِّر في القرآن على وجه يتعذَّر معه صرفه عن معناه البيِّن، بأي طريق من طُرُق صرف المعاني عن ظواهرها.
وَمِنْ رَحْمَتِه -عزَّ وجلَّ- بعباده: أنه حين ألزمهم بطريق واحد وشدَّد على هذا الإلزام، أوضح لهم هذه الطريق بالقوة والوضوح والقطعية التي فرضها الله بها عليهم.
فجاءت تسمية الطريق الصحيح الذي تُعرف بها السبيل الواحدة عن الله -سبحانه- وتعالى في كتابه الذي لا ريب فيه {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2]، {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص: 29]، {قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الزمر: 28].
فقد أخبر الله عن كتابه أنه عربي، وأنه غير ذي عوج، أي: لا ميل فيه ولا انحراف، فدلالاته على مراد الله -سبحانه- وتعالى واضحةٌ لا تحتاج في فهمها ولا إيضاحها إلى تأويلٍ أو تحريف.
فالكل قادر على فهمه بشرط أن يتدبره، أي: يتأمل فيه ويتفكر.
ومع كل هذا الوضوح في دلالات القرآن، فقد قسمه المولى -عزَّ وجلَّ- إل محكم ومتشابه؛ لحكمة أرادها الله -عزَّ وجلَّ-، فقال -سبحانه-: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 7].
فالمحكمات هي: أصول الدين التي يتضح بها السبيل الذي أراد الله -عزَّ وجلَّ- من عباده اتباعه.
ومنها: الآيات الدالة على معرفة الله -عزَّ وجلَّ- بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والآيات الدَّالة على ما أراد الله لنا معرفته من الغيب؛ كالبعث والنشور واليوم الآخر والحساب والجنة والنار والملائكة والكتاب والنبيين، وعلمُه -سبحانه- وقدرُه وتصرُّفه في ملكه، وحاجة العباد إليه وافتقارهم إلى جنابه وعجز من سواه أمام قدرته، كل ذلك أوضحه القرآن بالآيات المحكمات التي لا يختلف في فهمها المؤمنون الموحدون المُسَلِّمُون لله -عزَّ وجلَّ- المُسْتَسْلِمُون لأوامره ونواهيه، كما قال سبحانه: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 112]، ودلَّ القرآن في الآيات المحكمات غير المتشابهات على وحدة هذه الأمة وعلى مهمتها الأولى في هذه الحياة، وهي عبادته دون من سواه {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 92].
أما الآيات المتشابهة فهي تلك الآيات التي يحرم الأخذ بها منفردة دون ردِّها للآيات المحكمة، وإذا تم ردُّها للمحكمات وتفسيرُها من خلالها اتضح أن دلالتها لا تخالف دلالة المحكم، وإذا عجز المسلم عن ردِّ المتشابهات إلى المحكمات وجب عليه التسليم والإيمان دون تكلُّف تفسيرٍ يخرج به عن دائرة السُّنة واتباع الجماعة، وهذا هو منهج الراسخين في العلم الذين {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]، أي: هذا القرآن بما احتواه من محكمات ومتشابهات هو من عند الله ولا يسعنا حين نعجز عن الكشف عن مدلولات متشابهاته إلا الوقوف والتسليم.
وأما مرضى القلوب فإنهم يتعلَّقون بالآيات المتشابهات؛ بدعوى البحث عن التفسير وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: 7]؛ ليضربوا بها الآياتِ المحكمات، فتقع الفتنة ويقع الاختلاف.
وهذا عين ما حصل لأهل الكتاب، فقد جاءتهم البَيِّنة، أي: الدلالة الواضحة المحكمة، ولكنهم بَغو، أي: تجاوزوا حدهم في تقدير ذواتهم، ولم يُسَلِّموا لله -عزَّ وجلَّ- فتفرقوا واختلفوا في دينهم.
ولأهمية التجربة التاريخية التي مرَّ بها أهل الكتاب، وضرورة الاعتبار بها والاستفادة من أخطائهم فيها، كرَّر القرآن الحديث عنها في أكثر من موضع من كتابه الكريم، بل أفرد -سبحانه- لها إحدى قصار السور، وهي سورة البَيِّنة {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} [البينة: 4].
لكنهم حين تجاوزوا هذه الدَّلالات القاطعة الواضحة إلى الدَّلالات التي تُسوِّلها لهم أنفسُهم وأهواؤُهم تفرَّقوا واختَلفوا {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [البقرة: 213].
فكل خلاف في الدين الذي اتَّفقت على المجيء به الرسل بغيٌ، كما نصت عليه الآية السابقة، وكما في قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [آل عمران: 19]
ـــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) وذلك في حج عام 1437ه، حيث مرض فيها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية فناب الشيخ عبد الرحمن السديس عنه.