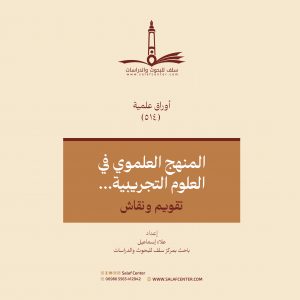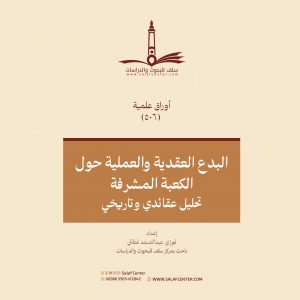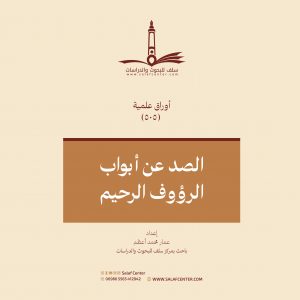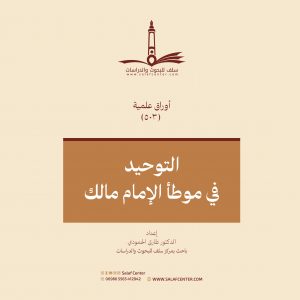الأحكام الشرعية لأحاديث جوامع الكلم
لقد من الله على الإنسان من بين المخلوقات بنعمة البيان، وأعطى لجنس العرب منها ما لم يعط لغيرهم، فكانوا يعبّرون عن المعاني بأحسن عبارة وأوجزها، ويتفنَّنون في ذلك، فكانت الفصاحة شعارَهم والبلاغةُ ديْدَنَهم، وخصَّ الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجز من البيان بإنزال الوحي عليه الذي لم يستطع العرب له محاكاةً؛ فأذعنوا لعبارته، ووقفوا منكسِرين أمام سَطوته، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم في كلامه فصيحًا، يعرف ذلك كلُّ من سمع كلامه وخُطَبه، وكان في اللّسان مقدَّمًا.
ومن هنا جاء الاعتناء بالعبارات النبوية، سواء في غريبها أو في معناها، وكان التشريعُ محطَّ أنظار جميع أهل الاختصاص، وهم متواطئون متواترون على الإشادة بها؛ وأنها في منتهى الإعجاز، قال يونس بن حبيب رحمه الله: “ما جاءَنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم”([1]).
ومن روائع الكلم جوامعُه التي يجمع فيها المعنى الكثير باللفظ الوجيز، وهي منه صلى الله عليه وسلم ليست للتبارِي والتفاصح، بل هي تشريعاتٌ وقواعد كلِّيَّة تؤسِّس لأمهات الأخلاق ومحاسن العادات وكلِّيَّات الشرع.
وهذه مدارسةٌ عجلى لها؛ تبيِّن أهمَّ أحكامها وما ينبغي اعتقاده فيها شرعًا، فهي ألفاظ نبويَّة تعبُّديّة، لا يليق بالمؤمن التكلُّم بها إلا على الوجه الذي نطق به الشارع، وهي من خصوصيَّات النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: «بُعِثتُ بجوامع الكَلِم، ونُصِرت بالرعب، فبينا أنا نائم أُتِيت بمفاتيح خزائن الأرض، فوُضعت في يدي»([2]).
معنى جوامع الكلم:
تكلم العلماء في معنى جوامع الكلم، واختلفوا في تحديدها، فكلٌّ منهم عبر عن مراده بما لا يتنافى مع قول صاحبه عند التأمُّل، قال ابن شهاب: “وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين، أو نحو ذلك”([3]).
وقد أحسن البيهقيُّ الجمعَ بين الأقوال حين علَّق على الحديث فقال: “والظاهر أنه أراد به القرآن، وعلى ذلك يدلُّ سياق الحديث الذي عن عمر في ذلك، وقد حمله الحليمي رحمه الله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محتمل… عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُعطيت فواتحَ الكلام، وخواتمه، وجوامعه»، فقلنا: يا رسول الله، علِّمنا مما علَّمك الله، فعلَّمَنا التشهّدَ في الصلاة، قال الحليمي رحمه الله: ويقال: إن من جوامع الكلم قوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يعلِّمه ما يدعو به: «سل ربك اليقين والعافية»؛ وذلك أنه ليس شيء مما يعمل للآخرة يتقبل إلا باليقين، وليس شيء من أمر الدنيا يهنأ صاحبه إلا بالأمن والصحة وفراغ القلب، فجمع أمر الآخرة كلَّه في كلمة واحدة، وأمر الدنيا كلَّه في كلمة أخرى”([4]).
وقال المناوي: “ومعنى «أُعطيت جوامع الكلم» أي: مَلَكة أَقتِدرُ بها على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى، بنظم لطيف، لا تعقيدَ فيه يعثر الفكر في طلبه، ولا التواء يحار الذهن في فهمه، «واختُصِر لي الكلام اختصارًا» أي: صار ما أتكلَّم به كثيرَ المعاني قليل الألفاظ”([5]).
اهتمام العلماء بجوامع الكلِم:
لقد اهتمَّ العلماء بأحاديث جوامع الكلم فأفردوها بالتأليف والتنصيص، فمنهم من تأمَّلها فوجدها أصولًا للشرع كما هو صنيع الإمام أحمد وأبي داود، قال الإمام أحمد: “أصول الإسلام عَلَى ثلاثة أحاديث: حديث عمر: «الأعمال بالنيات»، وحديث عائشة: «من أحدث فِي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وحديثُ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ: «الحلال بيِّن، والحرام بيِّن»“([6]).
وقد جعل الإمام أحمد بعضها أصول الأحاديث، فعن عبد الله بن أحمد، عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: «الأعمال بالنيات» وقوله: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما» وقوله: «من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد»، فقال: ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الأحاديث”([7]).
ومثله صنيع أبي داود رحمه الله حيث قال: “نظرتُ في الحديثِ المسنَدِ فإذا هو أربعةُ آلافِ حديثٍ، ثمّ نظرتُ فإذا مدارُ الأربعة آلافِ حديث على أربعةِ أحاديث: حديث النُّعمان بنِ بشيرٍ: «الحلالُ بيِّن، والحرامُ بيِّنٌ»، وحديث عُمَر: «إنّما الأعمالُ بالنِّيَّات»، وحديث أبي هريرة: «إنّ الله طيِّبٌ لا يقبلُ إلاّ طيِّبًا، وإنَّ الله أمرَ المؤمنين بما أمرَ به المُرسلين» الحديث، وحديث: «مِنْ حُسنِ إسلامِ المرءِ تَركُهُ ما لا يعنيه»… فكلُّ حديثٍ مِنْ هذه ربعُ العلمِ”([8]).
ولا شك أنَّ أحاديث جوامع الكلم غيرُ محصورة في هذه الأحاديث، فبعضها أيضا جوامع للأخلاق كما بعضها جوامع للشرائع؛ ولكن في تنصيص العلماء على جعلها أصولا للدين وللأحاديث ما يشعر بأهميتها وخصوصيتها، وقد جمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم كتابا سماه: “الشهاب في الحكم والآداب”، وقد فصل الخطابي في أول كتابه “غريب الحديث” في الأحاديث الجوامع، وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه: “الأحاديث الكلية”، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال: إن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة، كما ألف الإمام النووي كتابه “الأربعين” المعروف بالأربعين النووية، وهو من أنفس كتب الجوامع، وقد لاقى قبولا بين الناس حفظًا وشرحًا وتدريسًا.
حكم رواية أحاديث جوامع الكلم بالمعنى:
القارئ لكتب الحديث يجد تحفُّظًا عامًّا عند أهل العلم في رواية الحديث بالمعنى، وحين أجازوها شرطوا لها شروطًا، من ذلك أن يكون الراوي عالما بالألفاظ وبدلالتها، وأن لا يكون متذكِّرا للَّفظ النبوي؛ فإن تذكره لزمه تبليغه، وقيل: بشرط أن لا تكون المسألة من باب العمل فيجب، قال الماوردي: “إن نسيَ اللفظ جاز؛ لأنه تحمَّل اللفظ والمعنى، وعجز عن أداء أحدهما، فيلزمه أداء الآخر، لا سيما أنَ تركه قد يكون كتمًا للأحكام، فإن لم ينسَه لم يجُز أن يوردَه بغيره; لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما ليس في غيره، وقيل عكسه، وهو الجواز لمن يحفظ اللفظ ليتمكَّن من التصرّف فيه دون من نسِيَه، وقال الخطيب: يجوز بإزاء مرادف. قيل: إن كان موجبه علما جاز؛ لأن المعول على معناه، ولا تجب مراعاة اللفظ، وإن كان عملا لم يجز”([9]).
إلا أنهم استثنوا من الرواية بالمعنى رواية أحاديث جوامع الكلم والأحاديث التعبدية كالتشهد وغيره، قال القاضي عياض: “ينبغي سد باب الرواية بالمعنى؛ لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظنُّ أنه يحسن، كما وقع للرواة كثيرًا قديمًا وحديثًا، وعلى الجواز الأولى إيراد الحديث بلفظه دون التصرُّف فيه، ولا شكَّ في اشتراط أن لا يكون مما تُعُبِّد بلفظه”([10]). قال السيوطي معلقا على كلام القاضي عياض: “قد صرح به هنا الزركشي، وإليه يرشد كلام العراقي الآتي في إبدال الرسول بالنبي وعكسه، وعندي أنه يشترط أن لا يكون من جوامع الكلم”([11]).
حكم رد أحاديث جوامع الكلم:
أحاديث جوامع الكلم هي أصول للتشريعات، أو تشريعات عامة ظاهرة في الشرع، دلَّت على معانيها نصوص تفصيليَّة مفردَة، لكن جمعت معاني هذه النصوص والشرائع في لفظ موجزٍ مؤدٍّ للمعنى جامعٍ له، فتجد في أحاديث جوامع الكلم القواعدَ الكليةَ للشرع، وفيها تحريمُ الدماء وتعظيم الشرائع وأصول التحليل والتحريم، ومن ثم لم يُستَسغ ردُّها ولا تكذيبها؛ لأنه كفرٌ وضلال، ولم يخرج أحد عن معنى من معانيها إلا ضلَّ وزلَّ وذلَّ، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يردّ مشدّهم على مضعفهم، ومتسرِّيهم على قاعدِهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»([12]) وغيره من الأحاديث المعظِّمة لدماء المسلمين؟! فهذا الحديث شذَّ عن معناه طائفتان:
الخوارج فلم يفوا لمسلم بعهدٍ، ولم يعظِّموا دمًا محرَّمًا، فضلُّوا وأضلُّوا.
وشذَّ عنه العلمانيون، فرأوا قتلَ المؤمن بالكافر، وسوَّوا بينهم طِبقًا لما تمليه الدولةُ الوطنيَّة؛ فهوَّنوا من عظمة الإسلام، وآل أمرُهم إلى القول بأنه لا يُقتل كافر بمسلم، ولا يغري بقولهم تمسُّكُهم بأقوال بعض أئمَّة الإسلام ممن قالوا بالقول لكنَّهم علَّقوه بشروط تخفِّف من مخالفة النصِّ أو تتمسَّك بما يصرفه عن ظاهره ولو ظنًّا.
وحين تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»([13]) تجد أن من لم يسلِّم بهذا المعنى فإنّه لا يثبُت له إسلام، ولا يستقرُّ له إيمان، وقِس على ذلك بقيَّةَ الأحاديث النبوية الجامعة.
والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) ينظر: البيان والتبيين (2/ 14).
([6]) ينظر: جامع العلوم والحكم (1/ 57، 70).
([8]) ينظر: طرح التثريب (5/ 2).
([9]) ينظر: تدريب الراوي (1/ 537).
([12]) أخرجه أبو داود (2751)، وصححه الألباني في الإرواء (7/ 265).