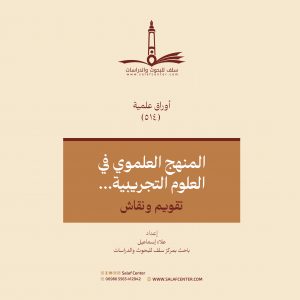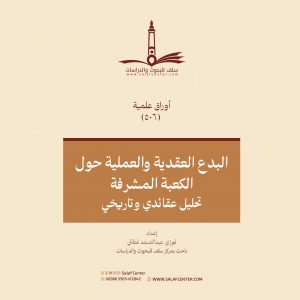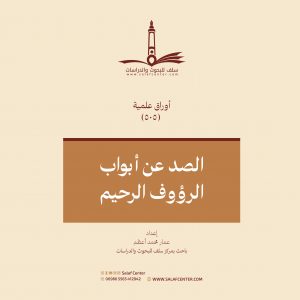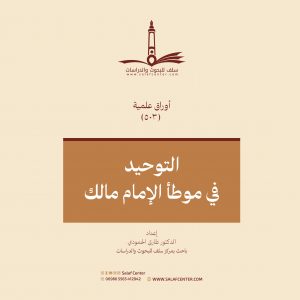مُحاكَمَة الملِحد إلى بَدَهيَّات العَقلِ
مِن مآزقِ العقل البشريِّ الحيرةُ في وجود الخالِق، وهي عَرَض مَرَضيٌّ يَدخُل في دائرة الوسوَسَة وليس في نطاق العِلم؛ لأنه في صورته النهائيَّة يعني الخروجَ بالإنسان من دائرة العَقل إلى الجنونِ، ومن هنا اقترحَ كثيرٌ من العقلاءِ معالجتَه على أنه ظاهرةٌ مَرَضِيّة، وليس ظاهرةً فِكريَّة أو علميَّة وإن حاول أصحابُه ذلك؛ لأنَّ الأعمى قد تراه ينظُر إليك وهو لا يُبصِر، وليس بأسوأَ حالًا من الملحد الذي تراه يفكِّر وهو لا يَعقِل؛ لأن الملحِدَ في حالته المرضيَّة لا يكتفي بمرضه المميت، بل يدعو إليه ويواجِه به بدهيَّات العقل ومسلَّمات الشرع وسنَنَ الكون والحياة، ثم يقول للناس: كونوا عبادًا لي من دونِ الله، فمؤدَّى قوله هو عبادةُ الإنسان لنفسه أو للطَّبيعة بحسب ما يمليهِ هواه.
ومِنَ المعلوم أنَّ الإلحادَ اليومَ له صورٌ متعدِّدة وكثيرة، فهناك مَن يشكِّك في وجود الخالقِ، فيدَّعي عدمَ قناعته بأدلَّة وجودِه لكنه لا يتجاوز ذلِك، ولا يقدِّم بدائِلَ ولا مقترحاتٍ للأجوبة الصَّحيحة، وهناك من ينفي وجودَ الخالِق ويحاول الاستغناءَ عنه بالعِلم والمادَّة، ويقدِّم أجوبةً يراها تشهَد لما يذهَب إليه، وتتبُّع تفاصيل الآراء لكلٍّ من الفريقين يَضيق المقام عن ذكرهِ، لكننا نقتصر على ما نراه مفيدًا للقارئ من تبيين مخالفةِ دعوى الملحِد لبدهيَّات العقل ولمسلَّمات الشرع.
تبيين بدهيَّات العقول:
لا يتنكَّر أهل الشريعة مطلقًا لوجود مصادرَ للمعلومات من غير الشريعة، وهي العقل والحس والتجربة وغيرها من مصادر المعرفة التي تتفاوت في يقينيَّة ما توصِل إليه، لكن يبقَى العقلُ حكمًا بين الناسِ قبل التجربةِ وعند من لا يؤمن بالوَحي؛ لأن وسيلةَ فهم كلام المتكلِّم هي العقل، فهو الذي يحدث النِّسَبَ بين التصوُّرات، فيحكُم بوجودِ الشيءِ أو عدمِه أو استحالته، وقد أودعَ الله في العقلِ بَدَهيَّاتٍ لا يستطيع الإنسانُ لها دفعًا، فلا تحتاج إلى البرهَنَة والإثبات، فتهجُم على العقلِ ولا بدَّ للإنسانِ أن يقبَلَها.
والبديهةُ: المعرفةُ يجِدها الإِنسانُ في نفسِه من غير إعمالٍ للفِكر ولا علمٍ بسَبَبها.
والبديهة قضيةٌ يُعترفَ بها ولا يُحتاج في تأييدها إلى قضايا أبسَط منها، مثل أنصاف الأشياء المتساوية([1])؛ ولذا تكلَّم العلماءُ عن أهمِّيَّتها وضرورتها في التفكير، يقول ابن حزم رحمه الله: “ما كان مُدرَكًا بأوَّل العقل وبالحواسّ فليس عليه استدلالٌ أصلًا، بل مِن قِبَل هذه الجِهات يبتدِئ كلُّ أحدٍ بالاستدلال، وبالردِّ إلى ذلك، فيصحُّ استدلالُه أو يبطل، وحدُّ العلم بالشيء -وهو المعرفة به- أن نقول: العلم والمعرفة اسمان واقعان على معنى واحدٍ، وهو: اعتقاد الشيء على ما هو عليه، وتيقُّنُه به، وارتفاع الشكوك عنه، ويكون ذلك إما بشهادةِ الحواسّ وأوَّل العقل، وإمَّا ببرهان راجعٍ من قُربٍ أو من بُعدٍ إلى شهادة الحواسّ أو أوَّل العقل”([2]).
وهذه البَدَهيّات هي التي تبدأُ منها العلوم وتنتهي إليها، فمن لم يسلِّم بها فإنَّه يضنّ على نفسه بالعقلِ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “البرهان الذي يُنال بالنظر فيه العلم لا بدَّ أن ينتهي إلى مقدِّمات ضرورية فطريَّة؛ فإنَّ كل علم ليس بضروريٍّ لا بد أن ينتهيَ إلى علم ضروريّ؛ إذ المقدِّمات النظرية لو أُثبِتَت بمقدِّمات نظريَّة دائمًا لزم الدَّورُ القبلي، أو التسلسل في المؤثِّرات في محلٍّ له ابتداء، وكلاهما باطل بالضَّرورة واتفاق العقلاء من وجوهٍ، فإن العلم النظريَّ الكَسبيَّ هو ما يحصل بالنظر في مقدّمات معلومةٍ بدون النظر؛ إذ لو كانت تلك المقدّمات أيضًا نظرية لتوقَّفت على غيرها، فيلزم تسلسل العلوم النظريَّة في الإنسان، والإنسان حادِث كائن بعد أن لم يَكن، والعلم الحاصِل في قلبه حادِثٌ، فلو لم يحصل في قلبه علمٌ إلا بعدَ عِلم قَبلَه لَلزِم أن لا يحصلَ في قلبه عِلمٌ ابتداءً، فلا بدَّ مِن علومٍ بَديهيَّة أوَّليّه يبتدئُها الله في قلبه، وغايةُ البرهان أن ينتهيَ إليها”([3]).
وتمتاز المبادئ العقلية بأمور منها:
أولا: استحالة نقضِها أو ردِّها بأيّ دليل نظري؛ لأن الضروريات هي أصل النظريات.
ثانيا: كونها مطلَقة غيرَ مدخولة بالشك أو التناقض؛ لأننا “إذا جوَّزنا أن يكون في البديهيات ما هو باطل، لم يُمكن العلمُ بأنَّ تلك البديهية المميِّزة بين ما هو صحيح من البديهيات الأولى وما هو كاذب مقبول التمييز، حتى يعلم أنها من القِسم الصحيح، وذلك لا يعلم إلا ببديهية أخرى مبيِّنة مميِّزة، وتلك لا يُعلم أنها من البديهيات الصحيحة إلا بأخرى، فيفضي إلى التَّسلسل الباطل، أو ينتهي الأمر إلى بديهيَّة مشتَبِهة لا يحصل بها التمييز، فلا يبقى طريقٌ يُعلم به الحقّ من الباطل، وذلك يقدَح في التمييز، والنظرياتُ موقوفة على البديهيات، فإذا جاز أن تكونَ البديهيات مشتبهة فيها حقٌّ وباطل، كانت النظريات المبنيَّة عليها أولى بذلك، وحينئذٍ فلا يبقى علمٌ يعرف به حقٌّ وباطل، وهذا جامع كل سَفسطة”([4]).
يقول الغزالي رحمه الله: “العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل؛ إذ يحكم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يتصور أن يكون في مكانين في حالة واحدة، وهذا حكم منه على كل شخص، ومعلوم أنه لم يدرك بالحسِّ إلا بعض الأشخاص، فحكمه على جميعِ الأشخاص زائدٌ على ما أدركه الحسّ”([5]).
أمثلة البدهيات: مبدأ عدم التناقض والسبيبة:
فمثال عدم التناقض: أن الشيء لا يمكن أن يكون ولا يكون في نفس الوقت.
والسببية تعني: أن كل موجود له سبب أو علة أوجدته.
ومن هذه الضروريات: إدراك العقل أن الكل أكبر من الجزء، وأن لا يمكن الترجيح بدون مرجح.
وحين نحاكم العقل الإلحادي إلى هذه الضروريات نجد أنه يسقط في نفيه للسببية، وهي قضية بدهية، ليحلَّ محلَّها خرافة المصادفة في وجود الكون وقوانين الحياة، فتصوَّر أنَّ شخصًا ما يحاول إقناعَك أن الطائرة بقوانينِها المعقَّدة وبرمجَتِها الإلكترونية الدقيقة حدَثَت عن طريق المصادفة، ويحاول أن تؤمِنَ بأن احتمال المصادفة واردٌ ولو بنسبة أقلَّ مِن الصِّفر، لكنَّك تلغي نسبةَ التسعة والتسعين في المائة وزيادة لتؤمن باحتمال أقلَّ من الصفر إن لم يكن مستحيلا، وتجعله عقيدةً، ذلك هو عين ما يدعو إليه الملحِد حين ينفي وجودَ خالقٍ مدبِّر عالم حكيم في فِعله أنشأ هذا الكون؛ فإننا حين ننظر إلى الكون بقانونه الدقيقِ وبانسجامه؛ فإنَّ نسبة احتمال وجودِه بكل هذه الصفَة عن طريق المصادفة نسبة لا وجودَ لها في الإمكان العقليِّ؛ لأنه لو جلس حمار وظلَّ يضرب برجله وَرَقا فإنَّ احتمال تأليفه كتابًا عن طريق المصادفة بذلك الضرب يعدُّ من المستحيل الممتنع؛ وهكذا الأمر لو جلس عطشانُ يعدّ الحصى فإنه لا يرتوي بذلك ولو مكث مئات السنين، وكل هذا يدلُّك على أنَّ علاقة الأسباب بالمسببات علاقةُ قانونٍ صارم، لا يقبل الاستثناء المجرد أو الوهم؛ لأن القضية بدَهيّة ضرورية ومؤسِّسة للعلوم، فنفيُها يُعَدّ مكابرةً.
وقد استخدَم القرآن البدهيات في الردِّ على من ينكر الخالق، أو ينكر قدرتَه، أو يقع في أي نوع من أنواع الإلحاد، من ذلك ما حكاه الله عز وجل عن إبراهيم في محاجَّة النمرود حين أحالَه إلى الحسِّ والمشاهدة في نقض دعواه، وكانت هذه الإحالة في قضية بدهية مدركة، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين} [البقرة: 258].
وهؤلاء الملحدون أنفسُهم قد يعتبرون خلقَ المسيح خُرافة؛ لأنه وُجِد من دون أبٍ، وخلق آدم كذلك، والإيجاد من دون أبٍ هو منَ المستحيل عادةً، وليس من المستحيل عقلًا، ومع ذلك يتصوَّرون أنَّ هذا القانون الذي يحكم حياةَ البشر مِن ألِفها إلى يائِها محضُ مصادفة، ولا شكَّ أن مبدأ السببيَّة الذي هو قانون بدَهيّ إنما يحكم حياةَ المخلوقات؛ ولذلك يستشهد به لقرآن في دفع الدعوى، قال تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُون} [الطور: 35]، وقال تعالى: {أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَّ يُوقِنُون} [الطور: 36].
فإقناع البشرية بأنَّ الكونَ مِن لا شَيء يُشبه إلى حدٍّ بَعيدٍ إقناعهم بصناعة كأسٍ لنَفسِه أو سيارة لنفسها، وكلُّ هذا مدعاة للضَّحِك والتندُّر من العقلاء.
إنَّ الفطرة تذهَب بالإنسان إلى اعتقاد وجودِ الإله، والعقل الضروريُّ يَفرِض ذلك، والحِسُّ يَشهد عليه، وأيُّ نفيٍ لوجود الإله هو تشكيكٌ في المعارف الضروريَّة ونفي لجميع العلوم البشرية؛ ولذلك حين يضطرب العقلاءُ في تعريف العقل وحدِّه فإنهم لا يختلفون على ميزته، وهي العلوم الضرورية، فيقولون: “العقل بعض العلوم الضرورية، فإن قيل: ما هو؟ فصِّلوه لنا؟ قيل: هو نحو العلم باستحالة اجتماع الضِّدَّين، والعلم أن المعلوم لا يخرج عن أن يكون موجودًا أو غير موجود، وأن الموجود لا يخلو عن الاتِّصاف بالقدم أو الحدوث، والعلم بمجاري العادات والمدركات بالضرورات كموجب الأخبار المتواترة الصادرة عن المشاهدات، إلى غير ذلك من العلوم التي يختصُّ بها العقلاء، وما من ضرب من هذه الضروب إذا ثبت إلا ويجب ثبوتُ أغياره، والميز بآحادها يقع بين العقلاء وغيرهم”([6]).
فالملحد ينبغي أن يُنحى به نحو مدركات العقول الأولية، وهي استحالة وجود كون بلا خالق، واستحالة وجود شيء من لا شيء، واستحالة أن يكون هذا التنظيم المحكَم عشوائيًّا، واستحالة أن تكون القوانين الصارمة التي تحكم حياتنا ولا يمكن تغييرها هي قوانين جاءت بمحض المصادفة.
والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) ينظر: البَدَهيّات في القرآن، مجلَّة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد (103، 104).
([3]) درء تعارض العقل والنقل (3/ 309).