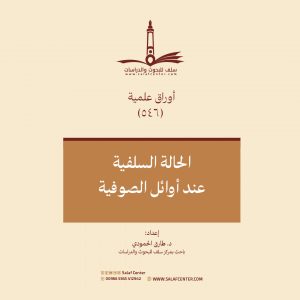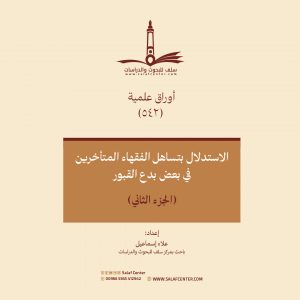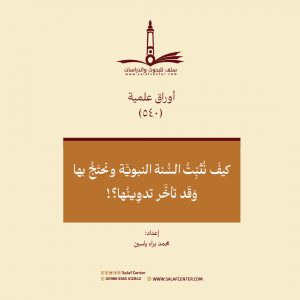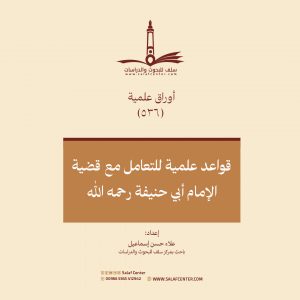فلسفة الإسلام حول الرق
جاء الإسلام للبشرية وقد انتشر فيها الظلم بجميع أنواعه، وكان من بين أنواع الظلم المنتشرة إهدارُ كرامة الإنسان واستعباده ظلمًا وعدوانًا، وتحميله ما لا يطيق، بل وصل الأمر إلى جعل الإنسان كالبهيمة يُمنَح بالجملة لإنسان آخر ليخدمه ويعبده. ولم تكن هذه النظم الإقطاعية تعترف للإنسان المستعبَد بأي حقٍّ بما في ذلك الزواج، فلم يكن تزاوج الأرقاء معدودًا في حكم الزواج، وإنما كان يحصل بناء على رغبة الأسياد ذات الطابع النفعي البحت؛ من أجل تكاثر الرقيق لمقاصد دنيوية تافهة، أهمها راحة الأسياد ولذّتهم، فبينما العالم كذلك إذ أشرقت شمس الإسلام على البشرية، وجلَت هذا الظلام الذي عمَّ بسبب الظلم، وكان من بين المشاكل التي واجهها الإسلام مشكلةُ الرق، ولم تكن مشكلة اجتماعية فحسب، بل كانت مشكلة اقتصادية ظاهرة في كثير من الشعوب والمجتمعات، فكان لا بد من معجزة إصلاحية للتعامل معها والقضاء على آثارها السلبية ونتائجها الكارثية. وسوف نسلط الضوء في هذا المقال على طريق معالجة الإسلام لظاهرة الرق وكيفية تعامله معها، بدءًا بتصوير موقفه منها عبر المسار التاريخي للظاهرة:
موقف الإسلام من الرق:
يتضح موقف الإسلام من الرق عند النظر إلى موقفه من الأسباب المؤدية إليه، خصوصًا ما غلب منها على الناس؛ كالنهب والسطو، وسرقة الأطفال والنساء واختطافهم، أو بيع الولد بسبب الفقر، وسيطرة الطبقة الغنية على الطبقة الفقيرة وسلبها حقَّها في الحرية والكرامة؛ فقد ألغى الإسلام كل هذه المنافذ وسدَّها، وقصر طرق الاسترقاق على سبب شرعي واحد، وهو استرقاق الأسرى في حالة الحرب المشروعة بين المسلمين وغيرهم، وليس هذا لازمًا؛ بل أتاح خيارات أخرى غيره، هي المن أو الفداء أو القتل أو دفع الجزية، وليس واحد منها واجبًا بعينه، قال تعالى:{فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُم} [سورة محمد:4]. “فإمام المسلمين مخير في أسراه في خمسة أوجه: القتل، أو الاسترقاق، أو ضرب الجزية، أو الفداء، أو المن. ويترجح النظر في أسير أُسر بحسب حاله من إذاية المسلمين أو ضد ذلك”([1]).
وقد اشترط العلماء أن يكون المُسترَقُّ رجلًا بالغًا عاقلًا حضر الحرب، فيخرج النساء ومن لم يحارب([2]).
فالرق يُنظر إليه على أنه جزء من السياسة الشرعية الحربية، وليس متاحًا في كل وقت، كما أنه لا يمكن اللجوء إليه مع وجود الخيارات التي هي أفضل منه وأصلح مثل الفداء، وهو مبادلة الأسرى بغيرهم، أو المنّ وهو إطلاق الأسير بدون مقابل لمصلحة شرعية، كما فعل النبي مع ثمامة بن أثال([3]) وغيره، أما المنافذ الأخرى فقد دل على حرمتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعط أجره”([4]). “وإنما كان إثمه شديدًا؛ لأن المسلمين أكْفاء في الحرية، فمن باع حرًّا فقد منعه التصرّفَ فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه، وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده”([5]). والتقييد بالمسلمين هو باعتبار الغالب؛ لأن الخطاب موجَّه إليهم، وإلا فغيرهم معهم سواء، لا يسترق إلا بسبب شرعي، وهو الذي مر معنا، ولعلك لا تجد في كتب الفقه ولا كتب الحديث تبويبًا خاصًّا بالرق ولا في فضله، وإنما تجد في هذه الكتب كتاب العتق وأحكامه وفضله، وهذا يدلك على نوع حكم الرق، وأنه إما جزاء بالمثل كالقتل، فَتُعامل به الأمم التي تسترق، وإما سياسة حربية من أجل النكاية بالعدو، وليس حكمًا شرعيًّا راتبًا لا يجوز العدول عنه إلى غيره من الخيارات، وتقليل الشريعةِ منافذَ الرِّقِّ تؤكد ذلك، إضافة إلى أنها فتحت أبوابًا للحد منه، منها:
أولًا: التطوع تعبّدًا لله عز وجل، ويدل على ذلك قوله سبحانه: {فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة فَكُّ رَقَبَة} [سورة البلد:11-13]. “أمّا فكّ الرّقبة: فإنّه الإسهام في عتق الرّقيق، والاستقلال في عتقها يعبّر عنه بفكّ النّسمة. وهذا العنصر من العمل بالغ الأهمّيّة، حيث قدِّم في سلّم الاقتحام لتلك العقبة. وقد جاءت السّنّة ببيان فضل هذا العمل، حتّى أصبح عتق الرّقيق أو فكّ النّسمة يعادل به عتق المعتق من النّار كلّ عضو بعضو، وفيه نصوص عديدة ساقها ابن كثير، وفي هذا إشعار بحقيقة موقف الإسلام من الرّقّ، ومدى حرصه وتطلّعه إلى تحرير الرّقاب”([6]).
ثانيًا: الكفارات: والكفارة في الشرع كفارة يمين، وكفارة ظهار، وكفارة صوم، وكفارة قتل الخطأ، وكل واحدة من هذه الكفارات جعلت الشريعةُ العتقَ أحد أنواعها، وأوجبت فيها عتق الرقبة إن وُجدت، قال الله في كفارة الظهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير} [سورة المجادلة:3]؛ “أي فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أي فكفّارتهم عتق رقبة”([7]).
وقال في كفارة القتل:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء:92].
يعنى أن قتل المؤمن خطأً إن كان من قوم محاربين ففيه تحرير رقبة، وإن كان من قوم مسلمين أو معاهدين ففيه تحرير الرقبة والدية معًا، فلا مناص لمن قتل نفسًا خطأ إلا بعتق نفس أخرى من الرق([8]).
وفي كفارة اليمين يقول سبحانه {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} [سورة المائدة:89]. “فمتى فعل واحدًا من هذه الثلاثة فقد انحلت يمينه”([9]).
وقال عليه الصلاة والسلام في كفارة المجامع في رمضان حين جاءه الأعرابي: “هل تجد رقبة”([10]).
ثالثًا: الحث على المكاتبة، كما في قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [سورة النور:33]. “وسبب نزول هذه الآية ما روي أنّ غلامًا لحويطب بن عبد العزّى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه، فأنزل الله هذه الآية، فكاتبه حويطب على مائة دينار، ووهب له منها عشرين دينارًا فأدّاها، وقتل يوم حنين في الحرب. والكتابة أن يقول الرّجل لمملوكه: كاتبتك على كذا من المال، ويسمّي مالًا معلومًا، يؤدّى ذلك في نجمين أو نجوم معلومة، في كلّ نجم كذا، فإذا أدّيت ذلك فأنت حر، ويقبل العبد ذلك، فإذا أدّى المال عتق، ويصير العبد أحقّ بمكاسبه بعد أداء المال، وإذا أعتق بعد أداء المال فما فضل في يده من المال يكون له ويتبعه أولاده الذين حصلوا في حال الكتابة في العتق”([11]).
ولعلنا نطلع القارئ الكريم على معلومة تزيل عنه إشكالات كثيرة، وهي أن الرق وإن لم يكن مقصدًا شرعيًّا في الشريعة ولا مفضّلًا، بل هو مباح ومتروك للسلطة التقديرية عند القضاء أو الحاكم؛ إلا أنه كسائر الأحكام التي شُرعت من أجل أسباب معينة وظروف خاصة، كالقتل والقطع، فإن الشريعة ليست متشوقة للقتل ولا للقطع، لكن إذا وُجد سبب أي من هذه الأحكام فإنها تجريها وتحكم بها، فكذلك الرق ليس له سبب إلا الكفر والحرب، بشرط أن تكون الحرب بين مسلمين وكفار ولسبب شرعي كما مر معنا، وكان المسترَقّ ممن حضر الحرب، فإن الرق قد يجرى باعتباره إجراء حربيًّا وخيارًا من بين خيارات عدة، أما غير ذلك فحرام بإجماع، كما أن الإسلام لا يتحمل مسؤولية تصرفات المجتمعات التي قد تطبق أحكامه تطبيقًا مختلًّا لا تراعي فيه شرائع الإسلام ولا مقاصده، وكذلك بعض أحكام الرق الموجودة في كتب الفقه هي اجتهاد من أصحابها، وليس عليها أثارة من علم، وينبغي ردها إلى الكتاب والسنة؛ لتمييز صحيحها من سقيمها وحقها من باطلها، كما أن الإسلام لا يمانع أن يتواضع المسلمون مع غيرهم على وضع الرق بينهم، وهذا مبثوث في كتب المذاهب([12])، فما دام الرق راجعًا إلى السياسة الشرعية، فهو موكول إلى اختيار الناس، فما دام للحاكم الحق أن يسقط سبب الرق -وهو القتال على الكفر- فمن باب أولى أن يسقط الرق.
ـــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([3]) قصة ثمامة في البخاري(4372)، ومسلم (1764).
([6]) أضواء البيان(8/532) وهذه الأجزاء من تكملة تلميذه عطية محمد سالم.
([8]) ينظر: تفسير الماوردي(1/519)
([9]) تيسير الكريم الرحمن (ص242).
([12]) ينظر: شرح السير الكبير السرخسي (1/303) والتهذيب في اختصار المدونة(3/7).