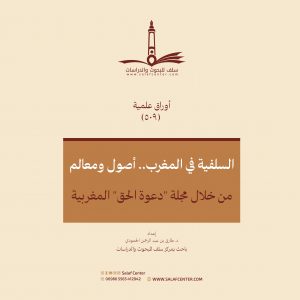(ليسُوا سواء) وجوبُ اتِّباعِ النَّبي ﷺ على أهل الكتاب بينَ نصوصِ الإسلام ونظريَّة عدنان (الجزء الأول)
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
المقدِّمة:
جاءَ الإسلامُ دينًا متكاملًا متماسكًا في عقائده وتَشريعاتِه وآدابهِ، ومِن العَوامِل التي كتبهَا الله لبقاءِ هذا الدين العظيم أن جعلَه مبنيًّا على المحكمات، وجعله قائمًا على أصولٍ ثابتَة وأركان متقنة، كفلَت له أن يبقَى شامخًا متماسكًا كاملًا حتى بعد مضيِّ أكثرَ من أربعة عشر قرنًا، وليسَ من الخير لهذِه الأمَّة أن تزلَّ قدمُها بعد الثبوت، وأن تتعثَّر بعد المسير، وتربية الناس وتنشئتُهم على الثَّوابت والمحكمات فيها عِصمةٌ لهم من كثيرٍ من الفوضى الفكريَّة التي تعصف اليوم بالنَّاس، وفيها حِفظٌ من التَّديُّن المغشوش والتَّلوُّن في الدِّين، وكمالُ هذا الدِّين وكمالُ تشريعاته يعني أنَّه لا يحتاج إلى من يكمِّله.
ومن الأمُور التي صرنَا نراها بكَثرة في وقتِنا المعاصر، خاصَّة داخلَ الدوائر الفكريَّة، ووسط أروقة العلم الشرعي: أناسٌ ينتسِبون إليه تعصِفُ بهم كلُّ شاردةٍ من الشُّبَه وواردة، وتتخبَّطُهم الهزائِمُ النَّفسية، وتسيطرُ عليهم وافداتُ التَّأثير الحائِف، ويُحاوِلون إعادَة ترتيب المنظومَة الشَّرعية محاباةً لمنظومةٍ أخرى طاغية، فيأتُون إلى محكماتٍ في الدين فيُشوِّهونَها، ويُلبسونَها غير لباسها، ويبرِّرونَ لفعلهم بتبريراتٍ سخيفة ساذجة لا تتماشى مع نسَق الدين الإسلامي، وكل ذلك حتى لا يُتهم الإسلامُ -في نظرهم- بقصورٍ في المعرفة أو التَّشريعات أو الغَايات، وفاعل هذا كالَّتِي نَقَضتْ غَزلَها منْ بَعدِ قوَّةٍ أَنكاثًا، والإسلام لا يحتاج إلى مثل هذا اللبوس الزَّائف لإظهاره بالمظهر الذي يريده غيرنا! فنحنُ لدَينا قيَمُنا وأخلاقُنا ومبادئُنا وخصوصيَّتُنا الدينية، والدعوة إلى دين الله لا تكونُ بتمييع دينِه، وتغيير تشريعاتِه، ومحاولة إظهارِهِ بغير مظهَره، وإنَّما بإظهار محاسِنه كما هي، وإظهار مبادئه وتشريعاتِه وغاياته الحميدَة كما هي دونَ تغيير.
تمهيد:
من محكمات الدِّين ما ذكَره ابن حزم -رحمه الله- تحت باب: (من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع) قال: “اتَّفقوا… وأنَّ محمَّدَ بن عبد الله القرشيَّ الهاشميَّ المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجنِّ والإنس إلى يوم القيامة، وأن دين الإسلام هو الدين الذي لا دينَ لله في الأرض سواه، وأنه ناسخ جميع الأديانِ قبله”([1])، وقال ابن تيمية -رحمه الله-: “والمقصود هنا: أنَّ الذي يدين به المسلمون من أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولٌ إلى الثَّقلين: الإنس والجن، أهل الكتاب وغيرهم، وأن من لم يؤمن به فهو كافرٌ مستحقٌّ لعذاب الله، مستحقٌّ للجهاد، وهو مما أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله عليه”([2]).
وقد جرت محاولاتٌ عديدة في نقض هذا الأصل، أو التَّشكيك فيه، أو تأويله بغير المراد منه، ومن ذلك ما ذَكَرهُ عدنان إبراهيم في بعض محاضراته من عدم كفر اليهود والنصارى بشروطٍ ذكرها وسيأتي التَّفصيل فيها، ولكن قبل أن نخوضَ في تفاصيل الشُّبهة وأدلتها ومناقشتها نودُّ أن ننبِّه إلى نقطتين مهمتين:
النقطة الأولى: أنَّ البحث في هذه المسألة في عدم تصحيح إيمان أهل الكتاب إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس في حُكمهِم في الآخرة، فإنَّ من الناس من يخلط بين المقامين رغم أن أحكامهما مختلفة جدًّا، فنحن في هذه الورقة لا نريد مناقشة حُكمِهِم في الآخرة، وإنما حكمهم في الدنيا.
النقطة الثانية: هذهِ المسألة من المحكمات كما بينَّا، وهي من المسائل التي تجمع ولا تفرِّق، ولذلك لم نتقيَّد بعلماء طائفةٍ معينة، فترانا ننقل عن أهل السنة والحديث وعن الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، للتَّأكيد على أنَّ المخالف في هذه المسألة يخالفُ سائرَ الطوائف، لا طائفةً واحدة.
وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مطالب:
الأول منها: في الأغلاط المنهجية التي وقع فيها عدنان إبراهيم وأمثاله.
والثاني: في مناقشة الدليل الأول بتفصيل.
والثالث: في مناقشة الأدلة الباقية.
وقبل الشروع في النقد نذكر الشبهة وأدلتها:
ماذا يقول عدنان إبراهيم؟
الشبهة التي ذكرها عدنان إبراهيم وذكرها غيرُه تتلخَّص في أنَّ اتِّباع محمَّد صلى الله عليه وسلم غيرُ لازمٍ لأتباع الديانات الأخرى، خاصَّة اليهودية والنصرانية، فلو بقِيَ كلُّ إنسانٍ على دينه فإنَّه ليس بكافِر إذا تحقَّق فيه بعض الشروط، وهي: 1- الإيمانُ بالله، 2- الإيمان باليوم الآخر، 3- العمل الصالح، 4- الإيمان بأنَّ محمدا صلى الله عليه وسلم نبيّ، ولا يشترط اتِّباعه. فلا يشترط للنَّجاة في الآخرة وارتفاع وصفِ الكفر في الدُّنيا أن يتَّبعَ النبيَّ محمَّدًا صلى الله عليه وسلم، أو يدخل في الإسلام!
وقد ذكر هذا عددٌ من المعاصرين فلبَّسوا على النَّاس، وعبثوا بأمر محكَمٍ في دين الله، وقد قالَ عدنان إبراهيم في بيانِ ما انتهى إليه في هذهِ المسألة: “لكن باختصار الذي بانَ لي أنَّ الكتابي يهوديًّا أو نصرانيًّا ليس ملزمًا بأكثر من أن يقرَّ بنبوَّة محمَّد صلى الله عليه وسلم، يقول: نعم هذا نبيّ؛ ولكنَّه ليس ملزمًا بأن يتَّبعه، وأن يتديَّن بشرعه؛ لأنه إن آمن بأنَّه نبي ورسول، فإنه مخيّر بعد ذلك أن يقيمَ كتابه”، ويقول: “إذا آمن الكتابي بمحمَّد في هذا فلا يعتبر كافرًا بمحمَّد، لكنه ليس ملزمًا بالاتباع”([3]).
أدلتهم:
عرفنا أصل المسألة وكلامَهُم فيها، وقد استدلُّوا على ذلكَ بأدلةٍ عديدة سنوردها كلَّها حتى لا نقع في الانتقاء كما وقعوا -وسنبيِّن ذلك-، وأدلتُهم التي ذكروها هي:
1- قول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 66]، مع قوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [المائدة: 69].
2- قوله تعالى: {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ} [آل عمران: 113، 114]. ووجه الاستشهاد منها: أن الله قسَّم أهل الكتاب في حال عدم اتباعهم للرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى فريقين، منهم أمةٌ قائمة يتلون آيات الله… إلى آخر الأوصاف، وقال الله فيهم: {وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ} [آل عمران: 115]، وسماهم: (الصالحين)، فلم يشترط الله اتباعَ محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يكفيهم -وهم على دينهم- أن يتَّصفوا بهذِه الصِّفات.
3- قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [المائدة: 68]. ووجه الاستشهاد: أن الله قال: {وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ}، يعني التوراة والإنجيل، فيكفيهم الإيمان بهما.
4- قولُه عليه الصلاة والسلام: «ثلاثةٌ يؤتون أجرهم مرَّتين: الرجل تكون له الأمَة، فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدِّبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوَّجها فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنًا، ثم آمنَ بالنبي صلى الله عليه وسلم فلهُ أجران، والعبد الذي يؤدِّي حقَّ الله، وينصح لسيِّده»([4]).
هذه أدلتهم التي ذكروها في هذه المسألة، وسنبيِّن الأغلاط المنهجية التي وقعوا فيها، ثم نناقش هذه الأدلة بالتفصيل؛ لكن قبل ذلك نودُّ أن ننبِّه على نقطتين مهمتين:
الأولى: أن بعض العلماء أو طلبة العلم الذين ردُّوا على مثل هذه الشُّبهة قد ردُّوا بأدلةٍ عمومية تفيد كفر أهل الكتاب في مجملهم، وهي طريقةٌ صحيحة لكنَّها ليست دقيقة؛ إذ يمكن ادعاء التخصيص، فهم يقولون حين نورد لهم هذه الأدلة: نحن لا نقول: إن كل أهل الكتاب ناجون، وإنَّما بعضهم وهم الذين حقَّقوا الشروط التي ذكرناها، ولذلك قال الله: {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ} [آل عمران: 113]، فإيرادُ أدلةٍ عامة تفيد كفر أهل الكتاب قد لا يدحض حجَّتَهم.
الثانية: لا نقصد في هذه الورقة التأصيل لمسألة كفرِ أهل الكتاب([5])، وإنَّما نقصد إبطال شبهات من يقول بعدمِ كفرهم استنادًا إلى نصوصٍ من الكتاب والسنة، لكنَّنا حتى ننطلق من أرضية صلبَة نودّ أن نشير إلى أنَّ كفر أهل الكتاب من المسائل التي نُقل فيها الإجماع، يقول في بيانِ ذلك الإمام ابن حزم -رحمه الله-: “واتَّفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارًا”([6])، وقال القاضي عياض المالكي: “ولهذا نكفِّر من لم يكفِّر من دان بغير ملَّة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شكَّ، أو صحَّح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافرٌ بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك”([7])، وقال النووي -رحمه الله-: “من لم يكفر من دان بِغير الإسلام كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده”([8])، ويصرح ابن تيمية -رحمه الله- بهذا الاتفاق فيقول: “وهذا كما أنَّ الفلاسفة ومن سلك سبيلَهُم من القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوزُ عندهم أن يتديَّن الرجل بدين المسلمين واليهود والنَّصارى. ومعلوم أن هذا كله كفر باتِّفاق المسلمين فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينًا سوى الإسلام فليس بمسلم”([9]).
وبين يدي مناقشة هذه الشبهة نودُّ أن ننبِّه إلى أننا سننأى كلَّ النأيِ عن منهج عدنان إبراهيم في التَّعامل مع أقوال العلماء المجتهدين ومذاهبِهم، وسترون كيفَ رمى بها عرض الحائط، بل وصفها بالكلام الفارغ! ونحن لن نصفَ كلامَه كما وصف هو كلام العلماء السادة المفسرين من القرون الأولى، ولكن سنناقشه نقاشًا علميًّا ليتَّضح للقارئ الكريم والباحث المنصف من أحقُّ بالكتاب والسنة: أهو الذي يجمع الآيات ويردّ بعضها إلى بعض ويفسِّرها كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم من يأتي وينقض كلامَ جمهور العلماء ويصفه بالكلام الفارغ؟! ولنرى ما الذي قدَّمه هؤلاء العلماء من أدلةٍ كالجبال مقابل ما قدَّمه عدنان إبراهيم في تأصيل هذه المسألة المشكلة جدًّا حسب وصفهِ لهَا!
المطلب الأول: الأغلاط المنهجية التي وقع فيها عدنان إبراهيم وأمثالُه:
وقع عدنان إبراهيم ومن معه في أخطاء منهجية كبيرةٍ تنقُض أصلَ ادِّعائهم قبلَ الخوض في تفاصيل الأدلة التي أتوا بها، ومن ذلك:
1- القفز الحكمي:
فعدنان إبراهيم وأمثالُه قد مارسوا قَفزًا حكميًّا في هذه المسألة، وأعني بذَلك أنَّهم جاؤوا إلى جزءٍ من النصوص الواردة في سياقٍ وموضوعٍ محدَّد فجعلوه هو أصل المسأَلة، فلم يُوردوا النُّصوصَ الأخرى الدَّالة على تكفير أهلِ الكتاب، ولم يوردوا النصوصَ التي فيها وجوبُ اتِّباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجيبوا عنها أو يوجِّهوها، وهذا مثل أن يأتيَ رجلٌ ويقول: يقول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} ثم يسكُتُ ولا يكمل!
وطالبُ العِلم والباحثُ عن الحقِّ هو مَن ينظُر إلى أقوالِ العلماء مِن قَبله ويفهمهَا ويعرف أدلَّتها، فإن أخطأ بعضُهم بيَّن خطأَه وصوَّبه لأن المطلوب هو الحقُّ؛ لكن يكون ذلك دون رمي الأقوال وتسفِيهها، ودون أن يأتيَ أحدهم ليقول عن كلِّ الأدلة السَّابقة وفهم العلماء لها بأنَّه كلام فارغ! ومن يريدُ أن يأتِيَ بما لم تأتِ به الأوائل ويريد أن يردَّ على العلماء من قبله عليه على الأقلِّ أن يُناقشَها ويبيِّن خَطأَها ولا يتعامل معها وكأنَّها غير موجودة!
وإذا تمَّ جمعُ كلِّ الأدلة الواردة في موضوعٍ واحدٍ يتبيَّن الحقّ، ولا شكَّ أن لَدينا أدلةً متوافرةً كثيرة في وجوبِ اتِّباع الإسلام الذي أتى به محمَّد صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85]، وقوله: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلَامُ} [آل عمران: 19].
فإن قيل: إن الإسلام المراد به هنا هو الإسلام العامّ، فإن الدِّين عند الله الإسلام، وهو دين كل الأنبياء.
نقول: نعم هو كذلك، فكل نبيٍّ أتى بالإسلام، والدخول في دين نبيٍّ منَ الأنبياء هو باتِّباع شرعِه الذي جاءَ به، فإن كانت الآيةُ عامَّةً في الدخول في الإسلام ومعناه الإسلام الذي جاء به كل نبيٍّ من الأنبياء، فإن الإسلام الذي جاء به محمَّد صلى الله عليه وسلم هو المطلوب اتِّباعه بعدما جاء به، فاليهودية في زمن موسى هي الإسلام، والنصرانية في زمن عيسى عليه السلام هي الإسلام، وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما هو الإسلام.
وإلى هذا أشار الراغبُ الأصفهاني في تفسير هذه الآيةِ بعد أن بيَّن أن للإسلام معنيَين قال: “والثَّاني: أن المراد بالإِسلام شريعةُ محمد عليه الصلاة والسلام، فبيّن أنَّ من تحرَّى بعد بِعثته شريعةً أو طاعةً لله من غير متابعتِه في شريعته فغير مقبولٍ منه، وهذا الوجهُ داخلٌ في الأول، فمعلوم أن من الاستسلام الانقيادُ لأوامر من صحَّت نبوته وظهر صدقه”([10])؛ ولِذلك قال مجاهدٌ في بيان سبب نزول قولِه تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا}: “لَمَّا نزلت هذه الآية قال أهل الملل كلهم: نحن مسلمون، فأنزل الله: {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، يعني: على الناس، فحجَّه المسلمون، وتركه المشركون “([11])، فتلاحظُ هنا أنَّ الإسلامَ أريدَ به الإسلامُ الذي جاء به محمَّد صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك حاججهم بشريعةٍ من شرائعه وهو الحجّ.
وإلى هذا أيضا أشار ابن جرير فقَال: “وذُكر أنّ أهلَ كل ملة ادَّعوا أنَّهم هم المسلمون لما نزلت هذه الآية، فأمرهم الله بالحجِّ إن كانوا صادقين؛ لأنَّ مِن سُنةِ الإسلام الحجّ، فامتنَعوا، فأدحض الله بذلك حجَّتهم”([12]).
ثم مَن نظَر إلى سياق الآيات دونَ اجتزاءٍ واقتصاصٍ عرفَ المرادَ من الإسلامِ هُنا، فإنَّ الله سبحانه وتعالى قد أبطَل أولًا ديانَة من يؤلِّه غيرَ الله فقال: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ * وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 79، 80]، ثم ذكرَ أخذَ العهدِ والميثاق من الأنبياءِ كلِّهم على أنَّه إن جاء محمدٌ صلى الله عليه وسلم فإنَّهم يؤمنون به، فقال: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 81]، وبعد أخذ الميثاق قال: {فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [آل عمران: 82] أي: بعد هذا الميثاق، ثم قال تبارك وتعالى: {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 84]، فمن هؤلاءِ الَّذين لا يُفرِّقون بينَ الأنبياء؟ هل همُ اليهود الذين لا يؤمنون بعيسى ويتَّهمونه ويرونه ابن زنا([13])، أم هم النَّصارى الذين ينسبون إلى الأنبياءِ العظائم؟ ثم بعد ذلك قالَ الله: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85]، فالسياق كلُّه يتحدَّث عن الإسلام الذي جاء به محمَّد صلى الله عليه وسلم، فالمراد بهذا الإسلام هو الإسلام الخاص بلا شكٍّ.
ويعضد هذا ما وردَ في سورة البقرة من آيةٍ مشابهة لهذه، فقد قال الله سُبحانه وتعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 136] فإن الآية واحدةٌ متقاربة، ثم قال الله: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا} [البقرة: 137] فتأمل معي قوله: {بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ}، ومعلومٌ أن ما آمن به المسلمون هو شريعة محمَّد صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك قال الله بعد ذلك: {أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ} [البقرة: 140]، فبرَّأ الله هؤلاء الأنبياء من أن يكونوا يهودًا أو نصارى، فهُم إذن لا يُحقِّقون هذه الصفةَ التي يحقِّقها المسلمون، وهم بوصف القرآن: {فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ} [البقرة: 137]، وبوصف القرآن: {فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85]، ثم يأتي عدنان إبراهيم ويقول: إنَّ نظريته نظرية قرآنية متكاملة!
2- التناقض:
قد وقع عدنان إبراهيم في تناقضاتٍ عديدة سيأتي بعضها أثناءَ نقاش الأدلَّة التي استدلَّ بها؛ لكن الذي يعنينا هُنا هو أنَّ الشرطَ الذي ذكرهُ يُناقض نفسَه، وهو: الإيمان والإقرار بنبوَّة النبي صلى الله عليه وسلم دونَ اتِّباعه، فإنَّ الإقرار بنبوته يقتضي ضرورةً اتباعَه، وذلك أنَّ من معنى (آمنوا به) أو (أقروا به): صدَّقوه، فإذا كان كذلك فقد قالَ الله: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 159]، فهل محمد صلى الله عليه وسلم صادقٌ في هذا؟ إن كان صادقًا فيجب اتباعه كما يتَّبعه المسلمون، فهو مرسل إلى النَّاس كافَّة، وعدَم اتِّباعه يعني تكذيبَه، وهذه بدهية منطقيَّة يعرفها كلُّ طالب علم، وهي: أنَّه لا يمكن أن يجتمع النقيضان وهمَا: التَّصديق والتكذيب.
فإن قالوا: هنَا المقابلة بين التَّصديق وعدم الاتّباع، وليسَ بين التصديق والتكذيب.
نقول: أولًا نقرُّ بأنَّه ليس كل عدم اتِّباع هو تكذيبٌ بالضَّرورة، فقد يكون عنادًا أو استكبارًا أو غيرها من المعاني؛ لكننا نتحدَّث عن هذه الآية بخصوصِها، فإن كانوا صدَّقوا محمَّدًا صلى الله عليه وسلم وجبَ أن يصدِّقوه أنَّه مرسلٌ إلى النَّاس كلهم، وهم لم يفعلوا ذلك، بل يصدِّقون ويقرّون بأنَّه نبيٌّ إلى العرب لا إليهم، وهذا تكذيبٌ له.
وقد وضَّح الرازي هذا فقال: “وقال طائفة من اليهود -يقالُ لهم: العيسوية، وهم أتباع عيسى الأصفهاني-: إنَّ محمدًا رسولٌ صادق مبعوث إلى العَرب، وغير مبعوث إلى بني إسرائيل. ودليلنا على إبطالِ قولهم هذه الآية؛ لأنَّ قوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} خطابٌ يتناول كلَّ الناس، ثم قال: {إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 159]، وهذا يقتضي كونه مبعوثًا إلى جميعِ الناس. وأيضًا: فما يعلم بالتواتر من دينِه أنَّه كان يدَّعي أنَّه مبعوثٌ إلى كلِّ العالمين، فإمَّا أن يُقال: إنَّه كان رسولًا حقًّا، أو ما كان كذلك، فإن كان رسولًا حقًّا امتنع الكذبُ عليه، ووجبَ الجزم بكونه صادقًا في كلِّ ما يدَّعيه، فلمَّا ثبَت بالتواتُر وبظاهر هذه الآية أنّه كان يدَّعي كونَه مبعوثًا إلى جميعِ الخلق وجبَ كونُه صادقًا في هذا القَول، وذلك يبطِل قولَ من يقول: إنَّه كان مبعوثًا إلى العرب فقط لا إلى بني إسرائيل”([14]).
وقال ابن تيمية رحمه الله: “ويعلم أنَّه لو قدّر أن قومًا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحنُ نؤمن بما جئتنا به بقلوبِنا من غير شكّ، ونقرُّ بألسنتنا بالشهادتين، إلا أنَّا لا نطيعك في شيءٍ مما أمرتَ به ونهيتَ عنه، فلا نصلِّي ولا نصوم ولا نحج، ولا نصدُق الحديث، ولا نؤدِّي الأمانة، ولا نفِي بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعَل شيئًا من الخير الذي أمرتَ به، ونشربُ الخمر، وننكح ذواتِ المحارم بالزنا الظاهر، ونقتُلُ من قَدرنا عليه من أصحابِك وأمَّتك، ونأخذ أموالَهم، بل نقتُلك أيضًا ونقاتِلك معَ أعدائك، هل كان يتوهَّم عاقلٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتُم مؤمنون كاملو الإيمان، وأنتُم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار؟! بل كلُّ مسلم يعلم بالاضطرار أنَّه يقول لهم: أنتم أكفَر الناس بما جئتُ به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك”([15]).
ثمَّ يقال: هب أنَّه لا يلزم التناقُض، لكن لَمْ يحصل المقصود من هذا كلِّه! أعني أنَّ عدنان إبراهيم ومن معه رتَّبوا على تصديقهم الرَّسولَ دون اتباعه إيمانَهم في الدُّنيا ونجاتَهم في الآخرة، فهل مجرَّد التصديق دونَ الاتباع يُنجي من العقاب؟! ماذا لو أن مديرًا قد أرسل رسولًا إلى آخر ليبلِّغه أوامره، فلمَّا جاءَهُ الرَّسول قال له الموظَّف: أنا صدَّقتُ أنَّك رسول من عنده، وأنك قد بلَّغتني الأوامر، لكنِّي لن أعمل بها، فهل هذ الموظَّف سيُكرَّم ويكون ما فعله أمرا محمودًا، أم أنَّه يستحقُّ العقاب لأنَّه صدَق بأن هذه الأوامر موجَّهة إليه ولم يمتثلها؟! لا شكَّ أنه الثاني، فكذلك أهل الكتاب يلزمهم إن صدَّقوا أنه رسولٌ من رسل الله أن يتبعوه، وسيأتي مزيد كلام في هذا.
ومن تناقضاته: أنَّه هنا يقضي بنجاتِهم، لكنَّه قال في تفسير سورة النساء عن اليهوديَّة: إنَّها ديانة وثنيّة، عكس ما يقوله بعض المشايخ وبعض العلماء: ديانة توحيدية([16])، فكيف يكون أهل ديانةٍ وثنيةٍ مسلمين غير كفار؟!
وحين فسَّر قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ} [آل عمران: 81]، جعل من خاصِّيَّة النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه مرسلٌ إلى النَّاس كافَّة، وأنَّ الله أخذ الميثاقَ الشَّديد من كلِّ الأنبياء على أنَّهم يتبعونه، ثم ذكر تفسير علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم بأنَّه ما بعث الله نبيًّا من الأنبياء إلا أخذ عليه العهد والميثاق، ثم قال: “أن يأخذ العهد على أمته [أي: كل نبي] إذا بُعث محمدٌ وأنتم أحياء أن تتركوا اتباعي وأن تتبعوه من دوني”، وقد أفاض عند الحديث عن هذه الآية في ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعمومية رسالته لكل الناس، وقد نقل كلام السبكي في ذلك، ونصُّه: “وقول المفسرين هنا أنَّ الرسول هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنَّه ما من نبي إلا أخذ الله عليه الميثاق أنَّه إن بُعِث محمد في زمانه لتؤمننَّ به ولتنصرنَّه، ويوصي أمته بذلك، وفي ذلك من التَّنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره العليِّ ما لا يخفَى، وفيه مع ذلك أنَّه على تقدير مجيئهِ في زمانهم يكون مرسلًا إليهم، فتكون نبوته ورسالته عامَّة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة”([17]). ثم علَّق عدنان إبراهيم فقال: “اليهود من أمَّة محمد، والنصارى والبوذيين وغيرهم، من أمة الدعوة”، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمَع بي أحد من هذه الأمة، يهوديّ ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمِن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار»([18])، ثم استرسل في التفسير إلى أن وصل إلى قوله: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85] ففسَّر الإسلام بأنه الإسلام العام وهو توحيدُ الله، ثم قال: “وفي الأخير تمَّت صورة الإسلام مع محمَّد، وفي دين محمَّد الإسلام الصحيح الحنيف الذي ليس فيه شائبة وثنية، وهو المحفوظ”([19]).
فكيف يأتي بعد ذلك ليقول: إنَّ عدم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نظرية قرآنية متكاملة؟! مع تسليمنا بأنَّه لا يشترط أن يكون هذا تناقضًا منه؛ لأنه قد يكون غيَّر رأيه فيما بعد، لكن كان من الأحرى أن يقدِّم إجابات عن كل الأدلة التي ذكرها هو في وجوبِ اتِّباع النبي صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن أن يقدِّم إجاباتٍ لأدلَّة ذكرها غيره، وسيأتي بيان تناقضات أخرى له في معنى الإيمان، وفي معنى أهل الكتاب في موضعه.
3- التحكُّم:
وقد فعَل ذلك حين جاءَ بشرطٍ زائد على ما في الآية، فإن الشروط التي ذكرتها الآية هي: {مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا} [البقرة: 66، المائدة: 69]، وأضافَ إليها عدنان إبراهيم شرطًا آخر وهو: وجوبُ الإقرار بالنَّبي صلى الله عليه وسلم والتصديق به. فمن أين أتى عدنان إبراهيم بهذا الشرط وكل الآيات التي ذكرها لم تذكر هذا الشرط؟!
فإن قيل: أخذ هذا الشرطَ من الآيات الأخرى.
نقول: نعم، وهو المطلوب، وهو ما أعنيه بالتحكُّم، فإنَّه أخذ هذا المعنى من آياتٍ أخرى، وهذا الفعلُ منه يدلُّ دلالة صريحة على أن الآيات التي ذكرها لا تستقلُّ بالدلالة على المعنى الذي أراده، وإنَّما تحتاج إلى آيات أخرى وردت في نفسِ الموضوع، فإن اتَّفقنا على هذه النقطة نقول: لِمَ ترك إذن آياتٍ أخرى كثيرةً توجِبُ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا مجرَّد تصديقه؟! أليس هذا تحكمًا من عدنان إبراهيم؟!
ثمَّ كيف يقول عدنان إبراهيم: إنَّ الواجب تصديقُ النبي صلى الله عليه وسلم دون اتباعه والله سبحانه وتعالى يقول: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]، فكلام من نسمع: كلام الله، أم كلام عدنان إبراهيم؟!
وإن كان عدنان إبراهيم في نظريته هذه لم يتطرَّق للآيات التي توجِب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنَّنا سنستعرض عددًا منها حتى تكتمل النظرية، ويتَّضح الزيف الذي يمارسه بهذا التحكّم!
ونصوصُ اتِّباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرةٌ متوافرةٌ توجب على جميع الناس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا مجرَّد تصديقه، بل غاية إرسال الرُّسل أن يُتَّبعوا ويُطاعوا، يقول الله تبارك وتعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [النساء: 64]، فالرَّسول أُرسل ليطاع لا ليُصدَّق فقط، يقول ابن جرير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: “يعني بذلك جلَّ ثناؤه: ولم نرسل -يا محمد- رسولًا إلا فرضتُ طاعتَه على من أرسلته إليه. يقول تعالى ذكره: فأنت -يا محمد- من الرسل الذين فرضتُ طاعتهم على من أرسلتُه إليه”([20])، وقال مكي بن أبي طالب: “المعنى: وَمَا أَرْسَلْنَا رسولًا إلا افترضنا طاعته على أمر من أرسل إليهم، فأنت -يا محمد- من الرسل الذين فرضتُ طاعتهم على من أرسلته إليهم، فهذا توبيخ لمن احتكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم”([21]).
وعلى هذا توارد المفسِّرون، فقد ذكر هذا المعنى ابن أبي زمنين([22]) والقرطبي([23]) والبيضاوي([24]) وابن كثير([25]) وغيرهم، وقد بوَّب الإمام مسلم في صحيحه بابًا أسماه: (باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالةِ الإسلام)، أورد فيه قولَ النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النَّار»([26])، وهذا نصٌّ صريح واضح في وجوب اتِّباع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّه قال: «بالذي أرسلت به»، ولا شكَّ أن الذي أرسل به هو القرآن الكريم.
وفي شرح هذا الحديث يقول النووي -رحمه الله-: “فيه: نسخُ الملل كلِّها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم… وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يسمعُ بي أحد من هذه الأمة» أي: من هو موجودٌ في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلُّهم يجب عليهم الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيهًا على من سواهما؛ وذلك لأن اليهود النصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أنَّ لهم كتابًا، فغيرهم ممَّن لا كتاب له أولى، والله أعلَم”([27]).
ثم أليسَ اليهود والنَّصارى يحبُّون الله جل جلاله؟! فالله يقول لهم: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 31]، بل حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن أمره بدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام؛ ففي صحيح مسلم: حين بعث النبي صلى الله عليه وسلّم معاذًا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائمَ أموالهم، واتَّق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»([28]). وهذا حديثٌ عظيم في بيان المقصود، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يرسل معاذًا إلى أهل الكتاب، فعلى نظرية عدنان إبراهيم كان من المفترض أن يخيِّرهم بين الدخول في الإسلام الذي جاء به محمَّد صلى الله عليه وسلم وبين أن يبقوا على دينهم مع الإقرار به، لكنَّه أمره أن يدعوهم إلى الشهادتين، ثم ذكر شرائِع الإسلام الخاصَّة.
وهناك نصوص أخرى كثيرةٌ لن نتوقَّف عندها؛ إذ إنَ هذا ليس غرضُ الورقة؛ ولكنَّنا سنتوقَّف عند صفحة واحدةٍ من القرآن الكريم من سورة الأعراف لنرى سياقَ الآيات الواردة فيها، ثم نحاكم إليها النَّظرية القرآنية التي أتى بها عدنان إبراهيم، يقول الله تعالى بعد أن ذكر قصَّة موسى عليه السلام مع قومه: {وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ} [الأعراف: 156]، فوعد الله بذلك صنفًا من الناس فقال: {فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} [الأعراف: 156]، ثم قال الله تبارك وتعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} [الأعراف: 157]، فمن هذا النبي الذي يجب عليهم اتِّباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم؟! ولا يمكن أن يكون موسى أو عيسى عليهما السلام؛ لأنَّ الآية توضِّح أنَّه يأتي بعد نزول التوراة والإنجيل، وقد وصفه بأنَّه النبيّ الأميّ، وبأنه {يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] أي: أنَّه سيغيِّر في ديانتهم التي كانوا يتَّبعون، ثم قال الله: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف: 157]، والنور الذي أنزل معه هو القرآن الكريم. وتلاحظ أنَّه قال: {واتَّبعوا}.
ثم تمضي الآياتُ في تأكيد هذا المعنى، فقال الله بعدها موضِّحًا عمومية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158]، ثم كرَّر النداء بالإيمان بالله ورسوله فقال: {فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ}.
فإن قيل: الإيمان يعني التصديق.
نقول: قد قطع الله هذا المعنى حتى لا يتحجَّج به أحدٌ، فقال بصريح العبارة: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158] أي لتهتدوا، فماذا يفعل عدنان إبراهيم بهذه الآيات التي تصرِّح بوجوب الاتباع، وأنه لا نجاة إلا باتباعه، ولا هداية إلا في اتباعه؟!
فالأمر في كلّ هذه النصوص بالاتباع لا بمجرَّد التصديق؛ ولذلك توارد العلماء على بيان وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنَّه لا ينجِّي إلا هذا، يقول الشافعي: “قال الله تعالى: {وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} [النور: 52]، فأعلمَ الله الناس في هذه الآية أنَّ دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينَهم: دعاء إلى حكم الله؛ لأن الحاكم بينهم رسولُ الله، وإذا سلَّموا لحكم رسول الله، فإنما سلموا لحكمه بفرض الله، وأنه أعلمهم أن حكمه: حكمه، على معنى افتراضه حكمه، وما سبق في علمه -جل ثناؤه- من إسعاده بعصمته وتوفيقه، وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره، فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله، وإعلامهم أنَّها طاعته، فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمر رسوله، وأن طاعة رسوله: طاعته، ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره -جل ثناؤه-“([29])، ويقول: “{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} إلى قوله: {وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157] فقيل -والله أعلم-: أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله تعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم كتابي ولا وثنيّ ولا حيٌّ ذو روح، من جنّ ولا إنس بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قامت عليه حجّة الله عز وجل باتِّباع دينه، وكان مؤمنًا باتباعه، وكافرًا بترك اتباعه”([30]).
ويقول ابن تيمية -رحمه الله- مصرِّحًا بذلك: “وهذا دينُ الله الذي لا يقبل من أحدٍ دينًا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، ولا تكون عبادته مع إرسال الرُّسل إلينا إلا بما أمرت به رسله، لا بما يضادّ ذلك؛ فإن ضدَّ ذلك معصيةٌ، وقد ختم الله الرسل بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مسلمًا إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وهذه الكلمة بها يدخل الإنسانُ في الإسلام”([31])، ويقول في موضع آخر: “ومن لم يقرَّ بأنَّ بعد مبعَث محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون مسلم إلا من آمن به واتَّبعه باطنًا وظاهرا فليس بمسلم، ومن لم يحرِّم التديُّن -بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم- بدين اليهود والنصارى بل من لم يكفِّرهم ويبغضهم فليس بمسلِم باتفاق المسلمين”([32]).
هذه جملةٌ من الأغلاط المنهجية التي يقعُ فيها من ينادي بمثل هذه الدعوات، وعلى رأسهم عدنان إبراهيم، وسننطلق بعد هذه الجولة إلى النُّصوص التي استدلّوا بها لنرى مدَى دلالتها على مرادهم([33])، وبالله التوفيق.
ــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) مراتب الإجماع (ص: 761-762).
([2]) الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح (1/ 368).
([3]) انظر كلام عدنان إبراهيم هذا في الرابطين:
https://www.youtube.com/watch?v=f5ns1L6x4Aw
https://www.youtube.com/watch?v=1bkzGHUppKw
وكذلك ردده إسلام بحيري، انظر:
([4]) أخرجه البخاري (3011)، ومسلم (154).
([5]) انظر إلى مقال في مركز سلف بعنوان (كفر أهل الكتاب.. مُحكمة يراد العبث بها) على الرابط:
([7]) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 610).
([8]) روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 70).
([9]) مجموع الفتاوى (27/ 463).
([10]) تفسير الراغب الأصفهاني (2/ 692).
([13]) انظر: فضح التلمود، تعاليم الحاخامين السرية، لآي بي برانايتس، إعداد: زهدي الفاتح (ص: 57-62).
([14]) التفسير الكبير (15/ 383).
([15]) مجموع الفتاوى (7/ 287).
([16]) انظر تفسير سورة النساء لعدنان إبراهيم، المحاضرة الرابعة بعد الدقيقة 14، على هذا الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=QIPd90kzhWA
([19]) انظر تفسيره لسورة آل عمران، المحاضرة الثالثة، دقيقة السابعة بعد ساعة: 1.07.49 على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=cnMev9QljSg
([21]) الهداية إلى بلوغ النهاية (2/ 1376).
([22]) تفسير ابن أبي زمنين (1/384).
([25]) تفسير ابن كثير (2/347).
([27]) شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 188).