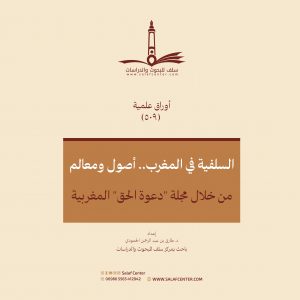هل تأثر المحدثون بالواقع السياسي؟ التأليف في الحديث نموذجاً
منَ المعلومِ أنَّ علمَ الحديث من أشرفِ العلوم الشرعية؛ وذلك بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعدُّ من العلوم الخادِمة للأصل الثاني من أصول التشريع؛ ولذا اعتنت الأمة به اعتناءً خاصًّا، فاعتنت بألفاظ الحديثِ وبطرقه ورواته، وهذَا الاعتناءُ سببُه تأثير كلِّ من انتسَب لهذا الميدان وقوَّة مصداقيته إن ثبتت أهليته، فاهتمَّتِ الأمَّةُ ببيانِ حالِ الرواة عدالةً وفسقًا، وسنة وبدعةً، وبيَّنت حكم كلِّ ذلك، ثم اعتنت بألفاظ الحديث وما أدخله الراوي فيها من كلامه أو رواه بالمعنى، وكل هذا أُلِّفَت فيه كتب بالمآت، ولم يقبلوا رواية راوٍ له فيها حظّ أو ينصُر بها مذهبه، فتكلَّموا في حكم رواية المبتدع، وجعلوا لها شروطا من أهمها: عدالته وتقواه، وعدم دعوته إلى بدعته، وضبطه وثقته.
قال الذهبيُّ رحمه الله: “هذه مسألة كبيرة، وهي القدريّ والمعتزليّ والجهميّ والرافضيّ إذا علم صدقه في الحديث وتقواه، ولم يكن داعيًا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه، وتردَّدوا في الداعية هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفَّاظ إلى تجنُّب حديثه وهجرانه، وقال بعضهم: إذا علِمنا صدقَه وكان داعيةً ووجدنا عنده سنةً تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرُّفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تُبِح بدعته خروجَه عن دائرة الإسلام، ولم تُبِح دمَه، فإن قبولَ ما رواه سائغ، وهذه المسألة لم تتبرهَن لي كما ينبغي، والذي اتَّضح لي منها أن من دخل في بدعةٍ ولم يعدَّ من رؤوسها ولا أمعَن فيها يقبل حديثه”([1]).
وهذا التقعيدُ يفيدنا في التدليلِ على جدِّيَّة علماء الحديث وقوَّة معاييرهم العلمية في قبول الحديث الشريف، وأن الراويَ ليس مؤثِّرا في الرواية بالدَّرجة التي يمكنه أن يضَع الحديث أو اللفظَ ويُفوِّته على المتابعات العلمية التي يقوم بها أهل الحديث من أجل التدقيق في المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ، كما أن المحدِّثين حياديون في قبول الرواية، لا دخل لآرائهم الشخصية ولا العقدية فيها؛ ولذا أجازوا الرواية عن المخالف لهم في العقيدةِ بالشروط التي سبق ذكرُها.
حقيقة الشبهة ومناقضتها للواقع:
قام بعضُ السمَّاعين للمستشرقين من المنتسِبين إلى القِبلة بمحاولة الطَّعن على المحدثين بأن روايتَهم كانت نتاجَ واقعٍ سياسيٍّ، حاولوا تسويغه شرعًا بوضع بعضِ الروايات التي تخدم الحاكمَ وتصرّفاته، وهذه التُّهمة وإن كان الواقع العملي وطريقة تأليف الكتب كلّها تردُّها، إلا أنها مع ذلك راجَت على بعض الناس، والجواب عليها يتبيَّن بعدة أمور:
أولًا: طبيعة مؤلفات أهلِ الحديث، فكثير منها لم يكن مختصًّا بالشأن السياسيّ، بل هو عامّ، والشأن سياسيّ ليس فيه مقدَّما من حيث الترتيب في التبويب.
ثانيًا: أن رواة الأحاديث في طاعَة الحاكم كانوا يأتون بالرواية وبالرواية التي تقيدها وليست في صالح الحاكم.
ثالثًا: أن في بعض أبواب كتب الحديث ما فيه حكمٌ على تصرفات الحاكم بالخطأ، وأحيانا بالتأثيم، ويكون هذا صريحًا.
رابعًا: مواقف المحدثين أنفسِهم من الواقع السياسي ومن الحاكم، سواء في عقائدهم أو في اختياراتهم الفقهية، فأحيانا تكون مصرِّحة بالمخالفة للحاكم وبالتمسك بالرواية؛ كما وقع للإمام مالك في يمين المكره، فقد تمسَّك بالرواية ورد رأي الحاكم([2])، وكما وقع للإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، وله موقف في ذلك في غاية الرفض، قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: “لما حبس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال له السجان: يا أبا عبد الله، الحديث الذي يروى في الظلمة وأعوانهم صحيح؟ قال: نعم، فقال السجان: فأنا منهم؟ قال أحمد: أعوانهم من يأخذ شعرك ويغسِل ثوبَك ويصلح طعامك ويبيع ويشتري منك، فأما أنت فمن أنفسهم”([3]).
خامسًا: حين نطبِّق دعوى هؤلاء على بعض كتب الحديث فإنها سرعان ما تنكشف ويتبين أن القائلين بها لم يكلِّفوا أنفسهم البحثَ عن قرينة تشهد لدعواهم، فضلا عن بينة، وهذه الشبهة تدَّعي أن تأليفَ السنة تمَّ تحت تأثير الضغط السياسيِّ، وكذلك الموقف من الحاكم.
الرد على الشبهة بالتفصيل:
وهذه التهمة تعدُّ في ميزان العلمي خطيرة، وتحتاج إلى بيِّنة، وهذه البينة لا بد أن تعتمد على أمرين:
أولا: على الاستقراء التام لكتب السنة ورجالها، وعلاقتهم بالسلطة، وإثبات علاقة كل مؤلف بالسلطة، وتوجيهها له في كل تأليف ألفه.
ثانيا: مراجعة جميع كتب السنة من سنن ومسانيد وكتب جامعة، وملاحظة ذلك فيها، وإثباته بالأمثلة، والاستعانة بالتاريخ.
وكلا الأمرين لم يقُم به أصحاب هذه الدعوى، فليس فيهم من وصل مرحلة المشاركة في الفنّ -فضلا عن النبوغ فيه- حتى يتمكن من القيام بهذه المهمة، فالتهمة من هذه الناحية باطلة ولا قيمة لها.
كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة:
من المعلوم لأهل الاختصاص أنَّ كتابةَ السنة سابقة زمنيًّا للسلطة، فقد دوَّن الصحابة السنة، ودونك بعض ما يدل على ذلك:
1- قول أبي هريرة رضي الله عنه: “ما من الصحابة أحدٌ أكثر حديثًا مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه يكتب ولا أكتب”([4]).
2- وعنه رضي الله عنه قَالَ: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحدٍ بعدي، فلا ينفَّر صيدها، ولا يختَلى شوكُها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُفدى، وإما أن يُقيد». فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخر». فقام أبو شاه رجلٌ من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي شاه». قيل للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم([5]).
3- عن عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت أكتبُ كلَّ شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدُ حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كلَّ شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلَّم في الغضب والرضا! فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «اكتُب؛ فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حقّ»([6]).
4- عن أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه قال: كتبت إلى مروان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متَّهم خُيِّر سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بالثمن، وإن شاء اتبع سارقه([7]).
5- وكتب جابر بن سمرة رضي الله عنه بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث بها إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص بناء على طلبه ذلك منه([8]).
6- وكتب زيد بن أرقم رضي الله عنه بعض الأحاديث النبوية، وأرسل بها إلى أنس بن مالك رضي الله عنه([9]).
7- وكتب زيد بن ثابت في أمر الجَدِّ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بناء على طلب عمر نفسه([10]).
مواقف للمحدثين تنقض الدعوى عليهم:
وممّا يردّ هذه الدعوى أنَّ بعض من جمع السنَّة وألَّف فيها لم يكن على حالة توافق مع السلطة، ولهم مواقف معلومة من السلطة، ومنهم محمد بن أبي ذئب([11]) وعبد الرحمن بن نصر الأوزاعي وسفيان الثوري([12])، وشعبة بن الحجاج([13])، والإمام مالك بن أنس، ومالك قد أفتى بالخروج مع محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب صاحب النفس الزكية، وردَّ بيعة جعفر المنصور، واعتبرها بيعة إكراه([14]).
وقد أفتى سعيد بن المسيب بفسادِ بيعة الوليد بن عبد الملك في عهد والده، واستدلَّ بحديث النهي عن بيعتين([15]).
وكبار المحدِّثين اتَّفقوا على رفض القول بخلق القرآن، وردوا على أهله، مع أنه كان رأي الحاكم في زمانهم.
وقد تعاقبت على الأمَّة دول مختلفة عقيدةً وتوجُّها، ومع ذلك لم يتغيَّر المحدِّثون ولا مسار التأليف عندهم، فقد ظلَّت مؤلَّفاتهم حيادية عن الحاكم، لا تؤيِّده، ولا تخذله، إلا بمقدار الشرع. فلو كانت الدعوى كما زعم المدعون لألَّف المحدثون في فضائل كلّ دولة وكلّ خليفة، ولم يثبِتوا في كتبهم ما يبيِّن خطأه.
أمَّا موقف المحدِّثين من الأحاديث المتعلِّقة بالحكام: فمن المعلوم أنَّ كثيرًا من المحدِّثين كانوا في عهد بني أمية، ومع ذلك رووا الأحاديثَ في فضل عليّ وآل بيته، كما رووا الأحاديث المجرِّمة لبعض أمراء بني أمية، بل أشدّهم عِتيًّا وهو الحجاج، فمن ذلك ما ورد عن أسماء في قصة مقتل ابن الزبير، قالت وهي تخاطب الحجاج: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذّابًا ومبيرًا، فأما الكذاّب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالُك إلا إيّاه، قال: فقام عنها ولم يراجعها([16]).
وهكذا فعل البخاريُّ وهو في العصر العباسيّ، فقد روى في فضائل الصحابة من طريق أبي مليكة: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؛ فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصاب؛ إنه فقيه([17]). وهذا بطبيعةِ الحال على رأيِ أهلِ التفسير السياسيِّ لا يُرضي العباسيِّين، ومن نظر في موطأ الإمام مالك وهو مدوَّنٌ في العهد العبَّاسي لا يجد أيَّ تأثير لهم، ولا ذكر، بل يجد فيه فتاوى معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وهما أمويّان، وأحاديث من طريق مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان وهما من خلفاء بني أمية كذلك([18]).
كما أنَّ المحدثين روَوا أحاديثَ في الإنكار على الحكّام، كما رووا أحاديث طاعتهم والصبر عليهم، فلماذا العدول عن النظرة الموضوعية إلى غيرها؟!
ومما ينقض هذه الدعوى أنَّ أكبر خصم للسلطة هم الخوارج، وقد روى عنهم المحدِّثون بما في ذلك الإمام البخاري، وهذا يدلُّ على مدَى الموضوعيّة التي تحلَّى بها رجال الحديث في تبني الرواية ونقدها وإثباتها.
وخلاصة الأمر: أن علاقة كبار المحدثين وأئمتهم بالسلطة كانت بحسب ما يمليه الشرع وما يسوغ فيه الاجتهاد، وليسوا على درجة واحدة، ففيهم من كان جزءًا من السلطة، يقوم بأمر الله، ويقضي وينصح، وفيهم من اعتزلها، وفيهم من اكتفى بالمناصحة، وكل هذا في حدود الاجتهاد المقبول، لكن الذي لم يَقَع هو تأثُّرهم بالسلطة إلى حدِّ وضع الأحاديث لصالحها، والعجيب أنَّ هذه التهمَة لم يتأملها أصحابها، فهَل يُعقَل أن توجِّهَ سلطةٌ جهةً ما لوضع الحديث لصالحها ثم لا يُستخدم هذا الوضع ضدَّها بدلَ قبوله وشرحه وتأويله؟! فلم يرِد أن دولًا من الدول التي تقاتلت بعد أن انتصرت إحداها على الأخرى عمدت إلى الموروث الحديثيّ المنتج في زمن الأولى وأفنته بحجَّة أنه موضوع وأنه نتاج فترة معينة.
فالمحدّثون رووا الأحاديثَ في فترات مختلفة، ودوّنوها، ولم تتغير منذ عصر تدوينها إلى يومنها هذا، وكان هذا التدوين وفق منهجيَّة لا تحابي أحدًا، ولا تقبل الكذبَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كفوا الناسَ مؤنة التخوين، فقد تتبَّعوا من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسب إليه ما لم يقله خطأً، وبيَّنوا ذلك، وميَّزوه، فلم يعُد لطاعن فيهم مقال يسلم له ولا دعوى تستقيم.
ــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) سير أعلام النبلاء (7/ 145).
([2]) ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي (13/ 140).
([3]) ينظر: الفروع لابن مفلح (11/ 145).
([6]) أخرجه أبو داود (3646)، وأحمد (6510).
([11]) ينظر موقفه من أبي جعفر المنصور في تهذيب التهذيب (9/ 271).
([12]) ينظر: المحدث الفاصل (ص: 617).
([13]) ينظر: تاريخ الإسلام (9/ 48).
([14]) ينظر: البداية والنهاية (11/ 156).
([15]) ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 231).
([18]) الموطأ: باب الوضوء حديث (58)، باب العمل في الإهلال حديث (33).