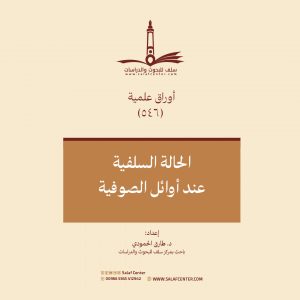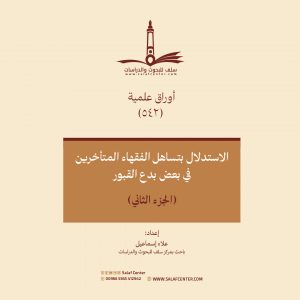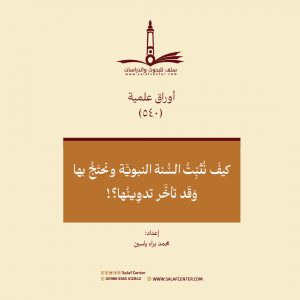ورقة في الجواب عن شبهة عدم الإلزام بفهم الصحابة في فهم نصوص الوحي
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
لم يعد العقلانيون المعاصرون يصادمون النَّص، ولم يعودوا يناقضون الإجماع؛ لأنهم علموا أنها معركة خسر فيها مرارًا وتكرارًا أسلافُهم ممن يريدون اتباع الهوى وإشباع الشهوة وتحريف الدين الإسلامي، فاتخذوا وسيلةً أخرى لاستهداف النصوص الشرعية، فصاروا يقدِّمون أفكارهم المخالفة للشرع في قالب شرعيّ بتوظيف النصوص لترسيخ أفكارهم الهدّامة للدين الإسلامي، وادعاء الاعتدال والوسطية ومواكبة العصر والواقع، وأن ما كان صالحًا في زمن لم يعد صالحًا في هذا الزمن، ويدّعون أن الدافع لتغيير الخطاب هو حماية العقول من التَّطرف.
إنهم يعلمون يقينًا ما للنصوص الشرعية من قداسة في نفوس المسلمين؛ فغيروا الأسلوب وتحوّلوا من مصادمة النصوص إلى مسايرتها؛ وذلك بتجويفها من معانيها الدالة عليها، ودس أفكارهم وإعطائها الصبغة الشرعية ليتقبّلها الناس؛ لأن عامة الناس ليس لديهم القدرة والملكة على المعرفة التفصيليّة وتمييز الحق من الباطل، ولأن الناس يقبلون الفكرة بمجرد الموافقة الظاهرة للنص، ويردّون المعنى الصحيح بإظهاره مخالفًا للنص.
وهذه الورقة ستتناول شبهةً لطالما اتخذها أهل الضّلال والجهل مطعنًا في إدراك الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- وفهمهم، ونقدَها بالحجة والبراهين.
أولا: مفاد الشبهة ومستندهم فيها:
مفاد هذه الشبهة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أهل زمانه على قدر عقولهم، وهذا يدلّ على محدوديّة فهم الصحابة؛ بالتالي فلا يكون فهمهم ملزمًا لأهل العصور الأخرى، وأنه لا بد أن يكون لكل أهل عصر فهم للنصوص يوافق عصرهم.
ومستندهم في هذه الشبهة النصوص الآتية:
1- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كُنْتُ رِدْفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على حِمارٍ يُقالُ له عُفَيْرٌ، فقالَ: «يا مُعاذُ، هلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ على عِبادِهِ وما حَقُّ العِبادِ على اللَّهِ؟»، قُلتُ: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: «فإنَّ حَقَّ اللَّهِ على العِبادِ أنْ يَعْبُدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شيئًا، وحَقَّ العِبادِ على اللَّهِ أنْ لا يُعَذِّبَ مَن لا يُشْرِكُ به شيئًا»، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، أفَلا أُبَشِّرُ به النّاسَ؟ قالَ: «لا تُبَشِّرْهُمْ؛ فَيَتَّكِلُوا»([1]).
2- ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: “حَدِّثُوا النَّاسَ بما يَعْرِفُونَ؛ أتُحِبُّونَ أنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ ورَسولُهُ؟!”([2]).
3- ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: “ما أنْتَ بمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إلَّا كانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً”([3]).
ثانيا: وجه استدلالهم على شبهتهم:
أن كتم النبي صلى الله عليه وسلم خبرًا أوحي إليه دليل على أنه يحدّثهم على قدر فهمهم، وكذلك يؤكّد هذا المعنى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن قوله: “بما يعرفون” يعني على قدر عقولهم، وأن مقولة علي رضي الله عنه يوضّحها أكثر ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: “لا تبلغه عقولهم”، وهذا واضح في ضرورة مخاطبة أهل كلّ عصر بما يناسب عقولهم، وأننا حين نلزم الناس في كل العصور بفهم الصحابة فإننا نعطي لهذه العقول قدرة لم يعطهم إياها من هو أعرف بهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الإجحاف وتحجير الواسع.
ثالثًا: ما يترتب على هذه الشبهة من مفاهيم هدامة
قبل الردّ على هذه الشبهة لا بد لنا من ذكر ما ترتب عليها من مفاهيم خاطئة، وهي:
1- القدح في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئًا من الوحي.
2- القدح في فهم الصحابة، ولمزهم بخفّة العقل وضعف الإدراك، وهذا مخالف لما دل عليه النقل والعقل والتاريخ.
3- مساواة القرون المفضلة بغيرها، وهذا يخالف نصوصًا صريحة من الكتاب والسنة في تفضيلهم.
4- منازعة الصحابة في أهليتهم واستحقاقهم؛ لمعاصرة عهد النبوة وتنزل الوحي.
إن الله تعالى قد اختار أنبياءه من صفوة بني آدم كما قال: ﴿اللهُ أعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَه﴾ [الأنعام: 124]، فكذلك حين اختار أصحاب أنبيائه فقد اختارهم مِن خير الناس، وخاصة أصحاب آخرهم وخاتمِهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خير الأصحاب والأتباع كما قال فقيه الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “من كان منكم متأسِّيًا فليتأسَّ بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم كانوا أبرَّ هذه الأمَّة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلُّفًا، وأقومها هديًا، وأحسنها حالًا، قومًا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيِّه صلى الله عليه وسلم وإقامة دِينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم”([4]).
5- القدح في حكمة الله تعالى وعلمه؛ إذ لا يستقيم عقلًا أن ينزل الله تعالى القرآن على قوم لديهم قصور في فهم لغة القرآن، وقد قال الله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ءَاعْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ} [فصلت: 44].
بل يشهد الله تعالى لمن عاصر التنزيل أنهم أعلم الناس باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وأقواهم فهمًا لها، فقال تعالى: {وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ * وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ * أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ * وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ * فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ} [الشعراء: 192-198].
رابعًا: الرد على الشبهة وبيان بطلانها من أوجه:
الوجه الأول: تحرير المعنى الصحيح للنصوص التي استدلوا بها:
إن الفهم الذي فهمه المعاصرون الذين يرفضون الالتزام بفهم الصحابة وأهل العلم من القرون المفضلة لم يقل به أحد من علماء السلف، والمعنى الصحيح لهذه الآثار باختصار هو: مراعاة فهم عوام الناس ورعاعهم وإدراكهم، فهم ليس لهم اشتغال بالعلم، وليسوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ليفهموا مراداته، وليس المقصود في الآثار الصحابةَ وعلماءَ التابعين.
وفيما يأتي بيان ما يدلّ على أن هذا هو المقصود من هذه الآثار:
- معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم «لا تبشرهم فيتكلوا»:
ليس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه من تبشير الناس ما يدلّ على قصور أفهام الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم على قدر عقولهم، وسبب المنع كما ذكر العلماء هو الآتي:
أ- أن المنع كان في أول أمر الإسلام وقبل أن تفرض الفرائض، فعن الزهري أنه سئل عن الحديث: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» قال: حدثني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير أن ذلك كان قبل نزول الفرائض. وعن عطاء بن السائب قال: سأل هشام بن عبد الملك الزهري فقال: حدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق»، فقال الزهري: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ كان هذا قبل الأمر والنهى([5]).
ب- “حمل النهي على إذاعته للعموم، ورأى أن يخصّ به كما خصّه به عليه السلام، ولهذا ترجم البخاري عليه: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا”([6]).
قال المهلب: “فيه أنه يجب أن يخصّ بالعلم قوم لما فيهم من الضبط وصحّة الفهم، ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من الطلبة ومن يخاف عليه الترخص والاتكال لقصر فهمه، كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقد قال مالك بن أنس: إنما أراد ألا يوضع العلم إلا عند من يستحقه ويفهمه”([7]).
ج- وقال بعض العلماء: إن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبشِّرهم» مخصوصٌ ببعض الناس، وبه احتجَّ البخاري وبوَّب للحديث في صحيحه: “من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا”.
ومما يدل على أن الخبر اختصّ به النبي صلى الله عليه وسلم علماء الصحابة وكبارهم ممن لازموا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون مراداته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى رأيهم أحيانًا ما جاء عند مسلم في حديث طويل حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه ليبشر الناس بنفس البشارة التي في حديث معاذ رضي الله عنه، فأعاده عمر رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رَسولَ اللهِ، بأَبِي أنْتَ وأُمِّي، أبَعَثْتَ أبا هُرَيْرَةَ بنَعْلَيْكَ: «مَن لَقِيَ يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بها قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بالجَنَّةِ»؟ قالَ: «نَعَمْ»، قالَ: فلا تَفْعَلْ؛ فإنِّي أخْشَى أنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عليها، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: «فَخَلِّهِمْ»([8]).
- معنى أثر علي وابن مسعود رضي الله عنهما:
أثر علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما ما هما إلا نتاج التربية النبوية كما في حديث معاذ وأبي هريرة رضي الله عنهما، ففي أثر علي وابن مسعود رضي الله عنهما إرشاد بأنَّ على العالم مراعاةَ عقول الناس وأفهامهم، وما ينفعهم من العلم والمعرفة، ويترك ما قد يشتبه عليهم ويصعب عليهم فهمُه؛ لكيلا تكون ذريعة لتكذيب الله ورسوله، وعدم تصديقهما، وأن يخصّ بما قد يشكل طلبةَ العلم النابهين لا العوام.
“فعلم أن من الأحاديث التي قالها الله ورسوله أحاديث لا يطيق كلّ أحد حملها، فإذا سمعها من لا يطيق ذلك كذَّب الله ورسولَه، وهذا إنما يكون في ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلّم به، لا في خلاف ما قاله ولا في تأويل ما قال بخلاف ظاهره، فإن ذكر ذلك لا يوجب أن المستمع يكذِّب الله ورسوله، نعم نفس ذلك التأويل المخالف لقوله يكون تكذيبًا لله ورسوله، إما في الظاهر وإما في الباطن والظاهر، فلو أريد ذلك لكان يقول: أتريدون أن تكذبوا الله ورسوله، أو أن تظهروا تكذيب الله ورسوله؟! فإن المكذّب من قال ما يخالف قول الله ورسوله إما ظاهرًا وإما ظاهرًا وباطنًا، وعليه إنما خاف تكذيب المستمع لله ورسوله.
فإن قال: هذه التأويلات الباطنية قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للخاصة، قيل: هذا من الإفك المفترى الذي اتفق أهل العلم بالإسلام على أنه كذب، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه في الصحيح من غير وجه لما سأله من ظن أن عنده من الرسول علمًا اختص به، فبين لهم علي رضي الله عنه أنه لم يخصه بشيء”([9]).
قال ابن وهب في أثر ابن مسعود رضي الله عنه في معنى “إلا كان لبعضهم فتنة”: “وذلك أن يتأولوه غير تأويله، ويحملوه على غير وجهه”([10]).
وقال ابن حجر في قول علي رضي الله عنه: “وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة”([11]).
الوجه الثاني: مواقف الصحابة ومن تبعهم تبين أن المقصود في الآثار عوام الناس:
إن الناظر في سير السلف يجد أنهم على منهج واحد في مراعاة عقلية المتلقي ومدى تمكنه من تحمل النصوص الشرعية، وهو منهج نبوي تتوارثه الأجيال، فيحمل علماء كل جيل العلوم إلى من له أهلية التحمل، وليس لكل الناس، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا في حديث «خلق الله لآدم على صورته» حيث قال: “لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك، وهو أيضًا مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها، ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه، كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن يفسد عقله أو دينه، كما قال عبد الله بن مسعود: (ما من رجل يحدث قومًا حديثًا لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم)، وفي البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قال: (حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!)، وإن كان مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول مطلقًا؛ بل لا بد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك، ولهذا اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه”([12]).
وصنيع الصحابة وعلماء التابعين ومن بعدهم يدل على أنهم يبنون فروع العلم على أصوله حسب الأدلة الشرعية، وبفهم الصحابة لهذه النصوص، فهم من عاصروا التنزيل، وهم أعرف الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف الناس باللغة العربية، وهم نقلة الدين إلى العالمين، وسنورد جملة من هذه الآثار الثابتة والتي تدل على أن المقصود في الآثار التي استدلوا بها على شبهتهم هم عوام الناس ورعاعهم:
- فعن قرظة بن كعب رضي الله عنه أنه قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة، وشيّعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له: صرار، فقال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قال: قلنا: لحقِّ صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقّ الأنصار، قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم: إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدّوا إليكم أعناقهم، وقالوا: أصحاب محمد، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم([13]).
“وإن قال قائل: ما وجه إنكار عمر على الصحابة رضي الله عنهم روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديده عليهم في ذلك؟
قيل له: إنما فعل ذلك عمر احتياطا للدين، وحسن نظر للمسلمين؛ لأنه خاف أن ينكلوا عن الأعمال، ويتكلوا على ظاهر الأخبار، وليس حكم جميع الأحاديث على ظاهرها، ولا كل من سمعها عرف فقهها، فقد يرد الحديث مجملًا ويستنبط معناه وتفسيره من غيره، فخشي عمر أن يحمل حديث على غير وجهه، أو يؤخذ بظاهر لفظه والحكم بخلاف ما أخذ به، ونحو من هذا المعنى الحديث الآخر عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار له… -وأرد حديث معاذ وفيه:- «لا تبشرهم، فيتكلوا»“([14]).
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل تفسير آية فقال: “ما يؤمنك أني لو أخبرتك بها لكفرت بها؟! وكفرك بها تكذيبك بها”([15]).
- وعن ابن عمر ضي الله عنهما قال: “لا تسأل عمّا لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن”([16]).
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن الصحابة: “ما كانوا يسألون إِلا عما ينفعهم”([17]).
فكما أنهم لا يسألون إلا عما ينفعهم، ويُعرضون عما لا ينفعهم خشية أن يفتنوا، فإنهم أحرص الناس على من بعدهم؛ فلا يحدثونهم بما لا تبلغ عقولهم، وهذا عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِن الله حرم ثلاثًا، ونهى عن ثلاث… ونهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»([18]).
- وقال عكرمة: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: “انطلق فأفت الناس، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإِنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس”([19])، وهذا يدل على أنه نهج قويم متوارث عن السلف.
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “حَفِظْتُ مِن رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وِعاءَيْنِ: فأمّا أحَدُهُما فَبَثَثْتُهُ، وأَمّا الآخَرُ فلوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هذا البُلْعُومُ”([20]). والوعاء الذي كتمه ولم يبثه للناس إنما المراد به ما يقع من الفتن([21]).
- قال ابن حجر: “وعن حذيفة وعن الحسن رضي الله عنهما أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوّي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب”([22]).
- وقال ابن مفلح: “وسئل أحمد عن يأجوج ومأجوج: أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أَحْكَمتَ العلم حتى تسأل عن ذا؟ وسئل عن مسألة في اللعان، فقال: سَلْ -رحمك الله- عما ابتُليت به. وسأله مهنا عن مسألة، فغضب وقال: خذ -ويحك- فيما تنتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدثة، وخذ فيما فيه حديث. وسئل عن مسألة فقال: ليتنا نُحْسن ما جاء فيه الأثر”([23]).
- وقال ابن تيمية: “سأل بعضهم زر بن حبيش عن حديث ابن مسعود في صفة جبريل، وأن له ستمائة جناح، فلم يحدثه به؛ خوفًا أن لا يحتمله عقله فيكذب به. فهذا وأمثاله كثير موجود في بني آدم، تضعف قوى إدراكهم عن إدراك الشيء العظيم الجليل؛ لا كون الوهم والخيال لا يقبل جنس ذلك، ولكن لأجل ما فيه من العظمة التي لم يعتد تصور مثلها”([24]).
ومما سبق يتبين لنا المراد الصحيح من الآثار التي استدل بها أصحاب الشبهة، وتبين لنا جليًّا أن هذا لم يكن منهج علي وابن مسعود فحسب، بل هو منهج جميع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ومن اتبع نهجهم.
الوجه الثالث: اعتبار ما كان عليه الصحابة من كيفيات العبادات:
مما يدل على أن المعتمد في فهم النصوص هو ما فهمه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وأنه لا يمكن أن ينفك أحد عن فهم الصحابة ما ورد من النهي عن بعض الكيفيات التعبدية التي لم تعرف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم.
فعن حذيفة بن اليَمان رضي الله عنه قال: “كلُّ عبادةٍ لم يتعبَّدْها أصحابُ محمَّدٍ رضي الله عنه فلا تَعبَّدوها؛ فإنَّ الأوَّلَ لم يدَعْ للآخِرِ مَقالًا؛ فاتَّقوا اللهَ يا مَعشرَ القُرَّاءِ، وخذوا بطريقِ من كان قبلَكم”([25]).
وقال ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنه للخوارج: “أتيتُكم من عند أصحابِ النَّبيِّ: المهاجرينَ والأنصارِ، ومِن عند ابنِ عمِّ النَّبيِّ، وعليهم نزل القرآنُ؛ فهم أعلَمُ بتأويلِه منكم”([26]).
وسئل سفيان عن رجل يكثر قراءة: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص]؛ لا يقرأ غيرها كما يقرؤها، فكرهه، وقال: إنما أنتم متبعون، فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما أنزل القرآن ليقرأ، ولا يخص شيء دون شيء([27]).
وأيضًا: عن مالك أنه سئل على قراءة {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص] مرارا في الركعة الواحدة، فكره ذلك، وقال: هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا([28]).
ومحمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة، ولأجل ذلك لم يأت مثله عن السلف، وإن كانت تعدل ثلث القرآن كما في الصحيح، وهو صحيح([29]).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: “اتَّبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفِيتم”([30]).
وقال عمر بن عبد العزيز لمن سأله عن القدر: “فارضَ لنفسك ما رَضي به القومُ لأنفسهم، فإنهم على علمٍ وقَفُوا، وببصرٍ نافذٍ كفُّوا، وهم على كشفِ الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سَبقْتُموهم إليه، ولَئنْ قلتم: إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبعَ غيرَ سبيلِهم، ورَغِبَ بنفسه عنهم، فإنهم هم السَّابقون، فقد تكلَّموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مِن مَقْصَرٍ، وما فوقهم مِن مَحْسَرٍ، وقد قَصَّرَ قوم دونهم فجَفَوْا، وطَمَحَ عنهم أقوام فغَلَوْا، وإنّهم بين ذلك لعلى هدًى مستقيم”([31]).
الوجه الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بلزوم سنة الخلفاء الراشدين والصحابة:
أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأمرهم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ورتب على هذا اللزوم أنهم سيهتدون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، فكيف يكون لزوم سنة الخلفاء الراشدين إن لم نفهم النصوص بفهمهم؟! فهذا ضلال بين.
فعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباضَ بنِ ساريةَ وهو ممن نزل فيه: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ} [التوبة: 92] فسلَّمنا، وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسِين، فقال العرباضُ: صلى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذاتَ يومٍ، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظةً بليغةً، ذرفت منها العيون، ووجِلت منها القلوبُ، فقال قائلٌ: يا رسولَ اللهِ، كأن هذه موعظةُ مُودِّعٍ، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى اللهِ، والسمعِ والطاعةِ وإن عبدًا حبشيًّا، فإنه من يعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ المهديّين الراشدين، تمسّكوا بها، وعَضّوا عليها بالنواجذِ، وإياكم ومحدثاتِ الأمورِ؛ فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ»([32]).
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنِّي لا أدري ما قَدْرُ بقائي فيكُم، فاقتَدوا باللَّذَينِ مِن بعدي -وأشارَ إلى أبي بَكرٍ وعمرَ- واهتَدُوا بِهدْيِ عمّارٍ، وما حدَّثَكم ابنُ مسعودٍ فصدِّقوهُ»([33]).
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتينَّ على أمَّتي ما أتى على بني إسرائيل حَذوَ النَّعلِ بالنَّعلِ، حتَّى إن كانَ مِنهم من أتى أُمَّهُ علانيَةً لَكانَ في أمَّتي من يصنعُ ذلِكَ، وإنَّ بَني إسرائيل تفرَّقت على ثِنتينِ وسبعينَ ملَّةً، وتفترقُ أمَّتي على ثلاثٍ وسبعينَ ملَّةً، كلُّهم في النَّارِ إلَّا ملَّةً واحِدةً»، قالوا: مَن هيَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: «ما أَنا علَيهِ وأَصحابي»([34]).
- ما المقصود بسنة الخلفاء الراشدين وسنة الصحابة؟
“إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر باتباع سنن الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورة من أحد وجهين:
1- إما أن يكون صلى الله عليه وسلم أباح أن يسنوا سننًا غير سننه، فهذا ما لا يقوله مسلم، ومن أجاز هذا فقد كفر وارتدّ وحلّ دمه وماله؛ لأن الدين كله إما واجب أو غير واجب، وإما حرام وإما حلال، لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلًا، فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أباح أن يحرموا شيئًا كان حلالًا على عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، أو أن يحلوا شيئًا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يوجبوا فريضة لم يوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسقطها إلى أن مات، وكل هذه الوجوه من جوّز منها شيئًا فهو كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف، وبالله تعالى التوفيق فهذا الوجه قد بطل ولله الحمد.
2- وإما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنته صلى الله عليه وسلم، فهكذا نقول، ليس يحتمل هذا الحديث وجهًا غير هذا أصلًا”([35]).
- اعتبار فهم الصحابة هو المعيار والعلامة الفارقة بين الفرقة الناجية وفرق الضلالة:
لا شك ولا ريب أنه قد تكفل الله تعالى بحفظ دينه من التحريف والعبث، وكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ضبطا وحفظا، فما الحاجة لمعرفة سنة الخلفاء الراشدين وسنة الصحابة أجمعين؟ أليست سنتهم هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟!
بلى كل ذلك صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن اختلاف أمته وافتراقها جعل سنة الصحابة والخلفاء الأربعة هي بوصلة النجاة التي تحدّد الحق في أي الفرق؛ لأن كل هذه الفرق الضالة ستدَّعي اتباع الكتاب والسُّنة، وأنها الفرقة الناجية، وأنها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فحتى لا يغتر بدعواهم المسلمون ممن ليس لديهم القدرة على التمييز بين الحق والباطل؛ كان من رحمة الله تعالى بأمة الإسلام أن يلازموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الخلفاء الراشدين وسنتهم، وسنة الصفوة من أصحابه الآخرين مثل ابن مسعود وعمار وأُبَي ونحوهم، فأبطل حجتهم، وقطع عليهم سبيل الانحراف بالأمة.
والناظر في الفِرَق التي تنكبت الطريق يجدها مخالفةً لمنهج الصحابة الكرام، وهذا كاف في الاستدلال على أن فهم الصحابة من أصول الدين الحنيف.
الوجه الخامس: أن المعتبر من سنة الخلفاء الراشدين والصحابة هو مجموعهم، وليس بأفرادهم:
ولا أدلّ على هذا من كون الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- كانوا يختلفون في فروع المسائل، ويردّ بعضهم على بعض، وينكر بعضهم على بعض، ففهم الصحابة وسنتهم معتبرة بمجموعهم.
ويدلّ على ذلك قولُ ابنِ مسعود رضي الله عنه: “إنَّ الله نظَرَ في قلوب العباد، فوجد قلبَ محمَّدٍ خيرَ قلوبِ العباد، فبَعَثه برسالته، ثمَّ نظر في قلوبِ العبادِ بعد قلبِ محمَّدٍ، فوجد قلوبَ أصحابه خيرَ قلوبِ العباد، فاختارهم لصُحبةِ نبيِّه ونُصرةِ دينه؛ فما رآه المسلمون حَسَنًا فهو عند الله حَسَنٌ، وما رآه المسلِمون قبيحًا فهو عند اللهِ قبيحٌ”([36]).
وقول ابن مسعود رضي الله عنه: “فما رآه المسلمون حَسَنًا…” إشارة إلى أن المعتبر ما كان عليه مجموعهم، يعني (إجماع الصحابة)؛ وذلك يكون إما اتفاقًا أو سُكوتًا (الإجماع السكوتي).
والمقصودُ أنَّ الفهمَ الصَّحيحَ لنصوص الكتاب والسُّنَّة: هو الفهمُ الذي كان عليه الصَّحابة -رضوانُ الله عليهم- بمجموعهم، والصحابة لا يقرون فهمًا يخالف الكتاب والسُّنَّة.
فحاصل ما سبق أنَّ كل فهم للكتاب والسنة يخالف ما كانوا عليه بمجموعهم فهو فهم خاطئ، وأن المراد بحجيَّة فهم السلف إذًا إجماعهم وما اتَّفقوا عليه.
قال ابن تيمية رحمه الله: “ومذهبُ أهلِ السُّنَّة والجماعة مذهبٌ قديمٌ معروف قبل أن يخلُقَ اللهُ أبا حنيفةَ ومالكًا والشافعيَّ وأحمدَ؛ فإنَّه مذهبُ الصَّحابة الذين تلقَّوه عن نبيِّهم، ومن خالف ذلك كان مُبتدِعًا عند أهل السُّنَّة والجماعة؛ فإنَّهم مُتَّفِقون على أنَّ إجماعَ الصَّحابة حُجَّةٌ، ومتنازِعون في إجماعِ من بَعدَهم”([37]).
وقال: “ولا يجوز لأحدٍ أن يَعدِلَ عمَّا جاء في الكتابِ والسُّنَّة واتَّفق عليه سلفُ الأمة وأئمَّتُها إلى ما أحدثَه بعضُ النَّاسِ ممَّا قد يتضمَّنُ خلافَ ذلك، أو يوقِعُ الناسَ في خلاف ذلك، وليس لأحدٍ أن يضَعَ للنَّاسِ عقيدةً ولا عبادةً من عندِه، بل عليه أن يتَّبِعَ ولا يبتدِعَ، ويقتديَ ولا يبتدئَ”([38]).
الوجه السادس: التاريخ يشهد على أثر إلغاء فهم الصحابة في النصوص الشرعية:
على العقلانيين المعاصرين أن يتّعظوا ويأخذوا العبرة ممن سبقهم في النداء بإلغاء فهم الصحابة رضوان الله عليهم؛ كيلا يجروا مزيدًا من الويلات على أمة الإسلام.
فالتاريخ يشهد أن الأمة ما ظهرت فيها البدع والضلالات والانحرافات العقدية إلا يوم استقلت بفهم النصوص عن فهم الصحابة والسلف الصالح، وأعملوا أفهام كل عصر، بحجة عدم صلاحية أفهام القرون المفضلة للنصوص، وبحُجّة أنهم رِجال وهم رِجال، فإلى مسرد تاريخي يبين لنا خطورة الاستقلال عن فهم السلف للنصوص والخروج عن سنتهم:
- أوّل ما ظَهَر من البدع بدعة الخوارِج، ظهروا والصحابة متوافرون، وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيَكونُ في أُمَّتي اختِلافٌ وفُرْقةٌ، قومٌ يُحسِنونَ القيلَ ويُسيئونَ الفِعلَ، يَقرَؤونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ تَراقيَهُم، يَحقِرُ أَحدُكُم صلاتَهُ مع صَلاتِهِم وصيامَهُ مع صيامِهِم، يَمرُقونَ مِن الدِّينِ مُروقَ السَّهمِ مِن الرَّميَّةِ، لا يَرجِعُ حتّى يُرَدَّ السَّهمُ على فُوقِه، وهُم شِرارُ الخَلْقِ والخَليقَةِ، طوبى لمَنْ قَتَلَهُم وقَتَلوه، يَدْعونَ إلى كتابِ اللهِ وليْسوا منه في شيءٍ، مَنْ قاتَلَهُم كان أَوْلى باللهِ منهم»، قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما سيماهُم؟ قالَ: «التَّحْليقُ»([39]).
ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَدْعونَ إلى كتابِ اللهِ وليْسوا منه في شيءٍ» إشارة إلى أنهم يدعون إلى الكتاب والسنة ولكنهم ينفردون بأفهامهم.
- ومن البدع التي ظهرت بدعة نفي صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن، والتي جاءت بها المعتَزِلة، وأتوا بفهم لم يُسبقوا إليه.
- وظهرت القدرِيّة وأنكرت القَدَر، وحمل لواءها معبد الجهني، ثم غيلان الدمشقي.
- وانحرفت الأشاعرة بِفهمها، وأتوا ببدع في فهم صفات الله تعالى، وفي تقرير حقيقة الإيمان، وفي إثبات القدر والأسباب.
- وأتت الروافض بأفهام لا تنقضي، وخرجوا تمامًا عن مظاهر شعائر الإسلام نتيجة أفهامهم.
- وظهرت الباطنية، وادعت أن للنصوص معنى ظاهرًا ومعنى باطنًا.
وما زالت أمة الإسلام تنقسم وتفترق شيعًا وأحزابًا؛ لأن كل حزب بفهمهم فرحون، ورموا فهم السلف الصالح بالرجعية، وعدم القدرة على مواكبة العصر، وافترقت أيضًا بسبب قدحهم في الصحابة ومساواتهم بهم، فضلوا وأضلوا.
الوجه السابع: أهلية الصحابة وأسباب تقديم فهمهم على فهم غيرهم:
قال ابن أبي حاتم: “فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونُصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضِيهم له صحابةً، وجعلهم لنا أعلامًا وقدوة، فحفِظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل، وما سنَّ وشرع، وحكم وقضى، وندب وأمر ونهى، وحظر وأدب، وعوه وأتْقنوه، ففقِهوا في الدين، وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله، وتلقُّفهم منه واستنباطهم عنه، فشرَّفهم الله عز وجل بما منَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة”([40]).
ختامًا: نختتم ورقتنا هذه بمجموعة من النتائج التي توصلنا إليها، وهي:
1- العقلانيون المعاصرون تحولوا من مصادمة النصوص إلى مسايرتها؛ وذلك بتجويفها من معانيها الدالة عليها، ودس أفكارهم وإعطائها الصبغة الشرعية ليتقبلها الناس.
2- يترتب على هذه الشبهة مفاهيم هدامة، ومنها:
- القدح في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئًا من الوحي، وأنه قصر في تبيينه.
- لمز الصحابة رضي الله عنهم بخفّة العقل وضعف الإدراك والفهم.
- مساواة القرون المفضلة بغيرها.
- عدم أهلية الصحابة واستحقاقهم لمعاصرة عهد النبوة وتنزل الوحي.
- القدح في حكمة الله تعالى وعلمه.
3- ليس في النصوص التي استدل بها أصحاب الشبهة ما يؤيد فكرتهم، والمعنى الصحيح لتلك النصوص: مراعاة فهم عوام الناس ورعاعهم، فهم ليس لهم اشتغال بالعلم، وليسوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ليفهموا مراداته، وليس المقصودُ في الآثار الصحابةَ وعلماء التابعين.
4- قول علي رضي الله عنه فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة.
5- الفتنة المقصودة في أثر ابن مسعود رضي الله عنه هي: أن يتأولوه غير تأويله، ويحملوه على غير وجهه.
6- من تتبع آثار السلف الصالح يجد أنهم على منهج واحد في مراعاة عقلية المتلقي ومدى تمكنه من تحمل النصوص الشرعية، وهو منهج نبوي توارثه العلماء.
7- المعتمد في فهم النصوص هو ما فهمه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، ولا يمكن أن ينفك أحد عن فهم الصحابة لما ورد عن السلف من النهي عن مخالفة بعض الكيفيات التعبدية لما كانت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم.
8- أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأمرهم بلزوم سنته مقترنًا بسنة الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم، ورتب على هذا اللزوم أنهم سيهتدون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف.
9- المقصود بسنة الخلفاء الراشدين وسنة الصحابة اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة.
10- اعتبار فهم الصحابة هو المعيار والعلامة الفارقة بين الفرقة الناجية وبين فرق الضلالة.
11- المعتبر من سنة الخلفاء الراشدين والصحابة هو بمجموعهم، وليس بأفرادهم.
12- كل فهم للكتاب والسنة يخالف ما كان عليه الصحابة بمجموعهم فهو فهم خاطئ، والمراد بحجيَّة فهم السلف: إجماعهم وما اتَّفقوا عليه.
13- التاريخ يشهد على خطورة إلغاء فهم الصحابة وإعمال العقل مجردًا في النصوص الشرعية.
14- من وجوه الرد على الشبهة: إبراز أهلية فهم الصحابة وتقديم فهمهم على فهم غيرهم إطلاقًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([4]) ينظر: جامع بيان العلم، لابن عبد البر (2/ 947).
([5]) ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (1/ 207-208).
([7]) ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (1/ 207-208).
([9]) بيان تلبيس الجهمية (2/ 117-119).
([10]) ينظر: الاعتصام (1/ 489).
([12]) بيان تلبيس الجهمية (6/ 373-374).
([13]) أخرجه ابن ماجه (28)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (26).
([14]) شرف أصحاب الحديث، للخطيب البغدادي (ص: 89).
([15]) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ 76)، وتفسير ابن كثير (4/ 386).
([16]) أخرجه الدارمي (1/ 47)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 170).
([17]) أخرجه الدارمي (1/ 48)، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 77-78): “بإِسناد حسن”.
([19]) ينظر: الآداب الشرعية، لابن مفلح (2/ 80).
([21]) ينظر: فتح الباري (1/ 272).
([24]) بيان تلبيس الجهمية (1/ 363).
([26]) أخرجه النسائي (8575)، وحسنه الوادعي في الصحيح المسند (٧١١).
([27]) ينظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 490).
([28]) ينظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 491).
([29]) ينظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 490-491) بتصرف.
([30]) أخرجه أبو خيثمة في العلم (54)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٨٦): “رجاله رجال الصحيح”.
([32]) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، قال العراقي في الباعث (1): “صحيح مشهور”.
([33]) أخرجه الترمذي (٣٧٩٩)، وابن ماجه (97)، وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 579).
([34]) أخرجه الترمذي (٢٦٤١)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1348).
([35]) الإحكام في أصول الأحكام (6/ 77-78).
([36]) أخرجه أحمد (٣٦٠٠)، وقال أحمد شاكر في تخريج المسند (٥/ ٢١١): “إسناده صحيح”.
([37]) منهاج السنة النبوية (2/ 406).