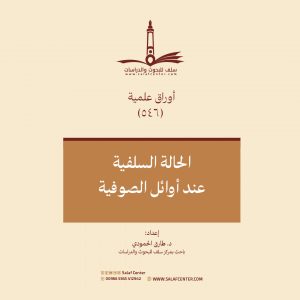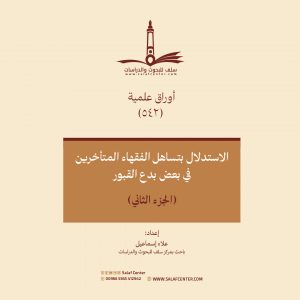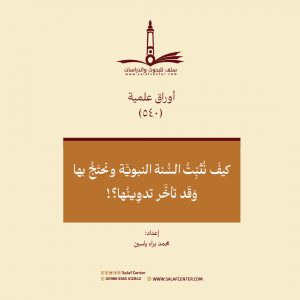الحكمة من تقدير الآلام والمصائب
تمهيد:
لماذا يُسَلَّطُ الكفارُ على المسلمين فيقتلونهم ويعذبونهم ويشرّدونهم؟!
ولماذا يُدال الكفار على المسلمين ولا تكون الغلبة لأهل الإسلام دومًا؟!
ولماذا لا ينتقم الله تعالى من الكفار والمجرمين الذين يقتلون أولياءه ويفتنونهم؟!
ولماذا يقع هذا الشر والفساد مع أن الله تعالى لا يحب الفساد؟!
ما الحكمة من تقدير الآلام بتسليط الكفار على خير الأنام؟!
كل هذه الأسئلة وما شابهها تُثار كلما يتعرض المسلمون في أنحاء الأرض لنكبة من النكبات، أو حينما يتعرضون لبلاء عظيم بتسليط أهل الكفر والشرك عليهم.
وهذا السؤال قديم من لدن خلق آدم الله عليه السلام، حينما علمت الملائكةُ أنه سيقع من بني آدم فسادٌ في الأرض -وأعظمه سفك الدماء- فقالوا: ﴿أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 30].
قال ابن كثير رحمه الله: “هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك”([1]).
فإذا كانت الملائكة استشكلت الحكمة من وجود الشر وسفك الدماء مع شدة إيمانهم وتسليمهم، فكيف بغيرهم؟!
وقد أجابهم الرب سبحانه وتعالى بقوله: ﴿إِنِّي أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾، وهو الجواب الذي يجب أن يبدأ به، وينتهي إليه كل باحث عن حكمة الرب سبحانه وتعالى، فحكمته عز وجلّ لا يحيط بها المخلوق مهما بلغ علمه وعقله، قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمًا﴾ [طه: 110]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡء مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ [البقرة: 255].
وإذا كان علم الإنسان بالنسبة لعلم الرب لا يساوي شيئًا، فواجب العبد التسليم بالحكمة، والرضا بالقضاء والصبر عليه.
قال تعالى: ﴿وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡئًا وَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 216].
وإذا كان الأمر كذلك، فواجب العبد أن يقف عند حدّه، ولا يسأل ربه سؤال المعترض أو الشاكّ؛ فإن هذا من فرط جهله وضعف عقله.
قال تعالى: ﴿لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ﴾ [الأنبياء: 23]، أي: لا يسئل عما يفعل لكمال علمه وحكمته، وليس فقط لكمال قهره وقوته، كما يحتج بذلك الجبرية من الأشاعرة نفاة الحكمة والتعليل، فاحتجوا بالآية على نفي الحكمة والتعليل، وإنما هي في إثبات تمام ملك الله وحمده، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، وله فيما خلقه حكمة بالغة، ونعمة سابغة، ورحمة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره، بل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته“([2]).
الإشارة إلى جوابين خاطئين عن هذا السؤال:
من الأجوبة الخاطئة على مسألة الشر في الوجود: الجواب على طريقة أهل البدع من أهل الكلام، المتضمن لنفي حكمة الرب سبحانه وتعالى، أو إطلاق بعض العبارات كقولهم: إنه لا يجب على الله تعالى شيء، أو إن النظر في الحكمة هو من خصائص أفعال العباد، أما أفعال الرب فلا. فهذه كلها أجوبة فاسدة ليست على طريقة أهل السنة، بل على طريقة الجبرية والأشاعرة نفاة الحكمة.
وأفسد منه في الجواب ما كان على طريقة المعتزلة نُفاة خلق الله لأفعال العباد، وكثير من المعاصرين ممن يتصدون للجواب عن معضلة الشر ربما وجد في جواب المعتزلة مخرجًا، فينفي أي سلطان لله تعالى على أفعال العباد، وأن الله تعالى بيّن الخير والشر، ورغّب ورهّب، ودعا للصراط المستقيم، وأما من اهتدى أو ضل وفعل الشر فهذا بمحض اختياره، ولا سلطان لله على فعله.
فهذا جواب أفسد من الذي قبله، فهؤلاء لم يقروا بتمام ملكه، ومن قبلهم لم يقروا بتمام حمده.
وإنما الجواب الصحيح على طريقة أهل السنة، الجامع بين إثبات ملك الله وحمده أن نقول:
إن الله تعالى خالق الخير والشر، والعباد هم الذين يفعلون الخير أو الشر بمشيئتهم التي خلقها الله تعالى لهم، من غير أن يكرههم على فعل الخير أو الشر، كما قال تعالى ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: 30]، فأثبت للعباد مشيئة بها تقع أفعالهم، ولكنها تحت قدرة الله تعالى ومشيئته.
وخلْقُ الله للشر ليس شرًّا؛ لأن الشر الموجود في هذا العالم هو شر نسبي إضافي، ولكنه يترتب عليه أنواع من الخير لا يحصيها ولا يحيط بها إلا الله تعالى.
فليس في العالم شرٌّ محضٌ، بل ما يخلقه تعالى من الشر يترتب عليه أنواع من الخير التي يحبها الله تعالى. ولذلك خلق الله تعالى للشر ليس شرًّا، فليس في فعله تعالى شرٌّ أبدًا، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح قيام الليل: «وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ»([3]). أي: ليس في فعله تعالى شرٌّ أبدًا، كما أنه ليس في ما خلقه شرٌّ محض، بل شر من بعض الوجوه، وخير من وجوه أخرى.
ومن ذلك: تسليط الكفار على المسلمين، فإنه شر لا يحبه الله تعالى، ولا يرضاه شرعًا، مع كونه واقعًا بمشيئته سبحانه وتعالى؛ لما يترتب عليه من أنواع الخير والعبوديات التي يحبها الله تعالى، فمن ذلك:
- ظهور أنواع من العبادة لا توجد إلا عند وجود الكفار وتسليطهم على المؤمنين، كالجهاد في سبيل الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله وعلى الابتلاء في الدين، واتخاذ الشهداء، وغيرها من العبادات التي لا توجد إلا إذا انقسمت الخليقة لمؤمنين وكافرين، وبهذا يحصل الاختبار والابتلاء.
ولذلك قال تعالى للملائكة جوابًا على سؤالهم {إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ}، قال ابن كثير رحمه الله: “فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء والعاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم”([4]).
وهذه العبادات التي توجد من بني آدم لا توجد من الملائكة، فالملائكة يعبدون الله تعالى بلا منازعة من داخلهم ولا من خارجهم، فنفوسهم مجبولة على فعل الخير، لا تتوجه إلى الشر، وهذا وإن كان محبوبًا لله، إلا أن الله تعالى يحب العبادة مع وجود المنازعة والمجاهدة ومخالفة الهوى أكثر، ولذلك كلما عظم داعي المعصية عظُم الثواب عند التعفف عنها، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله([5]).
فالله تعالى يحب الجهاد، ويحب أن يرى من عباده الصبر على الدين والثبات عليه، مع كون القابض على دينه كالقابض على الجمر.
والله عز وجل يحب أن يتخذ من عباده الشهداء، ويحب أن يرى من عباده من يبذل نفسه وماله في سبيل الله، فكيف يوجد كل ذلك إلا بانقسام الخليقة لمؤمنين وكافرين، وتسليط الكفار على المسلمين؟!
فهذا هو الذي يحصل به معنى الابتلاء الذي أقام الله تعالى الدنيا عليه، فالدنيا دار ابتلاء، قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَى ٱلۡأَرۡضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبۡلُوَهُمۡ أَيُّهُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: 7]، وقال تعالى: ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: 2].
ولو كانت الغلبة والدولة لأهل الإيمان دائمًا، وكان كلما ظُلِم أولياؤه انتقم مباشرة لهم، واتبع الناس جميعًا المرسلين، لما كان هناك معنى للابتلاء أصلا، ولزال معنى وجودنا في هذه الحياة.
ولذلك قدّر الله تعالى أن تكون الأيامُ دولا بين الناس، كما قال تعالى في الآيات العظيمة من سورة آل عمران التي أنزلها بعد غزوة أحد، وبين فيها بعضًا من حكمته في ما حصل لهم، وكشف لهم بعضًا من المصالح العظيمة التي ترتبت على هذا الشر والمصاب الذي أصابهم، فقال تعالى: ﴿إِن يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٌ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٌ مِّثۡلُهُۥۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَآءَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِين﴾ الآيات [آل عمران: 140].
فبين عز وجل بعضًا من المصالح والحكم فيما جرى لهم، مثل:
- ليعلم الله الذين آمنوا: وهو سبحانه وإن كان يعلمهم من قبل حدوث ذلك، إلا أنه أراد أن يظهر أثر علمه السابق، فيصير علمه بذلك علم شهادة، أي: يعلمهم علمًا يحاسبهم عليه، بعد أن كان علم غيب.
- ومنها: اتخاذ الشهداء واصطفاؤهم، وبيان ما لهم من المنازل العالية عند الله تعالى.
- ونبه بقوله تعالى: {وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِين} على أنه لم يسلطهم عليكم؛ لأنه يحبهم، بل هو لا يحب الظلم ولا الفساد، ولا يرضاه شرعا، وإنما لحِكَم تترتب على ذلك.
- ومنها: تمحيص المؤمنين: بأن يطهرهم في نفوسهم وفي صفوفهم، فيطهرهم في نفوسهم من الكبر والغرور والركون للدنيا والتوكل على العدد والعدة وغيرها من الأمراض التي تنشأ من النصر الدائم، كما حدث في مبادئ غزوة حنين حينما أعجبتهم كثرتهم، وقالوا: لن نهزم اليوم من قلة، فجرى لهم ما هو معروف، فاستكانوا لربهم وتابوا إلى ربهم، فتاب عليهم وغفر لهم.
ويمحصهم كذلك من المنافقين الذين دخلوا في صفوفهم، فبعد غزوة بدر دخل كثير من المنافقين في الإسلام، ورأوا أنه أمرٌ قد توجَّه، فلما جاء يوم أحد ظهر المنافقون على حقيقتهم، فعرفهم المؤمنون، ونُقِّيت الصفوف وتمايزت، ويا لها من فائدة عظيمة!
- ومنها محق الكافرين: بأن يستدرجهم، حتى يفعلوا ما يستحقون به المحق والهلاك.
- ثم بين سبحانه وتعالى أن الابتلاء وزلزلة المؤمنين هي سنته الماضية؛ لاستخراج الصبر والجهاد والعبادات التي يحبها الله تعالى.
- ومنها: تعريفهم سوءَ عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك.
والآيات إلى آخر السورة في حِكَم ذلك([6]).
والغرض من ذكر المثال حتى يقاس عليه ما سواه.
وخلاصة القول: هي في قوله تعالى: ﴿وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٍ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ * سَيَهۡدِيهِمۡ وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ * وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ﴾ [محمد: 4-6].
فلله الحكمة البالغة في ما قضى وقدر، وفي ما أمر وشرع، له الملك وله الحمد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) تفسير القرآن العظيم (1/ 124).
([4]) تفسير القرآن العظيم (1/ 124-125).
([5]) أخرجه البخاري (6806)، ومسلم (1031).
([6]) ينظر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (3/ 253-283) عند حديثه في غزوة أحد عن الفوائد والحكم التي تضمنتها هذه الغزوة، فقد أجاد وأفاد رحمه الله.