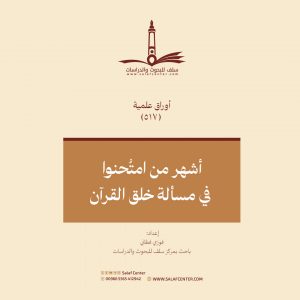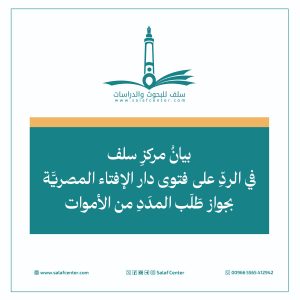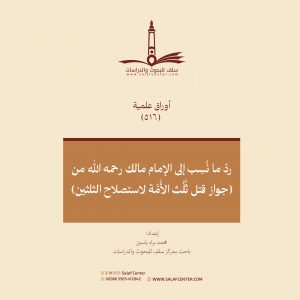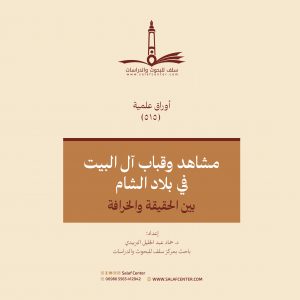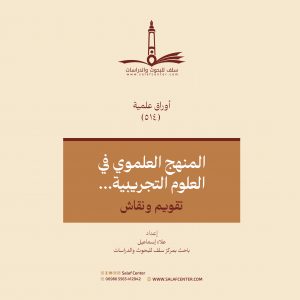المصلحة بين ضبط أهل الأصول وفوضى المتأخِّرين
جاءت الشريعة بالمصالح وتكميلها، وجعلتها مقصدًا من مقاصد التشريع التي لا يمكن تجاوزها، وراعتها في جميع التكاليف الشرعية، فما من تكليف إلا والشريعة تراعي فيه المصلحة من جهتين: من جهة تحصيلها، ومن جهة درء ما يعارضُها من مفاسد متحقِّقة ومظنونة.
والمصلحة المعتبرة شرعًا قد أخرج الفقهاء منها اتباعَ الهوى وتأثيرَ الشهوات، وذلك بمقتضى النصوص الشرعية المخرجة لهما عن هذا المعنى؛ لأن الوحي والهوى لا يجتمعان، قال سبحانه: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4]، وقال سبحانه: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُون} [الجاثية: 18].
وقد لخَّص ابن عاصم -رحمه الله- مفهوم المصلحة المناقضة للهوى بقوله:
| الْقَصْدُ بِالتَّكْلِيفِ صَرْفُ الْخَلْقِ | عَنْ دَاعِيَاتِ النَّفْسِ نَحْوَ الْحَقِّ |
| وَهْوَ عَلَى الْعُمُومِ وَالإِطْلَاقِ | في النَّاسِ وَالأَزْمَانِ وَالآفَاقِ |
| وَشَرْعُهُ لِقَصْدِ أَنْ يُقِيمَا | مَصَالِحَ الْخَلْقِ لِتَسْتَقِيمَا |
| أَمْرًا وَنَهْيًا بِاعْتِبَارِ الآجِلِ | وَقَدْ يَكُونُ باعتبار العَاجِلِ |
| مِنْ حَيْثُ سَعْيُهُمْ لأخرى تَاتِي | لَا جِهَةِ الأَهْوَاءِ وَالْعَادَاتِ |
| وَكَمْ دَلِيلٍ لِلْعُقُولِ وَاضِحِ | عَلَى الْتِفَاتِ الشَّرْعِ لِلْمَصَالِحِ |
| وَمَا أَتَىٰ في مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ | في مَعْرِضِ الْمِنَّةِ وَالتَّعْلِيلِ |
| كَقَوْلِهِ جَلَّ: «يُرِيدُ اللهُ» | غَالِبُهُ ذَٰلِكَ مُقْتَضَاهُ |
| وَفي الْمَفَاسِدِ مَعَ الْمَصَالِحِ | دَفْعًا وَجَلْبًا مَيْلُهُ لِلرَّاجِحِ |
| وَمِنْ كِلَا الضَّرْبين مَا لَا يُـعْـتَبَرْ | لِكَوْنِهِ في عَكْسِهِ قَدِ انْغَمَرْ |
| وَمَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالأُخْرَىٰ | فَهْوَ بِتَقْدِيمٍ لَدَيْهِ أَحْرَىٰ([1]) |
قرَّر -رحمه الله- فائدة التكليف ومقتضاه، وأنها صرف الناس عن اتباع الهوى والعادات إلى اتباع الشرع، وأن الشرع قاصد للمصلحة، والمصلحة التي قصدها الشارع تكون مصلحة دنيوية وأخروية، والمصلحة الدنيوية تابعة للمصلحة الأخروية؛ لأن المصلحة الأخروية أدوم وانفع.
وهذا الكلام الذي نظم ابن عاصم -رحمه الله- أصله منثور عند الشاطبي في الموافقات حيث يقول رحمه الله: “فإذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، فذلك على وجه لا يختلّ لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات، فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختلَّ نظامها أو تنحلَّ أحكامها لم يكن التشريع موضوعًا لها؛ إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد، لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق، فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديًّا وكلِّيًّا وعامًّا في جميع أنواع التكليف والمكلفين من جميع الأحوال”([2]).
وقد استدلَّ على إرادة الشارع للمصلحة بآيات قرآنية نصَّت على هذا المعنى، وجعلته علة للتكاليف، منها قوله تعالى: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وقوله تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وقوله: {يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28].
وقد لخص العلماء معنى المصلحة والمفسدة التي اعتبرها الشارع في المعاني الآتية: قال العز ابن عبد السلام: “فالمصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها. وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية.
فأما لذات الدنيا وأسبابها وأفراحها وأسبابها وآلامها وأسبابها وغمومها وأسبابها فمعلومة بالعادات.
وأما لذات الآخرة وأسبابها وأفراحها وأسبابها وآلامها وأسبابها وغمومها وأسبابها فقد دل عليها الوعد والوعيد والزجر والتهديد.
فأما اللذات ففي ممثل قوله: {يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُون} [الزخرف: 71].
وأما الأفراح ففي مثل قوله: {فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا} [الإنسان: 11]، وقوله: {فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون} [آل عمران: 170].
وأما الآلام ففي مثل قوله تعالى: {فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُون} [البقرة: 10].
وأما الغموم ففي مثل قوله تعالى: {كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيق} [الحج: 22].
فهذه هي قاعدة المصالح والمفاسد التي تعرف بها”([3]).
وبنحو هذا القول قال الامام ابن القيم: “فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلُّها، ورحمة كلُّها، ومصالح كلُّها، وحكمة كلُّها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدِّها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتمَّ دلالة وأصدقها”([4]).
ويقول الشاطبي: “ما فُهم رعايته في حقِّ الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقلُّ العقل بدركه على حال”([5]).
وتنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها ثلاثة أقسام:
المصلحة المعتبرة: وهي المصلحة التي شهد الشارع باعتبارها؛ كمصلحة الجهاد، ومصلحة قطع يد السارق، ومصلحة النظر إلى المخطوبة وغيرها([6]).
المصلحة الملغاة: وهي المصلحة التي شهد لها الشرع بالبطلان([7])؛ مثل مصلحة المرابي في زيادة ماله، فقد ألغاها الشارع، قال الله تعالى {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. ومثل المصلحة الموجودة في الخمر والميسر، والتي ذكرها الله تعالى في قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُون} [البقرة: 219]، ومع ذلك ألغى الشارع هذه المصلحة لوجود المفاسد الكبيرة في الخمر والميسر، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} [المائدة: 90].
المصلحة المرسلة: وهي المصلحة التي سكت عنها الشارع، فلم يَرِد طلبُها ولا إلغاؤها، وهذا النوع له شروط وضوابط وتفاصيل ليس هذا موضعها.
وهذا الضبط من الفقهاء والأصوليين لمعنى المصلحة ناتج عن الجدية العلمية في تناول النصوص الشرعية والتنزل على دلالاتها ومحاولة الاستقراء التام لها؛ من أجل الاستنباط الصحيح للأحكام الشرعية المستخرجة منها، ولكن يقابل هذه الجدِّيَّة كسل معرفي اتَّسم به كثير من الباحثين في الشريعة، وخصوصًا في هذا المورد، فجعلوا المصالح أداة لتعطيل النصوص والتملُّص من حاكميتها لصالح المصالح الموهومة، ورجعوا في تحديد المصلحة إلى اعتبارات لم يضع لها الشارع أيَّ اعتبار، وما اعتبر الشارع منها لكن جعله تبعيًّا جعلوه هم أصليًّا، فقد أغفلوا المصالح الأخروية ولم يعطوها أيَّ اعتبار، وأخرجوا العلة من الاعتبار الشرعي، وأناطوا الحكم بمجرد المصلحة والتي لم يعطوها مفهومًا محدَّدًا، ولم يضبطوها بضابط دقيق، لا من العقل ولا من الشرع، وتركوا الأمر موكولًا إلى ما تهوى الأنفس.
ويظهر الفرق بين ضبط الأصوليين وفوضى المتأخرين في الإنتاج المعرفي المبني على التنظير سالف الذكر، فقد استطاع الأصوليون من خلال تنظيرهم للمصلحة وضبطهم لها بناءَ كثير من الأحكام عليها في شتى المجالات من عبادات وعادات ومعاملات، بينما بقي المتأخِّرون يراوحون أمكنتهم، ويتعاطون الفشل المعرفي، ولا يتجاوزون العناوين المشاغبة، دون أيِّ إنتاج علمي يذكر، فليس لهم ذكر في مباحث العبادات ولا في المعاملات، وليس لأحد منهم كتاب يتجاوز حجم المتوسّط في عموم الدين، والمقبول من هذا المتوسط تحت المتوسِّط، بل تحت المقبول، بينما الأصوليّون ألَّفوا عشراتِ المجلدات في شتى المجالات، ولا يمكن تجاوز أيِّ شيء من إنتاجهم على كثرته، بينما المتأخرون جلُّ إنتاجهم مستغنًى عنه على قلته.
ــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([3]) القواعد الكبرى (1/ 15-16).