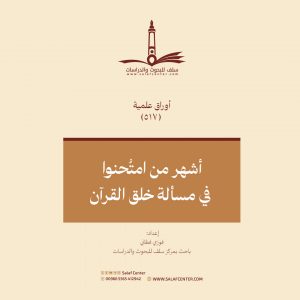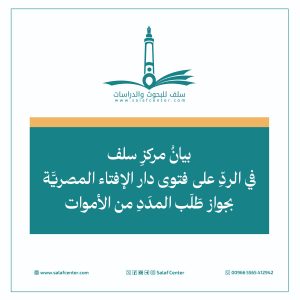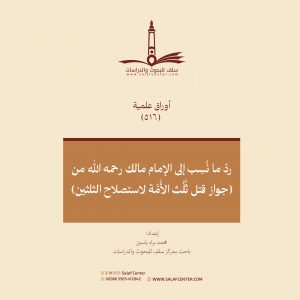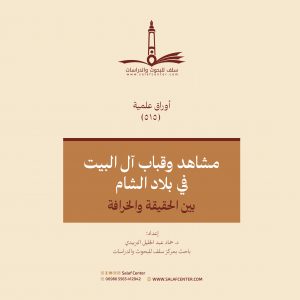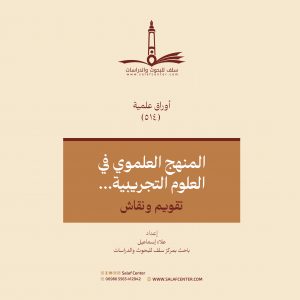المنهج السلفيُّ وتجديد الفِقه
منَ الدعواتِ التي قامَت على قدمٍ وساقٍ في العصر الحديث منذ بداية القرن المنصَرم الدعوةُ إلى تجديد الفقه الإسلاميِّ، وعلى الرغم من كون التجديد مصطلحًا شرعيًّا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا أن الدعواتِ التي نادت بتجديد الفقه كان أغلبُها في حقيقتها تجاوزًا لثوابت الدين([1])؛ ولذا تباينت المواقف تجاهَ هذه القضيةِ بين القبول والرد([2])، ونحن في هذا المقال نحاول أن نبيّنَ في عجالةٍ معنى التجديد المقبول ومعناه المردود، وبالله أستعينُ وعليه أتوكَّل.
اتِّجاهات التجديد المعاصرة:
لقد تعدَّدت اتِّجاهات التجديد في هذا العصر؛ وذلك بحسب مفهوم هذا المصطلح وما يحتاجه الواقع منه، فكان منها:
الاتجاه الأول: من يستعمل التجديدَ بمعنى التطوير، فالتجديد عندهم معناه إحلال الجديد محلَّ القديم، سواء كان بالوسائل الثورية، أو بالوسائل التي تأخذ من القديم بطرف ومن الجديد بطرف([3]).
وهؤلاء يرونَ الأمَّةَ بحاجة إلى فقهٍ جديد تمامًا، وأنَّ الأحكام الفقهيةَ الموجودة لا تناسبُ الواقعَ، فضلًا عن كونها نتاجَ صراعات مذهبيَّةٍ وسياسية، فمعالم التجديدِ عندهم تتمثَّل في الاستقلال بفهم الكتاب والسنة من خلال قواعدَ جديدةٍ تلائم متغيِّرات الواقع وإملاءاته([4]).
فمعنى التجديد عند هؤلاء يتلخَّص في أنه تطويرٌ للدين بما يتناسب مع الواقع العالميِّ الجديد.
وهؤلاء في الحقيقةِ هم الظهيرُ الشرعيُّ للعلمانيين، فهم من يسوِّغون باطلَ القول وسيِّئه بأن هذا هو مقتضى التجديد في الدين([5]).
ومن هؤلاء: حسن حنفي، ونصر حامد أبو زيد، ومحمد عشماوي، ومحمد عابد الجابري، ومحمد أركون، وغيرهم.
الاتجاه الثاني: من يرى أنَّ التجديدَ معناه الاجتهاد، ومجالُه هو الأدلة الظنّية، لكنهم يوسِّعون جدًّا فيما يقبَل الاجتهاد، فلا مانعَ من إعادةِ النظر في الأحكام الاجتهاديّة للأخذ بالأيسر والأوفق للعصر، وعدم التقيُّد بالأحكام إلا ما أجمع عليه الفقهاء، ومنهم من يستدلُّ بالخلاف على جواز الأفعال، وكذلك منهم من يسوِّغ الانفكاكَ من كثير من الأحكام الفقهيَّة العملية بدعوى أنها أحكامٌ فرعيَّة جزئية تعارض مقاصدَ أسمى كلِّيَّةً.
وهذا الاتجاهُ هو الغالب على من يكتبون في ضوابط التجديد المعاصر، مثل: جمال عطية([6])، ومحمد الدسوقي([7])، ومحمد سليم العوا([8])، وغيرهم.
والملاحَظ أن كلَّ اجتهاداتهم تميل إلى مسايرةِ العصر والتبرير له -رغم أنهم ينكرون ذلك على أصحاب الاتّجاه الأوَّل-، ومن أمثلة ذلك القول بجواز كشف المرأة لشعرها وذراعَيها وساقَيها، فضلًا عن وجهها وكفَّيها؛ بدعوى أنه قد حصَل خلاف في كلّ هذه الأمور، ولا يلزمنا سوَى ما أجمع عليه الفقهاءُ فقط، والالتزام بتغطية هذه الأمور يعارض مقصدَ الحرية!([9]).
وأصحاب هذين الاتِّجاهين يستدلُّون على دعواهم ومواقفهم بثلاثِ قضايا رئيسيَّة:
الأولى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن اللهَ يبعث للأمة من يجدِّد لها دينها على رأس كل مائة عام.
الثانية: ما قرَّره العلماء من أنه لا ينكر تغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان.
الثالثة: أنَّ اعتبار المقاصد مقدَّم على اعتبار ما دونها عند التعارض.
وقد أُفردت أوراق علمية للقضية الثانية([10]) والقضية الثالثة([11])؛ لذا سيكون حديثُنا في هذا المقال عن القضية الأولى، وهي: معنى التجديد.
معنى تجديد الدين عامَّة والفقه خاصّة:
التجديد في اللّغة: مِن جدَّد الشيءَ: إذا صيَّره جديدًا([12])، فمعناه: إعادة الشيء إلى حالته الأولى، وإزالةُ ما حصل بسبب القدُّم عنه، ومنه تجديد الثوب، أو إعادته ليكونَ على أكمل هيئاته، ومنه تجديد الوضوء.
إذن فالتجديدُ معناه: أن يكونَ الشيء على حالةٍ ما، ثم طرأ عليه ما غيَّره وأبلاه، فإذا أعيد إلى مثل حالته الأولى التي كان عليها قبل أن يصيبَه البلى والتغيير كان ذلك تجديدًا([13]).
وعلى هذا المعنى اللغوى فهِم العلماء معنى التجديد في الحديث الذي رواه أبو هريرة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله يبعث على رأسِ كلِّ مئة سنة من يجدِّد لها دينها»([14]).
قال العلقمي: “معنى التجديدِ: إحياء ما اندرسَ من العمَل بالكتاب والسنة، والأمر بمقتضاهما”([15])، وقال ابن رسلان مبيِّنًا معنى التجديد في الحديث: “يصحِّح لها أحكام دينها”([16])، وقال ابن الملك الرومي: “بأن يعلِّمهم علومَ الدين، ويبيِّن لهم السنة عن البدعة، ويكسر أهل البدعة ويذلهم، ويؤيّد الدين، ويعزّ أهله، ويكثر العلم بين الناس”([17]).
وهذا المعنى المذكور هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله؛ ينفون عنه تحريفَ الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين»([18]).
وعلى ذلك فمعنى التجديد المذكور في الحديث يشمل:
– إحياء ما طمس واندرس من معالم الدين، سواء كان مجاله القطع أو الظنّ، وسواء خالف أعراف الناس وعوائدهم أو لا.
– بيان البدع والمحدثات وإبطالها وإنكارُها، والعودة بالدين إلى الصورة الأولى النقيَّة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم.
– بيان الأحكام الشرعيَّة في النوازل، وتنزيل الأحكام الفقهية على الواقع؛ لبيان حكم الله تعالى في الحوادث.
هذه هي المعاني التي تدور عليها تفسيرات العلماء للحديث([19])، وهي بعينها التي يعادَى المنهج السلفيّ لأجلها! والتي لو أردنا تلخيصها لقلنا: إن معنى التجديد في المنهج السلفيّ هو: تصفية الدين من البدع والمحدثات، وإظهار ما اندرس من الأحكام.
موقف المنهج السلفي من الاتجاهين الآخرين:
موقفه من الاتجاه الأول:
التجديدُ عند أصحاب الاتجاه الأول غير قاصِر على الوسائل، بل همُّه الأساسُ هو المضمون نفسُه، لكنهم لا يستعملون مصطلح التطوير ويجدون في مصطلح التجديد غُنية لما يريدون، وهذا في الحقيقة هدمٌ للدين وتزيينٌ للباطل باسم التجديد.
أما التطوير في الوسائل فيكادُ لا ينكره عاقِل، لكنه ليس هو المقصود عندهم.
موقفه من الاتجاه الثاني:
التجديدُ عند أصحاب الاتجاه الثاني معناه: الاجتهاد، وهو معنى شرعيٌّ صحيح، داخل في معنى التجديد؛ لذا يلتقي المنهجُ السلفي مع الاتجاه الثاني في أهمية الاجتهاد وضرورة تجاوز ما يوضع له من عقبات، ووجدت قضايا مشتركة بين هذين الاتجاهين مثل الردّ على دعوى إغلاق باب الاجتهاد، ومحاربة التعصب المذهبيّ.
ومع ذلك فهناك نقاط اختلاف جوهرية بين المنهج السلفيّ وبين أصحاب هذا الاتجاه، يمكن تلخيصها فيما يلي:
– أنَّ الاجتهادَ هو أحد صور التجديد عند المنهج السلفيّ، بخلاف الاتجاه الثاني الذي يجعله عمودَ الصورة.
– أنه يوجَد بونٌ شاسِع بين آليات الاجتهاد وشروطه وضوابطه ومجالاته بين الاتجاهين.
– أن المعنى الرئيسَ للتجديد الذي تدلّ عليه اللغة وذكره العلماء لا يوجد له ذكر عند أصحاب الاتجاه الثاني، بل وهو مما ينكرونه على المنهج السلفيّ بدعوى تجديد الدين ومسايرة العصر.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) انظر: تجديد الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي (ص: 165-166)، بل يقول: “يؤسفني أن أصرِّح دون مجاملة أن بعضَ حاملي لواء التجديد المعاصر أغلبُهم تتلمذوا في الغرب، وفي معرفتهم بالإسلام سحطيون، ويغلب عليهم الجهل، وهم نظريّون لا عمليّون، ويناقضون أنفسَهم، ويصادمون نصوص الشريعة.. فهم مشبوهون أو جَهلة، والمخلص منهم قليل”.
([2]) انظر: ليس من الإسلام (ص: 135-136).
([3]) انظر: التجديد في الفقه الإسلامي لمحمد الدسوقي (ص: 36).
([4]) انظر: نظرات شرعية في فكر منحرف (1/ 292).
([5]) انظر: التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن (ص: 91).
([6]) انظر بحثه: التجديد الفقهي المنشود، وهو مطبوع مع بحث للزحيلي في كتاب واحد بعنوان: تجديد الفقه الإسلامي.
([7]) انظر كتابه: التجديد في الفقه الإسلامي.
([8]) انظر كتابه: الفقه الإسلامي في طريق التجديد.
([9]) انظر: الثبات والتغير في الحكم الفقهي لصفية الجفري، فالكتاب كله لتسويغ هذا القول الباطل.
([10]) في ورقة علمية بعنوان: تغيّر الفتوى بتغير الزمان والمكان، تجدها على هذا الرابط:
([11]) في مقال بعنوان: بين المقاصد والنصوص الشرعية، تجده على هذا الرابط:
([12]) انظر: لسان العرب (2/ 202)، معجم لغة الفقهاء (1/ 121).
([13]) انظر: التجديد في الفكر الإسلامي (ص: 16).
([14]) رواه أبو داود (4291)، وصحَّح إسناده السخاوي في المقاصد الحسنة (238).
([15]) ينظر: عون المعبود (11/ 260).
([16]) شرح سنن أبي داود (17/ 86).
([17]) شرح مصابيح السنة (1/ 221).