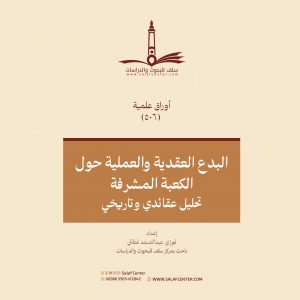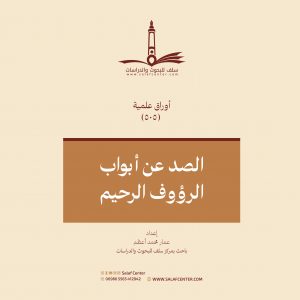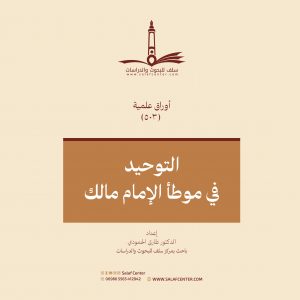نبذة عن أثر النبوّة في تشكيل التاريخ الاجتماعي والحضاري
التاريخُ هو السَّبيل إلى معرفة أخبار من مضَى من الأمم، وكيف حلَّ بالمعاند السّخط والغضب، فآل أمرُه إلى التلَف والعطَب، وكشف عورات الكاذبين، وتمييز حال الصادقين، ولولا التواريخ لماتت معرفةُ الدول بموتِ ملوكها، وخفِي عن الأواخر عرفان حالِ الأُوَل وسلوكها، وما وقع من الحوادث في كلّ حين، وما سطّر فيما كتب به من فعل الملوك، وإنه لم يخلُ من التواريخ كتابٌ من كتب الله المنزَّلة، فمنها ما ورد بأخباره المجمَلَة، ومنها ما ورد بأخباره المفصَّلَة([1]).
فهو عِلمٌ يُعنَى بدراسة المجتمعات الإنسانيّة وتطوُّراتها الفكريّة ومخلَّفاتها الحضارية وأحوالها الاقتصادية والسياسيّة، مما يفيد من التجارب الماضية في دراسة الحاضر([2]).
لَمّا كان الإنسان هو صانع التاريخ والحضارة، فلا بدّ لتفسير الحوادث والوقائع من تجلية ما يثير الإنسان ويدفعه نحو صناعة التاريخ وتشييد الحضارة.
وقد اهتمَّ الوحي بهذا الجانب، وحدَّث عن الأمم الماضية ما يُستَلهم منه الدروس والعبر، وجعل تاريخ البشرية مبتدِئًا بخلق الإنسان، ومنتهيًا بالحساب ويوم القيامة، ويمر بمراحل ومحطّات، أهمُّها تتابع الرسل والأنبياء من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليهم وسلم.
أهمية العناية بتاريخ الأنبياء والرسل عليهم السلام:
وسبب التركيز على تاريخ الأنبياء -عليهم السلام- أنهم صفوةُ البشر، وحياتهم حياة الكُمَّل من الناس، وهم معصومون فيما يتعلَّق بالعقيدة وما أمروا بتبليغه، وفي حياتهم أكبرُ العِظات والعبر للدعاة إلى الله، وحاجَة الناس ماسَّة للاهتداء بنور هديهم.
كما أن في تاريخهم جوانب الحضارة المتمثلة في الممالك والصناعات وغيرها، فالرسل والأنبياء عليهم السلام دعاة حضارة إنسانية لا تحد بزمان أو مكان، فالمجتمع الإسلامي لا يحقّر الإنتاج المادي والصناعي، ولا فن العمارة؛ لكنه يتعامل مع كل منتج حضاري وفق ما أراده الله، قال تعالى: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ} [الحج: 41].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ليس في الأرضِ مملكة قائمةٌ إلا بنبوّة أو أثر نبوّة، وإنَّ كلَّ خير في الأرض فمن آثار النبوات، ولا يستريبنَّ العاقل في هذا الباب الذين درست النبوة فيهم مثل البراهمة والصابئة والمجوس ونحوهم، فلاسفَتهم وعامَّتهم قد أعرضوا عن الله وتوحيدِه، وأقبلوا على عبادة الكواكب والنيران والأصنام وغير ذلك من الأوثان والطواغيت، فلم يبق بأيديهم لا توحيد ولا غيره)([3]).
وقال ابن القيّم: (لولا النبوات لم يكن في العالم عِلم نافع البتة، ولا عمل صالح، ولا صلاحٌ في معيشة، ولا قوام لمملكة، ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض. وكل زين في العالم فمن آثار النبوة، وكل شين وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها؛ فالعالم حينئذ جسد روحه النبوة، ولا قيام للجسد بدون روحه)([4]).
وقال ابن خلدون: (الفصل الرابع في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك.. أصلها الدين؛ إما من نبوة أو دعوة حق..)([5]).
وحين يبتعد البشر عن آثار النبوة وما جاءت به تفسد الأرض، وتستخدم الصناعات للإضرار بالناس والبيئة والمجتمعات، قال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم:41].
طريقة كتابة التاريخ بين المسلمين والغرب:
وقد دأب كثيرٌ منَ المؤرِّخين الأوائل على كتابة التاريخ انطلاقًا من الزمان، ثم ابتداء الخلق وعدد أيامه وخلق آدم، ثم تدوين تاريخ الرسل والأنبياء على وفق التسلسل الزمني لرسالاتهم، وذلك كما فعل الدينوري واليعقوبي والطبري والمسعودي.
وبدأت البشرية بآدم وذريته مسيرتَها التاريخية، فبعث الله الرسل مبشِّرين ومنذرين ليذكِّروا الناس بالرسالة الواحدة، وبطبيعة المهمَّة التي أرادها الله للإنسان في الحياة الدنيا.
وقد دأب الغرب في دراسة تطور حياة البشرية بنظرية (أوغست كونت) الذي يرى أن المجتمعات تمر بثلاث مراحل: دينية، وفلسفية (الغيبية)، وعلمية أو وضعية (الاكتشافات والاختراعات)([6]).
وهذا يعني أنه لا يمكن دراسة التاريخ الاجتماعيّ بين هذه المراحل من خلال مجموعة الأحداث الترابطية والعلل الغائية التي شاركت في تشكُّل الوعي الاجتماعي.
بينما نجد في قصص الأنبياء عليهم السلام -مع تفاوت الفترات التاريخية- انسجامًا واتفاقًا على أهداف رئيسة، والقراءة المتأنِّية للأديان تُشعر أنَّ هناك اتفاقًا مُسبقًا تمّ في مكان ما بين موسى وعيسى ومحمد، أو بتعبير النجاشي: (إِنَّ هذا -واللهِ- والَّذِي جَاءَ بِهِ موسى لَيَخْرُجُ من مِشْكَاةٍ واحِدَةٍ)([7]).
فدعوة الأنبيـاء عليهم واحدةٌ، ومنهجهم واحد، وسبيلهم واحِد: {مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ} [فصلت: 43]، وغاية دعوتهم أن: {اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 59].
كما أن نظرية كُونت التاريخية تشوِّه الإنسان وتقضي عليه، فمنذ متى كان الإنسان مؤمنًا أو دينيًّا وحَسب، أو كان مفكّرًا وكفى، أو عالِمًا لا غير!
إنَّ تقسيم الإنسانِ على أساس تجزئته إلى روح ومادّة، ونفس وجسَد، وفكر وعمل، يعني أنه يمكن تقسيمه كذلك إلى دين ودنيا، وانفصال الدنيا عن الآخرة.
إلَّا أنَ هذا التقسيم -وللأسف- صار كأنه الحقيقةُ بفعل تمركُز الغرب في الوعي وتوجيهه للفكر، والحقيقة أنَّ هذه النظرية دعوى لم يقم عليها برهانٌ صحيح، بل هي في اعتمادها على التاريخ تحرّف التاريخ، وفي ادِّعائها الاعتماد على الواقع تصادِم الواقعَ.
خطأ التقسيم التاريخي في نظرية (أوغست كونت):
إنّ تاريخ الأنبياء -عليهم السلام- يبيِّن لنا خطأَ هذا التقسيم وبناء التاريخ على هذه النظرية من أساسه.
فنبيُّ الله داود وابنه سليمان -عليهما السلام- قد جاء من أخبارهما أنهما كانا في عصر ازدهار الحضارة المدنية بتعبير اليوم، فجمع الله لهما بين الملك والنبوة، وبين خير الدنيا والآخرة، وكان الملك يكون في سبط والنبوة في سبط آخر، قال ابن كثير: (وقد كان داود -عليه السلام- هو المقتدى به في ذلك الوقت في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات، حتى إنه كان لا يمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلا ونهارا)([8]).
ومع هذا لم تكن العبادات وإدارة أمور الملك تشغل داود -عليه السلام- عن المخترعات، فكان يقوم بصناعة الدروع الحديدية بطريقة تحمي المقاتل ولا تعيق حركته في آن واحد، قد علَّمه الله تعالى كيفيَّة صناعتها، كما قال: {وَعَلَّمْناه صَنعةَ لَبوسٍ لَكُمْ لِتُحصِنَكُمْ مِن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ} [الأنبياء: 80].
ثم ماذا يقول كونت وأنصاره عن عصر ازدِهار الحضارة الإسلاميّة الذي اجتمع فيه الدين والعقل والعلم؟! تنمو وتزدهر وترتقي كلها جنبًا إلى جنب، فتجد الفقهاء والمفسرين والمحدثين والمتصوّفة، وبجوارهم الفلاسفة والمتكلمين، وأيضًا العلماء من الأطباء والكيميائيين والفلكيين والفيزيائيين والرياضيين، بل ربما تجد الواحد يجمع النواحي الثلاثة في شخصه، كما يتَّضح ذلك في سيرة ابن رشد صاحب “بداية المجتهد ونهاية المقتصد” في الفقه الإسلامي المقارن، وهو أكبر شارح لفلسفة أرسطو في تلك العصور، وصاحب كتاب “الكليات” في الطبّ.
فالواقع أن الحالات الثلاث التي صوَّرها كونت لا تمثِّل أدوارًا تاريخيَّة متعاقبة، بل تمثِّل نزعات وتياراتٍ متعاصرة في كل الشعوب، وليست متناقضة ولا متضادَّة بحيث إذا وجدت إحداها تنتفي الأخرى.
إن كونت وأنصاره جعلوا من نظريته قانونًا يستوعِب التاريخ كلَّه شوطًا واحدًا، قطعت الإنسانية ثلثيه بالفعل، ونفضت يدَها منهما إلى غير رجعة، فلن تعود إليهما إلا أن يعود الكهل إلى شبابه وطفولته، ولو أنهم جعلوا منه سِلسِلة دورية، كلما ختمت البشرية شوطًا رجعت عودًا، لكان الخطأ في هذه النظرية أقلَّ شناعةً، وربما كان تاريخ المعرفة في الغرب يؤيد ذلك([9]).
ختامًا: إنَّ تاريخ الأمم السابقة لا يمكن أن نتأكَّد من صحته إلا من طريق الوحي؛ لأنه من علم الغيب، وليس دونه إلا تكهُّنات وأساطير، لا زمام لها ولا خطام، قال الله تعالى بعد ذكر قصة مريم عليها السلام: {ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: 44]، وقال الله تعالى بعد ذكره لقصة نوح: {قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} [هود: 48، 49]، وقال الله تعالى بعد ذكره لقصة يوسف: {ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ} [يوسف: 102].
وإذا ثبتت الأحداث التاريخية عن طريق الوحي كما في قصص الأنبياء -عليهم السلام- صح أن نستنبط منها التاريخ الحضاري والاجتماعي للأمم، والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) أخبار الدول وآثار الأول، للقرماني (1/ 5، 6).
([2]) المدخل إلى علم التاريخ، محمد صامل السلمي (ص: 32).
([3]) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 250).
([4]) مفتاح دار السعادة (2/ 1155-1156).
([5]) تاريخ ابن خلدون (1/ 157).
([6]) انظر: العمارة وحلقات تطورها عبر التاريخ القديم (ص: 79).
([7]) أخرجه أحمد (3/ 180)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١/ ١١٥) (79). قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير [محمد بن] إسحاق وقد صرح بالسماع. مجمع الزوائد (6/ 27). ووقع في مجمع الزوائد (إسحاق) فقط وهو خطأ.
([8]) البداية والنهاية (2/ 18).
([9]) انظر: التغير الاجتماعي بين نظرة الاجتماعيين والنظرة الإسلامية، د. محمد عبد الله العتيبي، الموقع الرسمي، على الرابط: