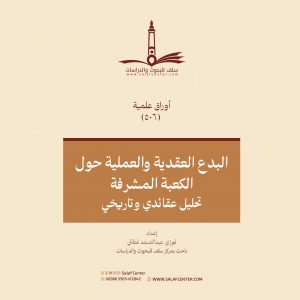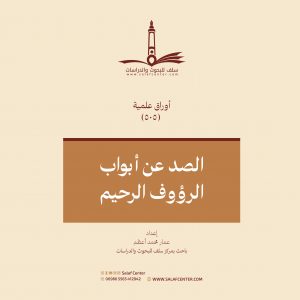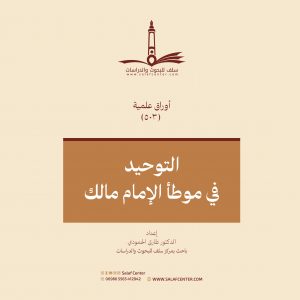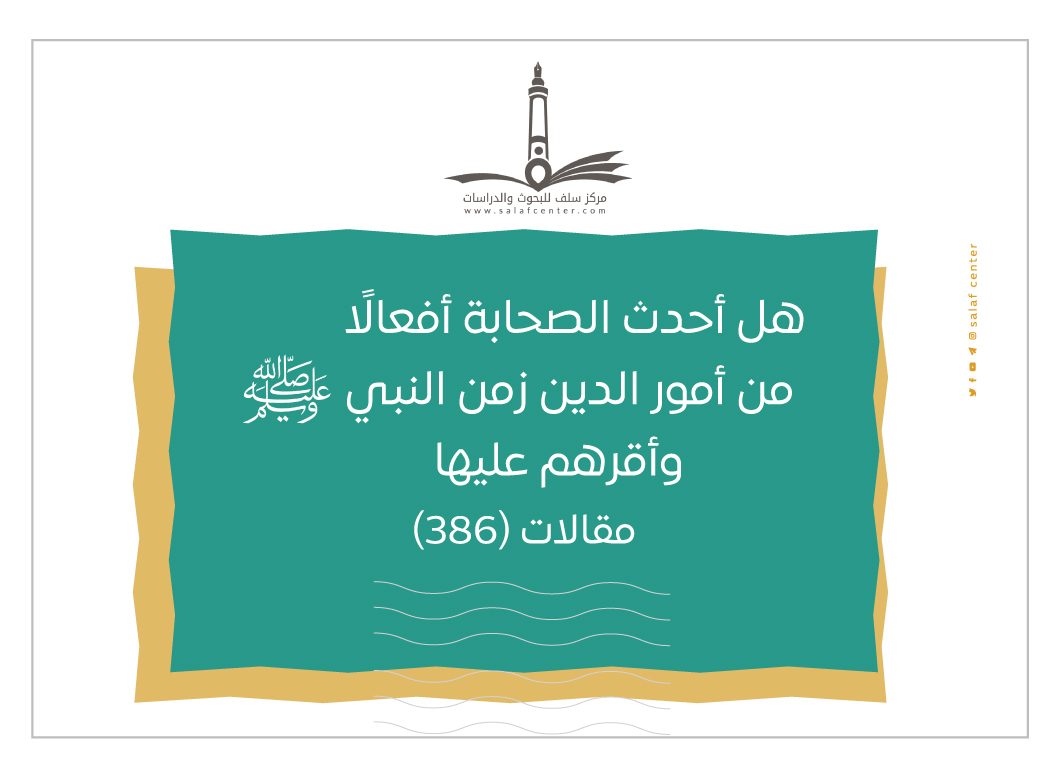
هل أحدث الصحابة أفعالًا من أمور الدين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليها؟
سبقَ للمركز أن تناوَل في مقالٍ مستقلٍّ مسألةَ تعريف البدعةِ، وأنَّ حقيقتَها قصدُ التقرب المحض بما لم يُشرَع([1])، وبين أن القاعدة العظيمة التي ينبني عليها هذا البابُ هي أن الأصل في العبادات المنع حتى يرِد الدليل بمشروعيةِ ذلك في ورقة علمية مستقلة أيضًا([2]).
ومِن أعظم الشبهاتِ التي يَستدلُّ بها من يسوِّغ للبدع لينقُض هذا الأصلَ زعمهم أن الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- أقدموا على إِحداث أمورٍ في الدين دونَ أن يَرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رَغمَ وجوده بينهم وقُربِه منهم، وأقرَّهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك([3])، فكان هذا المقال للجواب عن هذه الشبهة.
أما الأحاديث التي يستدلون بها فستة أحاديث هي: حديث قول الرجل: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بُكْرَةً وأَصِيلًا، وحديث مواظبة بلال على ركعتين بعد الوضوء، وحديث قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة، وحديث دعاء الصحابي باسم الله الأعظم، وما كان من الصحابة في الرقية، وحديث أن معاذا سن لهم في المسبوق سنة، وحديث صلاة خبيب بن عدي ركعتين قبل أن يُقتَل.
والجواب عن هذه الشبهة هو جواب إجمالي وجواب تفصيلي:
أما الجواب الإجمالي فهو أنه ليس في أي من هذه الأحاديث ما يدلُّ على ما ذهبوا إليه؛ لأن الصحابة في هذه الأحاديث كلها أقدموا على أمور كانت مشروعة لهم أصلًا بالدليل العام، وهذا هو القدر الذي حصل عليه الإقرار، أما ما ثبت فيه استحباب في حقنا فلم يكن هذا الاستحباب بمجرد فعل الصحابي، ولا بمجرد الإقرار على الفعل، وإنما ببيان النبي صلى الله عليه وسلم لما يدل على ذلك الاستحباب.
وبيان ذلك أنه يجوز للإنسان أن يفعل الفعلَ المندرج تحت الأصل العامّ، فيجوز للإنسان أن يدعو في كلِّ وقت، لكن تخصيص وقتٍ معيَّن لدعاءٍ بعينه اعتقادًا أنَّ هذا التخصيص له ميزة أو أفضليَّة هو أمر زائد عن مجرَّد ما ثبت بالدليل العام، فيحتاج إلى دليل يدلُّ عليه.
وليس في أي من الأحاديث التي استدلوا بها ما يدل على أن الصحابة خصَّصوا ذلك التخصيصَ بدون دليل، وبيان ذلك في الجواب التفصيليّ بذكر كلِّ حديث والتعليق عليه.
الحديث الأول:
حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بُكْرَةً وأَصِيلًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن القائلُ كلمة كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، فقال: «عَجِبْتُ لها، فُتحت لها أبواب السماء». قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتُهنّ منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك([4]).
والجواب: أنه ليس في الحديث ما يبطل أنَّ الأصل في العبادة المنع، وذلك لأن الصحابي أقدم على فعل هو مأذون له فيه، لحديث: «إنما هو الذكر والتكبير وقراءة القرآن»([5])، وفضل هذا الدعاء واستحبابه في حقِّنا لم يثبُت بفعل الصحابي، وإنما بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها.
فالتعبد هنا بأمرين:
الأول: الدعاء نفسه، وهذا لا إشكال في جواز أن يدعو الإنسان بما شاء، وهذا مأذون فيه بدون هذا الحديث، وهو ما فعله الصحابي في هذا الحديث.
والثاني: تخصيص الدعاء بموضع معين مع اعتقاد أفضليته في هذا الموضع، فهذا هو محلُّ النزاع، وليس في الحديث ما يدلُّ على جوازه، وثبوت الاستحباب كان بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها.
الحديث الثاني:
حديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا بلال، حدِّثني بأَرْجَى عمل عَمِلته في الإسلام؛ فإني سمعت دَفَّ نَعْلَيْكَ بين يَدَيَّ في الجنة»، قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طُهورًا في ساعةِ ليلٍ أو نَهارٍ إلا صليت بذلك الطُّهور ما كُتب لي أن أصلي([6]).
والجواب عنه أنه ليس فيه أنَّ الصحابيَّ قد أحدَث أمرًا مِن تلقاء نفسِه، فقد فعل أمرًا مأذونًا له فيه، وهو الصلاة طالما كان على طهور، فهذا داخِلٌ تحت الأصل العام باستحباب التنفُّل، أما ثبوت استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء فثبت من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفضلِهِما.
الحديث الثالث:
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا على سَرِيَّة، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيَختِم بـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «سَلُوه: لأيِّ شيء يصنعُ ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صِفة الرحمن، وأنا أحبُّ أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخبروه أنَّ الله يحبُّه»([7]).
والجواب عن ذلك يكون ببيان ما الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ففي هذا الحديث فعَل الصحابي فعلًا مأذونًا له فيه، وهو قراءة سورتين في ركعة، لكنَّه واظَب عليه على وجهِ لا يُعرف سببه، فلما أُخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بذلك لم يقِرَّ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ابتداءً، ولم يقرر له جوازه حتى سأَل عن السبب، فأين إذَن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل؟!
وعندما أُخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب علق النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على نيته وليس على فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرَّه على هذا الفعل لهذا السبب، فلا يقال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقرَّه مطلقًا. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل على جواز أن يكرر الإنسان آيات بعينها لأنَّه يحبُّها، وليس دليلًا على استحباب ذلك.
ويؤيِّد ذلك أنه لم يُنقَل عن الصحابة مواظبتُهم على ذلك الفعل بعد هذا الحديث، بل ولم يقُل أحدٌ من الفقهاء باستحباب قراءة هذه السورة في كلِّ ركعة([8]).
بل إنَّ هذا الحديثَ أصلٌ في أن حكم الفعل متوقِّف على القصد الباعث عليه.
الحديث الرابع:
حديث بريدة الأسلمي أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، فقال: «والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعِي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى»([9]).
ويقال في هذا الحديث كما قيل في سابقيه، فالدعاء بأيّ لفظ أمر مأذون فيه في الصلاة، واستحباب ذلك اللفظ كان بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفضله، وليس بمجرَّد دعاء الصحابي به.
الحديث الخامس:
رُقْية بعض الصحابة رجلًا لَدَغَتْه عَقْرب، وكان الرجل سيدَ قومه، وقد أَبَى أولئك القومُ أن يضيِّفوه وأصحابه، فرَقَاه بفاتحة الكتاب، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وما يدريك أنها رقيةٌ؟ أصبتم، اقسِموا واضربوا لي معكم بسهم»([10]).
والجواب عن هذا الحديث وأمثاله أن باب الرقية واسع، والأصل فيه الجواز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جابر رضي الله عنه عن خال له يرقي من العقرب: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»([11])، وقوله أيضًا: «اعْرِضوا عليَّ رُقَاكم، لا بأس بالرُّقَى ما لم يكن فيه شِرك»([12])، فليس فيه ما يعترض به على القاعدة المقررة.
الحديث السادس:
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في المسبوق، فقد كان الرجل من الصحابة إذا جاء إلى الصلاة مسبوقًا يسأل، فيُخْبَر بما سُبِق من صلاته، فيصلي ما فاته، ثم يلحق الجماعة، فيكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قائم وراكع وقاعد، فقال معاذ: لا أَراه -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- على حال إلا كنتُ عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن معاذًا قد سَنَّ لكم سُنة، كذلك فافعلوا»([13]).
قالوا: «فهذه بادرة خير من معاذ رضي الله عنه ابتدأها اجتهادًا من تِلْقاء نفسه، وليس عنده في ذلك سنة توقيفيَّة، فصارت سُنة المسبوقين إلى يوم الدين»([14]).
والجواب: نعم، صارت سنة للمسبوقين إلى يوم الدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا بفعل معاذ رضي الله عنه، أما ما فعله معاذ رضي الله عنه فليس فيه أنه فعل ما ليس مأذونًا له فيه على قولنا، فإن الحديث يدل على أنهم يكونون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، منهم القائم والراكع والساجد، فاختار هو إحدى هذه الصفات، وعللها بأنه يريد أن يكون موافقًا للحال التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغايته أنه اختار إحدى الهيئات التي كانت مباحة بنصّ الحديث ليفعلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا كفعل معاذ رضي الله عنه، فثبت الأمر في حقِّنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا الفعل ما ينقض القول بأن الأصل في العبادات المنع.
الحديث السابع:
حديث صلاة خبيب رضي الله عنه ركعتين قبل قتله، وهو حديث طويل رواه البخاري وفيه: «وكان خبيب هو سَنَّ لكل مسلم قُتل صبرًا الصلاةَ»([15]).
قالوا: «فهاتان الركعتان من السنن الحسنة التي سنها خبيب رضي الله عنه… ولم يكن عنده نص توقيفيّ خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهما، ولكن لما كانت الصَّلاة من أفضل الأعمال الصالحة أراد خبيبٌ أن يَختِم حياته بها»([16]).
والجواب عن ذلك هو: هل كان خبيب رضي الله عنه ممنوعًا من صلاة تلك الركعتين بناء على قولنا: إن الأصل في العبادات المنع؟! الجواب: لا؛ لأن الصلاة من أفضل الأعمال، وهي مستحبة في كل وقت، فأراد خبيب أن يختم حياتَه بها، لكن هل ثبت تفضيل الركعتين على غيرهما في هذا الموطن بمجرد هذا الفعل؟! هذا هو الذي ينقض قولنا: إن الأصل في العبادات المنع.
أمَّا متابعة غيره له في هذا الفعل فهو مما يدخل في حديث: «من سن في الإسلام سنة حسنة»([17])؛ لأنه لم يفعل ما ليس بمشروع له، ولكن الإنسان يذهل في هذا الموطن عن هذا الأمر، ففعل خبيب له فيه تذكير لغيره، وهذا الفعل منه مأذون له فيه، فلا ينقض قولنا: إن الأصل في العبادات المنع.
إذن فالخلاصة هي أنه ليس في أي من هذه الأحاديث ما يدلّ على جواز أن يُحدث الإنسان عبادةً جديدة من تلقاء نفسه، وليس فيها ما يجوِّز أن يخصِّص الإنسان عبادةً مشروعة في الأصل بزمن أو مكان أو هيئة أو مقدار يدلّ على أفضلية هذا الفعل فيما خصِّص له عن غيره إلا بدليل، وهو معنى قولنا: إن الأصل في العبادات المنع، والله تعالى أعلم.
([3]) انظر: مفهوم البدعة (ص: 125).
([6]) رواه البخاري (1149)، ومسلم (2458).
([7]) رواه البخاري (7375)، ومسلم (813).
([8]) انظر: فتح الباري لابن رجب (7/ 73-74).
([9]) رواه الترمذي (3475)، وصححه الشيخ أحمد شاكر.
([12]) رواه مسلم (4/1727، 2200).
([13]) رواه أبو داود (506)، وصححه الألباني.