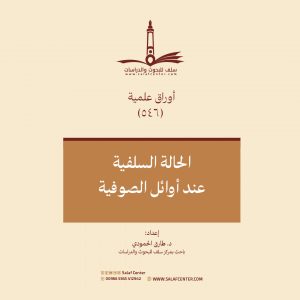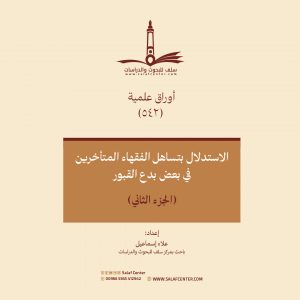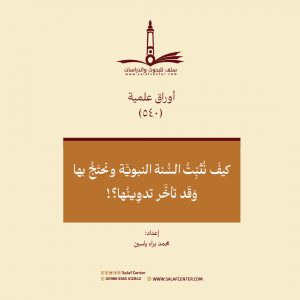فهم الصحابة | المدلول والحجيّة
#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات
#إصدارات_مركز_سلف
يعتبر مجتمع الصحابة رضي الله عنهم المثل الأول لتطبيق الإسلام المرضي في حياة البشر، وهم التجربة البشرية للتدين الصحيح الذي شهد القرآن وصحيح السنة بإصابة أهله للحق، فلا يمكن أن تعرِضَ مسألة دينية للصحابة ويتكلموا فيها، ويكون الحق خارج أقوالهم؛ لأنه يلزم من هذا تخطئة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المخاطبة بالوحي ابتداءً؛ لذا نص العلماء على أن فهم الصحابة هو الأحكم والأسلم، وجعلوه منهجًا للتعامل مع نصوص الوحي في تلقيها وتفسيرها والعمل بها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “للصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، ومعرفة بأمور من السنة لا يعرفها أكثر المتأخرين” ([1])
وعليه فيمكن اعتبار فهم الصحابة رضي الله عنهم أداة معيارية مهمة لضبط التنازع في التأويل الذي يمكن أن يقع في فهم الوحي، كما أنه يمثل منهجًا موضوعيًّا لحصر الأقوال التي يمكن قبولها في دائرة التفسيرات المختلفة للإسلام، وهو مذهب متكامل يقدم البدائل الشرعية ونصوص الوحي على غيرها.
ونهدف في هذا المقال الموجز إلى تحديد المقصود بفهم الصحابة، وتبيين حجيته بعيدًا عن التفسيرات المحدَثة التي ترى أنه معيار غير ملزم، ومن ثمَّ تفسّره انطلاقًا من مواقفها؛ ليتناسب تفسيرها مع حكمها عليه، فنقول:
المقصود بفهم الصحابة أحد أمرين:
الأول: اتفاقهم
ويُقصد به الإجماع([2])، وهذا لا خلاف أن منكره ضال، أو مبتدع، لأنه إنكار للإجماع، قال شيخ الإسلام([3]): “الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة ، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً “.
وقد دلَّ على اعتباره قوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} [سورة النساء:115] في دلائل كثيرة.
فلو لم يكن لاتباعهم معنى إضافيًّا في توضيح الحق، ولزوم الجادة، لما كان لذكره في القرآن فائدة، وسبيلهم إنما يعرف بطريقتهم في التعامل مع الوحي، والتي يُعدُّ الفهم مرحلة أولية منها؛ لأنه مقدمة العمل وشرطه؛ ولذا قال عمر بن عبد العزيز: “سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاة الأمر من بعده سننًا، الأخذ بها تصديقٌ لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها وتبديلها ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بها مهتدٍ، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، ولَّاه الله ما تولى وصلَّاه جهنم وساءت مصيرًا”([4]). ويقصد عمر بقوله: “ولاة الأمر من بعده”: الخلفاء الراشدين. ومن المعلوم أن الآية نزلت في طُعْمَةَ بْنَ أُبَيْرِق، كما نص على ذلك بعض المفسرين([5])، وكان قد ارتدَّ، ولا يعلم يومها مؤمنون غير الصحابة، فجعل الله تعالى مفارقتهم مفارقة لدين الحق وعلامة على الضلال.
ويدخل في معنى إجماعهم ما إذا قال الصحابي قولا واشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة، وهو الإجماع السكوتي. قال ابن حزم([6]): “واعلموا أن جميع هذه الفرق متفقة على أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم إجماع صحيح، وقائلون بأن كل ما اشتهر فيهم رضي الله عنهم ولم يقع منهم نكير له فهو إجماع صحيح”.
أما إذا قال الصحابيّ قولا ولم يشتهر، فهل يكون حجة؟ ذهب فقهاء السلف وجماعات من العلماء إلى كونه حجة، وخالفهم آخرون. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في بيان حجية قول الصحابي بأدلة كثيرة([7]).
الثاني: طريقتهم في التعامل مع النصوص
وهي قائمة على فهم قواعدهم في الفهم والاستنباط، كحَمْل الكتاب على المعهود من اللسان العربي في الخطاب، وعدم التكلف في التأويل، وقبول كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة الراسخين في العلم([8]).
والمقصود بقولنا: “حمله على المعهود من اللسان العربي”: أن العرب جروا في خطابهم على التمسك بالظاهر، وقد يخرجون عنه إلى غيره؛ لدليل يقتضيه، لكن الأصل هو الظاهر، فلا يُعدَل عنه إلا بدليل؛ ولذلك تمسك الصحابة بظواهر القرآن والسنة وعملوا بها، ولم يعدلوا عنها إلى غيرها إلا بدليل، ومن ذلك ما رواه البخاري: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لما نزلت: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ} [سورة الأنعام:82] شقّ ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أيُّنا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: {يَابُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم} [سورة لقمان:13]”([9]). فتمسَّكوا بالعموم حتى وجدوا المخصص، وهذا المجال رحب والخلاف فيه قد يقع بينهم تبعًا لتفاوتهم في العلم، فمن اطَّلع على مخصص للدليل فإنه يعدل عن الظاهر – وهو العموم – إلى الخصوص، ومن لم يطلع عليه تمسك بالظاهر وهو العموم، أو الإطلاق، أو المفهوم، أو الحقيقة، وهذه مباحث معروفة في أصول الفقه، يرجع إليها في بابها.
والمسلمون مطالبون بـ” معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بألفاظ الكتاب والسنة؛ بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ؛ فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرّفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلَّغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه؛ فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين مثل معنى التوحيد، ومعنى الواحد والأحد، والإيمان والإسلام، ونحو ذلك، كان جميع الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من معرفته”([10]).
فإذا اتفق الصحابة على أمر لا يجوز خلافهم مطلقًا، وإذا اختلفوا فالناس تبَعٌ لاختلافهم، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم.
وطريقتهم في تلقّي الوحي قائمة على التسليم والقبول لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مراد الله ورسوله، وهذا المراد محدد باللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم، وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الخروج ولا العدول عنها، قال ابن عاصم:
أصلُ الأدلَّـةِ القرآنُ ما كُتِـبْ في المُصحف الذي اتِّباعُه يجــــــــــــــبْ
أنزلـه سُبحـانـهُ على النَّـــــــــــــــــــــبي وقال فيـه بلســـــــــــــــــانٍ عربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ففيـه مـا في ذلك اللســــــــــــــــــــــانِ مِنَ الدَّلالـة على المعــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــي
مِن جهة اللفـظِ أوِ المفهـــــــــــــومِ وتـــــــــــــــــــــــــــــارةً بالاقتضـا الـمعلــــــــــــــــــومِ
ولُغةُ العُرْبِ لـها امتيــــــــــــــــــــــــــــــــــازُ بِبَدْئِها والمُنتهـى الإعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازُ
إلى أن يقول:
فهْو على نَـهج كلامِ العَـربِ فاسْلُـكْ به سبيلَ ذاكَ تُصِـــــــــــــــــــــــبِ
ومن يُرِدْ فهْمَ كلامِ الله بغيـرهِ اغْـتَــــــــــــــــــــــــرَّ بأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ واهِ([11])
إذا تبين المقصود بفهم الصحابة، بقي أن نعرف حجية فهمهم، ووجه كونه مقدمًا على غيره من الفهوم، فقد دلَّت نصوص الكتاب والسنة، وأقوال العلماء على اعتبار فهم الصحابة، وتقديم أقوالهم على غيرهم؛ لأنهم أجدر الأمة بالصواب، وأولاها بالحق، وأقربها إلى التوفيق، وكل الأوجه التي يحتملها الكتاب في الفهم، فإن بيان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لها حجة وأمارة على الحق؛ لأنهم حضروا التنزيل، وعلموا من أسبابه ومقاصده ما يجعلهم مقدمين على غيرهم في الفهم؛ ومما يدل على ذلك أن ابن عباس – رضي الله عنهما – وهو أحد فقهاء الصحابة قد أدرك حجية فهم الصحابة واحتج بها على من خالفهم من الخوارج، فقال:” جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله”([12]).
وهذا يدل على أن إدراك هذا المعيار كان حاضرًا عند الصدر الأول من الأمة، ومعمولا به، وليس أمرا مستحدثا من التابعين لرفض أقوال غيرهم، كما أن الصحابة هم المقصودون بأهل العلم في القرآن ابتداءً، كما في قوله تعالى: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد} [سورة سبأ:6]. قال قتادة: “هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم”([13]).
وهم الذين اصطفى الله بعد الرسل، كما في قوله سبحانه: {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُون} [سورة النمل:59]. قال سفيان: “هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم”([14]).
وقد نص القرآن على أنهم أهل لكل خير، وأولى الناس بكل صواب، قال تعالى: {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [سورة الفتح:26]. {وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا} من كفار مكة {وأَهْلَهَا} أي: وكانوا أهلها في علم الله؛ لأن الله تعالى اختار لدينه وصُحبة نبيه أهل الخير {وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﮩ }[سورة الفتح:26]([15]).
فمن أخبرنا الله – عز وجل – أنه علم ما في قلوبهم، فرضي عنهم، وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم، أو الشك فيهم البتة([16])، كما ميَّز النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بمتابعتها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»([17]). وهذا يقتضي الموافقة في الفهم والعمل؛ ولذا نص العلماء على وجوب اتباعهم، ولزوم طريقهم، فقد أرسل عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله حين سأله يوصيه بلزوم طريقتهم ويبيِّن له سلامتها، وكونها هي أفضل الطرق، وذلك بقوله: “فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبالفضل لو كان فيه أحرى، فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم، فما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم، ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهُمُ السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، وما فوقهم مخسر، لقد قصر عنهم آخرون فضلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم”([18]).
ويقول الشافعي – رحمه الله – مبينًا لمكانتهم وأهمية لزوم طريقتهم: “علموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامًّا وخاصًّا، وعزمًا وإرشادًا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يُرضى، أو حُكيَ لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول، ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله”([19]).
فهذه الكلمات من الإمام الشافعي تلخص المقصود بفهم الصحابة، كما أنها تبين مدى حجيته المعتبرة في كمال العلم مع كمال العقل، وكونهم أولى الناس بالحق، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم ولا مخالفة إجماعهم.
ويقول الإمام أحمد بن حنبل: “وإنَّ تأْويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله منه، أو أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحابه، فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا تنزيله، وما قصه الله له في القرآن، وما عني به، وما أراد به أخاصٌّ هو أم عامٌّ، فأمَّا من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة، فهذا تأويل أهل البدع”([20]).
ويؤكد الإمام ابن القيّم هذا المعنى، وأن علم الشريعة محقق عند الصحابة، والناس تبع لهم في ذلك، فيقول: “كل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، وعمق علومهم، وقلة تكلفهم، وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها، وضبط قواعدها، وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن، والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا”([21]).
وعليه فلا يشك مسلم فهِم حقيقة الدين ووعاها في إلزامية فهم الصحابة رضوان الله عليهم إذا اجتمعوا عليه أو اشتهر ولم ينكره أحدٌ منهم؛ لأنهم هم المقصودون بالرسوخ في العلم ابتداءً في كتاب الله، أما غيرهم فيدخل فيهم ظنًّا، وإذا تقرر أن طريقتهم في فهم الدين، والتعامل مع النصوص هي الممدوحة شرعًا، فإن من خالفها فإنه لا بدَّ وأن يكون مذمومًا؛ لأن النقيضين لا يجتمعان لا عقلًا ولا شرعًا، والوحي لم يمتدح من المؤمنين غير الصحابة جزمًا، فأما من جاء بعدهم فإنما يمتدح بمشابهته لهم، واتباعه لطريقتهم التي أوجبت مدحهم، ولا يمكن امتداحه بمخالتهم مطلقًا، والاتباع الذي يوجب محبة الله امتثله الصحابة، وزكاهم القرآن على أساسه؛ ولذا أضاف الله الاتباع إليهم وقيده بالإحسان فقال:{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم} [سورة التوبة:100]. والرضى من الله مستلزم للعدالة؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
وأهمية معرفة الكيفيّة التي فهم الصحابة بها الدين تشكّل قاعدةً مركزيّة لبناء منهج معرفي سليم في التعامل مع نصوص الوحي، باعتبار أنّ الصحابة شهدوا نزول الوحي، وعاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو مرشدهم ومعلمهم، وإليه المرجع في تصحيح فهمهم، وتزكية أعمالهم، وتوجيههم إلى معاني الهداية الحقة، والاقتداء الصحيح، فكانوا هم أهل الصِّفَةِ الخيريّة بشهادة الله ورسوله، وخيريتُهم تشمل الوعي بحقيقة الدين وفهمه فهمًا صحيحًا، وتعليمه، والعمل به على الوجه الكامل المرضي عند الله عز وجل، كما أنهم يمثلون بمجموعهم تحقيقًا للشخصية القرآنية التي أراد القرآن أن يكون عليها الإنسان، وهم النتيجة العملية والثمرة الحقيقية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإليهم أحال القرآن في فهم الإيمان، وبين أن مخالفتهم علامة على الشقاق، ومعاداة الرسل:{فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم} [سورة البقرة:137]. فلم يبق من سبيل إلا التزام طريقتهم ولزومها؛ عملًا بظاهر القرآن، وصحيح السنة النبوية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: “فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عَضُّوا عليها بالنواجذ”([22]).
فهم العصمة عند الخلاف، وهم معيار الإيمان ودليل النجاة، وسفينة نوح عندما تعم الفتن، ولا يسع المسلم مخالفة طريقهم؛ لأن في مخالفتها واعتبار غيرها أفضل منها طعنًا في القرآن، وتكذيبًا للسنة، ونزعًا للخيرية عن أول هذه الأمة، فلا يمكن أن يكون أصحاب محمد الذين زكاهم الوحي ورضي الله عنهم ورسوله قد ضلوا الحق، وأطبقوا على خلافه، في صغيرة أو كبيرة من الدين، كما أن خيريتهم تنافي أن يخلوَ زمانهم من ناطق بالحق، أو يوجد بعدهم من هو خير منهم في فهم الدين.
إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) فتاوى ابن تيمية (١٩/ ٢٠)
([2]) ينظر: شبهات العصرانيين “الإسلاميين” حول اعتماد فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (دراسة نقدية) عبد الله بن عمر الدميجي (ص 14).
([3]) مجموع الفتاوى ( 11/341 ).
([4]) تفسير ابن أبي حاتم (4/12).
([5]) ينظر: الطبري (4/ 50) والقرطبي (5/ 120).
([7]) ينظر: تنبيه الرجل العاقل (2/560- 600)، وأعلام الموقعين (5/546 -581، 6/5- 40).
([8]) ينظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 120).
([9]) رواه البخاري (32)، ومسلم (124).
([10]) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (17/ 353).
([11]) مرتقى الوصول للإمام ابن عاصم (20).
([12]) الاعتصام للشاطبي (3/140).
([14]) تفسير ابن كثير (3/ 450).
([16]) الفصل في الملل والنحل (3/ 320).
([17]) رواه الترمذي (2641) والحاكم (1/129) وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال الترمذي: حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه، وحسّنه الألباني. وفيه عبدالرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف مدلس.
([18]) ينظر: الشريعة للآجري (2/930).
([19]) ينظر: أعلام الموقعين (1/ 90).
([20]) ينظر: الإيمان لابن تيمية (306).
([21]) مدارج السالكين (1/139)، ونقله ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية (2/ 50).
([22]) رواه أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وابن ماجه (42)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.