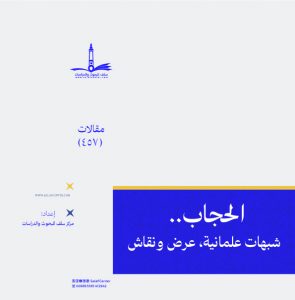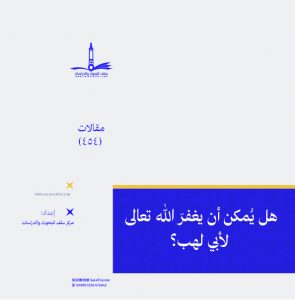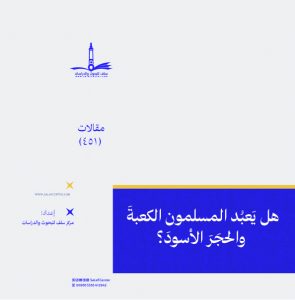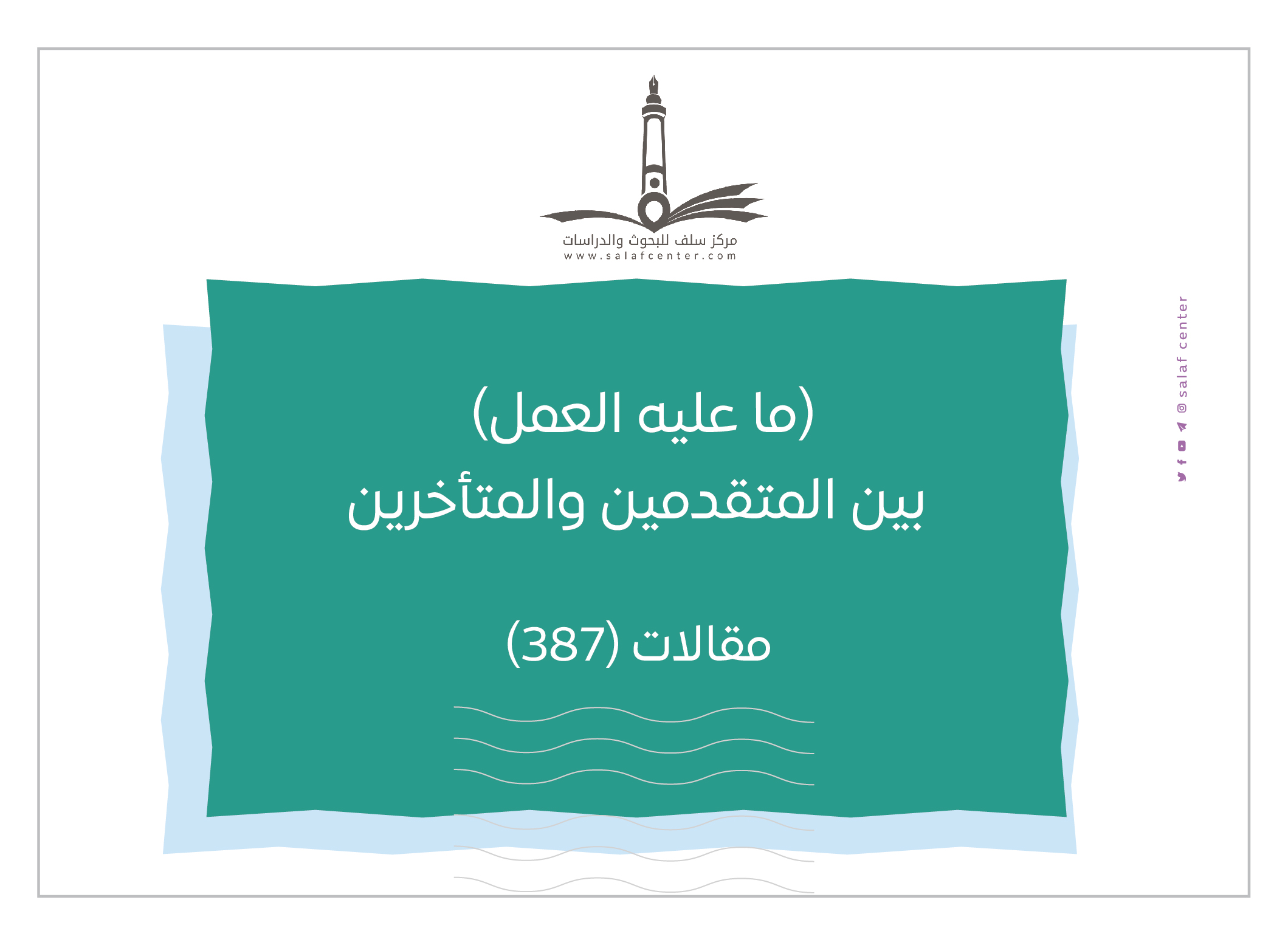
(ما عليه العمل) بين المتقدمين والمتأخرين
يكثر في استعمالات الأئمة المتقدمين عبارة: (وعليه العمل)، خاصَّة عند الإمام مالك في موطئه والإمام الترمذيّ في جامعه، فهل الأحاديث النبوية لا يُعتدُّ بها إلا بجريان العمل بها؟
أشار القاضي عياض (ت: 544هـ) عند ترجمته للإمام مالك إلى نصوص تدلّ على أهمية اعتبار العمل في تقرير السنن، فقال: (رويَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: أحرِّج بالله على رجل روى حديثًا العمل على خلافه)([1]). وذكر أيضًا عن ابن أبي حازم قال: (كان أبو الدرداء يُسأل فيجيب، فيقال: إنه بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال! فيقول: وأنا قد سمعته ولكني أدركت العمل على غير ذلك)([2]).
وعلى هذا مضى التابعون في تقرير ذلك، فقد ذكر القاضي عياض عن ابن أبي الزناد قال: كان عمر بن عبد العزيز (ت: 101هـ) يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التي يُعمل بها فيثبتها، وما كان منه لا يَعمل به الناس ألغاه، وإن كان مخرجه من ثقَة([3]).
وروى الدارقطني عن سالم بن عبد الله بن عمر (ت: 106هـ) والقاسم بن محمد بن أبي بكر (ت: 106هـ) أنهما سئلا عن عدَّة الأَمَة: هل هي حيضتان؟ فقالا: ليس هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمل به المسلمون([4]).
قال مالك: رأيت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وكان قاضيًا، وكان أخوه عبد الله كثير الحديث رجلَ صِدق، فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفًا للقضاء يعاتبه، ويقول له: ألم يأت في هذا حديثُ كذا؟! فيقول: بلى، فيقول أخوه: فما لك لا تقضي به؟! فيقول: فأين الناس عنه؟! يعني: ما أجمع عليه من العلماء بالمدينة، يريد أن العمل بها أقوى من الحديث([5]).
وهذا الإمام الترمذي اقتصر في جامعه على الأحاديث التي عمل بها العلماء، حيث ذكر في علله التي في آخر (الجامع) أن جميع ما في كتابه معمول به سوى حديثين، والحافظ ابن رجب رحمه الله زاد على الحديثين مما صح من الأحاديث ولم يعمل به أهل العلم. والحديثان اللذان استثناهما الترمذي:
أحدهما: حديث([6]) ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر.
والثاني: حديث([7]) معاوية في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. ذكر الترمذي أن العلماء اتفقوا على عدم العمل بهذا الحديث، وبعضهم يرى أنه منسوخ([8]).
وقد أكثر الإمام الترمذي من تقرير هذا الأصل، وكان يقول عقب كثير من الأحاديث نحو هذه العبارات: «وعليه العمل عند أهل العلم»، «والعمل عليه عند أهل العلم»، «والعمل عليه عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا»، «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم»، «وعليه العمل عند عامة الفقهاء»، «وعليه العمل عند بعض أهل العلم»، «والعمل عليه عند بعض أهل العلم»، «وعليه العمل عند أصحابنا».
وبهذا يتبين أهمية العمل عند الأئمة المتقدمين، وأنه معتبر في تقرير السنن.
المراد بالعمل:
وإن العمل يطلق ويراد به قول الأكثرية، ولهذا عبر بعضهم عن عمل أهل المدينة بإجماع أهل المدينة، كما أن الترمذي يذكر كثيرًا الأحاديث التي جرى عليها العمل ويبين أنها عمل أكثر العلماء وينص على ذلك؛ إلا أنه كذلك يذكر بعض الأحاديث ويذكر عقبها بعض من عمل بها وإن لم يكونوا هم الأكثرية؛ كقوله: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم»، أو يحددهم ويقول: «وعليه العمل عند أصحابنا»، أو يحدد العمل في مكان ما ويقول: «وعليه العمل بمكة».
العمل عند المتأخرين:
يعتبر جريان العمل عند المتأخرين من الملامح الاجتهادية المستحدَثة في المذهب المالكي، حيث اعتنى به الفقهاء المتأخّرون منهم، ومقتضاه العدول عن المشهور في المذهب.
ويُعزى شيوع هذا المصطلح لدى مالكية الأندلس إلى القرن الخامس الهجري، فجرى على ألسنة الفقهاء وطار ذكره في التأليف، ودونك كتب أبي الوليد الباجي (ت: 474هـ)، وابن سهل (ت: 486هـ) وغيرهما.
وقد ورد عن أئمَّة المذهب المالكي كثير من الفتاوى التي خالفوا فيها المشهورَ والرّاجح لقوّة المصلحة المترتِّبة على الأخذ بالضّعيف أو الشاذّ أو المرجوح، وفي ذلك يقول إبراهيم اللقَّاني (ت: 1041هـ): (لشيوخ المذهب المتأخرين -كأبي عبد الله بن عتّاب وأبي الوليد بن رشد وأبي الأصبغ بن سهل والقاضي أبي بكر بن زرب والقاضي أبي بكر بن العربي واللَّخمي ونظائرهم- اختيارات وتصحيح لبعض الرِّوايات والأقوال، عدلوا فيها عن المشهور، وجرى باختيارهم عمل الحكَّام والفتيا لما اقتضته المصلحة وجرى به العرف، والأحكام تجري مع العرف والعادة، قاله القرافي في القواعد، وابن رشد في رحلته، وغيرهما من الشيوخ)([9]).
ويظهر من كلامه رحمه الله النزعة المقاصديّة الموجّهة لتأصيل القول بمصلحة ما جرى به العمل واعتماده عند أولئك الفقهاء المالكيّين.
وعرّف العلماء هذا الأصل بعدة تعريفات، منها: العدول عن القول الراجح أو المشهور إلى القول الضعيف في بعض المسائل رَعيًا لمصلحة مجتلبة، أو لمفسدة مدفوعة، أو عرف جار، وحكم القضاة بذلك وتواطؤهم لسبب اقتضى ذلك([10]).
والذي يظهر من خلال هذا التعريف أن جريان العمل في حقيقته هو عدول عن قول راجح أو مشهور إلى قول مرجوح أو ضعيف؛ إعمالًا لمصلحة معتبرة أو دفعًا لمفسدة ظاهرة أو مراعاة لعرف جار عند أهل البلد.
الفرق بين جريان العمل والعرف:
وهناك فرق جليّ بين جريان العمل والعرف، فالأول من عمل الفقهاء والقضاة حيث أفتوا بذلك، وقضوا به، واستمروا عليه، أما العرف فمردّه إلى عامة الناس وما استقروا عليه من غير استناد إلى فتوى أو حكم([11]).
وهذه العادات والأعراف المتبدّلة هي الأعراف التي لم تنشئها الشريعة أصلًا، ولم تتعرَّض لها إطلاقًا، لا بمدح ولا ذمّ، إنما أنشأها الناس بأنفسهم نتيجة العلاقات الاجتماعية بينهم، فهذه هي التي يؤثّر تغيّرها في أحكامها الشرعية، فيتغير حكمها تبعًا لتغيرها.
أما الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية الآمرة والناهية -كحرمة الظلم، وحرمة الزنا والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق- فهذه لا تتبدل بتبدّل الزمان، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال، وتتغير وسائلها فقط.
وكذا جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص([12]).
فالحقيقة أن الأحكام التي تتبدّل بتبدل الزمان المبدأ الشرعي فيها واحد وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد.
والمالكية من أوسع المذاهب أخذًا بالأعراف، حتى قال القرافي: (يُنْقل عن مذهبنا أن من خواصِّه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وليس كذلك. أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرِّحون بذلك فيها)([13]).
وهذا يبين لنا أن العرف أوسع من العمل، فإن إعماله مما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، بخلاف جريان العمل الذي هو من مصطلحات المالكية، وإن عمل به في بعض المذاهب([14]).
وقد بدا للبعض أن منشأ قاعدة (ما جرى به العمل) يرجع إلى قاعدة (عمل أهل المدينة)، وفحوى هذا الرأي أنه تطورت نظرة الفقهاء إلى عمل أهل المدينة، فكما أن الإمام مالكًا ينظر إلى العمل الأكثر والمستمر ويقدّمه على أحاديث الآحاد، كذلك رأى القضاة والفقهاء أن القاضي عليه أن ينظر في عمل سلفه من القضاة، فما كان مستمرًّا عمل به والتزم به، وقدمه على المشهور وعلى أدلة أخرى([15]).
الفرق بين عمل أهل المدينة وعمل المتأخرين لدى المالكية:
وهذا الرأي وإن كان أصله أن العمل امتداد لفكرة عمل أهل المدينة، إلا أن هناك بعض الفروق بينهما: فعمل أهل المدينة دليل نقلي متواتر، ومن ثمَّ يقدّم على خبر الآحاد، وترجيحه مبدأ أصيل مستمرّ لا يخضع للعرف ولا للمصلحة، أما تقديم ما جرى به العمل على المشهور فإنما هو بمقتضى الأسباب الداعية إلى ذلك؛ كالعرف والمصلحة، ومتى زال السبب رجع إلى العمل بالقول الراجح، ولهذا يعدّون فقه ما جرى به العمل استثنائيًّا.
وأيضًا عمل أهل المدينة المقصود بهم العلماء الذين كانوا في المدينة منذ عصر الصحابة والتابعين إلى أن وصل العمل في عصر الإمام مالك، وأما العمل المتأخّر لدى المالكية فيقصدون به عمل القضاة والمفتين في الأزمنة المتأخرة في ناحية المغرب الذي نشأ عندهم هذا المصطلح ثم وصل لمالكية المشرق، وفرق بين عمل السلف في القرون المفضَّلة الذين أدركوا عصر التنزيل وفي منزل الوحي مع اكتمال آلة الاجتهاد، وعمل المتأخرين الذين لم يشهدوا شيئًا من ذلك؛ لذا كثر عندهم البدع في أبواب العبادات.
ومن المعلوم أن أبواب العبادات توقيفية، ولا يمكن أن نستحسن عبادة من عند أنفسنا، ثم نشرعها، ونعتمد على أفعال المتأخرين للدلالة على ثبوتها.
ولأجل صدور بعض النماذج من العمل الذي يظهر فيه مخالفة النص أنكر من أنكر من الفقهاء على فقه ما جرى عليه العمل، بل بالغ الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة حتى إنه قال بعد جعله جريان العمل من أهم أسباب سقوط الأندلس، قال: (أما في المغرب فلما بَلَغ الحالُ إلى هذا الحد تجلى انتقامُ الله تعالى في الاستعمار الذي أَلغَى هذا العملَ الضالّ، ونَسَخَه بِعَمل باريس الجاري به العملُ، لا في المغرب فقط كما هو مشاهَد ومعلوم، ولله الأمر من قبلُ ومن بعد)([16]).
ويشترط لتقديم ما يجري به العمل عند المالكية خمسة أمور:
ذكر الشيخ أبو العباس أحمد الهلالي هذه الشروط بقوله: “إنه يشترط لتقديم ما به العمل أمور:
أحدها: ثبوت جريان العمل بذلك القول.
ثانيها: معرفة محلية جريانه عامًّا أو خاصًّا من البلدان.
ثالثها: معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في الترجيح.
رابعها: معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور إلى مقابله”([17]).
ولا يختلف عنه كثيرًا د. محمد إبراهيم علي في كتابه (اصطلاح المذهب عند المالكية) فقد ذكر لتقديم ما يجري به العمل خمسة أمور:
الأول: ثبوت جريان العمل بذلك القول.
الثاني: معرفة محلية جريانه عامًّا أو خاصًّا بناحية من البلدان.
الثالث: معرفة زمانه.
الرابع: معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم الترجيح.
الخامس: معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور إلى مقابله([18]).
وهذه الشروط اختلف المالكية حول تطبيقها على أرض الواقع، وهل يلتزم القاضي والمفتي بها عند إصدار الأحكام، ويمكننا القول: إن الأمر سيكون أضبط في المحاكم الشرعية اليوم، وذلك بالنظر إلى السوابق القضائية، حيث يمكن من خلالها التعرف على ما جرى به عمل القضاة السابقين، والله أعلم.
ختامًا: يغلب استعمال العمل عند المتقدمين على الأقوال المشهورة، والتي قال بها أكثر العلماء، بل قد يصل إلى حدّ الإجماع؛ لذا استخدم كثير من العلماء في عمل أهل المدينة عبارة «إجماع أهل المدينة»، وكذا ما فعله الإمام الترمذي حيث لم يورد في جامعه إلا ما جرى عليه العمل، سوى حديثين، وفي بعضها يقول: «والعمل عليه عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا»، «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم»، «وعليه العمل عند عامة الفقهاء».
وأما العمل عند المتأخرين خاصة المالكية، فالمراد به العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح الضعيف أو الشاذ؛ إعمالًا لمصلحة معتبرة أو دفعًا لمفسدة ظاهرة أو مراعاة لعرف جار عند أهل البلد.
والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([8]) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 323).
([9]) منار الفتوى وقواعد الإفتاء، إبراهيم اللقاني (ص: 272-273).
([10]) العرف والعمل في المذهب المالكي، عمر الجيدي (ص: 342)، أصول الفتوى والقضاء، محمد رياض (ص: 513).
([11]) محمد رياض، أصول الفتوى والقضاء (ص: 515).
([12]) انظر: القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، للزحيلي (ص: 319).
([14]) ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز (ص: 42).
([15]) ما جرى عليه العمل نموذج من تراثنا القضائي، للمدغري (ص: 49).
([16]) نظرات في تاريخ المذاهب الإسلامية وأصول مذهب مالك (بوخبزة)، بحث منشور في ملتقى أهل الحديث.
([17]) شرح خطبة المختصر (ص: 131)، وانظر تفصيل ذلك في كتاب: أصول الفتوى والقضاء، لمحمد رياض، (ص: 517).