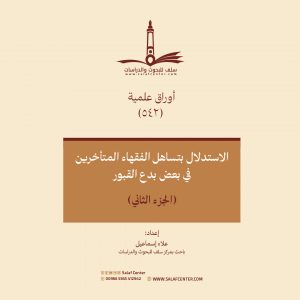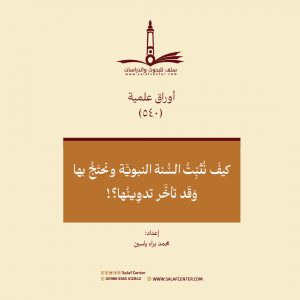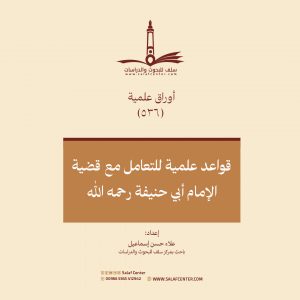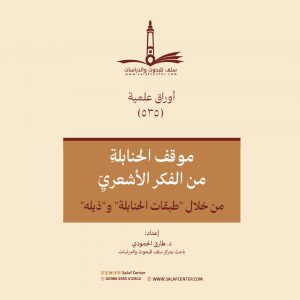منهجيَّة النَّقل ووحدةُ النَّاقل حجَّةٌ أخرى على مُنكري السُّنَّة
ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لعَن الله الواشماتِ والمستوشمات، والنامصات والمتنمِّصات، والمتفلِّجات للحسن المغيِّرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأةً من بني أسدٍ يقال لها: أمّ يعقوب، وكانت تقرأ القرآنَ، فأتته فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك أنَّك لعنتَ الواشمات والمستوشمات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله؟! فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟! فقالت المرأة: لقَد قرأتُ ما بين لوحَي المصحفِ فما وجدتُه! فقال: لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتِيه، قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]([1]).
هكذا نظر الصَّحابة الكرام إلى السُّنة النبويّة، فهي المصدر الثَّاني في التَّشريع، وهي التي تفصِّل ما أُجمل في القرآن، وتكشفُ غامضَه، وتبيِّن مبهمَه، وتقيِّد مطلقَه، وتخصِّص عمومَه، وتشرحُ أحكامه، فالعلاقة بين القرآن والسُّنة علاقةٌ وطيدةٌ لا تنفكُّ، ومن هُنا كان القرآن الكريم والسنَّة النبويَّة الشريفة هما المصدران الرئيسان للدِّين الإسلامي، فلا يمكن لمسلمٍ أن يفهَم الشريعةَ إلا إذا رجع إليهما معًا.
وقد بيَّن ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ الله قد أمر بالأخذِ بالسُّنة بقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}، قال الشيخ السعدي رحمه الله: “وهذا شاملٌ لأصول الدين وفروعه، ظاهرِه وباطنه، وأنَّ ما جاء به الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم يتعيَّن على العباد الأخذُ به واتِّباعه، ولا تحلُّ مخالفته، وأنَّ نصَّ الرسول صلى الله عليه وسلم على حكمِ الشيء كنصِّ الله تعالى، لا رخصةَ لأحدٍ ولا عذرَ له في تركِه، ولا يجوز تقديم قولِ أحدٍ على قوله، ثمّ أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة، وبها السعادةُ الدائمة والفوز العظيم، وبإضاعتها الشقاءُ الأبديّ والعذاب السرمدي”([2]).
وحجيَّة السنةِ أمرٌ مقرَّر عند عامَّة المسلمين، وعليها دلائل كثيرة، وفي هذا المقال نعرِّج على طريقةٍ من طرق تثبيت حجِّيَّة السنة، وهي: اتِّحاد المنهجيّة في نقل القرآن والسنة.
تحرير وتأصيل:
القرآنُ والسُّنة يتَّفقان في كونهما وحيًا من الله سبحانه وتعالى، وفي كونهما مصدَرين من مصادر التشريع، وفي وجوب تحكيمهما والرجوع إليهما، وقبول أحكامهما والتسليم لهما والرضا بهما، ويختلفان في أمورٍ؛ منها أن القرآنَ متعبَّد بتلاوته بخلافِ السنة، وأن القرآن معجز وقع التحدِّي به بخلاف السنة، وأنَّ القرآنَ أعظمُ منزلةً فهو كلام الخالق سبحانه وتعالى([3]).
وممَّا يتفقان فيه: أنَّ المنهجية التي اتُّبعت في نقل القرآن والسُّنة واحدة، فلا فرق بين القرآن والسُّنة إلا من جهة التَّفاضُل في النَّقل لا من حيث المنهجيَّة نفسُها، وما دام أنَّ السنة قد نُقلت إلينا بنفس المنهجية التي نُقل بها القرآن؛ فإنَّ من يفرِّق بينهما يَقع في حُزمة من الأخطاء المنهجيّة، كما أنَّه يمارس مغالطَةَ الانتقاء بجدارةٍ؛ إذ إنه يفرق بين متماثلين، فهذه الطريقةُ في إثبات حجِّيَّة السُّنة خلاصتُها: أن من أخذ بالقرآن يجب عليه ضرورةً أن يأخذ بالسنة، والأخذُ بالقرآن دون الأخذِ بالسنة هو طعن في القرآن.
وسيكون بيان ذلك بالنقاط الآتية:
أولًا: وحدة منهجية التلقي:
كان القرآن الكريم ينزل على النَّبي صلى الله عليه وسلم بواسطةِ جبريل عليه السلام، فينقله كما أخذه عن الله عز وجل، ثم ينقله النَّبي صلى الله عليه وسلم إلى الصَّحابة رضوان الله عليهم، فكان الصحابةُ يحفظون هذه الآيات التي أنزلت ويتلونها ويتداولونها ويكتبونها، وكان صلى الله عليه وسلم أيضًا يأمر بكتابة القرآن فيكتبه كُتَّابُ الوحي، فكانت منهجيَّة تلقّي القرآن من قِبَل الصحابة أنهم كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم فيعونَه ويحفظونه، وكذلك الشأنُ في السُّنة النبوية، فقد حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- على حفظ السنة، وتتبُّع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وهديِه الكريم، حتى إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها يقول: “كنت أكتب كلَّ شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه“([4])، فبين رضي الله عنه أنه كان يتتبَّع كلَّ ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حفظًا للسنة.
ومن مظاهر حفظ الصحابة للسنةِ والاعتناء بها أنهم كانوا يتناوبون في الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عمر رضي الله عنه قال: “كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن زيد -وهي من عوالي المدينة-، وكنا نتناوب النزولَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يومًا وأنزل يومًا، فإذا نزلت جئتُه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك”([5])، وجلوسُهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ليؤخَذ ويحفظ عنه كلّ الوحي، وهو يشمل القرآن والسنة.
والشاهد أنَّ المنهجية التي بها تلقَّى الصحابة القرآنَ هي المنهجية التي تلقَّى الصحابة بها السنة، فكلاهما عن طريق جلوسِهم عندَ النبي صلى الله عليه وسلم وسماعهم منه.
ثانيا: منهجية التقييد:
كان القرآنُ الكريم يكتبه كتَّاب الوحي بأمر النَّبي صلى الله عليه وسلم، فكان القرآن كلُّه قد كُتب في عهده صلى الله عليه وسلم، لكنَّه لم يكن مجموعًا في مكانٍ واحد، قال القسطلاني: “وقد كان القرآن كلُّه مكتوبًا في عهده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكنه غير مجموع في موضعٍ واحد”([6])، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقعت وقعة اليمامة، فقتل فيها كثير من قراء الصحابة، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما: “إنَّ القتلَ قدِ استحرَّ يومَ اليمامة بقرّاء القرآن، وإنِّي أخشى أن يستحرَّ القتل بالقرّاء بالمواطن، فيذهب كثيرٌ من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن”([7])، فجُمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم لَمَّا صار الأمر إلى عثمان رضي الله عنه جمَع الناس على مصحفٍ واحد.
والسنة أيضًا حظِيت بالكتابة منذ عهد النبوة، وإنَّ جولةً سريعة في النصوص الصحيحة التي تبين لنا حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تكشفُ بنا كيف أن السنة كانت تحتلّ مكانة عظيمةً في قلوبهم، ففي حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: كنت أكتب كلَّ شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كلَّ شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلَّم في الغضب والرضا! فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه، فقال: «اكتب؛ فوالذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حقٌّ“([8])؛ ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: “ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثًا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب”([9]). ولا تعارض بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر عن كتابة الحديث خوفًا من اختلاطه بالقرآن، فإنه أذن فيما بعد بالكتابة، كما يدلُّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «اكتبوا لأبي شاه»([10])، ولسنا هنا بصدَد بيان كتابة الحديث من عهد الصحابة ومن بعدهم([11]).
والشَّاهد: أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كما أنَّهم كتبوا القرآن فقد كتبوا السنَّة، والاتفاق في المنهجية لا في التفاصيل كما سيأتي، فالمنهجية واحدة، وهي أن يسمعوا شيئًا من النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبوه.
ثالثا: وحدة الناقل:
من غير المقبول أن يأتي إنسانٌ عدل صادق ضابط فيحدِّث الناسَ بحديث كثير، فيأتي أحدُهم ويصدقه في جزء ولا يصدقه في جزء آخر، وليس له في هذا التفريق إلا مجرد التشهي في القبول! وهذا هو الحاصل من منكري السنة في موقفهم من السنة النبوية.
فإنَّ من سمع القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام هم من سمعوا السُّنة أيضًا، فنقلوها إلى الجيل الذي بعدهم كما نقلوا القرآن إليهم، وقد عدَّ الذهبي رحمه الله الصحابةَ الذين نقلوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء رضي الله عنهم، ثم قال: “فهؤلاء الذين بلغَنا أنهم حفظوا القرآنَ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأُخِذ عنهم عرضًا، وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة. وقد جمع القرآنَ غيرُهم من الصحابة كمعاذ بن جبل وأبي زيد وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمر وعتبة بن عامر، ولكن لم تتَّصل بنا قراءتهم؛ فلهذا اقتصرتُ على هؤلاء السبعة رضي الله عنهم، واختصرتُ أخبارهم، فلو سقتها كلها لبلغت خمسين كراسا”([12]).
فهل رأيت هؤلاء الصحابة قد أحجموا عن رواية السنة، أم أنهم كما نقلوا القرآنَ نقلوا السنة كذلك؟! وكتبُ السنة مليئة بالأسانيد الموصلة إلى هؤلاء الصحابة الكرام، فلم يكن من الصحابة من كان يختصُّ بالقرآن ولا ينقل السنة حتى نقبل كلامَ فئة دون فئة، وإنما كان ناقل القرآن وناقل السنة واحدًا.
فوحدة الناقل يوقع منكري السنة في مأزق لا يستطيعون التخلُّص منه، إلا بقولهم: إن نقل القرآن متواتر ونقل السنّة ليس كذلك، وسيأتي الجواب عنه، ولكن الذي يهمُّنا هنا هو أن نبينَ أن الصحابة الذين نقلوا القرآن هم أنفسهم الذين نقلوا السنة، ولا يصحُّ التفريق بينهم من هذه الجهة.
رابعًا: طريقة النقل بالأسانيد:
ممَّا توافق فيه السنةُ القرآنَ منهجيةُ النقل، فهي منقولة بالأسانيد؛ راوٍ عن راوٍ إلى الصَّحابة -رضوان الله عليهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآنُ بالقراءاتِ العشرة المعروفة لدينا منقولة من أصحابها بأسانيدهم مقرئ عن مقرئ إلى الصحابة -رضوان الله عليهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطريقة نقل القرآن إلى الأمَّة تمَّت عن طريق السند، وكذلك طريقة نقل السُّنة إلى الأمَّة تمت عن طريق السند، فالاثنان متَّفقان في آلية النقل من هذه الجهة، ولا سبيل إلى التفريق بينهما.
فإذا أتينا إلى أسانيدِ القرآن مثلا نجد أن روايةَ حفص التي يَقرأ بها عامَّة أهل المشرق قد أخذها عاصم بن أبي النجود، وهو أخذها عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأخذها هو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم([13]). ورواية ورش التي يَقرأ بها عامة أهل المغرب أخذها عن نافع بن عبد الرحمن المدني، وأخذها نافع عن أبي جعفر وأبي روح يزيد بن رومان وأبي عبد الله مسلم بن جندب، وهؤلاء أخذوا عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وهما قد أخذاها عن أبي بن كعب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم([14]).
وكذلك السُّنة، فالإمام مالك رحمه الله -على سبيل المثال- يروي عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنه. والإمام أحمد يروي عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي بن كعب رضي الله عنه. والبخاري يروي عن محمَّد، عن عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومسلم يروي عن يحيى التميمي، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه. إلى غير ذلك من الأسانيد الكثيرة.
فهؤلاء الصَّحابة هم نفسهم الصَّحابة الذين تنتهي إليهم أسانيد القرآن، وقد نقلوها إلى التابعين، والتَّابعون نقلوها إلى من بعدهم، فما الفرق بين هذه الأسانيد؟!
لا يوجد أيُّ فرق منهجيّ معتبر بين أن ينقل الصحابيّ القرآن بإسناده ونأخذه وبين أن ينقل السنة بإسناده ونأخذها، ومن طعن في السُّنة لزمَه أن يطعنَ في القرآن الكريم؛ لأنه أيضًا منقول إلينا بهذه الأسانيد.
خامسا: وحدة الشرط:
والمقصود بذلك أن الشروط المعتبرة في تلقِّي القرآن وتحمُّله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلينا هي نفسها الشروط في السنة النبوية، فاتِّصال السند ضروريّ في أسانيد القرآن وأسانيد السنة، وبفقدِه يُحكم على الرواية بالضعف ولا يؤخَذ بها، ولا يخفى على عموم الناس ما كان من شروط صارمَة في نقل الحديث منذ أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدوَّن في الكتب المعتبرة، بل ومن بعد كتابتها إلى يومنا هذا.
فإن قيل: إن السُّنة لا تساوي القرآن في النقل؛ فالقرآن نُقل إلينا نقلًا متواترًا، والسنة ليست كذلك، والقرآن أخذه كثير من الصحابة والسنة ليست كذلك، والقرآن دوِّن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسنة معظمها ليست كذلك، فكيف تساوون بين الاثنين؟!
نقول: لم نزعم أنَّ السنة من جهة النقل مثلُ القرآن تمامًا، ولا يخفى على أحدٍ أن القرآن أعلى منزلة وأكثر حفظًا وصونًا، وهو ثابتٌ كله ثبوتًا قطعيًّا بخلاف السنة النبوية، فطريقتنا في إثباتِ السنة ليست هي الدعوى بأن السنة مثل القرآن تمامًا في طرق النقل، ولكن طريقتنا هي بيان أنَّ المنهجية واحدة، فآلية نقل القرآن الكريم هي نفسها آلية نقل السنة النبوية من حيث الاعتماد على الضبط، والاعتماد على نفس الأصحاب الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة، ومن حيث الوصول بالطريقة نفسها بالأسانيد.
والاتفاق في المنهجية كافٍ في الأخذ بهما جميعًا، مع وجود الفارق في التفاصيل.
فإن قيل: بل كتِبَ المصحف كاملًا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فنحن إنَّما نأخذ هذا المكتوب ولا اعتبار للسند والنقل.
نقول: أين هذا المصحف؟! هل يمكن أن تخرجه لنا، أم أنَّ الأمة حفظت ذلك المصحف ونقلوه لمن بعدهم، فأخذنا ما نقلوه لنا؟!
ولا شك أن المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه قد نقله الناس طبقةً عن طبقة، فرجعنا إلى ضرورة الأخذ بالنقل واعتبار السند.
بل يقال: من الذي قال بأن هناك مصحفًا جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا أن يكون عُلِم ذلك عن طريق النقل؟! فلا مناص إذن من الاعتماد على النقل والسند طبقة بعد طبقة حتى يصل إلينا.
وأخيرًا: يقول ابن أبي العز الحنفي: “وكيف يتكلَّم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسُّنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟! وإذا زعم أنَّه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول، ولا ينظر فيها، ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيَّرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلَّمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنُّه دين الله ولم يتلقَّ ذلك من الكتاب السنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره”([15]). فالسُّنة عند الصحابة ومن بعدهم ممَّن تبعهم بإحسان يعرفون أنها مبيِّنة للقرآن مفسِّرة له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بالقرآن جاء بالسنة، ومن أخذ بالقرآن دون الأخذ بالسنة فقد طعن في القرآن؛ لأن منهجية وصول القرآن إلينا متَّحدة مع منهجية وصول السنة، فكان منهج عموم المسلمين في الأخذ بالقرآن والسنة هو المنهج السليم الواضح، وأما منهج منكري السنة ممن يفرِّقون بين المتشابهات فهو منهج متلبِّس بحزمة من الأخطاء المعرفية، بل والتناقضات الواضحة، مثل هذا التناقض الذي مر معنا في هذا المقال.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) أخرجه البخاري (5939)، ومسلم (2125)، واللفظ لمسلم.
([3]) في مركز سلف مقال بعنوان: “هل يلزم من القول بصحة صحيح البخاري مساواته بالقُرآن الكريم؟” على الرابط: https://salafcenter.org/3764/
([4]) أخرجه أبو داود (3646)، وأحمد (6510)، قال ابن حجر في الفتح (1/ 207): “له طرق يقوّي بعضها بعضًا”، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1532).
([6]) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (7/ 446).
([10]) أخرجه البخاري (2434)، ومسلم (1355).
([11]) هناك كتب كثيرة تحدَّثت عن كتابة الحديث وتدوين السنة، وبالتسلسل التاريخي، انظر على سبيل المثال: تقييد العلم للخطيب البغدادي، والسنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب، وتدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري لمحمد بن مطر الزهراني، والسنة النبوية حجيتها وتدوينها لسيد الغوري، ودراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه لمحمد الأعظمي.
([12]) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار (ص: 20).
([13]) انظر: المبسوط في القراءات العشر للنيسابوري (ص: 41-44).
([14]) انظر: جامع البيان في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (1/ 224-225).