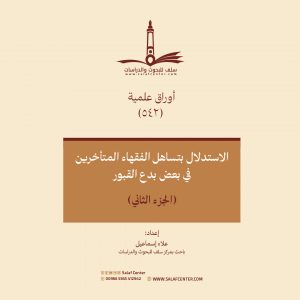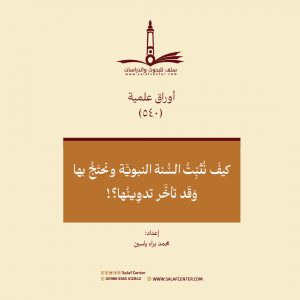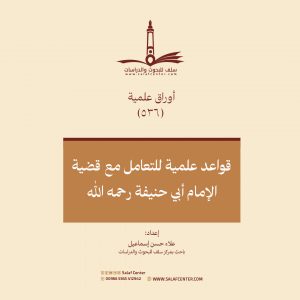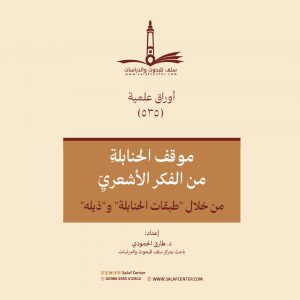بعض الأخطاء المنهجية في نقد السلفية -عدم التفريق بين اللازم والإلزام مثالا-
كلُّ ما يرتبط بالبشرِ -عدا الأنبياء- فهو عرضَة للخطأ والنسيان والنَّقص؛ لأنَّ الإنسان خلقه الله على هذه الهيئة، لا بدَّ أن يخطئ مرة ويصيب أخرى، وحسبه شرفًا أن يكثُر صوابه، ومن فضل الله على عباده أن ضاعَف لهم الحسناتِ والأجور؛ لأن الغالبَ في الإنسان إذا تُرك على عمله أن يغلبَ عليه طبعُه، وهو الجهل والظلم وعدم الصبر، قال سبحانه: {وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولًا} [الإسراء: 11]، قال قتادة: “يدعو على نفسه بما لو استجيب له هلك، وعلى خادمه، أو على ماله”([1]).
وهذا التقلُّب والضَّجر في الأمور يجعل أحكامَ الإنسان غيرَ منضبطة، ومن ثمَّ فلا يمكن الاستناد إليها مطلقًا، وذلك لتأثير الشهوة والطبع على العقل فيها، ومن هنا أدرك العقلاءُ أنه لا يمكن أن يصيَّر شخص بنفسه علامَة على الحقِّ أو دليلا عليه، وتبرئةُ البشر من كلِّ ما ينسب إليهم مجازفة، كما أن إثباتَ كلّ ما ينسب إليهم ظلمٌ وجَور، والعبرة في كلِّ دعوى يدَّعيها صاحبها هي البيِّنة وما شهد الشرع باعتباره من القرائن والظنون، وأكثر ما ينبغي أن تنطبق عليه القواعد المنهجية العلميَّة هو نقد الأفكار وتصويبها وتخطئتها، وقد درج كثير من الناس في نقده للأفكار على التشفِّي والتسلِّي والاسترسال بدلَ التأني والتثبُّت.
ومن الموضوعات التي تكثر فيها الأخطاء المنهجيةُ موضوع نقدِ السلفية، ولهذه الأخطاء أسبابٌ كثيرة، منها الشهوة الإعلاميَّة ومحاولة خطف الأضواء، ووضع قدم صدق عند صُناع القرار الدولي والعالمي ممن اتَّخذوا السلفيةَ عدوًّا، ومنها كذلك الانتصارُ للمذهب والطائفة، وإخراج ذلك في ثوبِ الحميَّة الإيمانية الصادقة. ومهما تعدَّدت الأسبابُ فثمَّةَ أخطاء تجمَع بين أصحابها لا ينفرد بها أحدٌ عن أحد منهم، ونكتفي منها بالمشتهر وهو: عدم التفريق بين اللازم والإلزام.
منَ المعلوم أنَّ لازمَ المذهب لا يكون مذهبًا إذا لم يلتزمه صاحبُه، والمقصود باللازم ما يترتَّب على القول؛ إما بإلحاق شبيهه به، أو كون هذه القضية لا تنفكُّ عن الأخرى لتلازمهما كما الشأن بين النار والحرارة، لكن ثَمَّ فرقٌ بين اللازم والإلزام، فالإلزام دعوى على الخصم قُصاراها أن تثبتَ تناقضَه إن صحَّت، وإذا لم تصحَّ فهي اعتقاد من الخصم باطل([2]). وهذا الخطأ المنهجيّ موجود عند منتقدِي السلفيةِ في أبواب المعتقد وفي الفقه وفي الأصول.
ومن أمثلته في أبواب المعتقد قضيتان أساسيتان:
القضية الأولى: التكفير
فحين يقرِّر السلفيون نواقضَ الإسلام ويشرحونها، يُلزِمهم خصومُهم بأن في تقريرها وتبيينها للناس تكفيرًا لهم، وهذا إلزام باطلٌ، فلا يكون لازمًا؛ إذ من المتَّفق عليه أن الردةَ بابٌ من أبواب الفقه، مبيَّن في كتب الفقه بشروطه وضوابطه، وبيانُه للناس تابعٌ لحاجتهم إليه، فكلَّما انتشر مرضٌ في الناس استدعى ذلك بيانَه وتوجيهَ الناس إليه، فحين ينتشر الترفُ والغنى ينسَى الناس ربهم، فلا بدَّ من الكلام في الزهد وحقيقة الدنيا وزوالها، وهكذا حين تهدَّد الأمة في عقائدها، فيلزم بيانُ ذلك وتوضيحُه للناس؛ لهدايتهم وردِّ الشبهات وإقامة الحجَّة على المعاند، وإذا غلا الناسُ في التكفير وجَب بيان خطره وخطَر الغلوّ فيه، وكلُّ هذا قد تناوله السلفيّون بإسهاب، وبعض متفقِّهة خصوم السلفية يعدلون عن الموضوع وإنكاره بالكلّية إلى محاولةِ التشغيب على بعض القواعد، وجعلها مداخل لنقدِ السلفية، مثل قاعدة: “من لم يكفِّر الكافر فهو كافر”، وادِّعاء أن السلفيين يكفِّرون كلَّ من خالفهم، ومن خالفهم في تكفير من كفَّروه كفَّروه أيضًا، وهذا لا يستقيم؛ إذ القاعدة ليست خاصَّة بالسلفيين، وتقريرها ليس على نحو ما يَفهم هؤلاء.
فالمقصود بالكفَّار في القاعدة هم الكفار الذين يُقطع بكفرهم، أي: أهل الملل من غير الإسلام ممَّن نطق القرآنُ بكفرهم، وليس منِ اجتهدَ عالمٌ أو مجموعة من العلماء في كفرهم؛ بدليل اختلاف العلماء في تكفير كثيرٍ من الطوائف، ومع ذلك لم يُجرِ أحدٌ منهم القاعدة على خلاف ظاهرها.
وأما وجودُ القاعدة عند غير السلفيين فهو مقطوعٌ به، يعرفه كلُّ مطَّلع على كتب الفقه، يقول القاضي عياض رحمه الله وهو مالكيّ المذهب: “ولهذا نكفِّر من لم يكفِّر من دان بغير ملَّة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شكَّ، أو صحَّح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقَده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك”([3]). وجولةٌ واحدةٌ في كتاب “الشفاء” للقاضي عياض رحمه الله تردُّ خيلَ هؤلاء على دابرها.
وما قاله القاضي عياض موجودٌ أيضًا في سائر كتب المذاهب ومقرَّر.
قال الشرواني الشافعي في وهو يعدِّد الأقوالَ المكفرة: “أو قال: توفَّني إن شئت مسلمًا أو كافرًا، أو لم يكفِّر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شكَّ في كفرهم، أو قال: أخذتَ مالي وولدي فماذا تصنع أيضا؟! أو ماذا بقي لم تفعله؟! أو أعطى من أسلم مالًا فقال مسلم: ليتني كنت كافرًا فأسلم فأعطَى مالًا، أو قال معلم الصبيان مثلا: اليهودُ خير من المسلمين لأنهم ينصفون معلِّمي صبيانهم”([4]).
وقال البهوتي الحنبلي: “وكذا منِ اعتقد قدَم العالم أو حدوث الصانع، أو سخر بوعدِ الله ووعيده، أو لم يكفِّر من دان بغير دين الإسلام كأهل الكتاب، أو شكَّ في كفرهم، أو صحَّح مذهبهم”([5]).
ويزيد مصطفى بن سعد السيوطي الحنبلي فيقول: “وكذا الدروز والتيامنة الذين ينتحلون عقائدَ القرامطة والباطنية، وجميع الطوائف المذكورون زنادقة ملاحِدة متقاربون في الاعتقاد، وقدِ اتَّفق المسلمون على كفرهم، ومن شكَّ في كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لأنهم أشدُّ كفرًا من اليهود والنصارى؛ فلا تحلّ مناكحتهم، ولا تؤكل ذبائحهم، بخلافِ أهل الكتاب، ولا يجوز إقرارهم في ديار الإسلام بجزيةٍ ولا بغير جزية، ولا في حصون المسلمين”([6]).
ثم قس على ذلك سائرَ المسائل في الباب مما يقع فيه خصوم السلفية في أخطاء منهجية؛ إما بالتحكُّم في النصوص، أو الذم بالشيء والمدح به معًا، فيقرِّرون أنَّ هذا القولَ غلوٌّ، فإذا وجد عندهم في مذاهبهم تأوَّلوه، وحاولوا إيجادَ فرقٍ ولو في التعبير لتسويغه.
القضية الثانية: الأسماء والصفات
فحين ينتقد خصومُ السلفية موقفَ السلفيةِ من قضيةِ الأسماءِ والصِّفاتِ يجعلونَ السلفيةَ هي مصدر المصادَرة للآراء؛ لأنها تقرِّر أقوالا يرون هم أنها تخالف ما عليه السوادُ الأعظم، وعليه فإنَّ تقرير هذه الأقوال وإبطال ما خالفها يعدُّ تفريقًا للأمة ومصادرة، وهذا القول يشمل خطأ منهجيًّا من نواحي عدة:
الناحية الأولى: أنَّ في تقرير هذه المسائل تفريقًا للأمة، والأمر ليس كذلك، فالأمة مطالبة بالاجتماع على الحقّ لا على الباطل، وهذا الحقُّ في هذا الباب محصور فيما كان عليه الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن تبعهم من الأئمة، ويجب على المسلم دعوةُ الناس إليه أصولًا وفروعًا؛ لأن ذلك من الدين، واجتماع الناس عليه هو الاجتماع المحمود شرعًا.
الناحية الثانية: السوادُ الأعظم لا يمكن أن يخرجَ منه الصحابة والتابعون وأئمَّة الحديث، ومن المعلوم أنَّ ما يقرَّره السلفيون هو ما عند هؤلاء في باب الأسماء والصفات، فمن استكثر بالسواد الأعظم فلا بدَّ أن يعدَّ هؤلاء، وإلا قلَّ سواده وتفرَّق جمعه، ومحاكمة العامَّة إلى هؤلاء هي الفيصل في الدين، فلا يمكن الالتفاف عليها بالاحتجاج بفرق الكلام ودولهم التي فرضت آراءها على الناس، سواء في ذلك الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، فكلٌّ منهم كان يفرض رأيَه ويُلزم به العامّةَ والفقهاءَ، حتى يصير أهلُ ذلك الزمن الذي حكموا فيه على قولهم، ومحاكم التفتيش عند المعتزلة في مسألة خلق القرآن وإكراه الناس على القول به لا تحتاج إلى عناءٍ لإثباتها.
فهذه الأكثريةُ المدَّعاة فُرِضَت على الناس قرونًا بسلطان الملك وحجّة السيف، وإغفال هذا الجانبِ في تقييم الكثرة غير موضوعيّ وغير منهجيّ، والمطالبةُ بإقرارها وهذا حالها غيرُ موضوعيّ، بل لا بدَّ من إرجاع الأكثرية إلى المنبع الأوّل والطريق الصحيح.
الناحية الثالثة: دعوى التفريق، هذا إذا سلمنا أنّ السواد متّفق أصلا، فإن قصد به مجموع المتكلمين فهم مختلفون بعدَد أنفاسهم، وإن قصد به خصوص الأشاعرة فهم مختلفون أيضًا في أبواب العقيدة أقوالا لا تقف على ساق واحدةٍ بين مؤوِّل ومفوِّض، وبين مثبت لبعض الصفات ومجرٍ لها على ظاهرها ومفوِّض للبعض ومؤوِّل للبعض الآخر، وهم أوَّل معترفٍ بهذا الاختلاف، يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: “والعجبُ أن الأشعريةَ اختلفوا في كثيرٍ من الصفات كالقدم والبقاء والوجه واليدين والعينين، وفي الأحوال كالعالمية والقادرية، وفي تعدد الكلام واتحاده، ومع ذلك لم يكفِّر بعضهم بعضًا، واختلفوا في تكفير نفاةِ الصفات مع اتِّفاقهم على كونه حيًّا قادرًا سميعًا بصيرًا متكلمًا، فاتَّفقوا على كماله بذلك، واختلفوا في تعليله بالصفات المذكورة”([7]). واختلفوا في حقيقة الوجود وفي معنى الإله وغيرها([8]).
فأهل المذهَب مختلفون في هذه المسائل، وبينهم نقاشاتٌ فيها، وهم أيضا مثرِّبون على من خالفهم مشنِّعون عليه. ثمَّ يُراد للأمة أن تبقى في هذا الخلاف ردحًا من الزمن، وكلّ من رام هدايةً أو بيانًا أو ردَّ الناس إلى حقٍّ أخفَته أيادي الخلاف وأبادته عوادي الشبهات يُعدُّ مفرِّقًا للأمَّة!
ثم قس على ذلك أصولَ الفقه والفقه، فالسلفية حين تنتقد التقليدَ -الذي هو جمودٌ وتوثين لآراء الرجال- تُجعَل رافضةً للتَّمذهب الذي هو طريقةٌ في الترقِّي العلميِّ، ولا ترادف بينه وبين التقليد؛ بدليل أنَّ مجتهدي الأمَّة متمَذهبون، وليسوا مقلِّدين، لكن أهل التقليد يلزمون السلفيةَ بأنَّ رفض التقليد هو رفضٌ للتمذهب، ويحمِّلونهم مسؤوليةَ كلِّ انفلات علميٍّ، وإن خالف أصلهم ومنهجهم العلميّ الذي يدعُون إليه، والآراءُ الفقهيَّة التي يقول بها السلفيون وإن اختصُّوا بها في زمن معينٍ فإنها ليست خاصَّة بهم من الناحية العلمية، بل إما أن تكونَ إجماعًا أو قول الجمهور كما هو الحال في اللّحية والموسيقى وتولية المرأة وغيرها من المسائل، سوى ما شذَّ فيه بعض السلفيّين ووافقوا فيه بعض أقوال الظاهرية؛ لكنَّ الخصومة الثقافيّة تعمِي خصومَ السلفية وتوردهم المهالك، فيأبون إلا إلزامَها بمخالفةِ المذاهب ومحاوَلة بترها عن الأمّة، والله المستعان.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) ينظر: تفسير الطبري (17/ 394).
([2]) ينظر: القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 193، 217).
([4]) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 84).
([5]) شرح منتهى الإرادات (3/ 359).