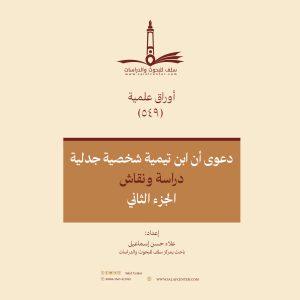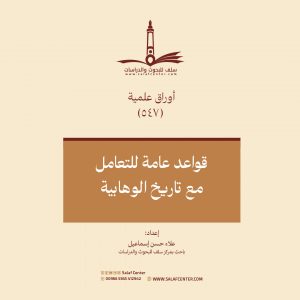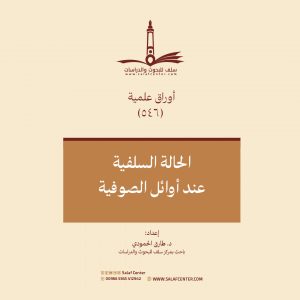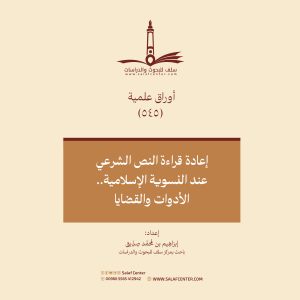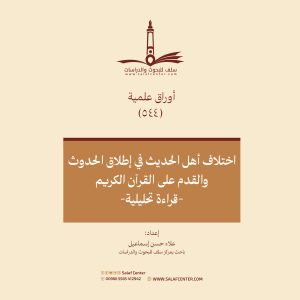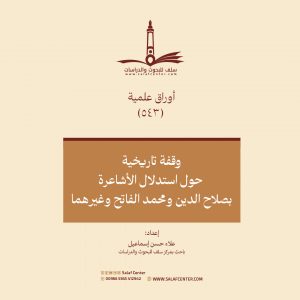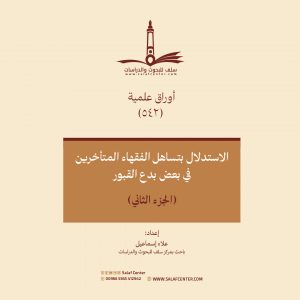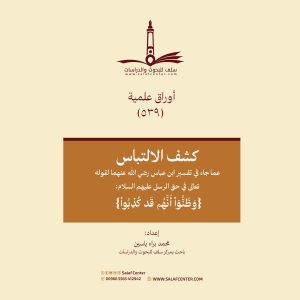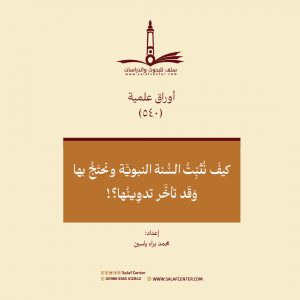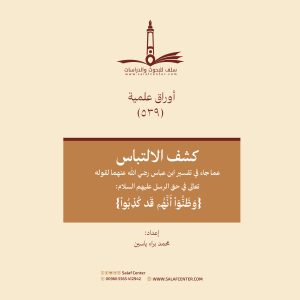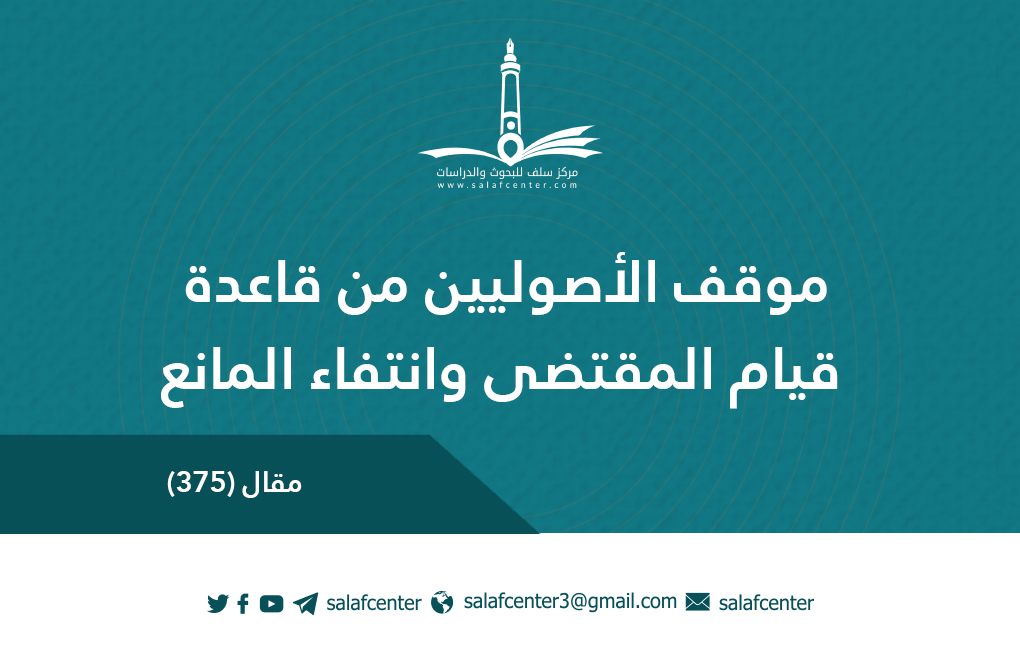
موقف الأصوليين من قاعدة قيام المقتضى وانتفاء المانع
كثُر اتِّهام السلفيِّين هذه الأيام بأنَّهم قدِ اخترعوا قواعدَ أصولية من أنفُسهم، ولم يقيموا عليها دليلًا ولم يوافقهم في ذلك الفقهاء أو الأصوليين. ومن تلك القواعد التي ينكرونها ما سمَّوه بقاعدة وجود المقتضى وانتفاء المانع، وهي أن ما وُجِد مقتضاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفَى المانع من فِعلِه ومع ذلك لم يفعَله فليس لأحدٍ أن يفعله، ويكون هذا الفعل ممنوعًا منه. ويستدلّون على ذلك بأنَّ الفقهاء لم يفهَموا هذا الفهم، فمِن ذلك ما نقَله المروذي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لأصحابه: إذا دخلتم المقابرَ فاقرؤوا آية الكرسي، وثلاث مرَّات: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، ثم قولوا: اللهم إنّ فضله لأهل المقابر، ويرون أنَّ هذا وأضرابَه لا مخرجَ منه إلا بتبديع الفعل على هذا القاعدة.
والحقيقةُ أنهم لم يفهموا هذه القضيَّةَ على وجهها؛ لذا فالهدف من هذا المقال هو بيان معناها، وبيان أنها لازم قول الفقهاء والأصوليين، وأن الادعاء بأنها من اختراع السلفيين ادعاءٌ باطل.
وهذه القاعدة في الحقيقة هي أحد طرق معرفة ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل، فهذه القاعدة لها علاقة بمتروك النقل، فلا بد من توضيح ذلك، وقد سبق في مقالٍ لمركز سلف بيان الدلالة الأصولية للترك([1])، فليس هذا محلَّ حديثنا في هذا المقال.
ما السبيل إلى معرفة ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟
السبيل إلى ذلك هو أحد أمرين:
الأول: أن ينقل الصحابي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الفعلَ، فلم يفعله، سواء في موقفٍ خاصّ كما في حديث الضب([2])، أو مطلقًا كقول أنس: «ما أكل رسول الله على خوان»([3]).
الثاني: وهو ما يسمَّى بمتروك النقل، وهو عدم نَقل ما لو فُعِل لتوفَّرت الهممُ والدواعي على نقلِه. إذن فالسبيل إلى معرفة متروك النقل هو البحث في إمكان وجود هذا الفعل في العهد النبوي، والبحث عن وجود مقتضى لذلك الفعل من عدمه.
وما ترك نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فَعَلَه لا يخلُو من أحدِ أمرين:
الأول: أن لا يكون مقدورًا له، والثاني: أن يكون مقدورًا له.
فالأول: خارج عن حديثنا؛ لأنه ليس من الترك الذي يتناوله البحث؛ لأن شرط الترك هو أن يكون مقدورًا. وهذا النوع إنما يدلُّ على حكمه بطريق القياس؛ لأن الأدلة الشرعية لا يمكن أن تتناوله بالنصِّ، وإنما تتناوله الأدلة عن طريق إلحاقه بما كان موجودًا وتناولته الأدلة.
والثاني: هو محل البحث، وقد قسمه الشاطبي إلى ضربين فقال: «سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:
أحدهما: أن يسكت عنه لأنه لا داعية تقتضيه، ولا موجب يقدّر لأجله، كالنوازل الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كجمع المصحف وتدوين العلم، فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعا بلا إشكال.
الضرب الثاني: أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان.. فهذا الضرب السكوت فيه كالنصّ على أن قصد الشارع ألا يُزاد فيه ولا ينقص»([4]).
هذا الضرب الثاني الذي ذكره الشاطبي هو ما جعله ابن القيم طريقًا لمعرفة الترك، وجعل وجود المقتضي وانتفاء المانع مع عدم الفعل دليلا على أنه لم يفعل([5]).
والنوع الذي يثبت بهذا الطريق هو الترك العدمي.
ويتضح من السياق السابق عدة أمور:
الأول: أن هذا التقسيمَ ليس من اختراع السلفيّين، ولو صحَّ أن يقال: إنه من اختراع أحدٍ لكان من اختراع الشاطبيّ -الأشعريّ كما هو معلوم-.
الثاني: أن هذه القاعدة ليست في كل ما ترك فعله على العهد النبوي.
الثالث: أنه لا بد من بيان المراد بالمقتضي كي تتضح القاعدة.
والمراد بالمقتضي في جانب العبادات هو التقرب المحض، وفي جانب المعاملات هو المصلحة.
الاستدلال على القاعدة:
الاستدلال على هذه القاعدة يكون بأمرين:
أحدهما: التدليل على أن ترك النقل يستلزم نقلَ الترك، أو أن عدمَ النقل يستلزم نقل العدم.
والثاني: الاستدلال على أن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على جوازه.
أما الأمر الأول فقد ذهب العديد من الأصوليّين -كالبيضاوي([6]) والإسنوي([7]) والقرافي([8]) وابن رشيق([9]) والآمدي([10]) وغيرهم- إلى أن الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم من الأدلة المقبولة شرعًا.
وذهب غيرهم إلى منع ذلك؛ لأنه يلزم منه خلوُّ الحادثة عن حكم شرعي، وهو باطل مردود.
ولذا فإذا قيل: إن المراد ليس ارتفاع الحكم بالكلية، وإنما عدم ثبوت الحكم على وجه الخصوص، ارتفع الخلاف وكان ما ذكره الفريق الأول محلَّ اتفاق كما صرح بذلك الشيخ محمد بخيت المطيعي([11]).
أما الأمر الثاني: فإن من أعظم الأدلة عليه أن الأشاعرة لهم قول مشهور بالوقف في مسألة الأصل في الأشياء، وعللوه بأنه لا يثبت حكم إلا بدليل، فهم فرّوا من إثبات الإباحة للأشياء حذرًا من أن يلزم منه إثبات عبادة بغير دليل.
إذن فهذه القاعدة هي لازم قول الأصوليين في هاتين القضيتين؛ ولذا قال ابن تيمية: «باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة وقربة إلا بدليل»([12])، وقال ابن القيم: «الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على الأمر»([13]).
ويؤيِّدُه إجماع الفقهاء على البقاء على الأصل في الاستصحاب وعدم إثبات حكم إلا بدليل، والعبادة دائرة بين الوجوب أو الاستحباب.
والمراد هنا هو العبادة المحضة التي لا تقَع إلا قربةً، وليس الفعل المباح الذي ينقلِب إلى قربةٍ بالنيَّة.
إذن: من فعل فعلًا على وجه التقرُّب المحض، وهذا الفعل كان مقدورًا وممكنًا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولم يفعله، ولم يمنع من فعل هذا الفعل مانع، فليس لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك الفعل على وجه التقرّب المحض، والتقرب المحض إلى الله تعالى بذلك الفعل بدعة.
وقد استدل الصحابة وتبعهم الفقهاء في كثير من المواضع بترك النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المقتضي وزوال المانع.
فمن ذلك: ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه، ولم يقيسوه على الميت غير الشهيد، وترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، ولم يقيسوه على الجمعة، وترك تخميس السلب، وترك تقسيم مال الكعبة، ولم يكتفوا فيه بمجرد المصلحة، وغير ذلك([14]) مما يدل على أن هذا أصل معتبر عند كافة العلماء.
وهنا سؤال هو: هل القول بالمنع من فعلٍ ما على وجه التقرب المحض يلزم منه أن الفعل ممنوع منه مطلقًا؟
والجواب: لا، إذا كان الفعل في أصله مباحًا أو داخلا في عموم أدلة أخرى.
وبالمثال يتضح المقال:
لو قال قائل: إن زيارة غار حراء من مناسك العمرة، ويستحبُّ الذهاب إليه وزيارته، لقلنا له: هذا أمر مبتدَع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعَله مع وجود المقتضي لفعله وهو قصد التقرُّب المحض به، وعدم وجود مانع منه.
ومع ذلك فهذا لا يعني أنَّ زيارة غار حراء محرَّمة أو ممنوعة بإطلاقٍ، أو بدعة في كلِّ حين، فلو أراد رجلٌ الذهابَ إليه لقصدٍ غيرِ محضِ التقرُّب (لغرض تعليمي أو بحثي أو توثيقي مثلا) فلا مانعَ من ذلك، وإنما المنعُ يكون في قصد التقرب المحض بذلك الفعل، وهذا يكون بإطلاق القول بأفضليته أو استحبابه.
ومثاله: الذكر المطلق، فيجوز للإنسان أن يخصِّص لنفسه من الأوراد ما شاء، فلو زعَم أنَّ أحدَها له فضلٌ في ذلك الوقت عن غيره لزمَه الدليل على ذلك التخصيصِ وإلا كان مبتدعًا.
وبناءً على ذلك فلا يشكِل على هذا التأصيل النقلُ المذكور في أول المقال، فإنَّ الإمام أحمدَ لم يقل باستحبابه في هذا الموضع، وله منزَع واضحٌ؛ فإن قراءة سورة الإخلاص تعدِل ثلثَ القرآن، فلعله أراد أن يفعلوا فعلًا صغيرًا عظيمَ الثواب يُهدون ثوابَه للأموات، وهذا لا مانعَ منه على ما سبق من التأصيل، لكن دونَ القول بتعميمه في كلِّ وقت أو القول باستحبابه بعينه في هذا الموطن.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
حكم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فِعله
([2]) رواه البخاري (5391)، ومسلم (1945).
([5]) إعلام الموقعين (4/ 264).
([6]) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (6/ 2656).
([7]) انظر: نهاية السول (4/ 395).
([8]) انظر: نفائس الأصول (9/ 4099).
([9]) انظر: لباب المحصول (2/ 462).
([10]) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 146).
([11]) في حاشيته على نهاية السول للإسنوي (4/ 396).
([12]) مجموع الفتاوى (31/ 35).
([13]) إعلام الموقعين (3/ 107).
([14]) هذه الأمثلة من الترك المنقول، لكنها يجمعها نفس الباب وهو أن الصحابة رأوا أن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور مع قيام مقتضاها مانع من فعلها، وتابعهم الفقهاء على ذلك، ولمزيد تفصيل في هذه القضية راجع كتاب: التروك النبوية تأصيلًا وتطبيقًا.