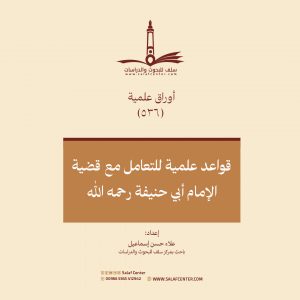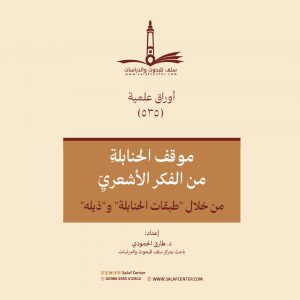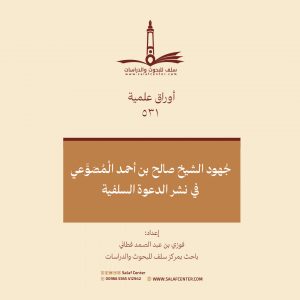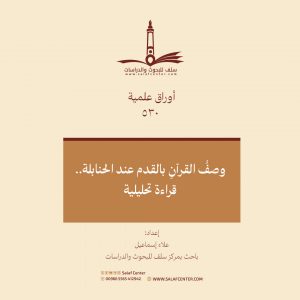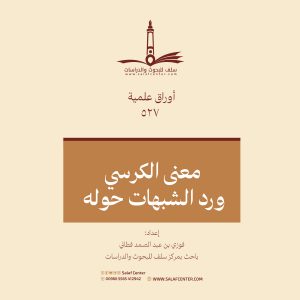معنى كون الحلال بيِّنًا والحرامِ بيِّنًا
لسانُ الشارع لِسانٌ مبينٌ، وقد قصد للبيان والإرشادِ، وصَرفَ العبارةَ في ذلك، ومِنَ المقطوع به أنَّ الحلال الذي يتوقَّف صلاحُ أمر الناس قد بُيِّن أحسنَ بيان، كما أنَّ الحرامَ الذي يتوقَّف عليه الفسادُ قد بُيِّن أحسنَ بيانٍ، وقد أحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانِ أصول الأشياء في أكثر مِن مناسبة، قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الحلالَ بيِّنٌ، وإنَّ الحرام بيِّنٌ، وبينهما مشتبهات، لا يعلمُهنَّ كثيرٌ من الناس»([1])، وسنناقش في هذا المقال معنى كون الحلال بيِّنًا والحرام بيِّنًا، ومعنى المتشابهات:
أولا: مفهومُ الحلال والحرام ومعنى كونهما بيِّنَيْن:
الناظِرُ في سياقِ الحديث يُدرِك أنَّ مَعنى الحلال في الحديث أعمُّ من مرادِفه الذي هو المباحُ في اصطلاح الفقهاء، وكذا الحرام؛ ولذلك حمَلَهما العلماء على المعاني الكُبرى، فحمَلوا الحلالَ والحرام على أصولِ المسمَّيات وكلِّيات الشرائع، وهي بيِّنةٌ وظاهرة، فالأصل في الماء الطهارةُ، وفي الميتةِ النجاسة، فما أشكَلَ على الإنسان في مسألةٍ من هذه المسائل أو نظائرها فإنه يردُّها إلى أصلِها، قال الخطابي رحمه الله: “وقوله: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن» أصل كبير في كثير من الأمور والأحكام إذا وقَعَت فيها الشُّبهة، أو عرض فيها الشكُّ، ومهما كان ذلك فإنَّ الواجب أن ينظرَ، فإذا كان للشَّيء أصلٌ في التحريم والتحليل فإنَّه يتمسَّك به، ولا يفارقه باعتراض الشكِّ حتى يزيله عنه يقينُ العلم”([2]).
كما بيَّن أيضًا أنَّ الحديث محمول على معنيين فقال: “وتأويل قوله: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن» على معنيين:
أحدهما: أن يكونَ ذلك في شيءٍ من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها مما يملكه الآدميون إذا تيقَّن أنَّ ذلك كان ملكًا له، فإنه على يقينِ ملكِه في ذلك، لا يزول عن أصله إلا بيقين زوالِ الملك، «والحرام بين»: هو مالُ غيرِه وامرأةُ غيرِه وخادمُ غيره، لا يستحلّ شيئًا من ذلك إلا بشرطه من نكاح أو ملك يمين أو هبة أو صدقة أو غير ذلك، وما بين ذلك فهو ما لم يتقدَّم له أصل من هذين الوجهين تحليل ولا تحريم يتيقَّنه، كالشيء يجِده في بيته وفي حيزه، فلا يدري هو ملكه أو مال غيره، فالورع أن يجتَنِبَه، ولا يحرم عليه أن يتناولَه؛ لأنَّ يدَه عليه قائمة، ومن هذا النحو قوله صلى الله عليه وسلم: «إني لأمرُّ بالتمرة الساقطة، فلا آخذها؛ خوفًا أن تكون صدقةً»، ورأى تمرة فقال: «لولا أني أخاف أن تكوني من الصدقةِ لأكلتُك»، وقد يشتبِه على الرجل في الليلة المظلمة فيطَأ جاريةَ غيره على أنها جاريتُه، فيكون ذلك شبهةً في حكم الحلال، ويلزمه في ذلك المهر، ولا يجوز أن يقال: إنه زانٍ، ولا يُحدُّ فيه، ولو لم يقدِم على ذلك حتى يتثبَّت في ذلك ويستبرئ الشكَّ فيه لكان قد استعمَلَ الورع واحتاط باليقين في أمره.
والمعنى الآخر: أن يكونَ الشيءُ الأصلُ فيه الإباحة أو الحظر، فما كان الأصل منه الإباحة كالماء الذي يتوضَّأ به والأرض التي يصلّى عليها ونحو ذلك من الأمور التي وُجِدت في أصل الفطرة على حكم الإباحة، حتى يطرأ عليها ما يغيِّرها عن حكمها الأول، فإنه لا يضيق في مذهب الورع استعماله على وجهه، ولا يُستحبُّ اجتنابه وإدخال الريب والشكّ على نفسه فيه، وما كان من ذلك في الأصل ممنوعًا لا يستباح إلا بشرائط وأسباب قد أخذ علينا مراعاتها فيه، وفي الاستمتاع به، كالبهيمة لا يحلّ أكلها إلا بالذكاة، وشرائطُها معلومة، والمرأة لا يحلّ نكاحها إلا بالعقد، وصفة ما يصحّ في العقد خصالٌ معدودة، فإنه لا يجوز استعمال هذا النوع منه، ولا الاستباحة له ما لم يوجد تلك الأسباب مستوفاة بكمالها، والورع في مثل هذا فرضٌ واجب”([3]).
وبعضُهم حمل الحرام على أنه لا بدَّ أن يكونَ بيِّنًا، وما لم يكن كذلك فهو المكروه.
وحاصل الكلام في المسألة: أنَّ الحرام هو ما استقرَّ في الشرع تحريمُه، والحلال هو ما استقرَّت إباحتُه، فلم يُنسَخا، فهما محكمَان مِن هذا الوجه؛ لعدم النسخ، ولاستقرارهما في الشرع، “فالمراد ما استقرَّ عليه الشرعُ من تحريم وتحليلٍ، وما نزل بيانه واضحًا بيِّنًا، وإليه أشار بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحلال بيِّن، والحرام بيِّن»، ولا شكَّ أن تحريم الربا والميتة والدَّمِ ولحم الخنزير بيِّن، ولا شكَّ أن تحليل الأكل من طيبات ما اكتسبنا وتزويج النساء حلال بيِّن، وإلى هذا وأمثاله أشار”([4]).
ثانيا المتشابهات:
مِنَ الواضحِ مِن خلال لفظِها أنها متشابهاتٌ لعدم اتِّضاح دلالتها، أو لتردُّدها بين معانٍ مختلِفَة، فيتحيَّر الناظرُ في إلحاقها بأيّهما، فبعض العلماء غلَّب الذريعةَ فألحقها بالحرام؛ لأنها وسيلتُه وتُفضي إليه([5])، وبعضهم توقَّف فيها، ورأى أنها مشتَبهةٌ، وتحتاج نظرًا خاصًّا، والعبرةُ بما يغلِب عليها من الشَّبَه، وقد لخَّص القاضي عياض الأقوالَ فيها فقال: “اختلَفَ الناسُ في ذكر المشتبهات، فقيل: مواقَعَتُها حرام، وقيل: حلال لكنه يتورَّع عنه لاشتباهه، وقيل: لا يقال فيها: حلال ولا حرام؛ لقوله عليه السلام: «الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات»، فلم يحكم لها بشيءٍ من الحكمين. وقوله: «لا يعلمها كثير من الناس» فقد دلَّ هذا أن ثَمَّ من يعلَمُها، فمَن علِمَها لا بدَّ أن يلحق عنده أحد الوجهين، فيكون لها حكمه. وما حصل عند العلماء في هذا الحدّ فقد خرج من المشتبه إلى البيّن، وإنما الكلام فيما لم يتبيّن لا في طريق ردّ، أو لم يظهر له دلالة لأحد الوجهين”([6]).
وهذه الأوجه التي ذكر عياض ذكر القرطبي خلاصَةَ الترجيح فيها، فقال: “المكلَّف بالنّسبة إلى الشرع: إما أن يترجَّح فعله على تركه، أو تركه على فعله، أو لا يترجَّح واحد منهما. فالراجح الفعل أو الترك؛ إما أن يجوزَ نقيضُه بوجه ما، أو لا يجوز نقيضه. فإن لم يجز نقيضه فهو المعلوم الحكم من التحليل؛ كحِلِّيةِ لحوم الأنعام. أو من التحريم؛ كتحريم الميتة والخنزير على الجملة. فهذان النوعان هما المرادان بقوله: «الحلال بيِّن، والحرام بيِّن». وأما إن جوز نقيض ما ترجَّح عنده: فإمَّا أن يكون ذلك التجويز بعيدًا لا مستند له أكثر من توهّم وتقدير، فلا يُلتفت إلى ذلك، ويُلغى بكلِّ حال. وهذا كترك النكاح من نساء بلدة كبيرة مخافةَ أن يكون له فيها ذات محرم من النسب أو الرّضاع، أو كترك استعمال ماء باقٍ على أوصافه في فلاة من الأرض مخافةَ تقدير نجاسة وقعت فيه، أو كترك الصلاة على موضع لا أثر ولا علامة للنجاسة فيه مخافةَ أن يكون فيها بول قد جفَّ، أو كتكرار غسل الثوب مخافة طروء نجاسةٍ لم يشاهدها، إلى غير ذلك مما في معناه. فهذا النوع يجب أن لا يلتفت إليه، والتوقّف لأجل ذلك التجويز هَوَسٌ، والورع فيه وسوسة شيطانيَّة؛ إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء، وقد دخل الشيطان على كثير من أهل الخير من هذا الباب؛ حتى يُعطِّل عليهم واجبات، أو يُنقص ثوابها لهم. وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية وأحكامها”([7]).
وهذه الخلاصة من الإمام أبي العباس القرطبي تخرج من ورطة الخلاف في المشتبهات: هل الورع تركها أو فعلها، لأن بها تفصيلًا يكون به الهدى ويتَّضح به الحقُّ إن شاء الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([4]) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 288).